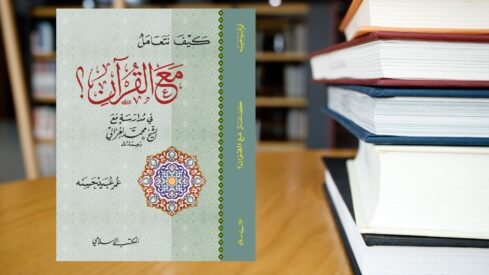تحتاج حياتنا الفكرية إلى محفِّزات لتحريك مياهها الراكدة، ولإحداث المفاعلة الثرية بين الآراء والعقول.. فهذا من شأنه تصحيح الرأي وتصويبه، وإثراء الفكر وتثميره، والكشف عن جوانب قد لا يلتفت إليها الإنسان بمفرده، أو قد يصل إليها بشيء من المشقة.
ولهذا من اليسير أن نرى الأشياء المادية تتضاعف حسابيًا بطريقة بسيطة حين تضاف لبعضها البعض؛ مثل: واحد زائد واحد يساوي اثنين.. لكننا في عالم الأفكار نكون أمام متتالية هندسية تتضاعف دون أن تتقيد بحدود؛ ففكرة على فكرة قد تنتج عشرات الأفكار!
كما أن المحاورة الفكرية تُكسِب النفسَ صفاتٍ حسنة، وتكشف لها عن بعض جوانب قصورها؛ فيزداد المرء تواضعًا وتهذيبًا.. لاسيما إنْ أُحيطت بجو هادئ لا صخب فيه ولا منافرة!
المحاورة الفكرية
ولعلنا نشير إلى أن المحاورة تمتد جذورها إلى ما كان يحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمين الوحي جبريل عليه السلام، في شهر رمضان من كل عام؛ حين كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وفي العام الذي قُبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآنَ مرتين (1) .
وفي تراثنا عُرفت المحاورة الفكرية- لاسيما المكتوبة، وهي المقصودة هنا- في مثل كتاب (الهوامل والشوامل) لأبي حيان التوحيدي؛ وهو فى الحقيقة كتابان لمؤلفَيْن كبيرين: أسئلة من أبى حيان التوحيدى سماها “الهوامل”، وأجوبة من مسكويه سماها “الشوامل” . ومعنى “الهوامل” الإبل السائمة يهملها صاحبها ويتركها ترعى، و”الشوامل” الحيوانات التى تضبط الإبل فتجمعها. وقد استعار أبو حيان كلمة الهوامل لأسئلته المبعثرة التى تنتظر الجواب، واستعمل مسكويه كلمة الشوامل فى الإجابات التى أجاب بها فضبطت هوامل أبى حيان؛ كما ذكر أحمد أمين في تقديمه للكتاب (2).
وحديثًا رأينا كتاب (كيف نتعامل مع القرآن) الذي جاء محاورةً فكريةً عميقةً بين الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، والأستاذ عمر عبيد حسنة حفظه الله؛ برعاية وتخطيط من المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وبتقديم بديع من الدكتور طه جابر العلواني رحمه الله.
وقد أعجبني أن يُصدَّر على غلاف الكتاب كلمة “مُدارسة”- التي تُذكرنا بجذورها وأجوائها النبوية- فكُتب وعلى عدة سطور: (محمد الغزالي/ كيف نتعامل/ مع القرآن/ في مُدارسة أجراها/ الأستاذ عمر عبيد حسنة).
وكتاب “كيف نتعامل مع القرآن” ليس مجرد أسئلة من الأستاذ عمر وأجوبة من الشيخ الغزالي؛ إنه “مدارسة” بكل معاني الكلمة ودلالاتها على المفاعلة والمحاورة والمثاقفة، وبما تدل عليه أيضًا من حسن التمهيد والتوطئة، وحسن التعقيب.. فضلاً عما اشتمل عليه الكتاب من محاور متعددة وأسئلة في مجالات شتى؛ فجاء كأنه “كشف حساب” أو تطواف شامل رأسيًّا وأفقيًّا؛ لأمرين:
- المشروع الفكري للشيخ الغزالي.
- هموم العقل المسلم المعاصر.
وإذا كانت ظروف الشيخ الغزالي الصحية أحدَ الدوافع لإخراج هذه المدارسة- وهو المكثر من التأليف، وتعرَّض لعدد كبير من محاور المدارسة في ثنايا كتاباته- فإنني أرى أن هذه المدارسة كانت ضرورية حتى لو لم تكن الظروف الصحية للشيخ حافزة عليها، ومانعة له من التطرق لموضوعاتها على النحو الذي خرجت عليه..
وقد جاءت المدارسة انطلاقًا من القرآن الكريم، ودورانًا مع هداياته، واستشفافًا لمعانيه، وإنصافًا لكلياته، واستحضارًا لمجمل الثقافة الإسلامية في أبعادها ومناحيها.. وذلك لمساعدة العقل المسلم على التخلص مما عطَّل إمكاناته، وشتَّت جهوده، وابتلاه بالنظر الجزئي لا الكلي، وباجترار الأفكار لا الإبداع.
فأصاب د. العلواني حين قال في تقديمه: إن المدارسة في الحقيقة هي محاولة لكسر هذا الطوق؛ فقد حاولت بعقل العالمين بغايات الدين ومقاصد الشريعة، وبوعي تام على التطورات التاريخية، التي أسرت انطلاقة الفقه الإسلامي بمعناه الشامل للفقه السياسي والدستوري وفقه العلاقات الاقتصادية والدولية- تحديدَ كيفية تأثير تلك التطورات التاريخية على موقف الأئمة والتزامهم ناحية فروع الفقه، كما التزم المحدثون برواية السنن وقضايا الإسناد. ومن خلال هذا التطور التاريخى يسعى الشيخ الغزالي لأن يستعيد للفقه مكانته التى تأثرت سلبًا بالواقع التاريخي، ويكشف هنا عن ثنائيات تعارضت، وما كان ينبغي لها ذلك في ظل الإسلام؛كثنائية الحكم والعلم، والفقه والتصوف؛ والتعارض بين الذين عكفوا على القرآن دون تتبع السنن، أو عكفوا على السنة دون التزام بموازين القرآن. وبمعنى آخر فإن المدارسة تكشف عن توجهات المتدارسين لتحقيق الاستقطاب الموحد لفعاليات الأمة الإسلامية وتوجهاتها ضمن إطار قرآني جامع، يتجاوز الثنائيات المتعارضة ويتعالى على الجزئيات؛ وذلك بهدف تحقيق القرآن العظيم لحضارة كاملة: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ} (النحل: 89) (3).
فكر قرآني حضاري
كما أوضح الأستاذ عمر عبيد في كتاب “كيف نتعامل مع القرآن” أن المدارسة حاولت الإسهام في “تقديم مجموعة ملاحظات يمكن أن تُعَد أساسًا لبناء فكرٍ قرآني قادر على الانطلاق باتجاه الشهود والإنجاز الحضاري، وإحياء موات الأمة”.
وأضاف: ما نقدمه في هذا الكتاب من “مدارسة” مع الشيخ الغزالي، نعتقد أنه عَرَضَ لمجموعة من الأمور المهمة، وقدم إضاءات جديدة على طريق بناء الفكر والثقافة القرآنية. ولا ندّعي بأننا استطعنا بهذه “المدارسة” تقديم أو إنضاج منهج للتعامل مع القرآن، والخروج بالمسلمين من حالة الهجر التي أورثتهم الأزمات الفكرية، والتي يعانون منها؛ فالوصول إلى منهج لفهم القرآن بأبعاده ومحاوره المتعددة ليكون مصدرًا للمعرفة، ليس بالأمر السهل الذي يمكن أن يتحقق بكتاب، أو حوار، أو مدارسة؛ ولكننا نستطيع أن نقول بكل اطمئنان: إننا استطعنا تقديم آفاق، ومؤشرات، ومعالم على الطريق، تثير وتستدعي كثيرًا من النظر والبحث والتأصيل (4).
وقد عبَّر الشيخ الغزالي عن أسفه لواقع أمتنا، وعجزها عن التعامل مع القرآني على النحو الذي يليق به، باعتباره وحيًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فقال: بقاء هذا القرآن هو العزاء الوحيد عن ضياع مواريث النبوات الأولى؛ لأنه استوعب زبدتها، وقدّم فى هداياته خلاصة كافية لها… لكن موقف المسلمين من القرآن الذي شرفوا به، يثير الدهشة!
وأضاف: مِن عدة قرون ودعوة القرآن مجمَّدة، ورسالة الإسلام كنهر جفّ مجراه، أو بريق خمد سناه..! والأمة التى اجتباها االله تتعامل مع القرآن تعاملاً لا يجوز السكوت عليه. كان الجاهليون الأقدمون يصمون آذانهم عن سماعه، ويتواصون بالشغب على مجالسه ويعالنون بتكذيب صاحبه، حتى شكا صاحب الرسالة إلى ربه هذا الكنود، قائلاً: {يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} (الفرقان: 30). أما المسلمون المتأخرون فهم يسمعون وقد يتأوّهون أو يسكنون، ولكن العقول مخدَّرة، والحواس مبعثرة، ومسالك الأفراد والجماعات في وادٍ آخر، وكأنها تُنادَى من مكان بعيد! الأمة المنتمية إلى القرآن مجهولة مستوحشة، والحضارة التي يصنعها لا تجد من يصوِّر معالمها بإتقان، ولا من يعبِّد طريقها بذكاء، ولا من يفتح لها دكانًا صغيرًا في سوق امتلأ بلافتات خداعة لسلع ما تساوى شيئًا، أو مذاهب باطلة بالتعبير الصريح. أهكذا يتصرف أصحاب الحقيقة مع الحقيقة التي شرفوا بها وانتموا إليها؟.
وفي إشارة للظروف التي أحاطت المدارسة، قال الشيخ الغزالي: جلست مع الأستاذ عمر عبيد حسنة نتشاكى تلك الحال، فقال لي: إن للقضية أبعادًا لا يبلغها النظر السطحي! وربما اشتبكت مع مخلفات قديمة من ثقافتنا التقليدية. وذكر الأستاذ أمثلة لما يراه موضوع بحث طويل فى هذا المجال، وأهاب بي أن أكتب. قلت له وأنا محزون: إنني في هذه الأيام أعجز عن الكتابة، وما عراني من مرض قيّد حراكي الأدبي والمادي. قال: فلنتدارس الأمر سويًّا، وأتولى أنا الشرح والصياغة. وعلمتُ أنه سيحمل العبء كله، ولم أرَ بدًّا من الاستجابة، داعيًا االله أن يلهمنا الرشد، وينير الطريق (5) .
ولعل هذه “المدارسة” تكون نموذجًا للمثاقفة والمحاورة المطلوبة في ميادين شتى، بين كبار المختصين والفاقهين لدين الله تعالى ولواقع المسلمين الذي يحتاج لأضعاف هذا العمل الفكري الثري..
([1]) في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ».
([2]) الهوامل والشوامل، تحقيق: أحمد أمين والسيد صقر، سلسلة الذخائر، رقم 68.
([3]) كيف نتعامل مع القرآن، ص: 10، 11، دار الوفاء، ط5، 1997م.
([4]) المصدر نفسه، ص: 22، 23.
([5]) المصدر نفسه، ص: 25، 26.