رواية “العطر” هي قصة محاولة الإنسان لأن يكون إلهًا معتمدًا على قدراته الذاتية والإمكانات العلمية، وهي المحاولة التي تؤدي به إلى أن يكون شيطانًا قديرًا لا أكثر.
رواية العطر نقطة تحول مهمة في حياة كاتبها، وفي مسار الكتابة الروائية معًا، فقد حولت السيناريست والكاتب المسرحي الألماني المغمور “باتريك زوسكيند” * إلى أحد أشهر الروائيين في العالم، إذ طُبع منها أكثر من مليونَيْ نسخة بلغات مختلفة، استقبلها القراء والنقاد بشغف وإعجاب متزايديْن، فرسختْ لهذا الاتجاه في الكتابة الواقعية الغرائبية المتكئة على أرضية معلوماتية لنص غير أدبي.
حكاية المستقبل
يستخدم الكاتب أسلوب الراوي العليم وروح المؤرخ في قَص روايته، وذلك في سرد متصاعدٍ زمنيًا منذ ميلاد البطل، يصبُه في قالب واقعي تقليدي، ليُوحي لنا بواقعية الشخصية التي يقدمها وتاريخيتها، وليبرر كل ما في الشخصية والرواية معًا من غرائبية، معتمدًا في ذلك على فيض من المعلومات غير الأدبية يفرش بها أرضية نصه الأدبي.
فليس عبثًا أن يبدأ الكاتب روايته هكذا: (في القرن الثامن عشر عاش في فرنسا رجل ينتمي إلى أكثر كائنات تلك الحقبة نبوغًا وشناعة، وهي حقبة لم تكن تفتقر إلى أمثال هذه الكائنات، وقصة هذا الرجل هي ما سنرويه هنا، كان اسمه “جان باتيست غرنوي”، وإذا كان اسمُه اليوم قد طواه النسيان -على نقيض أسماء نوابغ أوْغادٍ آخرين، مثل “دوساد”، “سان جوست”، “فوشيه”، أو “بونابرت” وغيرهم- فذلك بالتأكيد ليس نتيجة أن “غرنوي” -بمقارنته مع هؤلاء الرجال المريبين الأكثر شهرة- يقل عنهم تعاليًا واحتقارًا للبشر ولا أخلاقيةً -باختصارٍ: كُفرًا- وإنما لأن عبقريته وطموحه قد انحصرا في ميدان لا يخلف وراءَه أثرًا في التاريخ، أي في ملكوت الروائح الزائل).
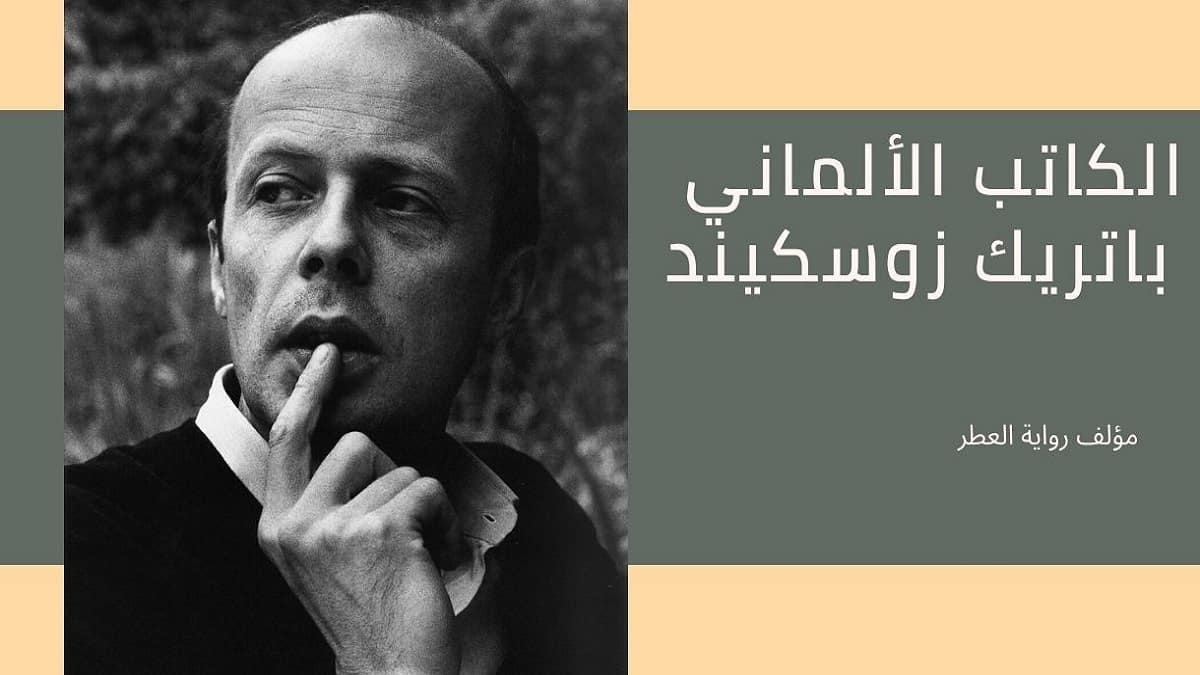
فالكاتب هنا يتحدث بروح المؤرخ، ويستخدم بعض الحيل الأسلوبية ليؤكد هذه السمة، كأن يحكي كل ما سيحدث لبعض شخصيات العمل حتى نهاية حياتهم بعد أن يكون دورُهم الروائي -أي علاقتهم بالبطل- قد انتهى بالفعل.
ومن حيله كذلك أن يستبق بعض الأحداث في حياة البطل، وأن يشير إلى أحداث تاريخية تحدث متزامنة مع أحداث الرواية، كالحروب والاحتفالات الملكية، وانهيار جسور وبناء غيرها… إلخ. كما يستخدم الكاتب كما هائلا من المعلومات التي تخص عالم الروائح ودباغة الجلود، ليجعلها أرضية يتحرك فوقها بناؤه الروائي، حيث يصبح لكل شيء رائحة مميزة، الطفل غير الرجل، والعذراء غير المتزوجة، والخشب بأنواعه، والبحر، والشوارع، والمباني… إلخ.
الرائحة بصمة الروح
يحدد الكاتب زمن روايته بالقرن الثامن عشر، وميلاد بطله بالسابع عشر من يوليو 1738، وهذا الاختيار يعود لثلاثة أسباب رئيسة، السبب الأول: أنك عندما تتحدث عن الماضي، وبالذات الماضي البعيد يمكن أن تحكي أي شيء مهما تكن غرابته على أنه قد حدث بالفعل، وهو ما يسعى الكاتب إلى تأكيده. السبب الثاني: أن الكاتب جعل بطله يعيش في عالم الروائح فاختار له القرن الثامن عشر حيث “لم يكن الإنسان قد توصل إلى وضع حد للتفاعل التحللي للبكتريا، ونتيجة لذلك لم تكن هناك أية فعالية بشرية، لا البناءة منها ولا المخربة، دون رائحة، كما لم يكن هناك أي تفتح على الحياة أو اندثار لها دون أن ترافقه رائحة”.
السبب الثالث: أن القرن الثامن عشر هو العصر الذي وصل فيه إيمان الإنسان بالعلم وبالقدرة الإنسانية إلى ذروته، فلنرجع إلى الأسماء التي استخدمها الكاتب في مفتتح روايته، وإلى أسماء أخرى وردت في الرواية، كـ”فولتير” و”روسو”، هذا العصر الذي أخذ فيه الإنسان يبتعد عن الدين والإيمان بل ويحاربهما اعتمادًا على قدرته الذاتية، هو أنسب لعصر لميلاد “غرنوي” بطل “العطر” الذي يسعى إلى امتلاك العالم والسيطرة عليه معتمدًا على أنفه، وأنفه فقط!.
اكتشاف شرور الذات
رغم طول رواية العطر (تبلغ 270 صفحة من القطع المتوسط) فإن أحداثها ليست كثيرة جدًا، أقصد الأحداث على المستوى الخارجي، فـ”غرنوي” يولد في السوق تحت عربة سمك، وهو ابن سفاح، تقرر أمه أن تتخلص منه كما فعلت بسابقيه، لكنه يقتلها عندما يصرخ، فيكتشف الناس وجوده، فيتم إعدام الأم، ثم تتكفل به الكنيسة، وترفضه المرضعات لأنه جشع عند الرضاعة، ولأنه بلا رائحة! حتى تقبل به مدام “غايار” صاحبة الملجأ لأن الكنيسة تدفع جيدًا، ولأنها فقدت حاسة الشم. ثم تتخلص منه مدام “غايار” عندما تكتشف أن له قدراتٍ خاصة، فهو يكتشف الدودة في القرنبيط، والنقود خلف دعامة المدفأة، والناس عبر الجدران، وعن بعد.. فتظن أنه بصير، ولهذا فهو جالب للشؤم، فتتخلص منه بأن تسلمه إلى “غريمال” دباغ الجلود، حيث يتعلم “غرنوي” كل شيء عن هذه الحرفة بقدراته الذاتية.
ثم يفرض نفسه على “بالديني” أشهر عطار في باريس ليعمل مساعدًا له، فينقذه من الإفلاس باختراعه لعطور جديدة، ويتعلم عنده الأصول العلمية للتقطير وصناعة العطور، ويحصل على رخصة كمساعد عطار، وهكذا يصبح أنف “غرنوي” العجيب القادر على التقاط أي رائحة وتحليلها إلى المواد المكونة لها، والقادر على إعادة تركيب هذه الروائح جميعًا في مخيلته الأنفية وإنتاج ما لا يخطر ببال أو بأنف بشر من روائح، يصبح هذا الأنفُ مثـقفًا قادرًا على استخدام كل الوسائل العلمية المتاحة في عالم الروائح في ذلك الوقت، فيزداد إيمانه بنفسه وبقدرته الخاصة، ويسعى بالتالي إلى وضع نظرية فلسفية تجمع شتات القدرات والمعلومات المتاحة له، نظرية “روائحية” بالأحرى، ويعثر على “المبدأ الأعلى الذي يجب على الروائح الأخرى أن تصنف نفسها وفقه.
يعثر عليه في رائحة فتاة عذراء، يجد أن تركيب عناصر رائحتها جعل لها عطرًا “هو من الثراء والتوازن والسحر بحيث أن كل العطور التي سبق له أن شمها، وكل تراكيب الروائح التي ابتدعتها مخيلته بدت له فجأة خواءً جافًا”، فخنقها دون أن ينظر إليها، لم يكن يهمه شكلها، كان كل ما يسعى إليه هو امتلاك عطرها إلى الأبد.
الحُب القاتل
يغادر “غرنوي” باريس، هاربًا من عالم البشر الذين يكرههم ويكره رائحتهم “فرائحة الجسم البشري عادةً إما أن تكون بلا نكهة، أو مقززة بائسة. روائح الأطفال تكون غير محددة، وروائح الرجال بولية ممتزجة برائحة التعرق اللاذعة والجبن، والنساء تفوح منهن رائحة الزنخ والسمك الفاسد”!.
وعلى قمة جبال سنترال بمنطقة “أوفيرج” يعيش “غرنوي” سنوات من السعادة، وحيدًا في كهف، في ملكوت الروائح الخاص به مُتألـهًا، لا يشم رائحة بشر. ثم يكتشف المأساة، أنه هو شخصيا بلا رائحة، فيقرر ترك عالمه، والنزول إلى عالم البشر للعثور على رائحته الخاصة/ذاته المفقودة، ويعمل في ورشة لصناعة العطور بمدينة “غراس”، أحد أهم مراكز صناعة العطور في ذلك الوقت. ويتعلم كيف يحصل على العطر الخاص بالإنسان بأن يلف الضحية بقماش مدهون قادر على امتصاص رائحتها، ثم يقطره بعد ذلك لاستخلاص هذه الرائحة.
وفي “غراس” يقتل الفتيات الخمسَ والعشرين الأجمل في فرنسا، ويصنع من عطورهن عطرًا رائعًا، لكن ينكشف أمره قاتلاً، وفي لحظة إعدامه يصب على نفسه قطرة واحدة من العطر فيجن جنون الجميع.. يعشقونه! ويعرض عليه والد إحدى القتيلات أن يكون ابنه ووريثه.
ويخرج من “غراس”، ليصل إلى “مقبرة الأبرياء” بشارع “أوفير”، مأوى اللصوص والقتلة والعاهرات والجانحين والهاربين من الجيش، أي كل أنواع السفلة، ويصب على نفسه قارورة العطر الثمين، فينسكب عليه الجمال فجأة كنارٍ متأججة. يرَوْنه كملاك، يهجمون عليه، يرمونه أرضًا، ويمزقونه قطعًا صغيرة، يأكلونه حتى يختفي أثره تمامًا..! “كانوا فخورين إلى أقصى حد، فلأول مرة في حياتهم فعلوا شيئًا عن حب”.
يحاول “غرنوي” امتلاك العالم بامتلاك رائحة هذا العالم، غير عابئ بأي إيمان أو أخلاق أو ضمير… إلخ، فكلها كلمات لا معنًى لها عنده، فهو يريد من البشر عندما يشمون رائحته أن يركعوا “كما يركعون أمام بخور الرب المقدس البارد، بمجرد شمهم رائحته، رائحة “غرنوي” الذي يبغى أن يكون رب الروائح كلها”.
وهو عندما ينجح في امتلاك ما يريد يتوجه بالشكر لنفسه، وليس للإله: (أشكرك يا “جان باتيست غرنوي” لأنك على ما أنت عليه)، لذلك فهو ملعون بطول الرواية وعرضها، منذ ولادته يحرص الجميع على عدم ملامسته دون أن يعرفوا السبب، ولا يحب البشر ملامسته لدرجة التهامه إلا عندما يمتلك عطرًا بشريًا، وكل من يستفيد منه بشكلٍ ما تنتهي حياته بالخسران المبين، بداية من مدام “غايار”، حتى الدباغ، و”بالديني” العطار، فالتعاون مع الشيطان قد يكون مفيدًا لقصار النظر على المدى القريب، لكنه في النهاية هو الخسارة بعينها، إن “بالديني” ينسى الصلاة لأول مرة في حياته في الليلة التي يؤوي فيها “غرنوي” في بيته.
تحدٍ غير متكافئ
في الرواية زمن خارجي يمضي يومًا وراء يوم، وعاما بعد آخر، وزمنٌ آخر نفسي يعيشه “غرنوي” داخل أنفه وقدراته العجائبية، الزمن النفسي يحاول أن ينتج ويبدع ما يقفز بـ”غرنوي” فوق الزمن الخارجي، يعوض النقص والكراهية، ويحقق الإحساس بالتفوق، فـ”غرنوي” (الشيطان)، أو العلمُ غير المرتبط بأخلاق ولا دين -تبعًا لهذه القراءة- يحاول فرض زمنه الخاص على زمن الرب. قد ينجح، أو يظن أنه نجح في بعض المراحل، لكنه في النهاية يتلاشى في بطون السفلة، المأوى الطبيعي لأمثاله، وكأن الكاتب يشير إلى الثورة العلمية والفكرية الحديثة في أوروبا، لأنها بدأت متطرفة بالحرب ضد الدين، والإيمان المطلق بالإنسان، انتهت نهايتها الطبيعية إلى المزبلة، فما نراه الآن هو تطور في القدرات، وأهمها القدرات الهدامة لإمكانات الإنسان الروحية ولحياته، وفي المقابل اضمحلال للإيمان والأخلاق.
أرى أن الكاتب انطلق من مقولة “ماذا يفيد الإنسان لو امتلك العالم وخسر ذاته؟”. وذاته في هذه الرواية هي رائحته، فـ”غرنوي” يمتلك العالم بامتلاك أسرار هذا العالم (رائحته) اعتمادًا على علمه المتمثل في معمل اختباره العجيب (أنفه)، واعتمادًا على إيمان مطلق بقدراته الخاصة، لكنه هو نفسه “غرنوي” بلا رائحة، بلا أخلاق، بلا ارتباط بما هو أسمى. امتلك الإنسانُ العالمَ وخسر ذاته، فوصل إلى ما يعانيه الآن من صراعات وحروب وضياع نفسي وأخلاقي. ورواية “العطر” صرخة تحاول تنبيه هذا الإنسان ليعدل مساره، قبل أن تضيع الإنسانية كلها كما ضاعت الشخصيات التي استفادت من “غرنوي” لفترة قصيرة، ثم خسرت إلى الأبد.
منير عتيبة
* باتريك زوسكيند، مولود في 26-3-1949 في بلدة “إمباخ” على بحيرة شتارنبرج الواقعة على سفوح جبال الألب، درس التاريخ في جامعة ميونخ بين 1968و1974، كتب عددًا من القصص والسيناريوهات السينمائية، بدأت شهرته سنة 1981 بمسرحية مونودراما من فصل واحد بعنوان “عازف الكونتراباس” حيث قدمتها معظم المسارح الألمانية والأوروبية، جعلت منه رواية العطر كاتبا عالميا، فقد ترجمت إلى 20 لغة، وحصل بسببها على جائزة “غوتنبرج” لصالون الكتاب الفرانكفوني السابع بباريس عام 1987.

















