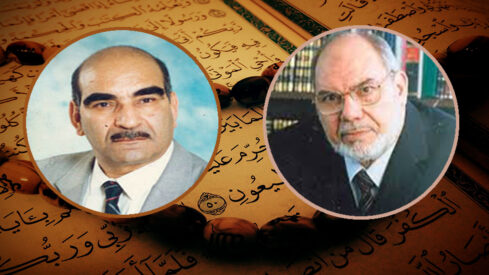فأجأنا الدكتور الجابري بمقالته –في صحيفة الاتحاد الإماراتية- والتي اعتمد فيها على موضوع مختلف فيه أفرزته ظروف معيَّنة، وينتهي جُملةً وتفصيلاً إلى أفكار السجال والصراع التي نشأت في بعض فترات التاريخ الإسلامي، ألا وهي فكرة نسخ القرآن. ففكرة النسخ فكرة خلافية قديمة طُرحت على العقل المسلم باعتبارها تحديًا من تحديات الثقافة الشفوية التي كانت سائدة في بعض المناطق العربية في عصر التنزيل، وعززتها اتجاهات السجال التي جرت بعد ذلك بين بعض الطوائف والفرق الإسلامية بعد حدوث الفرقة وبروز الاختلاف.
وقد استُغلَّ نسخ القرآن في تلك الفترات من مختلف المتساجلين وجرّ إلى بروز بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمختلقة المقتبسة من الثقافة الشفوية ومن التراث الموبوء الذي دخل مجالات تفسير القرآن وانتقل منه إلى علوم القرآن ثم إلى علم أصول الفقه.
ومع أن أهل العلم قد أعطوا تفسيرات عديدة لنظرية النسخ، واختلفوا فيه اختلافًا كبيرًا: في حقيقته، ومعناه، وكيفية الحكم به، وما إذا كان قضية مفترضة جائزة عقلاً أو أنها مع جوازها العقلي كانت قد وقعت. وأكثر الناسُ فيها كثيرًا، وذهبوا فيها مذاهب شتى ولا نستطيع أن نتصور باحثًا في مثل وزن الدكتور الجابري قد فاته ذلك الأمر أو الجدلُ فيه. كما لا نظنّ أن باحثًا يحترم نفسه ويعرف التراث الإسلامي حق المعرفة، ويقف منه موقف الناقد، لا يدري أن هذه القضية لا تدل –لا من قريب ولا من بعيد- على تحريف القرآن الكريم. فقد يكون التحريف شيئًا يمكن أن يُردَّ به على القائلين ببعض أنواع النسخ مثل الرواية الهزيلة: رواية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله) التي نسبوا إلى عمر -زورًا- أنه قال بأنها كانت مما يُقرأ في سورة “الأحزاب”، وهي نسبة لا يمكن أن تصحّ بأي حال من الأحوال، ولكنها قُبلت!. وحقيقة الأمر أن هذا النص (الشيخ والشيخة إذا زنيا..) هو نص من التوراة، وما يزال موجودًا بألفاظ مختلفة في أكثر من سفر من أسفارها. والذين نسبوه إلى القرآن كانوا مخطئين.
وحتى لو صحّت أية رواية من تلك الروايات بأنه كان هناك نصٌّ بهذا اللفظ أو قريبٍ منه لمجرد أن الرواية قالت: “كان فيما أنزل”، و”ما أنزل” هنا يمكن أن يُراد به، ما أنزل في التوراة أو ما أنزل في القرآن، أو الإنجيل. وحمله على أنه كان مما أنزل في القرآن حملٌ خاطئ لا يصحّ وإن تبنّاه بعضهم. ولا نطنّ أنّ مثل الدكتور الجابري – الذي نَقَد العقل: تكوينه وبنيته- يُعجزه أن ينقد نظرية نسخ القرآن ويبيّن كيف شاعت ويقوم بتفنيدها، بدلاً من أن يقفز إلى القول بما قد يلزم عن بعض الأقوال الواردة فيها.
ولتجلية هذا الأمر الذي كنّا نتمنى ألا يسقط أحد – في مستوى الأستاذ الجابري وفي هذه المرحلة من حياة الأمة – في إثارته على المستوى العام، وأن يبقى في دوائر أكاديمية قادرة على ممارسة النقد والتفكيك والتركيب، ولها مران وخبرة وقدرة على دراسة ومناقشة أمثال هذه القضايا. ولقد كتبنا دراسة في هذا الأمر أثبتنا فيها وبشكل نحسبه علميًّا خطأ القول بهذه النظرية، وناقشنا بتفصيل وإسهاب وبأسلوب أكاديمي -يعرفه المتخصصون- هذه القضية، وشرحنا جميع الروايات التي هوّل الجابري بها، وأسرج لها خيله وركابه، واعتبرها أدلة وهي أوهن من بين العنكبوت ليثبت بها دعوى يصعب علينا أن نجد لها تأويلاً وعوزًا في هذه المرحلة إلا الرغبة بالانضمام إلى ركب بابا الفاتيكان وأصحاب الصور الكاريكاتورية والجوقة البوشية في مهاجمة القرآن ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والشريعة الإسلامية، ومصادر التشريع والتنظير، وكأنها فرصة يجدها الغزو الخارجي والطابور الخامس الداخلي للإجهاز على مقومات الإسلام وحقائقه، غير مدركين أنهم بذلك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
ولكي نضع القّراء الكرام في صورة المسألة، ونوضح لهم بالتفصيل الدقيق ما أجلب الجابري عليه بخيله ورَجِله دون أن يكلف نفسه عناء التوضيح والبيان، بل اكتفى بإطلاق الدعوى المفتراة، لتفعل فعلها في عقول العامة وليكون الطوفان ما دام ذلك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الشهرة للكاتب وإلى إعلان انضمام للأجواق المعادية لهذا الدين وأهله، فنقول وبالله التوفيق:
لمن نشغل القراء بالاختلافات الكثيرة حول حقيقة “النسخ” ومعانيه، فلقد نطقت بذلك كتبنا الأصولية، وفي مقدِّمتها كتاب “المحصول” – بتحقيقنا – وكتب “علوم القرآن”. ولذلك فإننا سنتجه فورًا إلى مناقشة ما بنى الجابريّ عليه دعواه:
من أين جاء الخلل؟
إنَّ القول بالنسخ، وتأكيده بالشكل الذي نراه لدى علماء القرآن وجمهرة علماء الأصول إنَّما نجم عن أسباب كثيرة إضافة إلى ما أشرنا إليه سابقا، لعل من أبرزها تلك الروايات التي سبقت إلى الأذهان واستقرت فيها، وانشغلت بها العقول والقلوب زمنا طويلا حتى صارت مسلَّمات ضروريَّة، وأكثر الرواة من ترديدها وذكرها حتى صارت شهرتها صارفة عن البحث في صحتها من عدمها. إضافة إلى أسباب أخرى:
أولها: عدم الالتفات بقدر كاف إلى “الوحدة البنائيَّة” للقرآن المجيد؛ باعتبارها محدِّدًا منهاجيًّا، بل وضعت في إطار الفضائل، وشاعت قراءته مفرَّقاً، مجزءًا كأنّه أعضاء مفرَّقة، ومما ساعد على شيوع هذا النوع من القراءة انصراف الأذهان إلى الأحكام الفقهيَّة الجزئيّة في الوقائع الجزئيّة، وسيادة الفكر الثنائي التقابليّ بدافع من التفكُّر الفقهيّ الجزئيّ والانفعال بالمأثور، وعدم ملاحظة منطق القرآن ومحاولة الكشف عنه وبناء منهجه، وقد قاد ذلك –كلُّه- إلى الوقوع في براثن هذه الآفة آفة النسخ، وتحويل “النسخ” إلى علم من علوم القرآن ألقى على القرآن المجيد كثيراً من الظلال القاتمة.
ثانيا: عدم تحديد مفهوم “النسخ” تحديداً دقيقاً، فلو أنَّ المتأخرين التزموا بما فسّر المتقدمون “النسخ” به لما وقع ذلك الاضطراب الشديد الذي نشهده في هذه القضيّة لدى علماء القرآن والأصوليين ومن بعدهم لدى الفقهاء والمفسّرين.
ثالثا: لقد اعتبر المتقدِّمون “النسخ” بمعنى “النقل” أو حقيقة في النقل فحسب، فالنّص الذي يشير إلى الانتقال من حالة إلى أخرى عدوه ناسخاً لما سبقه، إذا كان تخصيصاً لعام أو تقييداً لمطلق أو بياناً لمجمل، مثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً} (الزمر:53) وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} (النساء:116) وقوله: {وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً ثُمَّ اهْتَدَى} (طه:82) فالنسخ -عندهم- لا يعدو أن يوجد نصَّان يردان – في ذهن الفقيه – على قضية واحدة، أحدهما أو السابق منهما- بالذات- يدل على حكم في حالة، واللاحق يدل على انتقال عن ذلك الحكم، وتَحَوَّل في تلك الحالة إلى إطار الأمور الثلاثة التي ذكرنا (التقييد والتخصيص والبيان)، فهو أمر لغويّ يدور أحياناً على أدوات التخصيص اللّغويّ داخل الآية الواحدة، أو تقييد المطلق، وبيان المجمل في آيتين، فجاء المتأخِّرون ليضيفوا إليه المعاني التي جعلتنا في مقدمة هذه الدراسة نعتبر “النسخ نظريَّة” لا مصطلحاً، وقد شجَّع على ذلك النظر الجزئيّ، وظهور فكرة ومقولة “تناهي النصوص وعدم تناهي الوقائع”(1)، وحصر آيات الأحكام بعدد قيل: “240، وقيل 340 وقيل خمسمائة”، وكذلك حصر أحاديث الأحكام، فقيل: خمسمائة بقدر الآيات، وقيل: تسعمائة، وقيل ألف ومائة… إلخ.
رابعا: في إطار ثقافة المأثور شاع ظنُّ ارتباط القرآن ببيئة النزول وبالمخاطبين في تلك البيئة. واعتبروا عصر القرآن عصر زمن الرسالة، والمطلوب تعميم الفهم الذي وقع للصدر الأول، لا تجدُّد فهم النّص وتجدُّد المخاطبة به في كل عصر وقرن، ولعل قول الشاطبي بعدم جواز فهم شيء من القرآن خارج دائرة فهم القرون الثلاثة الخيِّرة قد بناه على ذلك التصور وهو تصور فيه نظر(2).
الإسراف في دعاوى نسخ القرآن
لقد أسرف الأصوليُّون والكاتبون في علوم القرآن في دعاوى النسخ إسرافاً جاوز الحدود، وتباروا في بناء دعائمه وأركانه، ولعل بعضهم كان يتحرى ما يزيد به على سابقيه من دعاوى، وكأنّه نوع من الاجتهاد والكشف العلميِّ يتبارون فيه ويتسابقون إليه.
ونظرة سريعة على إحصاء لقضايا نسخ القرآن في بعض كتب هذا الفن والكتب التي تتناول أساساً بعض أنواع النسخ، وهو ما نسخ حكمه وبقي رسمه، باعتباره أكثر الأقسام وقوعاً عندهم يبيِّن إلى أي مدى انشغل العلماء بهذه القضية، وكم أنفقوا من الجهود الغالية المضاعفة فيها ومن هذه الكتب:
1. كتاب قتادة بن دعامة ت 117، عالج حوالي (40) قضية نسخ.
2. كتاب محمد بن حزم ت 978 (وهو غير ابن حزم الظاهري): (214) قضية.
3. كتاب أبي جعفر النحاس ت 245: (134) قضية.
4. كتاب هبة الله بن سلامة (213) قضية في الموضوع.
5. كتاب مكي بن أبي طالب (195) قضية.
6. كتاب ابن الجوزي (148) قضية.
7. كتاب العتائقي: (224) قضية.
8. كتاب ابن البارزي (249) قضية(3).
أما السيوطي في الإتقان فقد حصر نسخ القرآن في عشرين قضية، وأقام الأدلة عليها، ثم نظم قصيدة فيما ترجح لديه، ومطلع نظمه:
وقد أكثر الناس في المنسوخ من عـدد وأدخلوا فيه آيًا ليس تنحصـروهاك تحرير آي لا مزيد لهـــــا عشرين حررها الحذاق والكبر(4)
وحصرها الشيخ أحمد شاه دهلوي (المتوفى سنة 1179) في خمس آيات فقط(5)، ناقضاً ما أورده السيوطي في الإتقان، وحصرها الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في حوالي تسع آيات فقط(6)، وحصرها الدكتور مصطفى زيد في ست آيات فقط(7)، وهذا التباين الواسع يوضح مدى ما تحتاجه قضية النسخ ومسائلها المختلفة إلى جهد لتحرير قضاياه، ونفض اليد منه، وتنقية مقرّرات التعليم منها نهائيًّا وإلى الأبد.
وجهة مقابلة
وقد شعر غير واحد من أئمة المتقدمين بمدى حاجة هذه القضية الخطيرة إلى تحرير وتنقيح، فهذا الإمام مكي بن أبي طالب، يقول: “اعلم أنَّ أكثر القرآن في أحكامه وأوامره ونواهيه ناسخ لما كان عليه من قبلنا من الأمم، وقد أدخل أكثر المؤلفين في الناسخ والمنسوخ آياً كثيرة، وقالوا: نسخت ما كانوا عليه من شرائعهم، وما اخترعوه من دينهم وأحكامهم، وآياً كثيرة ذكروا أنَّها نسخت ما كانوا عليه مما افترض عليهم، وكان حق هذا ألا يضاف إلى الناسخ والمنسوخ، لأنَّا لو اتبعنا هذا النوع لذكرنا القرآن كلَّه في الناسخ والمنسوخ”!!.
وهذا ابن الجوزي يقول في مقدِّمة كتابه: “أمَّا بعد فإنَّ نفع العلم بدرايته، لا بروايته. وأصل الفساد الداخل على العلماء: تقليد سابقيهم، وتسليم الأمر إلى معظَّميهم من المتقدِّمين، من غير بحث عما صنَّفوه، ولا طلب للدليل عما ألَّفوه، وإنيِّ رأيت كثيراً من المتقدِّمين على كتاب الله -عز وجل- بآرائهم الفاسدة… ثم إني رأيت الذين وقع منهم التفسير صحيحاً قد صدر عنهم ما هو أفظع فآلمني، وهو الكلام في الناسخ والمنسوخ، فإنَّهم قد أقدموا على هذا العلم فتكلموا فيه، وصنّفوه، وقالوا بنسخ ما ليس بمنسوخ ومن نظر في كتاب الناسخ والمنسوخ للسدي رأى التخليط والعجائب، ومن قرأ كتاب هبة الله المفسر رأى العظائم، وقد تداوله الناس لاختصاره..(8)”(9).
ويقول بعد أن ذكر ما زعمه جماعة من المفسرين في حصر السور التي تضمنت الناسخ والمنسوخ قال: واضح بأنَّ التحقيق في الناسخ والمنسوخ يُظهر أنَّ هذا الحصر تخريف من الذين حصروه) 10).
ويقول السيوطي: “إنَّ الذي أورده المكثرون أقسام: قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا علاقة له بهما بوجه من الوجوه، وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ ومنه قوله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (البقرة:221) قيل: إنه نسخ بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} (المائدة: 5) وإنما هو مخصوص به، وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهليَّة، أو في شرائع من قبلنا أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن، كإبطال نكاح نساء الآباء، ومشروعيَّة القصاص والدية وحصر الطلاق في الثلاث، وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب، ولكن عدم إدخاله أقرب، وهو الذي رجحه مكيٌّ وغيره ووجَّهوه بأنَّ ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع القرآن منه؛ إذ كلُّه أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب. قالوا: وإنَّما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية فإذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفير مع آيات الصفح والعفو إن قلنا إنَّ آية السيف لم تنسخها(11).
وقال ابن العربي: قوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} (التوبة:5) ناسخة لمائة وأربع عشرة آية، ثم صار آخرها ناسخاً لأولها وهي قوله تعالى: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَواةَ وَءاتَوُاْ الزَّكَواةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (التوبة:5) قالوا: وليس في القرآن آية من المنسوخ ثبت حكمها ست عشرة سنَّة إلا قوله في الأحقاف: {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ} (الأحقاف:9) وناسخها أول سورة الفتح. قال ابن العربي: ومن أغرب آية في النسخ قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ} (الأعراف:199) أولها وآخرها منسوخان ووسطها محكم(12)!! فتأمّل!!
وهذا التصور لحدوث النسخ في الآية الواحدة تصور يعارض مفهوم “النسخ” ذاته، وكما فهموه من حيث هو إبدال آية مكان آية، من جهة أنَّ الآية الأولى {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ..} (التوبة:5) تأمر بقتل المشركين بعد نهاية هذه الأشهر إلا إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وليس في هذا الشرط نسخ أو تغيير في الحكم.
أما الآية الثانية: {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ} (الأحقاف:9) فهي حوار مع أهل مكة كما يتضح من سياقها داخل السورة، فهي آية مكيَّة لا علاقة لها بأول سورة الفتح المدنية التي نزلت عند الانصراف من الحديبية نوعاً من البشارة للنبيِّ –صلى الله عليه وآله وسلَّم- والمسلمين، والآية تدل على أنّ “عدم دراية النبيّ” تنصب على نتائج علاقته بقومه التي ساءت بسبب الدعوة بدليل قوله: “إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إليّ وَمَآ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ” (الأحقاف:9) كما أنَّها توكيد لبشرَّيته –صلى الله عليه وآله وسلَّم- وبيان أنّه بشر مثلهم ولكنّه بشر رسول، شأنه شأن بقيّة المرسلين الذين اصطفاهم الله –تعالى- وهم يدعون الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده وعبادته، لا لأنفسهم، والله –تبارك وتعالى- هو المتصرّف الأوحد في شئون عباده كافّة ومنهم الرسل والله –تبارك وتعالى- قد أمره أن يقول لأهل الكتاب: {وَإِنَّا أو إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} وهو على يقين أنّهم على ضلال مبين وأنّه على هدى، فذلك أسلوب خطاب لا علاقة له بالأحكام.
والقول في الآية الثالثة {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ} (الأعراف:199) بأنَّ أولها منسوخ بالزكاة وآخرها منسوخ بالأمر بالقتال قول لا يستقيم، بل هو من قبيل التزيّد، بل المجازفة التي لا سند لها ولا يليق ذكرها وتدوينها في مباحث القرآن المجيد، وتداولها بين الباحثين فيه.
بقاء ما ادُّعي نسخه في القرآن
وإذا فرضنا قبول نظريَّة النسخ –على سبيل الإجمال والتنزل– فلماذا بقيت الآيات التي زعم الزاعمون نسخها في القرآن تتلى فيه ويتعبَّد الناس بتلاوتها مثلها مثل سائر آيات القرآن الكريم، ما دامت قد فقدت وظيفتها التشريعيَّة وحكموا بنسخها – ولم يبق منها – حسب زعمهم – إلا ألفاظ مفرغة، حيث إن ما اشتملت عليه من تشريع هو أساس التعبُّد بها؟!
لقد ذهب بعضهم إلى أنَّ بقاء النصوص المنسوخة إلى جانب النصوص الناسخة يعد أمراً ضروريًّا؛ وذلك لأنَّ حكم المنسوخ يمكن أن يفرضه الواقع مرة أخرى(13)، وقد أدرك العلماء ذلك حين ناقشوا موقف النّص بين أمر المسلمين بالصبر على أذى الكفار وبين أمره بقتالهم، وقالوا: إنَّ الأمر بالصبر من قبيل “المنسأ”(14) الذي يتأجل العمل به، أو يلغى إلغاءً مؤقتاً أي: انتظارًا لتغير الظروف – وهو ما يعرف عندهم بإيقاف العمل بالنّص لعدم وجود المحل، كما قالوا في سقوط غسل الرجلين أو مسحهما في الوضوء عن فاقد قدميه – فإذا عادت الظروف إلى ما كانت عليه قبل ذلك عاد حكم المنسأ إلى الفعاليَّة والتأثير، فكان كل أمر يرد يجب امتثاله في وقت مّا لعلة مّا توجب ذلك الحكم.
ثم ينتقل عنه بانتقال تلك العلّة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنَّما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أو العمل به أبداً..، قالوا: ومن هذا قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} (المائدة: 105) ومثله قوله تعالى {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ} (الكافرون:6)، حيث إن مثل هذه الآيات نزلت والجماعة الإسلاميَّة في طور التكوين، فهي في حاجة لأن تصرف كامل عنايتها لعمليَّة التكوين والبناء الذاتيّ قبل أن تنطلق لدعوة الآخرين، فلما تمّ بناء الجماعة وكمل تكوينها الذاتي وصارت قادرة على حمل الرسالة إلى الآخرين والشهود بها عليهم، نزلت الآيات الموجِّهة لهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيصال الهدى والنور إلى سواهم.
ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلَّم- في قوله: “بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ“(15) ينسأ التكليف بحمل الرسالة إلى الآخرين بالشكل الجماعيّ، وقال -صلى الله عليه وآله وسلَّم- “حتى إذا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كل ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ”(16) (يَعْنِي اهتم بإصلاح نفسك). وهو -سبحانه وتعالى- حكيم أنزل على نبيه – صلى الله عليه وآله وسلَّم- حين كانت الأمَّة في طور تكوينها ما يليق بتلك الحال، رأفة بمن اتَّبعه ورحمة، إذ لو وجبت لأورث ذلك حرجاً ومشقة؛ لأنَّه من قبيل “تكليف ما لا يطاق”، فلما تم بناء الجماعة والأمّة، وأصبحت قادرة على حمل الأعباء ودعوة الأمم والتفاعل معها أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة من مطالبة الكفار بالإسلام، أو بأداء الجزية إن كانوا أهل كتاب أو الإسلام أو القتل إن لم يكونوا أهل كتاب، بل كانوا من مشركي العرب.
فإذا تغيَّرت الحال أخذت كل حال ما يناسبها من الحكم والتوجيه، وليس حكم المسايفة ناسخاً للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وليست بديلاً عنها. وكذلك العكس، بل كل منهما يجب امتثاله في وقته(17).
إنَّ بعض الكاتبين في علوم القرآن قد أخرجوا هذا “المنسأ” من باب “الناسخ والمنسوخ” وجعلوه شيئاً آخر يعطي فرصة للتخلُّص من تلك الأحكام القلقة – التي لا دليل على وقوع النسخ فيها، بل هو أقرب إلى التأويل الذي قد يجعل المنسوخ -كلَّه- من باب “المنسأ” ويكون معنى التبديل في الآيات التي ناقشناها قبل ذلك هو تبديل الأحكام في أنظار المجتهدين لا تغيير النصوص ذاتها، ولا إبطال وإلغاء القديم وإبداله بآخر جديد لفظاً وحكماً، فذلك يعني أنَّ فهم معنى “النسخ” بأنَّه الإزالة التامَّة للنّصِّ يتناقض مع تصوُّرهم لوظيفة النسخ؛ كما أنَّ الحكم على مدلول آية مَّا بأنّه منسأ لا بد له من دليل –كما قدَّمنا-، وإلا فإنّه سوف يؤدي إلى الإيهام، حيث لا يدري المكلَّف ما إذا كان مطالبا بإيقاع الفعل على الفور أو أنّه منسأ، ومنسأ إلى متى؟ أيكون منسأً إلى وقت حدّده الشارع، أو إلى وقت يحدّده المكلّف وكيف؟!(18).
أقسام الناسخ والمنسوخ عند القائلين به
لم يقتصر الاضطراب في هذه المسألة على المفهوم ذاته ولا على القضايا التي قال من قال بوقوع النسخ فيها أو نفيه عنها، بل تجاوز ذلك إلى تقسيماتهم للناسخ والمنسوخ، وإلى أنماط النسخ ذاته مما يدل على عمق الاضطراب فيها، وقد اختلفت تقسيمات علماء القرآن فيها عن تقسيمات الأصولييِّن، ولكن أشهر التقسيمات التي جرت عليها غالبيّة الفريقين التقسيم الثلاثيُّ، حيث قسموا المنسوخ إلى ثلاثة أقسام هي: منسوخ التلاوة دون الحكم، ومنسوخ الحكم دون التلاوة، ومنسوخ الحكم والتلاوة معاً.
والزركشيّ كما ينتسب إلى علماء القرآن ينتسب إلى الأصولييَّن فقد كتب البرهان في علوم القرآن، كما كتب البحر المحيط في أصول الفقه، وقد تبنى في البرهان التقسيم الثلاثي، لكنَّه في البحر المحيط جعل الأقسام ستة مع إمكان إرجاع بعضها إلى بعض، لكن اختيار هذا التقسيم قد يكون أوضح، فقال الزركشيّ في البحر المحيط: “قسّمه أبو إسحاق المروزيّ والماورديّ وابن السمعانيّ وغيرهم إلى ستة أقسام:
الأول: ما نسخ حكمه وبقي رسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه، كنسخ آية الوصيَّة للوالدين والأقربين بآية المواريث، ونسخ العدّة حولاً بأربعة أشهر وعشر، فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم، والناسخ ثابت التلاوة والحكم.
الثاني: ما نسخ حكمه ورسمه، وثبت حكم الناسخ ورسمه، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وصيام عاشوراء برمضان(19)!!
الثالث: ما نسخ حكمه، وبقي رسمه، ورفع اسم الناسخ وبقي حكمه، كقوله تعالى: “فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً” (النساء:15) بقوله: “الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله”، وزاد في البرهان: فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول(20).
الرابع: ما نسخ حكمه ورسمه، ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه، كالمروي عن عائشة رضي الله عنها “كان فيما أنزل عشر رضعات…”(21).
الخامس: ما بقي رسمه وحكمه، ولا نعلم الذي نسخه كالمروي أنّه كان في القرآن “لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب لابتغى أن يكون له ثان، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب”،(22) وكخبر أصحاب بئر معونة(23)، قال الزركشيُّ: هكذا ذكر الماورديُّ هذا القسم في الحاوي، ومثّله بالحديث الأول، وفيه نظر كما قال السمعانيُّ، وقال: هذا ليس بنسخ حقيقة، ولا يدخل في حده، وعده غيره مما نسخ لفظه وبقي معناه، وعده ابن عبد البر في التمهيد مما نسخ خطه وحكمه، وحفظه ينسى مع رفع خطه من المصحف، وليس حفظه على وجه التلاوة، ولا يقطع بصحته عن الله، ولا يحكم به اليوم أحد، قال: ومنه قول من قال: إنَّ سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة والأعراف.
السادس: ناسخ صار منسوخاً، وليس بينهما لفظ متلو، كالتوارث بالحلف والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة، ثم نسخ التوارث بالهجرة، ذكره الماورديُّ. قال ابن السمعانُّي: وهذا عندي يدخل في النسخ من وجه. ثم قال: وعندي أنَّ القسمين الأخيرين تكلُّف.
وذكر أبو إسحاق في وجوه النسخ في القرآن شيئاً أُنسي، فرُفع بلا ناسخ يعرف، فلم يبق له رسم ولا حكم، مثل ما روي أنَّ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة فرفعت(24).
وقد نحى الإمام مكيُّ بن أبي طالب منحى خاصًّا في تقسيم النسخ، فقد أدار أقسامه مع معاني النسخ في لغة العرب، ثم بقي عليه قسم لم يندرج معه تحت أيّ معنى مما ذكره فأفرده، كما أنّه أورد معنى لغويّاً من معاني النسخ لم يستقم مع أيّ من أقسام النسخ محل التقسيم، وحاصل ما ذكره ستة أقسام أيضا.
قال -يرحمه الله تعالى-: النسخ يأتي في كلام العرب على ثلاثة أوجه:
الأول: أن يكون مأخوذاً من قول العرب: نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر، فهذا لم يتغيرَّ المنسوخ منه، وإنَّما صار له نظيراً مثله في لفظه ومعناه، وهما باقيان، وهذا المعنى ليس من النسخ الذي قصدنا إلى بيانه، إذ ليس في القرآن آية ناسخة لآية أخرى كلاهما بلفظ واحد، ومعنى واحد، وهما باقيتان، وهذا لا معنى لدخوله فيما قصدنا بيانه، وقد غلط في هذا جماعة، وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن مأخوذاً من هذا المعنى، وهو وهم، وقد انتحله النحاس.
الثاني: أن يكون مأخوذاً من قول العرب: نسخت الشمس الظل: إذا أزالته وحلت محله، وهذا المعنى هو الذي عليه الجمهور في منسوخ القرآن وناسخه، وذلك على ضربين:
الضرب الأول: أن يزول حكم الآية المنسوخة بحكم آية أخرى متلوَّة، أو بخبر متواتر، ويبقى لفظ المنسوخة متلواً، نحو قوله تعالى في الزواني: }فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ{ (النساء:15) وقوله }وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فآذُوهُمَا{ (النساء:16) فأمر فيها بالسجن والضرب، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين، الذي تواتر به الخبر والعمل، المنسوخ لفظ تلاوته، وبالجلد مائة في البكرين المذكورين في سورة النور.
الضرب الثاني: أن تزول تلاوة الآية المنسوخة مع زوال حكمها، وتحل الثانية محلها في الحكم والتلاوة، وهذا إنّما يؤخذ من طريق الأخبار الثابتة، وذلك نحو ما تواتر (!!) به النقل عن عائشة -رضى الله عنها- أنهَّا قالت: “كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات” قالت عائشة: فنسخهن خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- وهن مما يقرأ من القرآن”. ترى من الذي أزالها من القرآن إن كانت تتلى بعد وفاة رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلَّم-؟!
قال مكيُّ: فهذا على قول عائشة -رضي الله عنها- غريب في الناسخ والمنسوخ، فالناسخ غير متلوّ، والمنسوخ غير متلوّ، وحكم الناسخ قائم، ولهذا المعنى اختُلف في ذلك، وعلى هذين المعنيين أكثر الناسخ والمنسوخ في القرآن.
الثالث: أن يكون النسخ مأخوذاً من قول العرب نسخت الريح الآثار، إذا أزالتها فلم يبق منها عوض، ولا حلت الريح محل الآثار، بل زالا جميعاً، وهذا النوع من النسخ إنما يؤخذ من جهة الأخبار، نحو ما رُوي أنَّ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة طولاً، فنسخ الله منها ما شاء، فأزاله بغير عوض، وذهب حفظه من القلوب!! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ودليل ذلك –كلّه- قوله عز وجل: “أو نُنْسها” أي نُنْسِكَها يا محمد، فأعلمه أنه ينسيه ما شاء من القرآن. وقد وهم من ذهب إلى ذلك، فالآية لبيان القدرة الإلهيَّة لا لبيان الوقوع، وهي مثل قوله تعالى: “وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً” (الإسراء:86)
وهذا النوع أيضا جعلوه على ضربين:
أحدهما: أن يزول اللفظ من الحفظ، ويزول الحكم(25).
الثاني: أن تزول التلاوة، واللفظ، ويبقى الحكم والحفظ للفظ، ولا يتلى على أنّه قرآن ثابت، نحو آية الرجم التي تواتر الإخبار عنها أنَّها كانت مما يتلى، ثم نُسخت تلاوتها(26) وبقي حكمها معمولاً به، وبقي حفظها منقولاً لم تثبت تلاوته في القرآن وهي ليست بآية من القرآن المجيد، لكنّها مما جاء في التوراة، وهي ما تزال في بعض نسخ التوراة بلفظها واختلط الأمر على بعض الرواة الذين ظنوا أنَّ قوله: “كانت مما أنزل الله” أي في التوراة، وتوهم البعض فظنوا أنَّ المراد “مما أنزل الله” أي في القرآن وفي بعض الروايات “كانت فيما يتلى” وتوهم البعض أنَّ المراد “فيما يتلى من القرآن” وليس الأمر كذلك، بل المراد: “فيما يتلى من التوراة”. ولا أدري من أين جاء مكيّ بدعوى التواتر لما سمّى “بآية الرجم”؟! وفي تفسير الطبري روايات أوردها تعضّد هذا الذي ذكرنا وتؤكد أنَّها من نصوص التوراة(27).
وبقي من أصناف المنسوخ صنف، وهو أن يزول حكم الآية بغير عوض متلوّ، ويبقى لفظها غير محكوم به، نحو ما فرض الله من شروط المهادنة التي كانت بين النبي -صلى الله عليه وآله وسلَّم- وبين قريش، والمذكورة في سورة الممتحنة، فنسخها زوال حكم المهادنة، لأنَّها إنّما كانت شروطاً معلَّقة بعهد، فلما زال العهد زال حكم الشروط، فهو زوال حكم بغير عوض، وبقي لفظ الشروط متلوًّا غير محكوم به(28). وهذا عجيب، لأنَّه لا يندرج تحت مفهوم النسخ ولا ينطوي حدّه عليه، فاعتباره من المنسوخ تعسُّف شديد.
ثم عاد مكيٌّ بعد ذلك فعقد باباً لأقسام المنسوخ، والذي يهمنا في هذه القسمة السداسيَّة التي أدرج فيها أقسام المنسوخ. فقال: المنسوخ من القرآن ستة أقسام:
الأول: ما رفع الله جل ذكره رسمه من كتابه بغير بدل منه، وبقي حفظه في الصدور، ومنع الإجماع على ما في المصحف من تلاوته على أنّه قرآن، وبقي حكمه مجمعاً عليه، نحو “آية الرجم”!!
الثاني: ما رفع الله حكمه من الآي بحكم آية أخرى، وكلاهما ثابت في المصحف المجمع عليه متلوٌّ، وهذا هو الأكثر في المنسوخ، وتمثيله في آية الزواني المنسوخة بالجلد المجمع عليه في سورة النور!!.
الثالث: ما فُرض العمل به لعلَّة، ثم زال العمل به لزوال تلك العلة، وبقي متلوا ثابتاً في المصحف، نحو قوله تعالى: }وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إلى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ{ (الممتحنة: 11) أمروا بذلك كلّه، وفُرض عليهم لسبب المهادنة التي كانت بين النبي -صلى الله عليه وآله وسلَّم- وبين قريش.
الرابع: ما رفع الله رسمه وحكمه، وزال حفظه من القلوب، وهذا النوع إنما يؤخذ من أخبار الآحاد، قلت: كيف يؤخذ بأخبار الآحاد في الحكم على القرآن المتحدى به المعجز القطعيّ؟! وذلك نحو ما روي عن زر(29) أنه قال: قال لي أبيٌّ: يا زِرُّ كانت سورة الأحزاب لتعدل سورة البقرة، ومنه ما روي عن أبي موسى أنه قال: نزلت سورة براءة، ثم رفعت؟!!
الخامس: ما رفع الله جل ذكره رسمه من كتابه فلا يتلى، وأزال حكمه، ولم يرفع حفظه من القلوب، ومنع الإجماع من تلاوته على أنّه قرآن، وهذا أيضا إنما يؤخذ من طريق الأخبار، نحو حديث عائشة رضي الله عنها في العشر الرضعات والخمس.
السادس: ما حصل من مفهوم الخطاب، فنسخ بقرآن متلو، وبقي مفهوم ذلك منه متلوا، نحو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلَواةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} (النساء: 43) فُهم من هذا الخطاب أنَّ السكر في غير قرب الصلاة جائز، فيكون فيه نسخان: نسخ حكم ظاهر متلوّ، ونسخ حكم ما فُهم من متلوه. وهناك تقسيم الإمام الرازي في المحصول وهو تقسيم ثلاثيّ جمع فيه الأقسام الستة، وجعلها مدرجة فيه(30).
آثار هذه التقسيمات.. والأفكار التي أملتها
تفرز هذه التقسيمات والأمثلة التي مُثل بها عددًا من المشكلات:
المشكلة الأولى: قضية “نسخ القرآن المجيد بالسنّة”، والجدال الذي قاده الإمام الشافعيّ حول هذا الموضوع، والذي تبدو فيه الإشكاليّة بحجمها الطبيعيّ بينه -يرحمه الله- وبين معاصريه والذين جاءوا من بعده، وخلاصتها: ما أورده الإمام في الرسالة (الفقرات 108-113)؛ حيث قال: “وهكذا سنَّة رسول الله: لا ينسخها إلا سنَّة لرسول الله، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سنَّ فيه غير ما سنَّ رسول الله لسنَّ فيما أحدث الله إليه، حتى يبيِّن للناس أنَّ له سنَّة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها. وهذا مذكور في سنته -صلى الله عليه وآله وسلَّم-، ثم قال: فإن قال قائل: أيحتمل أن تكون له سنَّة مأثورة قد نُسخت، ولا تؤثر السنَّة التي نسختها؟ وأجاب عن هذا السؤال بقوله: فلا يحتمل هذا، وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه، ويترك ما لزم فرضه؟ ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس؛ بأن يقولوا: لعلها منسوخة، ثم قال بعد ذلك: فإن قال قائل: هل تُنسخ السنَّة بالقرآن؟ قيل: لو نُسخت السنَّة بالقرآن كانت للنبي فيه سنَّة تبين أنَّ سنته الأولى منسوخة بسنته الأخرى، حتى تقوم الحجة على الناس بأنَّ الشيء ينسخ بمثله.
ثم قال رضي الله تعالى عنه: “ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله، ثم نسخ سنّته بالقرآن، ولا يؤثر عن رسول الله السنَّة الناسخة، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة: 275)، وفيمن رجم من الزناة: قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا؛ لقول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ} (سورة النور: 2)(31).
ومما نقلناه من كلام الإمام الشافعي يتبين لنا ما يلي:
1. أنَّ الإمام قرر بوضوح “أنَّ الشيء لا ينسخ إلا بمثله”، فلا ينسخ القرآن إلا قرآن، وبذلك تسقط جميع الدعاوى التي بنيت على أحاديث ادعى من ادعى أنَّها ناسخة لآيات قرآنيَّة، ولا ينسخ السنَّة إلا سنَّة مثلها، وذلك يسقط سائر الدعاوى التي ورد فيها ما يشير إلى أنَّ آية قرآنيَّة قد نسخت سنَّة من السنن.
2. أنَّ الإمام – فيما قاله- لم يكن يتحدث عن الناسخ والمنسوخ -من حيث الواقع، ونفس الأمر- وإنما كان حديثه عن الحكم بنسخ القرآن.
3. لم يكن كلام الإمام عن جواز نسخ السنَّة بالقرآن أو العكس، حديثا عن الجواز أو عدمه من حيث العقل أو السمع، فإنَّ حديثه لا يمكن حمله إلا على أنّه بيان لكيفيَّة الحكم بالنسخ.
وعلى هذا فيمكن القول بأنَّ معظم الذين تحدثوا عن رأي الإمام في هذه المسألة، تحدثوا عنه وفي أذهانهم أقوال العلماء الآخرين ونزاعاتهم في المسألة، ولذلك فهموا من قول الإمام أنه قول مقابل للأقوال المنقولة عن الأئمة الآخرين فاستهجنوه، مع أنَّنا نرى أنَّ قوله إنَّما هو في أمر آخر، غير أمر “الجواز والامتناع والوقوع” التي عليها مدار أقوال الآخرين، وإنمَّا هو في حكم المجتهد على النّص بالنسخ: متى يحكم به؟ وكيف؟.
فالإمام لا يرى للمجتهد الحق بأن يحكم بأنَّ هذه السنَّة منسوخة بالقرآن ولا العكس، وإنَّما يحكم بنسخ السنَّة إذا وجد سنَّة مماثلة تصلح ناسخة لها، وآنذاك تكون الآية مقوية للحكم بنسخ تلك السنة. وكذلك الحال بالنسبة للقرآن؛ فإنَّ المجتهد لا يحق له أن يحكم بأنَّ الآية منسوخة إلا إذا وجد آية تصلح أن تكون ناسخة لها، وتكون السنَّة الواردة في الموضوع مبيِّنة لكون الآية الناسخة ناسخة، والمنسوخة منسوخة، والإمام حين قرَّر ذلك كان يهدف إلى حماية أحكام كتاب الله وسنَّة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- من أي تغيير أو تعطيل من قبل من تحدثه نفسه بذلك تحت ستار النسخ.
وقد ذكر الماوردي في أدب القاضي (1/348) ثلاثة أوجه تصلح لإيضاح قول الإمام رضي الله عنه وهي:
1. أنه لا توجد سنَّة إلا ولها في كتاب الله تعالى أصل كانت السنَّة فيه بيانا لمجمله، فإذا ورد الكتاب بنسخها كان نسخا لما في الكتاب من أصلها، فصار ذلك نسخ الكتاب بالكتاب. قلت: وهذا لا نجد ما يدل على أنَّه مراد للإمام.
2. أنَّ الله تعالى يوحي إلى رسوله بما يخفيه عن أمته، فإذا أراد نسخ ما سنَّه الرسول – صلى الله عليه وآله وسلَّم- أعلمه به حتى يظهر نسخه، ثم يرد الكتاب بنسخه تأكيدا لنسخ رسوله، فصار ذلك نسخ السنَّة بالسنَّة. قلت: الكتاب تبيان لكل شيء، والسنَّة بيان قوليٌّ وعمليٌّ وتطبيقيٌّ للقرآن وليست معارضًا له، ولا بديلاً عنه، بل يستحيل أن تعارضه؛ كيف ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- مأمور باتّباع الكتاب؟!.
3. أنَّ نسخ السنَّة بالكتاب يكون أمرا من الله تعالى لرسوله بالنسخ، فيكون الله تعالى هو الآمر به، والرسول هو الناسخ له، فصار ذلك نسخ السنَّة بالكتاب والسنَّة.
قلت: ومن أعلم المارودي بذلك وما دليله عليه؟!
ولقد اقترب ابن السبكي كثيرا إلى فهم مراد الإمام -رضي الله تعالى عنه- حيث قال في جمع الجوامع(32): “وحيث وقع (نسخ القرآن) بالسنَّة فمعها قرآن (عاضد لها يبيِّن توافق الكتاب بالسنة) أو (نسخ السنة) بالقرآن فمعه سنَّة عاضدة (له) تبين توافق الكتاب والسنة. وما بين الأقواس للشارح الجلال، وراجع قول الجلال أيضا ص (80) منه.
ومما يعضد نحو قول ابن السبكي ما قاله الإمام الشافعي بعد الكلام عن صلاة الخوف، حيث قال: “وفي هذا دلالة على ما وصفت به قبل هذا، في هذا الكتاب (يعني الرسالة): من أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- إذا سن سنة، فأحدث الله إليه في تلك السنَّة نسخها أو مخرجا إلى سعة منها سن رسول الله سنَّة تقوم الحجّة على الناس بها، حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها.
فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل الله وسن رسوله في وقتها، ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته، صلاها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- في وقتها، كما وصفت(33).
ومع ما في مذهب الإمام الشافعي من وجاهة؛ حيث حاول أن يحمي الكتاب والسنَّة معا من شبهة التعارض والتناقض بينهما، كما حاول أن يضع معالم الاتصال والانفصال بين الكتاب والسنَّة، لكي لا تنمحي الفواصل بينهما، بيد أنَّ العلماء عارضوا ما ذهب إليه معارضة شديدة.
قال ابن السبكي(34): وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك منه –رضى الله عنه– حتى قال الكيا الهراسي: “هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه عظم قدره”. وكان القاضي عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضوع قال: “هذا رجل كبير، لكنّ الحق أكبر منه”، قال: والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره -كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتَّبه، وأول من أخرجه- قالوا: لا بد أن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل، فتعمقوا في محامل ذكروها، وأورد الكيا الهراسي بعضها. ثم قال: واعلم أنَّهم صعبوا أمرا سهلاً، وبالغوا في غير عظيم، وهذا إن صح عن الشافعي فهو غير منكر، وإن جبن جماعة من الأصحاب عن نصرة هذا المذهب فذلك لا يوجب ضعفه، ولقد صنف شيخ الدنيا أبو الطيب سهل بن أبي سهل الصعلوكي كتابا في نصرة هذا القول، وكذلك الأستاذان الكبيران أبو إسحاق الإسفراييني، وتلميذه أبو منصور البغدادي، وهما من أئمة الأصول والفقه، وكانا من الناصرين لهذا الرأي.
ولو قدر لما ذهب إليه الإمام الشافعي أن ينتشر ويقبل لربما خفف كثيرا من الآثار الجانبيّة لهذه الإشكاليّة الخطيرة “إشكاليّة نسخ القرآن”.
أما نحن فإننا نستطيع أن نرى بوضوح أنَّ الإمام الشافعي -وهو إمام جليل القدر من أئمة أهل السنَّة- أراد نفي النسخ عن القرآن جملة وتفصيلا، وأنَّ كل ما ادعي نسخه إنما هو آيات قابلة للفهم والتفسير لا تناقض بينها ولا تعارض ولا تعادل ولا اختلاف؛ فالقرآن المجيد قد عصمه منزِّله -تبارك وتعالى- وحفظه من كل تلك الأمور.
وأراد -رحمه الله- أن يؤكد للمجتهدين حرمة الحكم بنسخ آية بآية من آيات الكتاب الكريم إلا إذا جاءت آية مثلها تنص على أنها إنَّما نزلت لتنسخ الآية الأخرى وهذا ما لا وجود له في القرآن على الإطلاق.
وأما مذهبه -رضي الله عنه- في أنه لا تنسخ السنَّة بالقرآن، واشتراطه أن يأتي حديث ناسخ، فيه ما ينص على أنه جاء ناسخا لسنَّة أو لحديث جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- قبله، فإنَّه أراد أن يقضي على ذلك التساهل والإسراف في دعاوى النسخ، ويحصره في نحو قوله -صلى الله عليه وآله وسلَّم-: “كنت قد نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا”(35)، والحديثان -حديث النهي وحديث الإذن- أصلهما في كتاب الله ظاهر في آيات الأمر بالنظر والتفكر في مصائر الهالكين، وما جاء في قوله تعالى: } أَلْهَاكُمُ التَّكَّاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ{ (التكاثر: 1-2) ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- نهى عن زيارة القبور والناس حديثو عهد بالإسلام، وحديثو عهد بالكفر والجاهليَّة، فمن المناسب أن يقطع كل ما يمكن أن يذكرهم بالجاهلية، ويمهد السبيل أمامهم للعودة إلى ما فيها، ومن ذلك تعظيم القبور، وتعظيم الأموات، وعبادة الأصنام التي ترمز إلى صلحاء قد ماتوا.
فحين يأذن بذلك وينسبه إلى العبرة والدرس الذي ينبغي الحرص على استفادته من الزيارة ألا وهو تذكُّر الآخرة، بعد أن خالط الإيمان بشاشة القلوب، واستقر التوحيد في الضمائر، ولم يعد لديه -صلى الله عليه وآله وسلَّم- أي خوف على عقائد الأمة من زيارة القبور التي من شأنها أن تقلِّل من نزعة التكاثر، وحبّ الدنيا والانشغال به عن الله تعالى وعن الدار الآخرة أذن بذلك، وبين هذه المعاني وبين النسخ الذي أسرفوا في فهمه فوارق كبيرة، ومع ذلك فإنَّ الإمام الشافعي اعتبر حصر النسخ في السنَّة في نحو ذلك أقل خطرا وضررا من ذلك التعميم الذي ذهب إليه جماهيرهم.
ولذلك فإننا نرى أنَّ نظر الشافعي في هذا الأمر دقيق، وأنه لو قدر لعلماء الأمة أن يفهموه ويتبنَّوه وينشروه لما واجهنا اليوم هذه الإشكاليّة بهذا الحجم، رحمه الله رحمة واسعة.
أما المشكلة الثانية: فتبدو في ذلك الاستسلام التام لسلطة المرويّ والمأثور والموروث، والتساهل اللافت للنظر في تمحيصه ونقده، وخاصة أنَّ هذه المرويَّات تتعلق بكتاب الله المعجز المطلق الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يناله الاختلاف، وهو معصوم محفوظ، معجز، فكان عليهم أن يحتاطوا أشد الاحتياط فلا يسمحون بتداول أي شيء من تلك الرّوايات إذا لم يخضعوه لكل أنواع النقد والتمحيص دراية ورواية معا. وأنَّ التسليم ببعضها يستلزم أقوالاً خطيرة في حق القرآن المجيد، قد يكون منها الوقوع في الكفر بنوعيه الأصغر والأكبر!! ولقد رأيت كيف كان المتقدمون والمتأخرون يتسابقون، بل ويتنافسون في الكشف عما هو ناسخ ومنسوخ في المرحلة المكيَّة.
لقد صار المتأخرون مجرد جُمّاع للروايات الغثيثة الفجَّة، أكثرهم علما أكثرهم رواية، وقد يجتهد بعض هؤلاء ليزيدوا مرويّاتهم؛ إثباتا للقدرة وسعة الاطلاع، والإتيان بما لم يأت به من سبقوهم، وإيحاء بأنَّهم قد استقرءوا كل ما في المسألة من أقاويل، وتجاوزوا في تقسيم المسائل حدود القسمة العقليَّة، وأوردوا من النماذج والأمثلة نماذج لا تنسجم مع كثير من الأحكام البديهيَّة المتعلقة بالقرآن، ومنها ما أجمعوا عليه مع سائر علماء الأمة كامتناع واستحالة وانتفاء وقوع تغيير أو نسخ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؛ ومع ذلك فقد رددوا روايات نحو “الشيخ والشيخة” و”الرضعات العشر” و”لا ترغبوا عن آبائكم” وغيرها باعتبارها مما توفي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- وهي مما يقرأ، إذن من الذي رفعها، وكيف، ولماذا؟ وأين هذه من لغة القرآن ولسانه ونظمه وأسلوبه وبلاغته وفصاحته وتحدّيه؟
إنَّ حديث “الرضعات العشر” رواه مسلم على النحو التالي: “قالت عائشة: كان مما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات، توفي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- وهى مما يقرأ من القرآن” رواه مسلم.
وقد ذهبوا مذاهب شتى في تأويل قولها “وهنّ أو وهي مما يُقرأ”؛ حيث إنَّ ظاهره بقاء التلاوة إلى ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، إذن: من الذي رفعها؟ وكيف؟ وبدلا من ردّ هذه الروايات لتعارضها مع النّص القرآني على حفظ القرآن وعصمته أو لعدم وجود مستوى لسان القرآن فيها، ولا أسلوب نظمه لا في التحدي ولا في إعجاز النّظم ولا في مستوى الأسلوب ولا في أيّ وجه من وجوه أساليب القرآن، فإنَّهم آثروا المحافظة عليها بالتأويلات(36) فمنهم من أجاب: بأنّه عليه الصلاة والسلام قارب الوفاة، أو أنَّ التلاوة كانت قد نسخت، لكن ذلك لم يبلغ جميع الناس إلا بعد وفاته -صلى الله عليه وآله وسلَّم- فتوفى وبعض الناس يقرؤها، وهنا نود أن نتساءل: هل كانت أم المؤمنين عائشة من بين أولئك الناس الذين لم يعلموا بالنسخ وهى من نسبوا إليها رواية الحديث؟!
لقد كانت سلطة المأثور -على ما يبدو- سلطة مطلقة لا تقاوم، والعقليَّة الجزئيّة -وهي تمارس تشظّياتها وانشطاراتها- لم تلاحظ أيَّة ملازمات عقليَّة أو منطقيَّة أو منهجيَّة يمكن أن تترتَّب على تلك التخرُّصات والتأويلات الهزيلة التي من بينها أنَّ بعض القرآن يمكن أن ينسى ويندرس كالكتب القديمة، ويكون -في نظرهم- نسخا سائغا ومقبولا. وأنَّ نسخا للقرآن وقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إنَّهم لأجل المحافظة على سلطة الحديث والرواية الضعيفة والأثر جازفوا بعصمة القرآن، ولو أنَّهم تقيَّدوا بفهم المتقدِّمين للنسخ، وجعلوه منحصرا في دائرة النقل الذي يحدث للنّص عند تقييد المطلق وتخصيص وبيان المجمل لهان الأمر، ولم يعطوا هذا النسخ سلطة عليا تشتمل على إلغاء النصوص حكما وتلاوةً، وتلاوةً مع بقاء الحكم، وحكما مع بقاء التلاوة، وغير ذلك من تحكّمات بشريَّة جائرة في النّص القرآني الذي لا يجوز التحكم فيه؛ إذ له الحاكميَّة المطلقة.
ولو أنَّهم التفتوا إلى البعد الفلسفيّ في فكرة الإمام الشافعيّ بحصر مجالات تحرك “سرطان النسخ” في داخل النّص الواحد، وعدم تعديه إلى النّص الآخر لربما خفّف ذلك من بعض تلك الآثار الخطيرة، ولحصر مخاطر كثير من تلك المرويَّات في دائرة مرويّات مثلها لا تطاول القرآن المجيد، ولا تتطاول إلى عليائه .
ومع اتفاق جمهرة علماء أصول الفقه وعلماء القرآن والمفسرين على التقسيمات الأساسية التي ذكرناها -لكن بعضهم ألحن بحجّته من بعض- فإنَّ بعضهم وهو يمارس عملية التأويل لبعض المروي يأتي بالعجائب، فينقل الزركشي عن الواحدي (37) قوله: “وإذا جاز أن يكون قرآنا يعمل به ولا يتلى (؟!) وذلك لأنَّ الله أعلم بمصالحنا، وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا تعلق العمل بهذا الوجه”.
لعل الواحدي هنا يشير إلى “الشيخ والشيخة إذا زنيا” فهذا قد اعتبروه مما نسخ تلاوته وبقي حكمه، وقالوا بوجوب العمل به إذ تلقته الأمة بالقبول(38).
إنَّ الله سبحانه وتعالى جعل حد الزنا “مائة جلدة” {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} ولم تفرق الآية الكريمة بين الأعزب والمتزوج في العقوبة؛ لأنَّ الآثار المترتّبة على الزنا واحدة، سواء وقع الزنا من أعزب أو متزوج؛ لكنّ “الوعى الفقهيّ” مترع بالتوجُّهات القياسيّة، والقياس لا يقبل التسوية بين المتزوج والأعزب، فالمتزوج لديه الزوجة فيستطيع قضاء وطره معها، وليس كذلك الأعزب، إذن فالتسوية بينهما في العقوبة كما فعل القرآن لا بد له من تتمة يبحث عنها فما وجدوا إلا حديث “الشيخ والشيخة إذا زنيا، الذي هو نص من نصوص التوراة”(39)، وليتهم اعتبروا هذا مخصصا لعموم القرآن، لكنَّهم لم يكفهم إلا القول بالنسخ لورود الروايات التالية:
رُوي أنّه كان في سورة النور “والشيخ والشيخة” إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله، ولهذا قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لكتبتها بيدي، رواه البخاري في صحيحه معلقا. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها “والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما”(40).
وإذا كان الزركشي يذهب إلى أنَّ امتناع عمر بن الخطاب عن كتابة هذه الآية في القرآن، راجع إلى اعتقاده أنها من أخبار الآحاد التي لا يثبت بها القرآن، فإنَّ السيوطي يرى أنَّ ذلك مردود: فقد صح -في نظره- أنه تلقاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم، وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان المصحف فمرا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلَّم- فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك. فقال عمر: ألا ترى أنَّ الشيخ إذا زنا ولم يحصن جُلد، وأنَّ الشاب إذا زنا وقد أحصن رجم. قال ابن حجر في شرح المنهاج: فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها(41).
وهذا ينبه إلى أنَّ هذا لو صح عن عمر فإنّه ينفي نفيا قاطعا أن يكون عمر قد ظن في لحظة من اللحظات أنَّ هذه يمكن أن تكون آية من آيات القرآن الكريم المعجز في خصائصه ونظمه وأسلوبه، وإذا كانت قرآنًا فكيف يكره النبيّ –صلى الله عليه وآله وسلَّم- كتابتها، وهل يبيح العمل على غير الظاهر من عمومها إلغاء قرآنيتها؟ ومن الذي يملك سلطة إلغاء شيء من القرآن؟!.
ويرى آخر أنَّ الحكمة في نسخ التلاوة مع إبقاء الحكم ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمّة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظنِّ من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي(42). وهذا قول متهافت لا يتفق مع قوله تعالى {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} (النساء: 165)، ولا يتفق مع كون القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، ولا مع قوله تعالى: {لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ} (النحل: 39) وقد أغنانا الله بكتابه الذي أحصى كل شيء، وأحاط بكل شيء علما عن هذه التخرّصات وأمثالها مما نهانا الله عنه في قوله تعالى: {قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ} (الأنعام: 148)، وذمّه الذين يتبعون الظنّ. وكل ما في هذه الشريعة جاء بكتاب فصله الله على علم، وبيَّنه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- بوحي، وأقام عليه البرهان والحجة والأدلة العلميَّة {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (مريم: 64)، وهذه التأويلات والتخرصات هي التي فتحت عقول الكثيرين من المسلمين للظنون والأوهام والتخرُّصات، وهيأت للشياطين اجتيالهم عن المحجة البيضاء.
وإذا كان الامتناع عن التدوين مصدره النبي نفسه فليس وراء هذا دلالة على أنهَّا ليست جزءًا من النّص الذي نعلم الحرص على تدوينه من جانب النبيّ، وتفسير نسخها بأنَّ العمل بها على غير الظاهر من عمومها أمر عجيب(43).
ويغرب السيوطي أكثر حين يقول: وخطر لي في ذلك نكتة حسنة، وهو أنَّ سبب التخفيف على الأمّة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف، وإن كان حكمها باقيا لأنّه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود، وفيه الإشارة إلى ندب الستر. قلت: إنَّ الستر لا يحتاج إلى هذا الاتجاه الوعر الخطر؛ إذ إنَّ الستر قد تحقق بإفراد الزنا وحده من بين سائر المعاصي بضرورة إشهاد أربع عليه.
أما القول بأنَّ إخفاء ما ادّعي أنه آية رجم طلبا للستر، فإنّها دعوى تفتقر إلى كثير من المنطق لتستقيم، وأنَّى لها أن تستقيم!!.
خطورة القول بوقوع نسخ في القرآن
قضية نسخ بعض آيات القرآن الكريم قضية يرفضها القرآن الكريم ولا يستسيغها الحس العلمي الذي بناه القرآن المجيد في عقول وقلوب وأنفس المسلمين، وهي من الأمور المعقَّدة تماما التي أخذت مدى في العقل الإنسانيّ قبل الإسلام، وكانت موضع نقاش واختلاف وأخذ ورد وفي فترات تاريخيَّة كثيرة، وما من دين من الأديان السماويَّة والوضعيَّة إلا واجه هذه المشكلة بشكل أو بآخر؛ ذلك لأنَّ قدرات البشر وطاقاتهم في عمليات إنزال القيم الدينية على واقع الحياة قدرات محدودة يشوبها القصور في كثير من الأحيان، ولذلك يختلف الناس وينقسمون إلى فرق في مواقفهم من أصول الأديان، فهناك من يعمد إلى التأويل بقراءات بشريَّة ليكون قادرا على إيجاد حالة التوافق والانسجام بين ما يريده الدين الذي يتديَّن به وبين الواقع وإمكاناته والإنسان نفسه وطاقاته واحتياجاته وما إلى ذلك، وأحيانا يلجأ إلى إيقاف العمل بالنّص، وإيجاد مسوغات لذلك الإيقاف لا تجعل منه متمردا على ما جاء دينه به، ومن ذلك دعوى النسخ.
فدعوى النسخ قد أسيء استعمالها وفهمها وتفسيرها لدى أمم سابقة كثيرة؛ فاليهود حينما جاءهم عيسى بالبينات ورفضوه وأكدوا أنه ليس المقصود ببشارات موسى وأنبيائهم قبله، قالوا: إنَّ شريعتنا ثابتة، وديانتنا دائمة ومؤبَّدة، ولسنا بحاجة إلى أيّ تغيير أو التصديق برسالة المسيح وبما أنزل إليه، يعني أنَّنا لا نقبل فكرة النسخ ولا نقر بأنَّ رسالة موسى وما جاء به رسالة منسوخة، وطرحوا فكرة “البَدَاءِ” وقالوا: إنَّه يزعم أنَّ الله أرسله، وكأنَّ الله قد بدا له أن يرسل نبيا من بعد موسى، ولدينا ما يؤكد أنَّه لن يأتي بعد موسى نبيٌّ عدا المسايا، وصفات المسايا لا تنطبق -حسب زعمهم- على السيد المسيح، حيث إنَّهم درجوا على إنكار من يأتيهم بعد رسول قد جاءهم.
والقرآن الكريم أشار إلى هذا، قال تعالى: {وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولا} (غافر: 34)، فكلما هلك رسول قالوا: لن يبعث الله من بعده رسولاً، ولذلك درجوا على قتل الأنبياء وإنكار نبوَّاتهم ظنا منهم أنَّهم بذلك يحافظون على الثبات، وإن كان أحبارهم قد أعطوا لأنفسهم في بعض مراحل حياتهم حق التغيير والنسخ، وحرَّفوا بعض النصوص وغيَّروا فيها واستبدلوها بسواها وغيَّروا أحكاما كثيرة واردة في التوراة ومنه الحكم في رجم الزناة(44).
ومع أنَّهم استوطنوا الجزيرة العربية قبل بعثة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلَّم- بسبعة قرون انتظارًا لبعثته، وخالطوا العرب وحملوا أسماءهم وانتموا إلى قبائلهم طمعا في أن يكون النبيُّ الخاتم من أبنائهم، ولكنهم حين جاءهم من كانوا ينتظرون بالبينات تنكروا له وأنكروه وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم -كما فعلوا مع السيد المسيح قبله- وحاولوا اغتياله وقتله مرات عديدة، وموَّلوا كثيرا من حملات المشركين ضدَّه، وكانت حجتهم في رفض الاعتراف بنبوته عليه السلام أنَّ شريعتهم ثابتة، ودينهم كامل، وأنَّ الله -تبارك وتعالى- لا يمكن أن يغيِّر رأيه ويرسل بعد موسى رسولا ينزل عليه شريعة تغاير شريعة موسى.
وكما وضع قارئهم كفه على النّص القائل بوجوب رجم الزناة في التوراة، وهو “الشيخ والشيخة إذا زنيا…”، فقد غيّروا في صفات خاتم النبيين في توراتهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وعملوا كل ما استطاعوه لينزعوا عن الشريعة الإسلاميَّة العالميَّة النازلة على رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلَّم- صفاتها الواردة في سورة الأعراف {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الأُمِّىَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأٌّغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (الأعراف: 157) وفي مقدمتها التخفيف والرحمة وإزالة الإصر والأغلال ليؤكدوا بذلك أنّه -عليه الصلاة والسلام- ليس هو المقصود ببشائر التوراة وتشبثوا بنفي النسخ.
وفي إطار الجدل الذي أثاره الكلاميُّون لإثبات ورود النسخ، وأنَّ النسخ خاصَّة من خواصّ الشرائع، دخلت فكرة النسخ إلى العقل المسلم، وصارت تتردَّد على بعض الألسن، وحملتها روايات دخلها الكثير من الإسرائيليّات والثقافة الشفويَّة لتجعل من النسخ وسيلة لهدم حجَّة اليهود في رفض الإيمان بالمسيح أولا ثم برسول الله محمد -صلى الله عليه وآله وسلَّم- ثانيا، فتحول بعد ذلك إلى سلاح وجِّه إلى العقل المسلم ذاته وارتدَّ إليه، وإذا ببعض العلماء يتبنَّون فكرة النسخ ويدخلونها إلى تفاصيل شريعة القرآن وبيانها في سنَّة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- ظنًًّا منهم أن القول بالنسخ سوف يحمل اليهود على التسليم بنبوّة ورسالة رسول الله -صلى الله علية وآله وسلَّم- وحين وجد الفقهاء -خاصَّة- في النسخ سهولة في التخلُّص من عمليَّات التعارض الموهوم بين النصوص خاصَّة في مجال السنَّة النَّبويَّة المطهرة التي لا شك أنَّها قد وقع فيها النسخ؛ لأنَّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- كان يتحرك في واقع له خصائصه وطرائقه في الاستجابة إلى النّص والتفاعل معه، ولذلك كثر في سنن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- ما يمكن اعتباره نسخا في المعاني اللُّغوية التي وردت بها أحاديث مثل قوله: “نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عن لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ فَأَمْسِكُوا ما بَدَا لَكُمْ”(45)، ومنه نهيه عن أكل الحمر الأهلية(46) خوفا من أن تحدث أزمة في المواصلات.
فهو عليه الصلاة والسلام -وكان يتحرك في ذلك الواقع بقيم القرآن منزِّلا لها في ثنايا الواقع متابعا ردود فعل ذلك الواقع وطرائقه في استقبال آيات القرآن الكريم- كان يلاحظ – صلوات الله عليه وهو الرءوف الرحيم الحريص على أن يجنِّب أمته أيَّ عنت- الأولويَّات والمقاصد والمآلات وسائر الجوانب التربويَّة بحكمته وبما يوحى إليه ليمكّن للقرآن عقيدة وشريعة ونظم حياة في واقع الأمة المؤمنة.
وهنا عندما حصلت عمليَّة الخلط والمزج بين الكتاب والسنة- لأسباب كثيرة تناولناها في دراستنا عن السنَّة النَّبويَّة المطهرة وعلاقتها بالقرآن الكريم- فمن الطبيعي أن يختلط لدى البعض موضوع النسخ فينقل من دائرة السنَّة النَّبويَّة إلى دائرة القرآن الكريم، وهنا برزت هذه الإشكاليّة بشكلها الحادّ.
ولذلك حين وجدنا الإمام الشافعي -رحمه الله- وهو من هو في تعزيز موقف أهل الحديث، والانتصار للسنَّة النَّبويَّة، حينما بلغ الأمر القول بنسخ الكتاب بالسنَّة والعكس وقف موقفه الصلب الذي أساء كثير من معاصريه فهمه، كما أنَّ أتباعه غاب عليهم مرماه ومقصده، فجاءوا “بنظريَّة المعضِّد” لتمييع تلك الفكرة الجليلة التي كان الإمام الشافعيُّ يرى نفسه وكأنّه المسئول عن تصحيحها بعد أن مهدت دراساته وانتصاراته لأهل الحديث لعمليَّة الخلط والتسوية بين الكتاب والسنَّة، بحيث أصبح الفارق بينهما ينحصر بأنَّ الكتاب معجز، متحدَّى به، متعبَّد بتلاوته وليست السنَّة كذلك، وكلاهما وحي، وتجرأ البعض على أن يقول: “الوحيان”، وهو أمر قد عالجناه في دراستنا المشار إليها حول علاقة السنَّة بالقرآن الكريم فارجع إليه يتضح لك أنَّ هذا المزج أمر لا يقبله القرآن الكريم ولا السنَّة النَّبويَّة المطهرة، فالعلاقة بينهما علاقة بيان ومبيَّن دون أن يعني ذلك أي غضّ من السنَّة النَّبويَّة المطهرة أو المساس بحجيَّتها، ولكنَّها عملية وضع للأمور في مواضعها، والابتعاد عن الخلط المرفوض.
من هنا نستطيع أن نقول بناءًا على المبدأ الذي طرحه الإمام -ولم يُبن عليه، ولم يتمَّ تفصيله- بأنَّه لا نسخ في القرآن بإطلاق قولا واحدا، فلا القرآن ينسخ بعضه بعضا لأنَّه من عند الله تعالى }وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا{ (النساء: 82)، كما لا يُنسخ بالسنَّة أبدا؛ لأنَّ مهمة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- هي تلاوة الكتاب وإبلاغه للناس واتِّباعه وتعليمهم مع الكتاب كيفيَّة اتِّباعه وتنفيذ ما فيه، وبالتالي فإنَّ جميع هذه الأقسام التي ذكرها الكاتبون في علوم القرآن والأصوليُّون هي من التراث المصاب الذي لا بد من إخضاعه لتصديق القرآن وهيمنته واستيعابه وتجاوزه، وأنَّ بعضها مما يمكن أن نلتمس له بعض التأويلات فيقال بأنَّه روي بالمعنى وتصرف الراوي فيه -حسب فهمه- أو أنَّ هناك ما يطعن في صحة الرواية أو دقتها، ولكن -والأمر يتعلق بالقرآن الكريم- لا بد من الحسم، ولا بد من القول بأنَّه لا نسخ في القرآن على الإطلاق، وأنَّ كل ما ادّعي نسخه لم يكن يحتاج إلا إلى جهد يسير، يجمع فيه بين القراءتين، وتلاحظ فيه الوحدة البنائيَّة في القرآن الكريم، وبقيّة خصائص الخطاب القرآنيّ ليفهم ويتضح، وتبرز معانيه، وأنَّ عملية فهم الآيات التي ادعي وقوع النسخ فيها استمرّت منذ القرن الثاني الهجري في التناقص كلما اتضح للناس معنى يزيل التعارض من أذهان المجتهدين أو العلماء رفعت من بين الآيات التي أدخلت في النسخ حتى بلغت عند المتأخرين ست آيات فقط أو خمسة.
وإليك معاني هذه الآيات الكريمة الستّ:
1. قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (البقرة: 240). قالوا: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (البقرة: 234) ظنا منهم أنَّ الآيتين قد وردتا على مورد واحد ألا وهو فترة العدة التي تعتدها المتوفى عنها زوجها.
والحق أنَّ مورد الآيتين مختلف تماما؛ إذ إنَّ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} جاء مراعيا لعادات الأمم وأعرافها، فللأمم عادات مختلفة في التعبير عن تكريم الأحياء لموتاهم، واحترامهم لذكراهم، وإعطاء الانطباعات الإيجابيّة بأنَّهم كانوا في موقع الحب والتقدير لدى أهلهم وذويهم، وأنَّ هذا المتوفَّى له ذكرى طيبِّة واحترام وقدر عند المتَّصلين به، والخواص من المنتمين لأسرته.
واختلفت تقاليد الأمم في التعبير عن هذه المشاعر ولا تزال مختلفة، وقد راعى القرآن الكريم هذه المشاعر الإنسانيّة أحسن مراعاة وأجملها، فمنزل الرجل الذي شهد حياته مع زوجته وبنيه يبقى وكأنّ تغييرًا لم يحدث بهذه الوفاة، تخفيفا على المنتمين للأسرة كلِّها وفي مقدِّمتهم الزوجة، فامرأته قائمة فيه، وأبناؤه وذووه يترددون عليه، وذكراه بينهم، لكي يأخذ كل منهم فرصته الكافية للصبر والسُّلوّ، وتجاوز الإحساس بالموت والفراق، والإسلام جاء للعرب والشعوب الأميَّة من حولهم، والشعوب الكتابية تقاليدها وعاداتها في هذا المجال، ولا شك أنَّ زوج المرأة منها لبمكان كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم(47 )، وهناك براءة الرحم من ماء المتوفَّى وهي التي تكفيها القروء الثلاثة، وهناك فترة الإحساس النفسي الثَّقيل الشديد على المرأة وتكفيها أربعة أشهر وعشر.
وهناك فترة إعادة ترتيب الحياة بالنسبة لها ولأبنائه بعد هذه التغيُّرات الحادّة الماديَّة منها والمعنويَّة، وفترة إعادة ترتيب الحياة لا يمكن أن تتم بشكل ملائم في أقلَّ من حَوْل، سواء أكان الناس ينتمون إلى مجتمع زراعيّ تتعلق حياته بالمواسم، أو مجتمع رعويّ تتعلَّق حياته بالماء والكلأ، أو مجتمع تجاريّ ترتبط فيه الحسابات بحولان الحول، وكذلك الزكاة وحساباتها، وإذا كان البيت مستأجرا فتغلب أن تكون الإجارة مرتبطة بالحول، فالحول يعتبر بمثابة الوحدة الصغرى لإعادة تنظيم شئون الناس وحياتهم، خاصة بعد مصيبة كبيرة مثل “مصيبة الموت” كما سماها القرآن الكريم (48) بأن تُعطى الزوجة المفجوعة في زوجها فرصة عام لتعيد ترتيب أمورها وأمور صغارها، ولتعوّد نفسها على تحمل المسئوليَّات -منفردة- بعد اجتياز الصدمة العاطفيَّة وبراءة الرحم وما إلى ذلك، وذلك أمر معهود في أحكام القرآن الكريم القائمة على التخفيف والرحمة ومراعاة مختلف المشاعر والقضايا الإنسانيَّة وفي مقدّمتها “الأسرة” التي هي حجر الزاوية في بناء المجتمع. وعنها تتفرع شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعيَّة التي يحرص الإسلام على إنمائها والمحافظة عليها .
فالتربُّص بالنفس لاستبراء الرحم وللتهيُّؤ لاستئناف دورة حياتيَّة جديدة قد تكون الأربعة أشهر وعشر ليالي حدا أدنى كافيا لذلك، وقد يكون كافيا لتسوية الجانب النفسيّ والجسميّ للمرأة، وأما الحول فهو حد للتسويات المختلفة خاصّة الماديَّة منها، المتعلقة بإعادة ترتيب الحياة. وحين نلتفت إلى بعض العلوم المعاصرة خاصّة علوم النفس والاستفتاءات التي يقوم بها الباحثون بين المتوفى عنهن أزواجهن، وملاحظة مختلف الجوانب العاطفيَّة نجد توضيحا لكثير من المعاني التي ربما لم يلاحظها المفسِّرون؛ لأنَّ أعينهم كانت مشدودة إلى الحكم الفقهيّ الجزئيّ التكليفيّ، لكنَّهم لو لاحظوا الأمور الأخرى لحكموا بإحكام الآيتين، وأنَّه لا نسخ بينهما، فكل منهما اتجهت جهة؛ فالآية الأولى متجهة نحو الزوجة في بدنها ونفسها ورحمها وخروجها من تأثيرات مصيبة الموت.
أما آية الحول فهي وصية من الله -تبارك وتعالى- للأزواج وللأسرة والورثة وللأمّة في أن تعطي الزوجة المتوفى عنها زوجها فرصة إعادة ترتيب حياتها الماديَّة التي صار لها فيها شركاء آخرون هم بقية الورثة، فهي في حاجة إلى تلك الفرصة بقطع النظر عن طبائع العلاقات بين أبناء المجتمع، وبالتالي فليس هناك تعارض أو تناقض أو تصادم بين الآيتين يستدعي القول بتخريجها على قواعد النسخ نفسها -عند القائلين بها- لينسخ المتأخر بالمتقدم، وللدخول في تلك التأويلات المتعسِّفة، ما دام من الممكن فهم الآيتين اللتين اختلف موضوع كل منهما عن موضوع الأخرى وانتفى التعارض بينهما.
وأما تلك الروايات التي رويت بناءًا على هيمنة أفكار النسخ، والنظر إليه على أنَّه من المسلَّمات، فإنَّها لا تقف أمام هيمنة القرآن الكريم على ما عداه، ولا تصلح لنسخ حاكميته لجعل غيره حاكما عليه.
2. قوله تعالى: {وَاللاتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً * وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابا رَّحِيما} (النساء: 15– 16).
ذهب أكثر المفسرين إلى أنَّ هاتين الآيتين منسوختان، غير أنَّهم اختلفوا في الناسخ وفي كيفيَّة النسخ؛ فذهب جماعة منهم إلى أنَّ الآية الأولى نسخت بالثانية وإلى أنَّ الثانية نسخت بآية النور وبحديث عبادة بن الصامت الذي ورد فيه أنَّ الحد كان الحبس، ثم نسخ بالإيذاء، ثم نسخ الإيذاء بآية النور الجلد للبكر، والرجم للمحصن وبـ”الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة”(49)، وعكس بعضهم الأمر فقال: إنَّ الآية الثانية نسخت بالأولى؛ حيث كان حد الزنا في نظر هؤلاء الإيذاء، ثم نسخ الإيذاء بالحبس، ثم نسخ الحبس بالجلد والرجم، قائلين: إنَّ الآية الثانية كانت سابقة للأولى في النزول، وذهبت فرقة ثالثة منهم إلى أنَّ الآيتين نزلتا معا، وأنهما نسختا معا بآية النور وحديث عبادة، أي الجلد للبكر والرجم للثيب.
وقد أثارت دعوى النسخ هذه إشكاليَّات عديدة، منها: تجويز نسخ القرآن الكريم بأحاديث الآحاد التي روي جلُّها بالمعنى، وقد يكون الراوي أخطأ في فهم المعنى، فيكون الحديث كلّه موضع نظر!! واستدراكات عائشة وعمر وغيرهما كافية للفت الأنظار إلى هذا الاحتمال الكبير، وقد حاول بعضهم الخروج من هذا المأزق ببعض التأويلات، وهي تأويلات ساقطة يصعب قبولها إن لم يتعذر كما قال ابن الجوزي في زاد المسير (2/36)، ناقلا عن قوم: بأنَّه يحتمل أن يكون النسخ قد وقع بقرآن رفع رسمه وبقي حكمه!! وهو تأويل بعيد جدا، وعمليَّات التجويز وفرض الاحتمالات هذه عبارة عن فرضيَّات بشريَّة ما كان لمن له مسكة من علم أن يسقطها على القرآن المجيد، فآيات الكتاب الكريم لا تخضع لفرضيَّات إنسانيَّة لا سند لها بإطلاق، وإلا فما الذي أبقيناه لأهل الكتاب الذين وقعوا في التبديل والتحريف، حينما اجتالتهم الشياطين وفتحت أمامهم سبل الافتراض والآراء الخطيرة التي لا يقوم عليها دليل ليسقطوها على كتبهم وما جاءهم أنبيائهم به عن الله تبارك وتعالى؟!!
قال القاضي أبو يعلى: وهذا وجه صحيح يخرَّج على قول من لم ينسخ القرآن بالسنة، قال: ويمتنع أن يقع النسخ بحديث عبادة لأنَّه من أخبار الآحاد والنسخ لا يجوز بذلك، وردَّ بعض المفسرين والفقهاء دعوى نسخ الآية، ومن هؤلاء الخطابي في معالم السنن حيث قال:
لم يحصل النسخ في الآية ولا في الأحاديث، وذلك أنَّ الآية تدل على أنَّ إمساكهنَّ في البيوت ممتد إلى غاية وهي أن يجعل الله لهن سبيلا، وذلك السبيل كان مجملا فلما قال -صلى الله عليه وآله وسلم- (خذوا عني الثيب ترجم والبكر تجلد وتنفى) صار هذا الحديث بيانًا لتلك الآية لا ناسخا لها، وصار أيضا مخصصا لعموم آية الجلد (فالمهم أنَّ الحكم الذي دلت عليه الآية يغيّر ويبّدل بحديث الآحاد سواء سمَّوه ناسخًا أو مخصصًا، أو مبيّنا لإجمال مزعوم في الآية؛ فالنتيجة واحدة).
وقد نقله النيسابوري عنه في غرائب القرآن (3/204)، واعترض على القول بالنسخ الإمام الرازي في الكبير (9/230- 234)، والقرطبي في الجامع (5/282 – 285)، وأبو حيان في البحر المحيط (3/194، 195)، والسيوطي في الإكليل ص (35)، ورشيد رضا في المنار (4/438 – 440) نقله أولا عن محمد عبده وأيده وتبنَّاه، وكذلك السعدي في تيسير الكريم الرحمن 2/37، وعبد الكريم الخطَّابي في التفسير القرآني للقرآن (4/718 – 721).
ونقل رد القول بالنسخ عن مجاهد وانتصر له أبو مسلم الأصفهاني وأيده بكثير من الأدلة، وأبطل دعوى النسخ، وقد تولى الإمام الرازي تفصيل مذهب أبي مسلم، فقال -بعد أن ذكر القول الأول والقول الثاني وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني-: إنَّ المراد بقوله تعالى {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ{ المساحقات وحدُّهن الحبس إلى الموت، وبقوله }وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا{ أهل اللواط وحدُّهما الأذى بالقول والفعل، والمراد بآية النور }الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (النور:2) الزنا بين الرجل والمرأة وحده في البكر الجلد، وفي المحصن الرجم، واحتج أبو مسلم عليه بوجوه منها: أنَّ اللاتي يأتين مخصوص بالنسوان، و”اللذان” مخصوص بالرجال، وعرض الإمام الرازي بقية أدلة أبي مسلم والتي تؤكد على أنَّ الجهة منفكة، وأنَّ آيتي سورة النساء لم تتجها لبيان حد، بقدر ما كان توجُّه الآيتين لبيان كيفية صيانة المجتمع من إشاعة السحاق واللواط، ولما كان الزنا بين رجل وامرأة، وليس بين رجلين أو امرأتين، فإنَّ آية النساء غير ما ورد في سورة النور، ورد عليه القائلون بالنسخ بتمسكهم بما قرروه، وبالتأكيد على أنها متجهة للموضوع ذاته ألا وهو الزنا، وهناك مفسرون رووا هذه الأقوال كما هي دون أن يتبنَّوا شيئا منها.
وتمسَّك مصطفى زيد بما تمسَّك به الجمهور، وناقش أدلة أبي مسلم لأنَّها عنده من بين الآيات الخمس التي دخلها النسخ في نظره.
وقد علمت مما تقدم أنه لم يقع تعارض ولا تعادل بين الآيات الثلاث؛ فالأولى تتعلق بالنساء الشاذّات السحاقيَّات اللَّواتي يملن إلى إناث مثلهن، وهي فاحشة تؤدي إلى اكتفاء النساء بالنساء، وهدم الأسرة والمجتمعات، والخروج من العهد الإلهي، والتمرُّد على عهد الاستخلاف، والإخلال بالكرامة الإنسانيَّة، والحيلولة دون قيام مجتمعات إنسانيّة تحقّق العمران في هذه الأرض. وحبسهن بالبيوت حتى يتوفاهن الموت إجراءٌ وقائيٌّ يحول بينهنَّ وبين إشاعة هذه الفاحشة في المجتمع، والترويج للفاحشة بين بنات جنسهن.
وأما الآية الثانية فإنهَّا في اللِّواط واللُّوطييِّن، وهو انحراف يقع بين الذكور، وهو فاحشة لا تقل خطرا عن الانحراف والشذوذ الذي يقع بين الإناث، والأذى يناسبه، وقد يوقف هذه الظاهرة، ويحمي المجتمع منها، فالأذى يدخل في باب التعاذير، والمجتمع والأمة وولاة الأمر يستطيعون الاستفادة من التشريعات التعزيرية لحماية المجتمع المسلم من ظواهر الانحراف والشذوذ بكثير من الشذوذ.
وأما آية النور فهي في الزنا الذي يقع بين الرجل والمرأة، فالجهة منفكة، ولا تعارض ولا تعادل ولا شيء يقتضي القول بالنسخ. وأما القول المضطرب القائم على حكم التوراة ونصّها” الشيخ والشيخة…” وادعاء نسخ آية الجلد في حق المحصن بنص من التوراة التي زعم البعض أنها آية قرآنيَّة منسوخة التلاوة، فهو قول في غاية الغرابة.
وقبول الروايات الواردة في هذا الشأن تترتب عليها مجموعة من العظائم، منها الطعن في الصحابة الكرام، وفي مقدمتهم عمر وعثمان وزيد وكتاب الوحي ومن عملوا في جمع القرآن المجيد بشتى صيغ الجمع، فكل هؤلاء تنتفي عنهم الأمانة والدقة والضبط، وتوجّه إليهم تهمة التفريط في تدوين آيات قرآنيَة توفي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وهي مما يقرأ.
ومنها: أن الله -تبارك وتعالى- الذي تكفل بحفظ القرآن كما تكفل بإنزاله وجمعه وأنَّه -تعالى عن أقوالهم وعما تؤدي إليه أقوالهم- قد أخلف وعوده وفرّط في ذلك كلّه وتركه أو بعضه لهوى الرواة إن شاءوا أثبتوا وإن شاءوا محوا.
ومنها: الطعن ببلاغة القرآن وفصاحته ونظمه وأسلوبه وتميّزه في ذلك -كلِّه- واعتبار هذا القول الركيك المترجم عن التوراة: “الشيخ والشيخة…” كان آية من آياته وكأنَّ الصحابة لم يتمكنوا من إدراك الفروق الهائلة بين أساليب القرآن المتحدي المعجز. فلم يشر أي منهم وهم من ذؤابة فصحاء العرب إلى ركاكة هذا المرويّ الذي لا يرتقي إلى مستوى أحاديث أفصح من نطق بالضاد -صلى الله عليه وآله وسلم-، فأنى له أن يطاول فصاحة القرآن وبلاغته وهو بتلك الركاكة. لقد برزت هذه الدعوى أو الشبهة أول ما برزت في حديث جاء في موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني – صاحب الإمام أبي حنيفة ومستشار الخليفة العباسي هارون الرشيد. وتوفي الشيباني سنة (189) هـ حيث جاء في هذا الحديث: “أخبرنا مَالِكٌ حدثنا يحيى بن سَعِيدٍ أنّه سَمِعَ سَعِيد بن الْمُسَيَّبِ يقول لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ من مِنًى أَنَاخَ بِالأَبْطَحِ ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً بَطْحَاءَ ثُمَّ طَرَحَ عليها رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ فقال اللهمَّ كَبِرَتْ سِنِّي وَضَعُفَتْ قُوَّتِي وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غير مُضَيِّعٍ وَلاَ مُفَرِّطٍ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ الناس فقال أَيُّهَا الناس قد سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ وَفُرِضَتْ لَكُمُ الفرائض وَتُرِكْتُمْ على الْوَاضِحَةِ إلا أن تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالاً وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ على الأُخْرَى ثُمَّ قال إِيَّاكُمْ أن تَهْلِكُوا عن آيَةِ الرَّجْمِ أن يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ حَدَّيْنِ في كِتَابِ الله فَقَدْ رَجَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَوْلاَ أن يَقُولَ الناس زَادَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ في كِتَابِ الله تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فإنَّا قد قَرَأْنَاهَا، قال سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ: فما انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حتى قُتِلَ عُمَرُ -رَحِمَهُ الله-.(50) وقد ناقشنا هذا الخبر أو الأثر مناقشة مستفيضة تناولنا فيها سنده ومتنه، وذلك في دراستنا قيد الإنجاز في “حد الرجم” نورد شيئا مما قلناه هناك:
1- الحديث نسبوا إلى سعيد بن المسيب روايته عن عمر، وسعيد قد ولد قبل استشهاد عمر بسنة واحدة، وذلك يعني أنه يستحيل على مثله التحمّل والأداء. إذن فهناك حلقة مفقودة، فما هي؟.
2- إنَّنا لا ننفي عن هذا الإصحاح -من إصحاحات التوراة كونه منها؛ ولكنّنا ننفي عنه- القرآنيّة، بل نذهب إلى استحالة ذلك. ونؤكد استحالة أن يكون حديثا من أحاديث أفصح من نطق بالضاد، فلفظ الحديث “يبدأ بالشيخ والشيخة.. “، ولم يعرف في العربية، ولا في الاصطلاحات الفقهية أنَّ الشيخوخة تفيد الإحصان(51).
3-إنَّ القرآن حين ذكر جريمة السرقة بدأ بذكر الذكر “السارق والسارقة”، لأنَّ الغالب أن تقع السرقة من الرجال، وأما الزِّنا فإنَّ القرآن قد بدأ بذكر الزانية لتوقُّف هذه الجريمة على استعدادها ورضاها.
إلى غير ذلك من مناقشتنا للمتن والسند فليحرص على الرجوع إليه في ذلك البحث.
3. قوله تعالى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ{ (النساء:43) قيل: إنّها نسخت بقوله تعالى } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{ (المائدة: 90)
ونحن نرى أنَّ الآيتين كل منهما قد وردت في موضع منفصل عن موضع الآية الأخرى وعلى مورد مغاير؛ فالآية الأولى منعت الإنسان من أن يصلي وهو سكران، فموضوعها حينما نريد تحديده إنما هو “صلاة السكران”؛ لأنَّ السكر لا يتناسب والصلاة التي يفترض أن يقوم الإنسان بها بكامل وعيه مستجمعا كل طاقاته العقليَّة والنفسيَّة ليتحقق بالفهم لما يقرأ، والفهم لما يفعل، والخشوع الذي هو لباب الصلاة، والذي يجعل منها شيئا ينهى عن الفحشاء والمنكر؛ فالنهي منصبٌّ على منع الصلاة للسكران.
وأما الآية الثانية: فموضوعها بيان حكم مجموعة من موروثات الجاهليَّة، منها الخمر ومعها الميسر والأنصاب والأزلام، فانصبت على منع ممارسة أي شيء من ذلك، وضرورة اجتناب كل هذه المحظورات، فلا تشترى ولا تباع ولا تُصنَّع ولا يجري تداولها، فما هو مأمور باجتنابه هو غير ما نهي عنه في الآية الأخرى؛ فالجهة منفكة تماما، ولكن حديث أمنا عائشة في البخاري هو الذي أوحى بفكرة التدرُّج، وهو في الحقيقة تدرُّج في التربية والاستعداد، وتهيئة نفسيَّة الإنسان لقبول هذا التغيير في نظم حياته.
4. قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَّكُن مِّنْكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ . الآَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنْكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (الأنفال: 65- 66) هاتان الآيتان وردتا في سورة الأنفال، وسورة الأنفال اشتملت على آيات كثيرة تنبه إلى أنَّ السياق سياق تشجيع وتعبئة نفسيَّة للمؤمنين؛ فقد سبقت هذه الآيات آيات أخرى {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ . وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقْدَامَ . إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} (الأنفال: 9- 12)،
{إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ} (الأنفال: 43- 44) فسياق السورة كله يدور حول رفع معنويات المسلمين الذين وجدوا أنفسهم في معركة لم يكونوا يتوقعون حدوثها، بل كانوا لا يريدونها، كما قال تعالى { كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} (الأنفال: 5) وبالتالي فهذا كلُّه يؤكد أنَّ هذه السورة الكريمة هي سورة تعبئة للجماعة المسلمة لتحقق نصرا بإذن الله يغيِّر من موازين القوى على مستوى الجزيرة العربية كلها، ويفتح أمام الإسلام سائر الأبواب المغلقة، ويزيل كثيرا من العقبات، فأعطوا هذا السقف، وربطوا بأنَّ تغلبهم على عدوهم أمر لا بد أن يتحقق بإذن الله، ولأنَّ عدوهم وصف {بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ}فالتفوُّق حاصل بقطع النظر عن العدد الذي لم يلتفت سياق السورة إليه كثيرا، فإدخالها في مجال الأعمال التكليفية أمر لم يكن واردا، خاصة أنه ما من فعل تكليفي إلا وقد علَّقه الله تبارك وتعالى -فضلا منه ونعمة- بالاستطاعة بما في ذلك التقوى، ورفع الحرج وعدم تكليف ما لا يطاق في الحروب القائمة على المسايفة تعتبر العشرة عددًا كبيرًا مقابل الواحد، وفي بدر نفسها التي جاءت السورة الكريمة لتبين لنا ما جرى فيها لم يكن التفوق العددي للمشركين يتجاوز (ثلاثة إلى واحد)، ومع ذلك أيَّد الله -تبارك وتعالى- بكل ما أيَّد عباده المؤمنين به.
5. قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}{ (المجادلة: 12-13).
ذهب جمهرة العلماء إلى أن الآية الأولى منسوخة، واختلفوا في ناسخها، فروى الطبري وابن عباس أنها نسخت بالزكاة، وروى عن عكرمة والحسن البصري أنها نسخت بالآية التالية لها، كما أنهم اختلفوا في وقت النسخ، فقال أبو حيان: إن هذا الحكم نسخ قبل العمل به، وقال قتادة: عمل به ساعة من نهار، وقال مقاتل: عمل به عشرة أيام، فانظر الطبري ( 28 /15)، وأبو حيان في البحر (8/237).
وأما الإمام الرازي فقد علل الأمر بتقديم الصدقة بأن الحاجة كانت ماسة إلى تمييز المنافقين عن المؤمنين، فإن المنافقين لا يتوقع منهم أن يقدموا صدقة ليناجوا الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-، وعللها آخرون بأن الله -سبحانه وتعالى- رأفة بنبيه الذي أكثر الناس عليه، وكان كل منهم يحرص على مناجاته أنزل هذا الأمر نوعا من التقييد لذلك، ولهم في ذلك أقوال كثيرة وتعليلات مختلفة، ومنها أن الصدقة التي أمر بها أمر بها على سبيل الاختيار والندب، وأنها غير محددة المقدار ولا النوع، ويمكن أن تكون ذكرا –أي أمرًا معنويا- ويمكن أن تكون أمرا ماديا، وأن الذي أثار شبهة النسخ في هذه الآية هو تصور أن الله -تبارك وتعالى- أراد أن يؤدِّب الناس ليعاملوا رسوله الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم- كما تعامل الشعوب من حول الجزيرة ملوكها وأباطرتها ليدركوا هيبتهم وعظمتهم، وعدم سهولة الوصول إليهم.
وهذا أمر لا يمكن أن يكون مقصودا للشارع الحكيم الذي ميَّز بين رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- وبين أولئك الملوك والحكام، ولكن لا يبعد -بالرغم من ذلك- أن يقيس الناس النبي الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- على من حولهم من عظماء، ألم يقل مشركو مكة {لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} ( الزخرف: 31) فكأنه قيل: إنَّ هذا النبي الكريم أعظم من كل أولئك الذين يشيرون إليهم، وفي تقديم الصدقة قبل مناجاته – صلى الله عليه وآله وسلم- إعداد وتربية للجماعة المؤمنة على أفضل أنواع السلوك معه بأن لا ينادوه من وراء الحجرات، وأن يلتزموا أرقى أنواع السلوك في تعاملهم معه.
فإنه حتى لو قدموا بين يدي نجواهم صدقات فليس ذلك بكثير عليه -صلى الله عليه وآله وسلم- خاصة وأن فوائد ذلك إنما تعود عليهم أولا وآخرا، ففقراؤهم هم المستفيدون بتلك الصدقة، وقوله تعالى {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ} ليست بناسخة لما سبقها، بل هي محكمة إحكامها، ومتممة لمعانيها، فإن كثيرا من الناس قد أشفقوا على أن ذلك قد يحرمهم من مناجاة نبيهم الذي هو أحب إليهم من نفوسهم لقلة ذات اليد(52) وقد يستأثر بملاقاته ومناجاته الأغنياء، ولذا قال تعالى{}أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} ثم أردفها بقوله -جل شأنه- (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) فكأنَّه أراد أن يقول إذا كانت الصدقة فيها نوع من الإثبات والدليل على حبكم للرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- واحترامكم له، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله تطهركم وتزكيكم وتجعلكم مؤهلين لمناجاته -عليه الصلاة والسلام- فإنها نوع من اتباعه -صلى الله عليه وآله وسلم- التي تدل على محبتهم المشار إليها في قوله تعالى: } قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ{ (آل عمران: 31) – ففيها معنى عميق كالمعنى المشار إليه في فهم القرآن الكريم كما قال -جل شأنه-: }لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ{ (الواقعة: 79) فالاستفادة بمناجاته -صلى الله عليه وآله وسلم- لا تحصل إلا لقوم تزكوا وتطهروا وتهيئوا لملاقاة المتلقي الأول لكتاب الله -جل شأنه- ففي الآيتين معا تهيئة نفسية على أعلى مستوى لأولئك الذين يريدون مناجاة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- ويتأثرون بصحبته ويستفيدون بها.
وإذا كانت الصدقة الماديّة قد تكون وسيلة لتمييز المنافق الذي أحضرت نفسه الشح، والذي لا يرى أهمية لمناجاته لرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو غير مؤمن به فإن المؤمنين لا يأتون إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلا بقلب سليم تطهره مختلف أنواع وسائل التزكية والتطهير، فلا ناسخ ولا منسوخ بين الآيتين، وجنس ذلك مراعى في الآداب التي علَّم الله المؤمنين عليها، والآداب التي أمرنا بالتحلي بها عند مقاربة القرآن أو مقاربة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، لكن العقل الفقهي يحرص على الدوام أن يترجم كل شيء إلى حلال وحرام، وأمر ونهي، وناسخ ومنسوخ، وعمليات بناء الأمم وتربيتها لا تتوقف على التقنين الفقهي وحده.
وإذا صحت الآثار التي نقلها بعض المفسرين بأن هذا الأمر قد أريد به تمييز المنافقين عن المؤمنين فإنه لا يعارض ما ذكرنا -بل يعززه- لأن الله – تبارك وتعالى- حين أمر رسوله بأخذ الزكوات علل ذلك بقوله جل شأنه } خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ{ (التوبة: 103) ويكون الأمر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى بمثابة القيام بالتزامات لا بد من الوفاء بها قبل لقاء رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- التي يحدث بها تطهيرهم وتزكيتهم وصلاته عليهم، فأمروا بالتطهر وتهيئة القلوب والعقول والنفوس للقاء رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بحيث يكونون مؤهلين لاستغفاره لهم، وصلاته عليهم، وتعليمهم وتزكيتهم وتطهيرهم. فالمقصود هو التطهر قبل المناجاة، وهو قصد يمكن تحققه بكل أنواع العبادة، صدقة أو صلاة أو ذكرًا.
وحينما ننظر إلى كل تلك الآيات وترابطها فإننا لا نجد أنفسنا بحاجة إلى الاقتراب من القول بالنسخ أو مجرد إثارته بفضل الله. ومفهوم “الصدقة” مفهوم واسع جدًا فالكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكد على العيال صدقة. ويبدو أن البعض قد ذهبت أوهامهم إلى أن الأمر منصرف إلى صدقة المال بخصوصها فحصل لديهم شيء من الإشفاق بأن ذلك قد يحول بين الفقراء، ومناجاته -صلى الله عليه وآله وسلم- فطمأنهم القرآن بأن الله –جل شأنه- يتوب عليهم، ويطهرهم بأي نوع من البر يفعلونه، ويعدهم نفسيا لمناجاة رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- بحيث يتلقون ما يتلقونه منه بالجدية اللازمة. والله أعلم.
6- قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً . نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً . أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً} (المزمل: 1-4).
زعم القائلون بالنسخ أن هذه الآيات الثلاث قد نسخت بقوله تعالى {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (المزمل:20).
واختار القول بالنسخ ابن سلامة وابن حزم والخازن والكلبي والفيروز آبادي والشنقيطي وبعض المحدَثين مستدلِّين بروايات عن عائشة وابن عباس والحسن وعكرمة ومقاتل والشافعي وابن كيسان. ورد القول بالنسخ الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والطبرسي وآخرون. ووقف مجموعة من المفسرين موقف الحيدة بين الفريقين فلم يذهبوا إلى القول بالنسخ ولم يردوه، ويمكن أن نضع من بين هؤلاء الماوردي والزمخشري والرازي والقرطبي والبيضاوي والنيسابوري والبغوي والألوسي والشوكاني ومن إليهم. ومن بين هؤلاء أناس لم يشيروا إلى قضية النسخ في هذه الآيات ومنهم الإمام الطبري وابن العربي وأبو حيان وابن كثير وغيرهم.
ونحن لا نرى ما يسوغ الحديث عن وقوع نسخ بين الآيات الثلاث المذكورة، وما زعم أنَه ناسخ لها {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ…} ذلك أن كل ما في الأمر أن هذه الآيات من أوائل آيات القرآن الكريم نزولا على الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-، وأن الوحي وتلقيه وعملية تبليغه للناس وتلاوته عليهم وتعليمهم وتزكيتهم به كل هذه الأمور أمور في غاية الخطورة والأهمية، يعجز البشر بطاقاتهم المحدودة وقدراتهم عن القيام بها، والنهوض بأعبائها، فهي تحتاج إلى معية الله -تبارك وتعالى- في كل منها والارتباط الدائم به، والحضور الدائم بين يديه -سبحانه وتعالى- وذلك لا يتحقق إلا بالصلة الدائمة به – سبحانه- الصلة المستمرة التي لا تنقطع بحال من الأحوال، ولذلك فإن الأمر في هذه الآيات قد علل بقوله تعالى {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلاً} (المزمل:5)؛ أي إن من شأنه أن يحتاج منك إلى أن تكون في معية الله -تبارك وتعالى- على الدوام، فأمر -عليه الصلاة والسلام- بأن يقوم الليل، ويكون على ذكر دائم لله -تبارك وتعالى-، يذكره في نفسه تضرعا وخفية، ويذكره بين الملأ، ويذكره قائما وقاعدًا وعلى جنبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- وهناك أصحاب كرام كانوا يحيطون به -صلى الله عليه وآله وسلم- يقتدون به ويتبعونه ويتأسون به لا يسألون عما إذا كان واجبًا عليهم أو مندوبا أو غيره فالمهم عندهم اتباعه -صلى الله عليه وآله وسلم- في كل ما يأتي وما يدع، وما يفعل وما يصنع، فأراد الله -تبارك وتعالى- أن يدرك هؤلاء برحمته فبيّن لهم أنه يعلم الفرق بين نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- وبين غيره، ولذلك يمكن أن تخرَّج على ما جرى بالنسبة لصلاة التراويح وقيام رمضان؛ فرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حين رأى الأصحاب قد انضموا إليه في صلاة التراويح امتنع عن الذهاب إلى المسجد وقال: “خشيت أن تفرض عليكم” (53)، فقيام الليل كان مفروضا على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لأنه من ضرورات التأهيل لتلقي القول الثقيل، ولذلك قال تعالى: } وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ{ (الإسراء:79)، وبقي بالنسبة للأمة أمرا مندوبا إليه وما زال يمارسه كثير من المسلمين ويعتبرونه من أهم وسائل التزكية وتطهير النفس والتقرُّب إلى الله -تعالى-، والعلاقة بالله -تبارك وتعالى- كما رسمها القرآن العظيم علاقة لا تخضع لقضايا التقنين الفقهي والأحكام التكليفية وما إليه، بقدر ما تخضع للعلاقة القائمة على حب الله -تعالى- والرغبة إليه، وطلب القرب منه وحب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- والتأسي به فلا داعي لتحويل كل شأن إلى نوع من العلاقة القانونية والفقهية التي تخضع للناسخ والمنسوخ، ورسول الله كثيرا ما كان يواصل وينهى الآخرين عن الوصال، ويقول: (لستم مثلي إنِّي أبيت يطعمني ربي ويسقيني)(54)، فهو يتحمل ما لا يتحمله الآخرون، ورأفته ورحمته بهم مستمدة من رحمة الله -تبارك وتعالى- بهذه الأمة، وبالتالي فإن السورة محكمة –كلُّها- ليس فيها ناسخ ولا منسوخ.
النسخ وصفة القدم
القرآن كلام الله -تعالى- قديم غير مخلوق، وأخطر المعارك الفكرية التي وقعت في تاريخنا تلك المعركة التي ما زالت آثارها عالقة في تراثنا الفكري، وهى التي عُرفت بمعركة “خلق القرآن” يوم ذهب المعتزلة إلى القول بالخلق، وخالفتهم الأمة -كلها- في توكيد قدم القرآن المجيد وإطلاقه ونفي تاريخانيته، وأنه كلامه -تعالى- غير مخلوق. ولقد دفع بعض علماء الأمة حياتهم ثمنا لذلك، ودفع بعضهم حريتهم في هذه المعركة، ولم يسأل المسرفون في دعاوى “النسخ” أنفسهم حول مدى قيمة أو أهمية هذه القضية إذا قيل بالنسخ خاصة نسخ التلاوة، وكيف يستقيم لهم القول بالنسخ والقول بقدم القرآن المجيد في وقت واحد؟ إنها عقلية التجزئة، تقول القول، وتتجاوز لوازمه المنطقية، أو تتغافل عنها لعدم الخضوع لمنهج صارم يضبط حركة العقل الإسلامي وهو يقرأ الخطاب القرآني.
والعجب من الأشاعرة ومن إليهم من القائلين “بالكلام النفسي” كيف يتقبلون القول “بنظرية النسخ” ويروِّجون لها مع القول “بالكلام النفسي”، الذي اعتمدوه لتوكيد صفة القرآن المجيد الأساسية ألا وهي “القدم”، مقابل القول “بخلق القرآن” الذي تبنته المعتزلة، فإن القدر المشترك بين سائر معاني النسخ التي ذكروها “كالرفع والبيان والنقل والإزالة والتبديل والإبطال وما إليها” وغيرها إنما هو “التغيير”؛ ففي كل تلك المعاني تغيير ما، وهذا يتنافى مع القول “بقدم القرآن” باعتباره كلام الله -تعالى- وصفة من صفات ذاته العلية لا يقبل التغيير، والفوائد والحكم التي ذكروها للنسخ لا تكفي للتخلص من هذا الإشكال، فإما القول بقدم القرآن، -وآنذاك- لا بد من نفي النسخ كليا بسائر معانيه، أو تحويل كل ما ادّعي وقوعُ النسخ فيه إلى أمور أخرى يمكن أن تشكل أدوات لفهم المجتهد، لا أحكاما تسري على الخطاب القرآني، ولا تتناقض واتصافه “بالقدم”، كأن يعتبر النصان المتعارضان أو المتعادلان -في ذهن المجتهد- من قبيل عام وخاص، فيخصَّص العام بالخاص، أو يقيّد المطلق بالمقيَّد، أو يبيّن المجمل بالمبيّن، أو نحو ذلك مما لا يعد تغييرًا ولا يخل بصفة القدم أو يعارضها.
نقول فيها نظر
هناك نقول متناقضة مهدَّت لنظرية النسخ التي رأيت ما فيها لروايتها وتداولها واستمرار تناقلها جيلا بعد جيل وقد نقل السيوطي(55) روايات كثيرة في هذا الصدد منها:
قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: “لا يقولَنَّ أحدكم قد أخذت القرآن -كله-، وما يدريه ما كله؟ قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن قد أخذت منه ما ظهر” (). وقال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: “كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مائتي آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن”(57)!!.
وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال في سورة الأحزاب: “اثنتان وسبعون آية أو ثلاث وسبعون آية، قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم، قلت: وما آية الرجم، قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله، والله عزيز حكيم” (58).
وقال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت:” لقد أقرأنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة”(59).
وأخرج ابن الضرير في فضائل القرآن عن يعلى بن حكيم عن زيد بن أسلم أن عمر خطب في الناس، فقال: “لا تشكُّوا في الرجم فإنَّه حق، ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبَّي بن كعب فقال: أليس أتيتني وأنا استقرؤوها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فدفعت في صدري وقلت: تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر”، قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف(60)؟ أهو الاختلاف يا حافظ الأمة أم الاختلاق؟.
وقال حدثنا حجاج عن أبى جريح أخبرني ابن أبي حميد عن حميدة بنت أبي يونس قالت: “قرأ على أبي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة: } إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا{، وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى، قالت قبل أن يغير عثمان المصاحف”(61(.
وقال حدثنا عبد الله بن صالح عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا أوحى إليه أتيناه فعلمنا ما أوحى إليه، قال: فجئت ذات يوم فقال: إنَّ الله يقول: “إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أنَّ لابن آدم واديا لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان إليه الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب”(62).
وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبى بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ، “لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين” ومن بقيتها: لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سأل ثانيا فأعطيه سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، وأن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية والنصرانية ومن يعمل خيرًا فلن يكفره”(63(.
وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى حرب بن أبي الأسود عن أبي موسى الأشعري قال: “نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب”(64(.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال: كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات نسيناها غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة(65(.
وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن سعيد عن الحكم ابن عتيبة عن عدى بن عدى قال: قال عمر “كنَّا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك؟ قال نعم”(66).
وقال حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فإنَّا لا نجدها؟ قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن(67(.
وقال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المغافري عن أبي سفيان الكلاعي أنَّ مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين من القرآن لم يكتبا في المصحف، فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك، فقال ابن مسلمة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون، والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون(68).
وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فكانا يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فذكرا له ذلك فقال: إنها مما نسخ فالهوا عنها(69(.
وفي الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت يدعو على قاتليهم، قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع: أن بلغوا عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا.
وفي المستدرك عن حذيفة قال: ما تقرءون ربعها، يعني براءة(70)، قال الحسين بن المناري في كتابه الناسخ والمنسوخ: ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتي القنوت في الوتر وتسمى سورتي الخلع والحفد(71).
وبعد: فإن إشكالية “النسخ” لا تنفصل عن قضايا جمع القرآن وتاريخه وتدوينه وأسباب نزوله وقراءاته وتناقله، ومن المتعذر تصور جوانبها – كلِّها – دون الإحاطة بذلك كلّه، والنظر فيه بشكل منطقي مترابط، وكذلك النظر في اختلافات الصحابة في تلك المرحلة، ومآخذ بعضهم على سيدنا عثمان، ومآخذ بعضهم على اللجنة التي شكّلها لكتابة القرآن في المصاحف، وتنافسهم في نيل ذلك الشرف، وما ورد من اعتراضات على عثمان وزيد من قراء آخرين مثل ابن مسعود وابن عباس وسواهما، فكل ذلك لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار، وكذلك لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار تناول البعض من الذين اطّلعوا على بعض مصاحف الصحابة، والخلط بين ما كتبوه باعتباره قرآنا يتلى وبين ما كتبوه تعليقا واستنباطات فقهية، أو تفسيرات وتأويلات لهم، وتلك مصاحف شخصية كان كل واحد من الصحابة يحتفظ بمجموعة من السور في مصحفه، إما لكونه لا يحفظها في ذاكرته، أو لأنه كتبها أمام الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-، مثل مصحف ابن مسعود الذي كان يشتمل على سبعين سورة، ومصاحف آخرين من الصحابة كانت تشتمل على سور معينة.
كذلك لا بد أن يأخذ الباحث في هذه المسائل بنظر الاعتبار الخلافات التي ثارت بين أهل الشام وأهل العراق والتي جعلت حذيفة وغيره يهربون إلى عثمان بحثا عن علاج لتلك الظواهر التي بدأت تبرز وتنميها الفتن، وتقويها الاختلافات، ولو أن علماء القرآن وعلماء أصول الفقه التفتوا إلى مثل هذه الأمور التي لا يستطيع أن يتجاهلها أي مهتم “بعلم الاجتماع الديني” و”علم اجتماع المعرفة” الذي نبَّه كثير من أئمتنا إلى قواعده، بدءا بالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري، وانتهاءً بابن خلدون وابن تيمية ومن إليهم، ولذلك فإن لنا كبير الأمل في أن ترفع تلك الروايات الغثيثة في قضايا “الناسخ والمنسوخ” من برامج التعليم في “علوم القرآن وفي علم أصول الفقه”، وتحال مسائلها إلى التراث الذي يرجع إليه الباحثون المتعمقون والمتخصصون في هذه المجالات، لمعرفة كيف تنعكس مشاكل المجتمعات وتطور الفتن على مواقفها من مرجعيتها وأصول تلك المرجعية، ويعرف الناس ما حاكه الكفار والمشركون والمنافقون والمغفلون من شبهات حول القرآن المجيد.
ولعلنا في هذا الذي قدمناه قد رسمنا معالم منهج في المراجعات التي نحتاجها لمراجعة كثير من جوانب تراثنا، مراجعة علمية منهجية، لعلها تساعد على تنقية هذا التراث مما أصابه، والتصديق عليه بالقرآن المجيد والهيمنة عليه، واستيعاب ما يصدق القرآن عليه وتجاوز ما لا أصل له، لعل ذلك يعيد إلى العقل المسلم فاعليته وتألقه وقدرته، وثقته في تراثه، ويعيد بناء الشخصية المسلمة بناء يتسم بتحقيق الإرادة والفاعلية، وبناء قواعد الشرعية، والله الموفق.
لقد حفظ الله القرآن المجيد من داخله، ولم يتركه لروايات الرواة حفظوا أو نسوا، ولم تتكرر معه تجربة الاعتماد على ذاكرة وحفظ الربانيين والأحبار الذين فرطوا بالكتب السابقة وأضاعوها، بل جعل نظم القرآن نفسه حافظا له من داخله والله تولى حفظه من خارج، والنظم قد جعل القرآن كله قولاً واحدًا متصلاً يتمتع بوحدة بنائية تلمسها في محدِّدات منهاجية دقيقة، وجعل كل سورة من سوره بمثابة غرفة في البناء الواحد متكاملة لا نقص فيها، لها عمودها الذي تدور حوله أجزاؤها من الحرف حتى الآية الكاملة، وكل السور بعد ذلك تمثِّل كلمة إلهية واحدة، ترفض التأويلات المنحرفة والتفسيرات الشاذة، والقراءات المبتورة إذا أحسن الناس تدبُّره والكشف عن خصائص نظمه.
لكن الرزيَّة كل الرزيَّة جاءت من تلك القراءات المبتورة التي يمكن أن توصف “بالتعضية” والتجزئة، والتي تجعل القارئ كثيرًا ما ينسى أجزاء، ويتذكر أجزاء أخرى { فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ…} ( المائدة:14) إن القراءات المبتورة جعلتنا نختلف في تفسيرنا للقرآن وفهمنا له، وننقسم حول معانيه وندخل مراحل الفتن والصراع المختلفة، ولم يعد القرآن بالنسبة لنا حبل الله المتين الذي نعتصم به فتجمع كلمتنا عليه.
إن القول بالنسخ وبالطريقة التي سار عليها المتأخرون من علماء الأصول والقرآن والتفسير تطرح تساؤلات في غاية الخطورة، ولذلك فلا بد من التوقف عن الأخذ به أو قبوله بأي حال من الأحوال. ولعل من بين هذه التساؤلات:
1. إذا قلنا بالنسخ في تلك الفترة الزمنية المحدَّدة فترة المدينة أفلا يستدرجنا ذلك إلى القول بالنسخ، أو التوقف عن التطبيق أو استبدال تلك التشريعات التي مضت عليها القرون تشريعات أخرى مغايرة؟ لذات الأسباب التي ذكرت لتسويغ النسخ في عصر النبوة؟.
2. كيف يقع النسخ داخل الآية الواحدة، والقرآن خصه بالآية “مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ” على فرض أنَّ المراد هو الآية القرآنية وليس المراد جزءا من آية على مذهب القائلين بالنسخ لو تنزلنا للتسليم به؟.
3. كيف يقع النسخ بين نصيَّن مختلفي المرتبة والنسبة؟ (موضوع نسخ الكتاب بالسنَّة والعكس)؟.
4. كيف يُدّعى النسخ بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وبمثل تلك الرايات المتهافتة؟.
5. كيف ينسخ النص القرآني الثابت القطعي بأخبار آحاد لم تثبت وفي كل منها مقال؟ خاصة وقد أكد العلماء عدم جواز نسخ القرآن بأحاديث الآحاد، وفي مقدمتهم أولئك القائلون بالنسخ!!.
6. كيف يعدون ما ليس فيه إعجاز، ولا ما يقرب منه قرآنًا؟.
7. كيف ينسخ القرآن المتواتر المتلو بمروي لا يتجاوز في حالة صحته أن يكون خبر آحاد، أورده صاحبه بالمعنى أخطأ في فهمه أو نسي؟ وكيف يحكم بمثل هذا على كتاب الله المتحدي المعجز الذي { لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} (الإسراء: 88).
لذلك فإن أملنا كبير أن يرفع هذا الموضوع من برامج التعليم في سائر المؤسسات التعليمية التي ينبغي أن تكون مهمتها -على الدوام- تعزيز الإيمان بالقرآن المجيد وتحديه وإعجازه وإطلاقه وهدايته للتي هي أقوم في كل شيء، وأن كل ما فيه -من حرف وكلمة وآية أو بعض آية- إنما هي صادرة عنه -سبحانه وتعالى- فلا ريب فيه، ولا تناقض ولا اختلاف.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا وأحزاننا، ونور أبصارنا وبصائرنا، إنك سميع مجيب.
أ.د. طه العلواني رحمه الله
هوامش
([1]) هذه المقولة شاعت وانتشرت في “جيل الفقه”وبها احتج القائلون “بحجيَّة القياس” ثم استرسلوا في الاحتجاج بها في الأدلة المختلف فيهل – كلها – وبذلك صيَّروا “القرآن المطلق” نسبيَّاً و”الوقائع النسبية الحادثة” مطلقا!!
([2]) قد ناقشنا مذهب الشاطبي هذا في الحلقة الخاصة “بالوحدة البنائية” وهي الحلقة التي نشرت ثالثة في هذه السلسلة فلا نعود إليه وراجعه هناك ففيه الكثير من الفوائد.
أما قضية مخاطبة من لم يكن مولودا في عصر الرسالة بالقرآن الكريم وبخطاب رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فهي المسألة التي عرفت عند الأصوليين بمسألة “تكليف المعدوم” ولهم في ذلك جدل طويل لا ضرورة له لولا سيطرة بعض الأفكار الكلاميَّة مثل قضية الحسن والقبح، ووجوب الأصلح، وعدم جواز تكليف من هو غير مؤهَّل للتكليف، والخلط بين تعلّق الخطاب بما يتناوله العموم، ومن يتناوله، وبما لا يتناوله العموم ومن لا يتناوله، وخلط البعض – كذلك – بين التعلّق التنّجيزي الذي يراد به إنجاز الفعل أو القيام به ساعة الخطاب به، وبين ضرورة القيام به عند توافر شروطه، واستيفاء المكلَّف به لشروط الإنجاز، وقد أخذ الله –تبارك وتعالى- العهد من البشر وهم في “عالم الذر” بقوله تعالى ” وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِىءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَآ أن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أو تَقُولُواْ إنمَآ أَشْرَكَ ءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ “( الأعراف: 172 – 173 ) وهو خطاب منه – سبحانه وتعالى – للبشر وهم في حالة لا يمكن أن يتعلّق بها الخطاب تعلّقا تنجيّزيا يقتضي القيام بالفعل حين الخطاب، ولكنه يصدق عليه أنَّه خطاب مستوف لكل أركان الخطاب لمخاطَب مؤهّل للفهم والإدراك ليذكَّر به عندما يصبح قادرا على إنجاز ما فهمه، بحيث يتعلق الخطاب – آنذاك – بفعل المخاطب تعلّقا “تنجيّزيا”، بعد أن تعلق به تعلُّقًا صلوحيّاً.
كما أنَّ نصوص الكتاب والسنَّة متضافرة على عموم هذه الرسالة وشمولها “وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً” (سبأ: 28) “قُلْ ياأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا” ( الأعراف: 158 ) “إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ” (الأنعام: 90 ) والعالمون شاملة لمن كانوا في عهد الرسالة ووقت تلقي الخطاب وللذين يأتون من بعدهم ويندرجون تحت هذا المفهوم إلى يوم الدين، وقد كان في مقدور العلماء الذين أنفقوا كثيرا من الوقت والجهد في مناقشة هذا الأمر أنَّ لا يأسروا أنفسهم في المسائل التي جرهم إليها الجدل الكلاميِّ مثل مسألة الحسن والقبح، ومفاهيم الشيء، والمعدوم، وتحديد مقولات الوجود وما إلى ذلك بالطرق التي فعلوها ليوفروا على أنفسهم وعلى الأمة ذلك الجدل العقيم ويمكنك مراجعة المسألة بتفاصيلها وبتعليقنا عليها بهامش المحصول( 2/55 ) وما بعدها فستجد تلخيصا وافيا ودقيقا، ومناقشة مستفيضة كتبناها لهذه المسألة. فاحرص على الاطلاع عليها هناك.
([3]) قام بهذا الإحصاء الدكتور حاتم الضامن في مقدمته لتحقيق كتاب ناسخ القرآن لابن البارزي.
([4] ) الإتقان، ( 2/30).
([5]) كتاب حجة الله البالغة( 1/259).
[6]) ) مناهل العرفان، (2/152-162).
[7]) ) مناهل العرفان، (2/152-162).
[8]) ) وما زال ليومنا هذا أكثر كتب النسخ المتداولة، وقارن ما قاله ابن الجوزي في حق ابن سلامة نفسه في مقدمة كتابه في حق المفسرين، حيث قال (ص8)” لما رأيت المفسرين قد تهالكوا هذا العلم، ولم يأتوا منه وجه الحفظ، وخلطوا بعضه ببعض ألفت هذا الكتاب..” أنَّ مثل هذه العبارات تدل على مدى عمق المشكلة، كما تدل العبارات المتبادلة بينهم على أنَّهم مع إحساسهم بالمشكلة لم يستطيعوا بما قدموه مجاوزتها أو الوصول إلى القول الفصل فيها لأسباب لا تخفي على المطلع على تراثنا في هذه الجوانب.
[9]) ) نواسخ القرآن لابن الجوزي، ص (74-76) و(123).
[10]) ) نواسخ القرآن، ص ( 123).
[11]) ) الإتقان (2/22).
([12])راجع البرهان للزركشي 2/40-41.
(([13]وهذا غير مقبول بحال فإنَّ النسخ لا يمكن أن يقع -عند القائلين به- خارج عصر الرسالة فلا تصح دعاوى ناسخ ومنسوخ بعد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- حسب مذهب القائلين بالنسخ، كافّة فمن الذي يزيل صفة المنسوخ عنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟!! فكيف يقال هذا؟ ومن الذي يملك هذه الصلاحيَّة؟؟
[14]) ) الإنساء هو التأجيل، والتأجيل في الأحكام الشرعيَّة يتوقف على دليل يقوم على ذلك، وإلا فإنَّه يكون تحكمّا في النّص بلا دليل، كما أنَّ القول بالإنساء ليس فيما نحن فيه، بل ذلك خروج عن موضع النزاع ودخول في موضوع آخر ليس هذا موضع بحثه، كما أنَّ من لم يسلم النسخ لن يستطيع قبول مبدأ الإنساء، لأنَّه لا دليل عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى يجعل النّص تابعا للواقع في حين أنَّ قطع القرآن عن أسباب النزول في العرضتين الأخيرتين واتخاذه صفة الإطلاق يجعل المطلوب من المخاطبين صياغة أسئلة الواقع على أنَّها أسئلة نرفعها إلى القرآن ليجيب القرآن عنها بدون أن يتحكم المجتهدون في الآيات، بل يتحكمون في صياغة وقائعهم وأسئلتهم والقرآن يجيب عنها.
[15]) ) صحيح مسلم كتاب الإيمان، بَاب بيان أنَّ الإسلام بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وإنه يَأْرِزُ بين الْمَسْجِدَيْنِ (1/130) رقم 14.
[16]) ) صحيح ابن حبان ذكر إعطاء الله -جل وعلا- العامل بطاعة الله ورسوله في آخر الزمان أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ( 2/108 رقم 385).
[17]) ) الزركشي في البرهان (2/42-43).
[18]) ) هذا ولإمام الحرمين في البرهان فرضيَّة افترضها وناقشها، وقد تلقي ضوءًا على ما نحن فيه، وستناولها في آخر هذه الدراسة إن شاء الله، فراجعها في البرهان (2/880 وما بعدها).
[19]) ) أخرج البخاري بسنده من طريق عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت (كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قبل أن يُفْرَضَ رَمَضَان وكان يَوْمًا تُسْتَرُ فيه الْكَعْبَةُ فلما فَرَضَ الله رَمَضَان قال رسول اللَّهِ – صلى الله عليه وآله وسلم – من شَاءَ أن يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أن يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ). صحيح البخاري كتاب التفسير، بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ) (2/578 رقم 1515) ولكي يقال: إن استقبال بيت المقدس منسوخ لا بد من وجود الدليل القوليّّ الدال على وجوب استقباله، ليعلم أنّه قد نسخ بالدليل الأمر بالتوجة إلى الكعبة، وإلا فسيكون من قبيل نسخ الفعل النبوي بالقرآن، وذلك ما لم يقرّه الإمام الشافعي وآخرون.
[20] )) البرهان، (2/35)، وام يذكر شيئًا عن الشروط أو الضوابط التي تجعلنا قادرين على الحكم بأنَّ الأمّة قد تلقته بالقبول!!.
[21])) أخرج مسلم بسنده عن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ أنها قالت (كان فِيمَا أُنْزِلَ من القرآن عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ من القرآن)
صحيح مسلم كِتَاب الرِّضَاعِ بَاب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ ( 2/1075 رقم 1452).
قال النووي: ومعناه أنَّ النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه – صلى الله عليه وآله وسلم – توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أنَّ هذا لا يتلى. شرح النووي على صحيح مسلم (10/29) قلت: وهل “العشر” مما يتلى؟!
[22]) ) أخرج البخاري بسنده من طريق عَطَاء قال سمعت ابن عَبَّاسٍ يقول سمعت رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وآله وسلَّم – يقول: (لو أنَّ لابن آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالًا، لَأَحَبَّ أن له إليه مثله، ولا يَمْلَأُ عَيْنَ بن آدَمَ إلا التُّرَابُ وَيَتُوبُ الله على من تَابَ) قال ابن عَبَّاسٍ: فلا أَدْرِي من القرآن هو أَمْ لَا؟ قال: وَسَمِعْتُ ابن الزُّبَيْرِ يقول ذلك على الْمِنْبَرِ. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، بَاب ما يُتَّقَى من فِتْنَةِ الْمَالِ( 5/2364 رقم 6073).
[23]) ) أخرج البخاري بسنده عن أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال دَعَا رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- على الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً على رِعْلٍ وَذَكْوَان وَعُصَيةَ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قال إنسٌ: أُنْزِلَ في الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قرآن قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أن قد لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عنه) كتاب التفسير بَاب فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى }ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ الله من فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لم يَلْحَقُوا بِهِمْ من خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ من اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ { (3/1036 رقم 2659).
[24]) ) البحر المحيط،( 5/252-258). لست أدري كيف سوَّغ هؤلاء العلماء لأنفسهم تناقل هذه الروايات التافهة التي انفرد بها راو عرف بالأوهام، لا ثقة فيما يرويه للنيل من مسلَّمة عقديّة لا يجوز الشك فيها، فمجرد الشك بأنَّ الله – تبارك وتعالى – لم يحفظ كتابه الذي أعلن أنه هو الذي يتولى حفظه وجمعه وقرآنه، وإقراءه لنبيه، وهذه الرّوايات الساقطة التافهة الغثيثة تصادم ذلك – كله – بل تنفيه تماما، وإذا كان الشغف بالرّوايات من بعض الناس لأية أسباب قد حمل هؤلاء على ترديد ورواية تلك الروايات الساقطة فلم رددها هؤلاء العلماء ومنحوها الحياة وجعلوها تتنزل من جيل إلى جيل، وهل هذه الروايات ومن رواها من أهل الأوهام والأغراض أغلى وأعز على الناس من مسلَّمة “سلامة القرآن وعصمته” بحفظ الله له؟!!
[25]) ) ترى كيف يزول وجود الشيء الذهني والواقعي ومع ذلك يحكمون عليه بالبقاء أو الزوال؟!
[26])) أخرج البخاري بسنده عن ابن عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قال: قال عُمَرُ: (لقد خَشِيتُ أن يَطُولَ بِالنَّاسِ زمان حتى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله، ألا وَإن الرَّجْمَ حَقٌّ على من زَنَى وقد أَحْصَنَ إذا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أو كان الحمل أو الِاعْتِرَافُ، قال سُفْيان كَذَا حَفِظْتُ ألا وقد رَجَمَ رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلَّم- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ) صحيح البخاري، كتاب المحاربين، بَاب الاعْتِرَافِ بِالزِّنَا (6/2503 رقم 6441).
[27]) ) فراجعها في تفسيره (3/156) وما بعدها، ط، دار المعرفة في لبنان المصورة عن الأميريّة.
[28]) ) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي بن أبي طالب، ص (41-49).
([29] ) زِرُّ بن حبيش –بكسر أوله وتشديد الراء- بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال وقيل: هلال بن سعد بن نصر بن غاضرة بن مالك بن ثعلبة بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي، أبو مريم، ويقال أبو مطرف الكوفي، مخضرم أدرك الجاهلية. يروى كثيرًا عن أبيّ، وهو الذي رويت عنه سائر الروايات النافية لقرآنيَّة الفانحة والمعوذتين. كان يتشيَّع لأمير المؤمنين عليّ عليه السلاِم ويقدمه على عثمان –رضي الله عنه- وثقة بن معين:، وقال اين سعد: إنه كان كثير الحديث.
قال عاصم: وكان زِرٌّ من أعرب الناس وكان عبد الله يسأله عن العربيّة، وقال العجلي: وكان شيخًا قديمًا إلا أنّه كان فيه بعض الحمل على علي بن أبي طالب t، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة. وعن زِر رويت كل تلك العظائم، فهل كان ذلك بدافع من معارضته لعثمان، ومحاولة للنيل من “المصحف” الإمام، والنيل من زيد انتصارًا لموقف ابن مسعود؟ كل ذلك محتمل. والله أعلم.
له ترجمة تهذيب الكمال (9/335) ومعرفة الثقات (1/370) وسير أعلام النبلاء (4/ 166) وتهذيب التهذيب (3/ 277) وتقريب التهذيب (1/ 215).
[30])) فمراجعة في المحصول: (3/322- 324) بتحقيقنا. أما إمام الحرمين فله في موضوع النسخ –كلّه- موقف خالف فيه القاضي في بيان حقيقة النسخ، فالإمام يشير إلى أنَّ النسخ –عنده- “في حكم البيان لمعنى اللفظ.. فالمكلفون قبل وروده (أي: الناسخ) لا يقطعون بتناول اللفظ الأول (أي الذي عدّوه منسوخًا) جميع الأزمان” على التنصص، وإنّما يتناولها ظاهرًا معرضًا للتأويل.
وعلى هذا فإنّه يرى فيه ما يقرب أن يكون قسيمًا للتخصيص الذي يبيّن زوال العموم المحتمل، والنسخ يبيِّن زوال التأبيد المحتمل الذي لم ينصّ عليه. فراجع البرهان (2/842) الفقرة (1413). وعقّب على ما ذكره القاضي الباقلاني بقوله: “وهذا الذي ذكره القاضي عندنا تشغيب غير مستند إلى مأخذ” فقرة (1417).
وقال في الفقرة (1419): “.. ولا يسوغ فهم الناسخ والمنسوخ مع تنزيه كلام الله –تعالى- عن التناقض ويبسّط الموضوع بشكل كبير حين يقول يرحمه الله: “.. فإذاً الحكم الذي يرد النسخ عليه في علم الله –تعالى- غير مؤيّد، ولا لبس على الله –تعالى- وإنمّا حسب المتعبّدون أمرًا بأن خلاف ماحسبوه، ولو تحققوا لكانوا في استمرار الحكم الأول مجوّزين للتقدير الذي ذكرنا فلا يكونون إذا قاطعين بالتأبيد في الحكم مع تجويزهم ورود ما ينافيه…” ويرجع يرحمه الله الأمر كلّه إلى انعدام شروط دوام الحكم الأول الذي يظهره النص الآخر.
[31])) الرسالة ص 109 – 111.
[32])) (2/78-79) بحاشية البنانى.
[33])) انظر الرسالة، ص (183-184).
[34])) في الإبهاج (2/159-160).
[35])) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، بَاب اسْتِئذان النبي -صلى الله عليه وسلم- رَبَّهُ في زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، 2/672 رقم 977.
[36])) هذه التأويلات نقلها الزركشى في البرهان (2/39)، وتبنى بعض هذه التأويلات النووي في شرحه لحديث عائشة في صحيح مسلم (10/29).
[37])) البرهان (2/41).
[38])) البرهان (2/35). وقولهم: “تلقته الأمة بالقبول” قول فضفاض لا علم بسنده ولا دليل يعضده، وضعوه وتعلق به من تعلق ليتخذ منه وسيلة لتعزيز ما لا يمكن إقامة دليل على قبوله.
[39])) انظر تفسير الطبري (3/156) وما بعدها. طبعة دار المعرفة، وانظر الكتاب المقدس سفر التثنية الإصحاح الثاني والعشرين رقم (21)، والإصحاح الثالث والعشرين.
[40]) ) المصدر نفسه.
([41]) المصدر نفسه.
([42]) المصدر نفسه.
([43]) مفهوم النص، نصر أبو زيد، ص 146.
([44]) وإذا جاريناهم في هذا المنطق فهذا يعني أنَّ عليهم أن يرفضوا رسالة موسى؛ لأنه جاءهم بعد إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف.
([45]) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، بَاب استئذان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- رَبَّهُ في زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ 2/672 رقم 977.
([46]) أخرج البخاري بسنده عن أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- جَاءَهُ جَاءٍ فقال: أُكِلَتْ الْحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فقال: أُكِلَتْ الْحُمُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فقال: أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى في الناس (إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عن لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ)، فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ وَإنهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. صحيح البخاري، كتاب المغازي، بَاب غَزْوَةِ خَيْبَرَ، 4/1539 رقم 3963.
([47]) أخرج البيهقي في دلائل النبوة من طريق ابن إسحاق قال: “لما انصرف رسول الله e راجعا إلى المدينة من أحد لقيته حمنة بنت جحش فنعي لها الناس أخاها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت، فقال رسول الله e: إنَّ زوج المرأة منها لبمكان، لما رأى من صبرها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها”، دلائل النبوة (3/301).
([48]) المائدة آية (106).
([49]) أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قال: قال رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: “خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قد جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ” كِتَاب الْحُدُودِ بَاب حَدِّ الزِّنَى (3/1316، رقم 1690).
([50]) انظر موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني باب الرجم ص (241) رقم (693) بتعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. ط ثانية – المكتبة العلميَّة.
([51]) وقد بيَّنا المراد بمفهوم “الإحصان” في دراستنا لحد الرجم، فارجع إليه.
([52]) ومن جنسه وينبه إليه شكوى الفقراء من استئثار الأغنياء بالأجور مثل ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: جاء الْفُقَرَاءُ إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ من الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، يُصَلُّونَ كما نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ من أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بها وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، قال (ألا أُحَدِّثُكُمْ بأمر إن أَخَذْتُمْ به أَدْرَكْتُمْ من سَبَقَكُمْ ولم يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ من أَنْتُمْ بين ظَهْرَانَيْهِ إلا من عَمِلَ مثله تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كل صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فقال بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إليه فقال تَقُولُ سُبْحان اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حتى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ) صحيح البخاري كتاب الصلاة، بَاب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ 1/289 رقم 807
([53]) أخرج البخاري بسنده عن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (صلى ذَاتَ لَيْلَةٍ في الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صلى من الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ الناس، ثُمَّ اجْتَمَعُوا من اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ فلم يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلما أَصْبَحَ قال: قد رأيت الذي صَنَعْتُمْ، ولم يَمْنَعْنِي من الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إلا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ في رَمَضَانَ) صحيح البخاري أبواب التهجد، بَاب تَحْرِيضِ النبي صلى الله عليه وسلم على صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ من غَيْرِ إِيجَابٍ (1/380 رقم 1077).
([54]) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال 4/177.
([55]) الإتقان في علوم القرآن (2/66).
([56]) الحديث ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة ضعيف. انظر الكاشف للذهبي.
([57]) الحديث ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة ضعيف. انظر الكاشف للذهبي.
([58]) فيه عاصم بن بهدلة بن أبي النجود صدوق له أوهام. انظر تقريب التهذيب 1/384، وهذا من أوهامه لأنه لم يتابعه أحد عليه فيكون ضعيفا.
([59]) فيه عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث صدوق كثير الغلط. انظر تقريب للتهذيب 1/308
([60]) انظر فتح الباري (12/143).
([61]) فيه حميدة بنت أبي يونس مجهولة.
([62]) صوّب بعضهم أنَّه حديث قدسي أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/218 رقم 21956)، وقال شعيب الأرناؤط: إسناده ضعيف من أجل هشام بن سعيد المدني.
([63]) فيه عاصم بن بهدلة بن أبي النجود صدوق له أوهام. انظر تقريب التهذيب (1/384)، وهذا من أوهامه لأنه لم يتابعه أحد عليه فيكون ضعيفا. وهل أراد عاصم برواية هذه الأوهام أن يغرب أو أن يعزِّز توجُّهه في القراءآت، فيضفي على نفسه صفة المحدث تعزيزا لرواياته في القراءآت؟! أو للطعن في عثمان والمصحف الإمام والذين قاموا بكتابته الله أعلم.
([64]) فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. انظر تقريب التهذيب (2/37 ).
([65]) أخرج مسلم بسنده عن أبي الْأَسْوَدِ قال: بَعَثَ أبو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إلى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَدَخَلَ عليه ثلاثمائة رَجُلٍ قد قرؤوا القرآن فقال (أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ فأتلوه ولا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ كما قَسَتْ قُلُوبُ من كان قَبْلَكُمْ، وَإنا كنا نَقْرَأُ سُورَةً كنا نُشَبِّهُهَا في الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَأُنْسِيتُهَا غير أَنِّي قد حَفِظْتُ منها لو كان لابن آدَمَ وَادِيَان من مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا ولا يَمْلَأُ جَوْفَ بن آدَمَ إلا التُّرَابُ، وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كنا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا غير أَنِّي حَفِظْتُ منها ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لَا تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً في أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عنها يوم الْقِيَامَةِ) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، بَاب لو أنَّ لابن آدَمَ وَادِيَيْنِ لَابْتَغَى ثَالِثًا (2/726 رقم 1050) فأبو موسى هنا شهد على نفسه بالنسيان وقسوة القلب، وكان يحاول أن يقدم لقراء البصرة نصيحة بضرورة تعاهد ما يحفظون من القرآن وعدم إهماله فينسون كما نسي هو وغيره، أفيكون ما بقي في ذاكرته مضافا إليه مزيدا عليه لا يلتقي مع بلاغة القرآن في شيئ حجة على كتاب الله المعجز؟!!
قلت: ولعله يقصد بالسورة الأولى سورة آل عمران لأنَّ هناك رواية أخرى رواها عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/132 رقم 21241 ) قال: حدثني عُبَيْدُ اللَّهِ بن عُمَرَ القواريري ثنا مسلم بن قُتَيْبَةَ ثنا شُعْبَةُ عن عَاصِمِ بن بَهْدَلَةَ عن زِرٍّ عن أبي بن كَعْبٍ قال: قال لي رسول اللَّهِ – صلى الله عليه وآله وسلم – (إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أمرني أن أَقْرَأَ عَلَيْكَ قال فَقَرَأَ عَلَىَّ لم يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا من أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حتى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مَطْهَّرَةً فيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وما تَفَرُّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الا من بَعْدِ ما جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ وَلاَ الْيَهُودِيَّةِ وَلاَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ – قال شُعْبَةُ: ثُمَّ قَرَأَ آيَاتٍ بَعْدَهَا – ثُمَّ قَرَأَ لو أنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ من مَالٍ لَسَأَلَ وَادِياً ثَالِثاً وَلاَ يَمْلأ ُجَوْفَ بن آدَمَ الا التُّرَابُ قال ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا بَقِىَ منها) قلت: إنَّ أبا موسى أراد أن يؤكد على قراء البصرة ضرورة تعاهد حفظهم للقرآن الكريم وعدم الغفلة عن المراجعة الدائمة لما يحفظون، ويشير من خلال خبرته وتجربته إلى أنه قد نسى سورا كان يحفظها لعدم مداومته على تعاهد = حفظه ومراجعته المستمرة، فكانت النتيجة أنه نسي ما كان يحفظ وبقيت معاني أو رءوس موضوعات فقط في ذهنه، فأراد أن يحذرهم جميعا من الوقوع في مثل ما وقع فيه، ويبدو أنَّ بعضهم قد فاته فهم ما قال ووهم بأنه كان يتحدث عن سور قد رفعت من القرآن، وهو لم يكن يريد ذلك، بل كان يريد أن يقول بأنَّ هذه انمحت من ذاكرته وذهنه وحفظه هو فلم يعد يتذكر منها إلا بعض رءوس الموضوعات الأساسيّة التي علقت بذاكرته وردت فيها، ورءوس الموضوعات التي أشار إليها هي من موضوعات سورة آل عمران التي قد تكون هي السورة التي كان قد نسيها أبو موسى لعدم تعاهده لحفظها، وحملها الرواة الغفلة على ما كان مستقرا في أذهانهم من أن هناك سورا في القرآن أنزلت ثم محيت من أذهانهم ورفعت من مصاحفهم، وليس الأمر كذلك، إذ أنَّ في هذا تأكيدا من أولئك الغفلة على أنَّ القرآن منقوص، وأنَّ ما بأيدي الناس هو ليس كل ما قد أوحي، وهذا كفر صحيح إذا قاله الإنسان بوعي وبقصد، لقوله تعالى ” إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ” (الحجر: 9 ) وقوله تعالى ” إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ” (القيامة: 17) وقوله تعالى ” سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى” (الأعلى: 6) وكل النصوص الدالة على عصمة هذا القرآن وإعجازه وتحديه بنظمه وبأسلوبه، ولست أدري ما الذي ترك هؤلاء للمشركين وأعداء القرآن ونفاة حجيته وحفظه من أقوال، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وأما ما نقلوه عنه من قوله “لم تقولون ما لا تفعلون” فواضح أنَّ الرجل بعد أن أقر على نفسه بالنسيان قد ذكر طرفا من آية كما في كتاب الله وهي قوله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ” (الصف: 2)، وأضاف هو أو أضاف النقلة الغفلة فيه معنى قد قام في ذهنه بأنَّ دعوى الإنسان فعل ما لم يفعل يجعله ملتزما بالفعل الذي دلت دعواه عليه، فإن لم يفعل كان كاذبا، ويكون بمثابة شهادته على نفسه بحيث يسئل عن ذلك يوم القيامة، وذلك يعني أنه ربما كان يحفظ سورة الصف ونسيها لانشغاله بالإمارة عن تعاهد القرآن، فكل ما في الأمر أنه كان خائفا على القراء من أن ينشغلوا عن تعاهد القرآن فينسونه، فأراد تحذيرهم، وبيان تجربته لهم ليأخذوا منه درسا، وليس ما قاله شهادة على القرآن الكريم بالنقص أو التحريف كما ذكر المغفلون أو الحاقدون، وأن ما بقي في ذاكرته مما كان يحفظ معان رواها فيها ألفاظ قرآنية، وفيها معان بقيت في الذهن عبَّر عنها!!.
([66]) هذا حديث نبوي أخرجه البخاري قال: حدثنا أَصْبَغُ بن الْفَرَجِ حدثنا بن وَهْبٍ أخبرني عَمْرٌو عن جَعْفَرِ بن رَبِيعَةَ عن عِرَاكٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال (لَا تَرْغَبُوا عن آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عن أبيه فَهُوَ كُفْرٌ) صحيح البخاري كِتَاب الْفَرَائِضِ، بَاب من ادَّعَى إلى غَيْرِ أبيه (6/2485 رقم 6386)، فكيف يجعلونه من القرآن الكريم؟ ولعل هذا يذكرنا بنهي رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – عن أن يكتب أي شيئ مع القرآن الكريم لئلا تحدث مثل هذه الأوهام ومثل هذا الخلط الذي أدى إلى مثل هذه الدعاوى، بحيث أدرج البعض آراء الصحابة أو فتاواهم التي علقوها على هوامش مصاحفهم – مثل ما أدرجوا ما علقته السيدة عائشة وابن مسعود وغيرهما – وذلك دليل على أنَّ مخالفة رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – ماحقة للبركة، مؤدية للوقوع في المحذور، فلو تمسَّك هؤلاء جميعا بأمر رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم -، وخافوا من مخالفة أمره لما وقعوا وأوقعوا غيرهم في هذه المشكلات، ولجردوا مصاحفهم من كل ما لا علاقة له بالقرآن، إذ مهما قيل عن أذواقهم البلاغيَّة وفصاحتهم فإنَّ إدمانهم القراءة قد يجعلهم يقولون أو يكتبون عبارات قد توحي للأجيال بعدهم وهي دونهم بكثير في الفصاحة والبلاغة – كما حدث – أنها آيات واردة في مصاحفهم، وهي لم تكن غير تفسيرات = وتعليقات علقوها على مصاحفهم، ظنّاً منهم أنَّ مصاحفهم هذه ستبقى محصورة في الإطار الشخصيّ ولا يطلع عليها سواهم.
([67]) إنه يقصد أنها سقطت من حفظه.
([68]) فيه ابن لهيعة ضعيف. انظر الكاشف (1/590).
([69]) الحديث ضعيف جدا فيه عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن حنظلة الواقفي متروك الحديث. انظر (تقريب التهذيب 1/293).
([70]) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/361 رقم 3274 ) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهذا وهم منهما، بل الحديث ضعيف لأنَّ فيه عبد الله بن سلمة المرادي، قال فيه البخاري: لا يتابع في حديثه.(تهذيب التهذيب 5/ 213) وفيه – أيضا – القاسم بن الحكم العرني، قال أبو حاتم: لا يحتج به (الجرح والتعديل 7/109)، وقال ابن حجر: صدوق فيه لين (تقريب التهذيب 1/ 449)
([71]) هذا الذي ادعاه الحسين بن المنارى ليس عليه دليل إلا زعم البعض أنه كان موجودا في مصحف أبي، وهؤلاء لم يأتوا بدليل، بالإضافة إلى أنَّ القنوت الذي فيه الحفد ليس مأثورا عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم-، بل هو مما أثر عن سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -، ولعل أبى كان كتبه في مصحفه تعليقا فظنوه قرآناً.