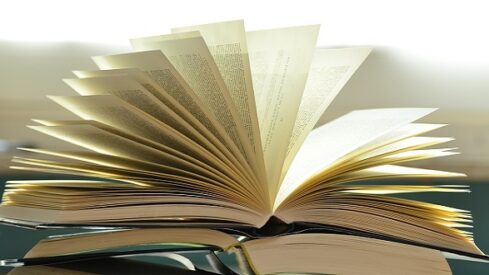لابد وأن صادفت يوما في حياتك أناسا يعيشون في قفص ذهبي يدعى (الماضي)، هوايتهم تعطيل اللحظة الآنية للغوص في مشاهد لا تثمر عملا ولا تورث موعظة، وفي الجهة المقابلة نجد من يسابق الزمن ليعيش حزنا لم يحن وقته بعد، يسبق الأحداث لينصب لنفسه تمثالا مستقبليا يلقي عليه التحية في ساحة الفكر، هي حالة تشبه الإدمان الذي يصعب الإقلاع عنه، إدمان التعلق بالماضي والخوف من المستقبل وقتل “الآن”.
إن الحياة لوحة تشكل مجموع اللحظات التي عشتها وستعيشها، واللحظة التي تقرأ فيها هذا المقال هي لحظة لم تحدث من قبل، ولن تحدث بعدُ حتى ولو أعدت القراءة في نفس المكان! إنها لحظة تحدث الآن فقط، ولا يمكن لك أن تكتشف أسرارها وخباياها إلا بقدر تحررك من أحزان الماضي وشكوك المستقبل.
هي ليست دعوة للتملص من أخطاء الماضي ولا لتعتيم صورة المستقبل، بل هي انطلاقة في اللحظة الآنية بشجاعة وبكل ما أوتيت من خبرات الماضي وتجارب السابقين في مضمار الحياة، بحيث تصبح فاعلا في الزمن، فتصيّر الأمس والغد قوة لخلق سعادة الآن بنفس الأدوات التي كان بإمكانك صناعة تعاستك بها.
فقضية استثمار “الآن” هي من صميم شريعتنا الإسلامية دون أدنى شك، والأجمل من ذلك أن قوة وحينا تقتطع من حاضرنا سعادة تمتد للدار الآخرة، فخيرك الذي يصل الآخرين هنا تجده مضاعفا هناك، والدقيقة التي تسدي فيها الجميل هنا تصير سنوات هناك، كل هذه المعاني وغيرها نلمسها من طرف خفي في قول ابن عمر رضي الله عنهما: (إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك)؛ فالمعادلة واضحة: الأمس ليس لك، والغد غائب عنك، ولك اللحظة التي تعيشها، إنها دعوة واضحة لإخراج الفكرة لحيز الوجود وتطبيقها على أرض الواقع دون تسويف ولا تماطل، فالفكرة التي تأتيك في الصباح قد ترافقك لقبرك في المساء!
إن غياب مثل هذه المعاني عن حياتنا اليومية يجعل حركتنا مضطربة نحو الآخر، فنفقد بذلك قراءة أنفسنا والواقع معا، الشيء الذي يخلق حلقات فارغة ومتباعدة في صياغة رؤية مستقبلية تنطلق من أخطاء الماضي ومرونة الواقع؛ فكل لحظة تميل فيها النفس إلى الإفراط في التعلق بزمن غير زمنها هي لحظة قاتلة إن لم نقل مدمرة!
ونحن لا نتحدث هنا عن الاقتباس من الماضي لبناء الحاضر أو دراسة الواقع لتشييد المستقبل، بل حديثنا عن التعلق المرضي الذي لا يجدي نفعا ولا يجر خيرا، فمثل هذ الممارسات التي تقتل الواقع وتغيب دور الإنسان في هذه الحياة نهت عنها الشريعة الإسلامية صراحة، يقول تعالى: {لِكَيْ لا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ}؛ فالمراد من قوله تعالى كما أورد الرازي في تفسيره أنه ليس نفي الأسى والفرح على الإطلاق، بل النهي عن الإفراط في ذلك حتى يخرُج الإنسان عن حاضره ليتعلق بما فاته، أو أن يفرح فرحا شديدا يطغى به فيخرجه عن إنسانيته، والقصد من ذلك ألا يكون الإنسان فريسة للماضي ولا ضحية لأوهام المستقبل، وإنما عقل متأمّل وقلب متعلّم.
صحيح أن الإنسان مرتبط اترباطا وثيقا بماضيه ومستقبله، وهذا جزء من كينونتنا وطبيعتنا البشرية، لكن الثغرة التي لا ننتبه لها وننساق وراءها؛ تلك التي يستولي فيها الماضي والمستقبل على واقعنا، وذلك بسبب الخلل الوظيفي الذي نمارسه في اللحظة الآنية لنغتال واقعنا بأيدينا، نعم فالإنسان يبكي ويضحك، ولكن بالقدر الذي يثبت به إنسانيته لا غير، وقد ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا للمصيبة صبرا وللخير شكرا)، وكأنه رضي الله عنه يقول: اجعلوا لكل شعور سقفه الزمني الذي يستحق دون إفراط ولاتفريط.
إن قيمة اللحظة الآنية لا تدرك إلا بفقدناها وزوالها، بالضبط حين تصبح ماضيا مطويا يستحيل الرجوع إليه، ولذلك نبه القرآن الكريم لهذه الحقيقة ليوقظ العقول الغافلة والنفوس اللاهية {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ*لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا…} ، فمن هنا نستشعر قيمة اللحظة التي نعيشها الآن، والتي تمتد لتشكل المستقبل، تلك اللحظة التي نغتالها بزيارتنا المتكررة للماضي والمستقبل. إننا في أشد الحاجة لإعادة تفعيل وجودنا في حاضرنا بالصورة التي تسمح لنا بفهم واقعنا، وما دمنا لا ندري متى نموت، فالأولى أن نستشعر النفس الذي يتردد في صدورنا إلى هذه اللحظة، وما دمنا لا نعلم ما يحمله لنا الغد من أحداث ووقائع، فالأولى أن نبني ذواتنا وننمي مهاراتنا.
إن فقه [الآن] ليس وليد نظرية غربية ولا فكرة أجنبية، إنه قوله صلى الله عليه وسلم: (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل)، فحتى في أشد اللحظات التي ينسى فيها الإنسان بأنه موجود؛ يحثنا صلى الله عليه وسلم باستغلال اللحظة الراهنة لترافقنا هناك، والفسيلة هنا ليست بالضرورة أن تكون نبتة أو برعم شجرة، الفسيلة قد تكون عمل خير توصله للغير، أو صدقة تمدها في سر لفقير، الفسيلة هنا هي كل حركة خير يمتد صداها للآخر فتعود عليك بالنفع، والقاسم المشترك بين الفسيلة وغيرها من الأعمال هو [الآن].
إن استيعاب اللحظة الآنية تهب للمسلم أمنا وطمأنينة ما دام يحسن الظن بالله، فلا يكترث لما انقضى وفات، ولايجزع بما هو آت، وإنما حاله كقول زهير بن أبي سلمى:
بدا ليَ أني لَستُ مُدْرِكَ ما مَضَى * ولا سابِقاً شَيْئاً إذا كان جائِيَا.