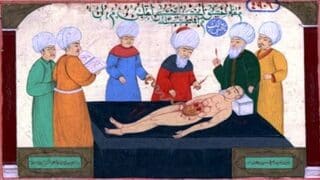يتطلع المسلمون إلى كسب الرهان العالي، وإلى تحقيق الحلم الغالي، المتمثلين في انبعاث هذه الأمة من جديد، في صورة حركة تجديدية جادة وشاملة لجميع ميادين الحياة الإسلامية؛ الدينية منها، والعلمية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية بشكل عام، وفق منظور الشرع، وخصائصه، ومقاصده.
إلا أن هذا المطلب التجديدي سيظل بعيد المنال، عسير التحقق، ما دام العقل الإسلامي مشلولا عن الجد، مكبوحا عن الاجتهاد، منحصرا في أركان زوايا حادة، مما لا يتوافق وطبيعة المكانة التي بوأها الله تعالى إياه، وكذا ووظيفته التي وكلها إياه.
وللأسف، فإننا حينما نتحدث عن العقل الإسلامي، ومشروع تأهيله للقيام برسالته القرآنية التجديدية والمصيرية حضاريا وكونيا، فإننا نصطدم بحواجز متعددة، وموانع مختلفة، تصدنا عن دراسة قدراته الاجتهادية، وتحليل مسؤولياته التجديدية.
ومن أبرز هذه العقبات الكؤود التي تشل العقل الإسلامي عن الجد الشرعي، والكسب الإنساني، والإنتاج الحضاري، عقبة كَأْداء لشدتها وصعوبتها، في علاقتها بنوعين متقابلين من الاحتراب، قلَّ من يسلم منهما إلا مَن وفقه الله تعالى لذلك؛ أما أحدهما، فهو احتراب زماني، ناتج عن فرط الثقة بالتاريخ، وبتراث الآباء والأسلاف. وأما الآخر، فهو احتراب مكاني، سببه فرط الثقة بالغرب، وبمنظومته الفكرية والفلسفية.
فأما الصعوبة الأولى، فتتجلى في الرؤية التاريخية، مشحونة بصراعاتها الكلامية، متمثلة في العقل الفلسفي تارة، والعقل الاعتزالي تارة ثانية، وغيرهما تارة ثالثة، مما سمة القاسم المشترك بينها، رغم البون الشاسع بينها منطلقا، ومنهجا، ونتائج بحثية طبعا، التقابل الشديد بينه وبين نصوص الوحي (أي: القرآن الكريم والسنة النبوية)، بحيث لا يصح التمسك بأحدهما إلا بنصب العداء مع الآخر، مما جعلنا أمام نزعات تنتصر للتاريخ والتراث أكثر من نصرتها للوحي.
ولذلك، فلا غرابة أن يتم إدخال العقل الإسلامي، على المستوى التاريخي، في ثنائيات تقابلية؛ كالعقل والنقل، وظاهر النص وباطنه، والروح والجسد، والدين والدنيا، والخير والشر في قدر الله تعالى، والجبر والاختيار في أفعال المكلفين، وغيرها من الثنائيات الوافدة من الثقافات والحضارات المجاورة للمسلمين عصرئذ، مما سمتها المشتركة بعدها عن المنهج الرباني الذي ارتضاه للبشرية عبر أزمنتها الطويلة بشكل عام، وعن الإسلام نصوصٍ ومقاصد بوجه الخاص.
ومن أبرز نتائج هذا النوع من الاحتراب الزماني، أننا »نكون للأسف من حيث لا نشعر نؤسس في وعي الأجيال ثقافة فيها من التاريخ أكثر مما فيها من الوحي، بل نضيق من قدرات هذا الوعي الاستيعابية والتواصلية والعلمية والمعرفية.. التي تمنحها إياه الدلالات الشرعية الكلية والعامة عندما نجعله يدور في فلك الحدود والتعريفات الجزئية والنسبية وحدها على أهميتها في بناء العلوم والمعارف«[1].
وأما الصعوبة الثانية، فمؤطرة بالرؤية العلمانية، التي تروم الاستغناء عن التراث الإسلامي بشكل عام، والاستقلال عن الوحي بوجه خاص، متمردة على كل مطلق، وثابث، ونهائي، إذا كان انتماؤه إلى الثقافة والحضارة الإسلاميتين، في مقابل تلميع صورة الوافد الغربي، وتضخيم الإنتاج الأجنبي، وتقديس العقل الأوربي سواء في بعده اليوناني، أو الأنواري، أو الحداثي، أو مَن بعده.
ومن أهم نتائج هذا النوع من الاحتراب المكاني، كونه مؤسَّسا على »مشاريع قراءات حداثية ومعاصرة تنتهي صلاحيتها قبل الانتهاء منها، لأنها من موقع تبعيتها تقلد فكرا ليست أصوله أصولا لها ولا اختياراته اختيارات لها. كما لم تحسن مداخل ودوائر التفاعل الإيجابي وضوابط النقل والاستعارة التي تضعها الثقافات والحضارات والأديان على تخومها وحدودها بما يحفظ كياناتها في علاقاتها [مع] الغير أيا كان هذا الغير«[2].
وهكذا، فلا العقل التاريخي المحترب زمانيا، ولا مثله العقل الحداثي المحترب مكانيا، قادرين على التجديد الديني والحضاري لهذه الأمة الإسلامية بشكل عام، والعلمي منه بشكل خاصخص، لسبب بسيط يجليه كونهما غير مؤهلين -لا بالقوة ولا بالفعل- لتشخيص الأزمات المعاصرة للأمة الإسلامية من جهة، فضلا عن إيجاد الحلول الشرعية لمشاكلها العديدة والمتنوعة من جهة ثانية، بحكم موقعهما البعيد عن الرؤية الوسطية القرآنية للعقل الإنساني المستنير بالوحي ومقاصده من جهة ثالثة.
تبعا لذلك، فإن المخرج الأصيل من هذه الأزمة المنهجية والحضارية للأمة الإسلامية على حد سواء، هو محاولة الحسم التام في قطبي هذه الثنائية (التاريخ في مقابل الآخر)، دون انحراف وميل لأحد هذين القطبين على حساب القطب الآخر.
ولبلوغ هذا الهدف، فالواجب حسن تأمل ودراسة قطبي هذه الثنائية، وجودة تحليلهما، في بعد تام عن اتخاذ المواقف النفسية المستعجلة، التي تنبني على ردود أفعال شديدة وعنيفة، مما تجعلنا دائرين في فلك الردود، والردود المضادة، وإشعال نار الحروب الثقافية المجانية، ونظيرتها من الحروب بالوكالة، مما يزيد في تمزيق الجسد الفكري والحضاري لأمتنا الإسلامية، دون إغناء حقيقي لساحة الفكر، والعلم، والمنهج، والبناء الثقافي والحضاري لهذه الأمة.
وإذا كان مصير الانبعاث الحقيقي لأمتنا المباركة رهينٌ بالحسم الجاد والهادف في هذه الثنائية (التاريخ في مقابل الآخر)، بالخروج من ضيق قطبيها المتقابلين، فلا سبيل لهذا الحدث المنهجي والثقافي ذي البعد الحضاري العام، إلا بالاسترشاد بأحد خصائص الإسلام الكبرى، في ارتباطها بالوسطية، التي تجسد مظهرا من مظاهر كونية رسالة هذا الدين وعالميته، لاتفاق أصحاب العقول النيّرة، والفطر السليمة، من حكماء البشرية عامة، على نبذ جميع أشكال التطرف الفكري، والانحراف التصوري، والميل السلوكي.
وتجسيدا لوسطية الإسلام، يقول ربنا سبحانه: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) الآية، [البقرة،142]. على أن من لطائف تدبر آيات الذكر الحكيم، أن الجملة القرآنية التي تلي هذا المقطع المذكور قريبا، تسير إلى حد كبير في صلب ما نحن بصدده، في قوله تعالى: (لتكونوا شهداء على الناس) الآية، [البقرة،142].
وهذا يعني أن من مقاصد منهج الوسطية التي جعلها الله تعالى خاصية كلية لهذه الأمة، مقصدُ الشهادة على الناس، سواء تعلق الأمر بالموافقين لنا ملة وتدينا، أو ما ارتبط بالمخالفين لنا عقيدة وشريعة.
على أن مقصد الشهادة على الناس، لا يمكن تصوره إلا من خلال مقصد القسط والعدل في التصور والحكم على الناس مسلميهم وغيرهم على حد سواء. وفي هذا يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين إن يكن غنيا او فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اللّه كان بما تعملون خبيرا) [النساء، 134].
ومِثل هذا في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للّه شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتّقوا اللّه إن اللّه خبير بما تعملون) [المائدة، 9].
فتأملْ كيف ربطت الآية الأولى من سورة النساء مقصد القسط والشهادة على بني البشر بالانطلاق من الحكم على الناس -وهو أمر عزيز-، ثم بالوالدين وبالأقربين -رغم صعوبته لمكانتهم الاجتماعية-، ثم نبهت الآية إلى أن الإعراض عن العدل إنما هو محض اتباع الهوى، الذي لا يخفى على رب السموات والأرض.
وهو نفس المعنى الذي سارت عليه الآية الموالية من سورة المائدة، بالتنبيه إلى أن وجود العداوة بين الناس، ليس مسوغا لترك العدل، الذي هو سبيل للتقوى، التي لا تخرج بذاتها، ولا بما يضادها، عن علم علام الغيوب.
تبعا لذلك، فإن من ملامح هذا التصور الوسطي لتجاوز هذه الثنائية (أي: التاريخ في مقابل الآخر)، هو الاستفادة من نواحي القوة في كل تصور احترابي مما سبق؛ بالنظر إلى أن الاحتراب الزماني تحذوه الرغبة في الاحتماء بالذات الإسلامية وحماية حياضها. في حين يرمي الاحتراب المكاني إلى انبعاث العقل الإسلامي ودعوته للجد والعمل، ليلتحق بنظيره الغربي في حمل لواء العلم والمعرفة والإنتاج الثقافي.
وهذا ما يساهم في إعادة تصورنا إلى قطبي هذه الثنائية، بضرورة الاعتناء بمقصد خدمة الذات الحضارية الإسلامية خدمة تتأسس على التمييز بين الثوابت في إرثنا الثقافي (وهي نصوص الوحي) والمتغيرات فيه (وهي اجتهادات العلماء لفهم نصوص الكتاب والسنة وتنزيلها)، على أساس أن الثوابت تتميز بالديمومة والاستقرار، عكس المتغيرات التي يمكن أن تخضع لقانون الاجتهاد، تبعا لتغير فهمنا للوحي، أو للواقع، أو لهما معا.
وبالمقابل، فإن خدمة هذه الذات الحضارية الإسلامية تظل بعيدة المنال، ما لم يستفد من العقل الإسلامي من مثيله الغربي في سعيه الحثيث والمتواصل وراء العلم والمعرفة والدراسة والتحليل.
ولبلوغ هذا الهدف، ومن أجل انبعاث هذه الأمة من جديد، فالواجب التأكيد على أن مجال اشتغال العقل الإسلامي في صورته المطلوبة، يجد مشروعيته النظرية، ومنطلقاته العملية، من خلال الجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون، قراءةً تهدف إلى حسن قراءة النصوص الشرعية، بغية جودة تطبيقها على واقع الناس ومعاشهم، طلبا لإسعادهم في الدين والدنيا.
وبالمقابل، ولما كانت العلوم التجريبية المادية، والإنسانية الاجتماعية، هي السبيل الحقيقي لاستعباد الغرب لنا ولغيرنا من الشعوب الضعيفة، فالواجب على العقل الإسلامي إعطاء الأهمية الكبرى لهذا الصنف من العلوم، والاجتهاد في تحصيلها، وبذل الجهد في تطويرها، بغية راهنية متميزة لهذه الأمة، يسعد بها المسلمين أنفسهم، كما يسعد بها غيرهم من شعوب العالم كذلك.
الهوامش :
[1] شبار، سعيد، المصطلحات والمفاهيم في الثقافة الإسلامية بين البناء الشرعي والتداول التاريخي، منشورات المجلس العلمي الأعلى [بالمغرب]، ط 1، 1431هـ – 2010م، ص 27.
[2] شبار، سعيد، مناقشة هادئة، جريدة “التجديد” المغربية، عدد يوم 13-03- 2010م.