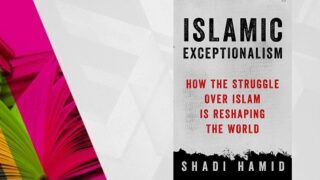يمثل كتاب “أنا والقرآن، محاولة فهم” للمفكر جاسم سلطان خلاصة تجربة ذاتية للكاتب مع التدبر وإعادة النظر بعيون واعية في القرآن الكريم، لا بوصفه كتاب تبرك وتحصن من قوى الشر بل باعتباره كتاب هداية وحضارة وتعمير، وباعتباره كتابا يدعو إلى تحرير العقل وبالتالي إلى التفكر والتدبر والتأمل في ثناياه بدل الخوف منه والاعتماد على فهمه بواسطة المفسرين أو الفقهاء.
يقرر جاسم سلطان في الصفحات الأولى أهدافه من الكتاب ويأتي في أول تلك الأهداف “البحث عن الخرائط العقلية”، وهو ما يستدعي استحضار الطاقة العقلية لأن القرآن لا يعطي أسراره إلا لمن يطلبها بصدق ويستخدم عقله وبصيرته ما استطاع، ثم يضيف الكاتب “إنه محاولة غوص متواضعة في بحر أفكار القرآن الكبرى”، إذن جوهر هذا الكتاب هو البحث عن منظمات العقل والتصور في القرآن، وهي العالم المكين لإصلاح عالم العلاقات الإنسانية وعالم المشاريع البشرية، ولصناعة حضارة الرحمة بالبشر كل البشر، والخلق كل الخلق.
ويحدد الكاتب الجمهور المستهدف بكتابه، إنهم كل طلاب الفكرة في القرآن، كل من يريد النظر في القرآن من زاوية عالم الأفكار الضيق، لأن إصلاح عالم الأفكار يأتي أولا، ثم يلفت الكاتب النظر إلى أن القرآن ليس موجها للعلماء فقط، بل لكل الناس، تلك هي الحقيقة البسيطة، وقد أصبح اليوم بإمكان أي إنسان أن يتدبر لنفسه، فوسائل المعرفة أصبحت متاحة من كتب التفسير إلى معاجم اللغة وغير ذلك، فالعصر “عصر تفكر بامتياز”، كما يقول الكاتب.
القرآن بين التجريد والفكرة الناظمة
ينبه الكاتب إلى الاختلالات التي أصابت نظر المسلمين في القرآن، ويحاول أن يعطي وصفا جديدا للقرآن، إن هناك ما سماه المؤلف “النسيج الضام” الذي يشكل أرضية للقضايا الكبرى وهي قضايا الإيمان والآخرة والبشارة والنذارة، وفي ثنايا هذا النسيج الضام هناك موضوعات أخرى متنوعة تشكل تطريزا وتأثيثا للنسيج الضام تنطلق منه وتعود إليه، ولكنها ليست هو في الحقيقة، إن هذا النسيج الضام –في نظر الكاتب- ليس هو الخط الكلي الناظم الذي حاول كل من محمد الغزالي وسعيد حوى رسمه للقرآن، بل يذهب الكاتب إلى أن القرآن ينتظمه معنى واحد كبير هو “إصلاح عالم الأفكار وزرع التقوى في نفس هذا الإنسان”.
إن قصورنا في رؤية الأنساق التصورية للمعالجات القرآنية يتضح أكثر كلما حاولنا إعادة الاقتراب من القرآن محررين من السوابق واللواحق، حيث طغى على أفكارنا النظر الجزئي للمنظومات القرآنية، بل “في أحيان كثيرة تأثرت نظرة المسلمين إلى القرآن بآثار العصور، فاستعيض عن تصور العلاقات الإنسانية الطبيعية بالبناء على الأحوال الاستثنائية، وجعلها الأساس”.
أتى الكتاب متأثرا في بنائه الموضوعي بالقرآن حيث احتوى على مقدمة وباب تمهيدي وباب لسورة الفاتحة وباب لسورة البقرة، وقد عرض الكتاب للأفكار الكبرى والجوهرية في سورة الفاتحة باعتبارها تمثل تلخيصا للخطوط العريضة لموضوعات القرآن، كما استفاض المؤلف في الحديث عن سورة البقرة لأنها مثلت تجربة البشر في تفاعلهم مع الدين ممثلة في تجربة بني إسرائيل بما فيها من الثراء والعبرة والتنوع.
المفاتيح السبعة لأم الكتاب
يعيد الكاتب تشكيل تصور الفاتحة في الأذهان من خلال إبراز المفاتيح السبعة التي اشتملت عليها، وهي مفاتيح انتظمت جوانب الخطاب التأسيسي للفعل الإنساني، وهذا ما يفسر –حسب المؤلف- الاحتفاء بها في كل صلاة، وهذه المفاتيح هي:
1 ـ مفتاح المنظور الشامل
2 ـ مفتاح المفهوم الكوني
3 ـ مفتاح مركزية الرحمة
4 ـ مفتاح مركزية الحساب
5 ـ مفتاح مركزية العمل
6 ـ مفتاح الصراط المستقيم
7 ـ مفتاح أهمية المثال
المحاور الأربعة للبقرة
تأخذ سورة البقرة أكثر من ثلثي الكتاب، ويحاول الكاتب الاقتراب منها بطريقة منهجية تبدأ بتحديد محاورها الكبرى، وهي محاور متساندة حسب تعبير الكاتب ومتسلسلة في بناء منطقي يجعلها تنتظم الكون والحياة، وهي:
1 ـ تقسم عام (مؤمن، كافر، منافق)
2 ـ قصة الوجود (الله، الملأ الأعلى، الإنسان)
3 ـ أمة سلفت (أهل الكتاب بنموذج اليهود)
4 ـ أمة تولد (مجتمع الإسلام)
ويقدم الكاتب قراءة واعية في الآيات الأولى من سورة البقرة، منبها إلى ما سماه مثلث (الهداية والكتاب والتقوى) من خلال قوله تعالى:”ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ”، إن هذا المثلث يمثل وصفة سحرية لحياة الإنسان، ولكن هذا المثلث يحتاج إلى حركة ذات اتجاهين كي يؤثر في واقع الحياة، حركة في اتجاه الخالق (الإيمان بالغيب والصلاة) وحركة في اتجاه (الإنفاق) ، “الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
ثم تحدثت السورة عن بدء الخلق، أي نشأة هذا العالم الدنيوي المسخر للبشر، أما الكون فشيء آخر أوسع من هذه الدنيا التي لا تمثل إلا شيئا يسيرا فيه، ثم أعطت السورة كثيرا من آياتها للحديث عن بني إسرائيل الأمة السالفة التي تحتاج الأمة الناشئة لمعرفة تجاربها مع الدين وسلوكها في التدين.
وينبه المؤلف إلى امتزاج التاريخ بالتوجيه في قصص بني إسرائيل، والتاريخ يبقى تاريخا لكن التوجيه هو الذي يعبر الزمن ويصل إلينا، و”لكن الخط العام يسير بالتدرج لنزع الشرعية والراية التي يدعيها بنو إسرائيل ليسلمها إلى الدين الجديد.
وفي مسار الحديث عن بني إسرائيل يركز القرآن على تبيان أسباب ومظاهر التدين المغشوش لدى بين إسرائيل من أجل أن تنتبه الأمة الناشئة لذلك فتتجنب الأسباب وتعالج المظاهر، إن من أول أسباب التدين المغشوش هو طول الأمد وقسوة القلوب، أي وجود أجيال لم يختاروا الدين اختيارا بل هم أبناء بيئتهم، وهكذا ولدوا على دين آبائهم، وتحيط بهم سلوكيات الآباء ومؤسسات تفسير الدين.
ومن مظاهره، نسيان الحق وبيانه وتغليب مكاسب الدنيا على خوف الآخرة وخلط الحقائق وكتمانها بعد استبانتها وترك أهل الحق وطريقهم ثم أمر الناس بأحسن العمل وعدم إتيانه، وقد جمع ذلك قوله تعالى:” يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ * وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ* وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون* وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ* أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ”.
وعلى كل حال فالكتاب مليء بالنظرات العميقة التجديدية في القرآن وأساليب تدبره وكيف نفهمه في إطاره الكلي دون أن نصدم بعض آياته ببعض.