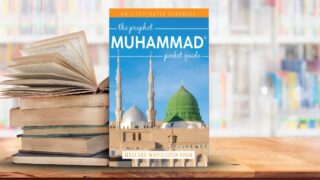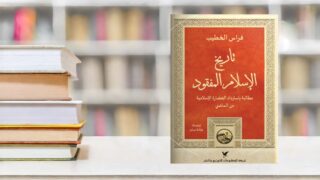تتعدد كليات التربية في الدول الإسلامية والعربية، لكن السؤال هل مناهج تلك الكليات مستمدة من رؤية فلسفية إسلامية تحقق بناء نموذج المتعلم المسلم الذي ينفتح بقلبه وعقله على الكون وأسراره؟ أم أن هذه المناهج تستمد رؤيتها من الحداثة الغربية المنقطعة الصلة بالدين والبعيدة عن الوحي وأنواره؟
الحقيقة أن كثيرا من مناهج كليات التربية تستمد رؤيتها وفلسفتها من الحداثة الغربية، التي تنظر إلى الإنسان وإلى الكون على أنهما ظواهر وليسوا آيات تستدعي التوقف والتفكر، وفي هذا الإطار يأتي كتاب الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن “من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر” الصادر عن دار إبداع في (115) صفحة، وفي الأساس تجميع لمحاضرات للدكتور طه جهزها للنشر الدكتور رضوان مرحوم، وتمت طباعة الكتاب مرتين في عام 2016م نظرا لأهميته وما يحتويه من أفكار ورؤية تمس الإنسان العربي والمسلم خاصة فيما يتلقاه من تربية في سنوات عمره التعليمي التي تقترب من ستة عشر عاما .
التأسيس الفلسفي
يؤكد “طه عبد الرحمن” أن كل نظرية تربوية تحتاج إلى تأسيس فلسفي، تجعل وجودها مشروعا وبناءها معقولا، وفي الحالة الإسلامية تحتاج النظرية التربوية إلى تأسيس له خصوصية؛ فهي تحتاج إلى شرعية دينية، وشرعية عقلية، فالتدين في حق المسلم ليس مجرد سلوك تعبدي يلجأ إليه لتسكن نفسه، ويملأ فراغ قلبه، وإنما هو طريقته لتحقيق ذاته في الوجود، لذا فالعقل المجرد أو البعيد عن العمل الشرعي لا تستقبل إدراكاته الحقائق الإيمانية والغيبية.
ولكن كيف نبني تلك المشروعية والمعقولية؟ وما هي المبادئ التي تؤسس لها فلسفيا؟
يرى “طه” أن الذين يستحقون أن يتولوا التأسيس الفلسفي للتربية الإسلامية هم أهل “العقل الواسع” أي أهل العقل الموصول بالشرع والمسدد بالمقاصد، وهو عقل يُسلم بأنه ليس في مكنته الاستقلال بإدراك حقائق الغيب وعالم الملكوت بمفرده، ولكن يستمد أصوله من الوحي المنزل، فيتجاوز النظر للملك إلى الاستمداد من الملكوت.
وأول سبيل لبناء تلك النظرية هي ممارسة التقويم أي النظر في الخطاب التربوي السائد، خصوصا الخطاب الحداثي، ونقده نقدا إيمانيا في أصوله ومسلماته، فتصوب إرادته في فصل القيم التربوية عن الدين، وهذا النظر ضروري للتخلص من تأثيرات الاستعمار في تربيتنا.
ويرى “طه” أنه لا يمكن أن توجد نظرية إسلامية في التربية في ظل إغفال مفاهيم “التزكية”، وما يرتبط بها من أفعال القلوب، لذا فهذه النظرية ليست إصلاحا جزئيا لشخص ما، أو تقويما لخلق ما، ولكنها تقوم بإعادة التشكيل الكلي للإنسان مقصدا ووجهة، في ولادة قلبية جديدة كولادته الأولى من بطن أمه، ولادة تهدم أركان نفسه القديمة، وتصحح قبلته، “ولادة كوثرية” عظيمة النفع والخير، على خلاف “الولادة الأبترية” العقيمة التي لا عقب لها والمعطلة الفاقدة للإرادة، فالمقصد الأسمى للتربية الإسلامية هو إيجاد الإنسان الكوثر.
ويؤكد “طه” أن التأسيس الفلسفي للتربية الإسلامية مقيد بالتاريخ وغير مستقل عنه، وهو ما يفرض على الفيلسوف المسلم أن يستنبط من هذه الممارسات ما تأكدت فائدته، لتظل الصلة بالتاريخ التربوي قائمة اعتقادا في صلاح بعض مسالكه أو انتقادا لبعض مكوناته.
ويذهب –أيضا- أنه تأسيس تربوي، لا تأمل تجريدي؛ لأن الأصل في الفلسفة هو السؤال عن المنهج الذي يوصل الإنسان إلى تحصيل حياة طيبة، وهو ما يفرض على الفيلسوف أن ينهض بمهمة تحويل القواعد والمعايير إلى ممارسات سلوكية حية، كذلك من الضروري أن يدفع ذلك التأسيس الفلسفي عن نفسه شبه الجمود على التراث التربوي، باللجوء الدائم إلى الأدلة العقلية اليقينية.
محو الانفصال
يرى “طه ” أن القصد الأساسي للحداثة في كل ما تنتجه هو محو الدين، وعندما فشلت في قصدها لجأت إلى أن تستصحب الحكم السلبي عن الدين في كل إنتاجياتها، لكن تبقى المشكلة الكبرى في أن المؤسسة الحداثية هي التي تولت تربية الأجيال الحالية على مناهج بديلة عن منهج التكوين الديني، ومنعت غالبية علماء الدين ورجاله من مزاولة دورهم في التربية والتعليم، لأنها تدرك أن قصد النظرية التربوية الإسلامية هو إقامة الدين في العملية التربوية كلها توجيها وتنظيما وتحقيقا، ومحو الانفصال الحداثي بين الدين والتربية.
ويلاحظ أنه بعد سيطرة الحداثة على التربية فكرا وتنظيما وسلوكا، غابت مفاهيم في العملية التربوية مثل: الهدي، التدبر، النور، البركة، البصيرة، الميزان، لكن كان أشدها إيلاما في التربية غياب مفهوم التزكية نظرا لمحوريته في العملية التربوية في الرؤية الإسلامية، وهو ما أدى إلى إنتاج الإنسان الأبتر، ذلك الإنسان الذي لا يستثمر من قواه ولا يُحقق من إمكاناته إلا قدرا ضئيلا، ويبدو أن التقدم المادي الحالي حصل بذلك الإنسان الأبتر، إذ صرف ذلك إنسان كل طاقته في جزئية ما، دون إدراك للنظر الكلية للكون والإنسان، وذلك على خلاف الإنسان الكوثر الذي يحقق التكامل في ذاته، جاعلا من الإيمان مركزيته وباعثه، فتصبح نفسه تواقة إلى فعل خير الأعمال، ويتوق إلى تحقيق الكمال.
ومن المبادئ التي وضعها “طه” للفلسفة الإسلامية التربوية، أن تتسم بالثبات والاستقلال والحياة والإبداع، لكن يبقى عنصر الحياة ذا أهمية خاصة لأنه يجعل النظرية تملك القدرة على التقلب في مختلف السياقات التربوية مع احتفاظها بسماتها الجوهرية في مضمونه، فالحياة تخلق ديناميكية وفاعلية، خاصة في رؤيتها الخاصة للعالم، ويقوي القدرة على التفاعل مع تحديات العصر، وهنا يتوسع نطاق تأثيره وإسهامه في بناء نمط تربوي كوني جديد.
وفي العنصر الحي يجب البحث عن العنصر المنتج والعنصر المبدع، الذي ينشئ المضمون وآلته، بما يمكنه من الإبداع التربوي مقدما إنتاجا تربويا منافسا، خاصة وأن الإسلام ذا خصوصية في عالمية رسالته، وفي خاتميتها، وهو ما يستوجب نقد الخطاب التربوي نقدا إيمانيا، يناقش فيه مواطن الانفصال بين الحقيقة الدينية وبين المفاهيم التربوية.
الإنسان الكوثر
ويؤكد “طه” أن التربية تنبه العقل المسلم أن يتعامل مع كل ظاهرة على أنها آية تستوجب النظر والاعتبار، والبحث عن موطن الإيمان، وإذا علمنا أن الإنسان الحداثي يظن أنه لا يخفى عليه إلا أشياء قليلة، ظنا منه أن العالم تجرد له من أسراره منذ الثورة الصناعية أي منذ ما يسميه بـ”عصر الأنوار”، فإن تسلط هذه الرؤية على عقل الإنسان منعته من التفكر في الملك والملكوت، وحجبته أن يسبح بعقله وقلبه في الكون، ويدرك ببصيرته ما لا يدركه بصره.
وهذا الأمر يتطلب أن يخرج الإنسان المتعلم المسلم من ضيق العقل إلى سعة الإدراك للكون بقلبه وهو ما يجعل قوة الإدراك في الإنسان مزدوجة قلبية وعقلية، وهنا يمتلك الإنسان عقلان، فيعيد للعقل اتساعه بعدما جعل الإيمان أساسه في كل شيء، فقد أساءت التجزئة إلى وحدة الإنسان التي خلق عليها، وهو ما أوجد القلق في حياة الإنسان، وأوصله إلى القلق الوجودي الذي لا يطمئن إلا بهداية من الوحي وأنواره.
ويتأسس على ذلك أن يتبني النظرية التربوية الإسلامية على النظر للظواهر ليس كأشياء تخضع لمقاييس ما، ولكنها آيات مرتبطة بالكون وخالقه، فتستيقظ القيم الكامنة في فطرته، لأن العلم الذي لا تصحبه أخلاق يضر أكثر مما ينفع، ويتساوى في ذلك العلم الوضعي والعلم الشرعي، فالأول يجمد على ظاهر الأشياء، والثاني يجمد على ظاهر الأخلاق، والظاهر لا فائدة له ولا فيه إلا إذا تأسس على الباطن، فإذا انتفى الباطن وصل العلم بالإنسان إلى مرحلة الطغيان والشطط، لذا كان القرآن الكريم يؤسس العلم كظاهر، على الخشية كباطن، وهو ما يفرض على العلم أن يتزود بالمعاني والقيم، أي أن الأخلاقية هي التي تثبت العقلانية وتوسع نظرها، وهنا تنتج التربية الإسلامية الإنسان الكوثر المنشغل بإحياء روحه، إحياء لا يفصل بين العقل والقلب.
ومن هنا فتجديد الإنسان المسلم لا يمكن أن يتم إلا عن طريق إحياء القلب، أي إحياء الروح التي هي مستودع سره ووجوده، فهي قبس من عالم الملكوت، توسيع عقل المتعلم المسلم وتثبت إرادته، وهو ما يتطلب هداية ذلك الإنسان التائه البعيد عن ربه.
ويؤكد “طه” أن الشهود على الناس لا يتحقق إلا بتفوق أخلاقي حي، لذا وجب على المسلم أن يتوسل بالمعرفة المادية والقوة العلمية لتحقيق ذلك الشهود، ويتعجب “طه” ممن يظن أن رتبة الشهود على الناس تفرض أن يحذو المسلم حذو المشهود عليهم في إقامة الصروح العلمية والتقنية أي الانجاز العلمي التقني، ويرى أن هذا الرأي من رواسب العلمنة في عقل المسلم، حيث إن الشهود على الناس مجاله عالم القيم والأخلاق أي الاستمداد من الوحي والغيب.
تنزيل PDF