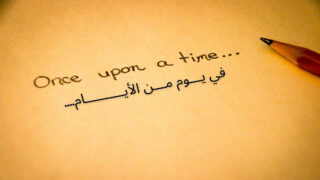“الرواية” ترسم عالمًا متكاملاً، وتبني شخصيات نابضة بالحياة، فيها المتعة الفنية والدرس والعبرة؛ ولهذا تحتاج “الرواية” للكثير من القراءات والاطلاع على منجزات السابقين، بجانب مراكمة الخبرات الشخصية من الحياة ودروبها.. وهذا ما سنتعرف عليه من خلال تجربة الروائي المصري كارم عبد الغفار، الذي شق طريقه في عالم الرواية العربية بتميز واقتدار.
وقد حصل كارم عبد الغفار على ثلاث جوائز في مسابقات “الهيئة العامة لقصور الثقافة”، في دورات مختلفة.. منها المركز الأول في دورة 2021م، بروايته “عتبة وداد”.. فإلى الحوار:
نود أن نتعرف على رحلتك مع “الرواية”.. من القراءات الأولى ثم الاتجاه للتعمق.
بداية، أهلاً بكم وسعيد بتشريفي بهذا اللقاء، أما القراءات الأولى فالفضل فيها يرجع لخالي، فقد نبّهني مبكرًا إلى معنى الكتاب والمكتبات، وسهَّل لي الوصول للكتب في سن مبكرة، بدأت بشكل جاد في نهاية الإعدادية. فرغم وجودنا في مكان ريفي قليل الموارد المادية، فضلًا عن الثقافية، لكن كانت مكتبة خالي جيدة بالنسبة لأعمارنا الصغيرة.
فطالعت سيرة بنت الشاطئ، وكتب عباس محمود العقاد، وأشياء لنعمات أحمد فؤاد.. ثم في الثانوية تفتحت عيني على كنز بمكتبة المدرسة بالدلنجات؛ وبدأت أتعرف إلى الرواية وعالمها، وأول دخول كان من بوابة الأستاذ نجيب محفوظ، ولا أزال أذكر حتى الآن موضع رواية “الحرافيش” على رف المكتبة هناك.
وكيف اقتحمت عالم النشر؟
بدأت الكتابة على استحياء في نهاية الثانوية، وكانت ميولي في البدء ناحية السيناريو، فكتبت سيناريو هزيلاً عن التربية وعالمها وضاع بعد ذلك.. وفي الجامعة كتبت سيناريو بعنوان ليلة شتا (حوّلته بعد ذلك إلى رواية “وحل الشتا”) وكتبت سيناريو “الترحيلة”.
وبعد محاولات في طريق الكتابة السينمائية، لم أجد الأمر ميسورًا؛ فسكت عن الكتابة وقتًا حتى أنهيت الدراسة في دار العلوم وبدأت العمل في دار نشر شهيرة، وفي تلك الدار تيقظت همتي مجددًا نحو الكتابة، وهذه المرة استهللت الكتابة الأدبية بتحويل سيناريو فيلم “الترحيلة”، الذي صغته في الجامعة، إلى رواية قصيرة باسم “دمعتان وبسمة”، عام 2008.
قراءاتي الأولى شملت سيرة بنت الشاطئ وكتب العقاد
وكيف استقبلها النقاد والقراء؟
حفاوة شديدة فاجأتني من إدارة الدار، حتى إنني أذكر أن د. إيهاب عبد السلام (مدير الدار حينها) بكى بعد قراءة العمل، وشد على يديّ، وبالغ في تقديري، وكان لدعمه الفضل الكبير لمواصلة الطريق في هذا الإطار.
وماذا عن رواياتك التالية؟
كتبت بعد ذلك رواية “الغولة” 2009، كانت أيضًا عن سيناريو قديم لي، وتحكي وقائع الأمة العربية في إطار رمزي.. ثم تلتها رواية “مستورة” 2010، وقد نالت المركز الثالث في مسابقة قصور الثقافة وهي عن قصة حقيقية تدور بالأساس حول سيرة جدتي لأمي.. ثم رواية “وحل الشتا” 2011، ترصد انقسامات وشروخ الجدار العربي .. ثم توقفت فترة عن الكتابة لانشغالي بالدراسة الأكاديمية، ثم رجعت إلى الرواية بـ”جراب الخضر” المنشورة عام 2018.
كيف جاء فوز روايتك “عتبة وداد” بالمركز الأول في مسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة؟
حصلت رواية “عتبة وداد” على المركز الأول في دورة 2021، وكان ذلك حافزًا كبيرًا بالنسبة لي.. وقد صادفت توفيقًا أكثر من مرة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ حيث فازت رواية “مستورة” ومجموعة قصصية بعنوان “الملك”، بمركز ضمن المسابقة، في دورتي 2011 و2014.
انتشار الرواية مؤخرًا يعود بالأساس لمالكي أدوات الدعاية التجارية
لو جئنا للكتابة نفسها.. من أين تستمد أفكارَ روايتك؟
غالب رواياتي ترصد الواقع الريفي الذي نشأت فيه وعشت تفاصيله وتشربت وقائعه الاجتماعية، وأحيط بمعالمه وروحه وأهله بشكل جيد؛ بصفتي من مواليد محافظة البحيرة (أم الأرياف)، وفي مركز الدلنجات الذي يعد أكبر منطقة زراعية في القطر المصري.
البناء الروائي.. هل ترسمه في المخيلة أو على الورق مختصرًا ثم تبدأ، أم تترك تتداعي الأفكار ليرسم التطورات والشخصيات؟
استفدت كثيرًا من طريقة كتابة السيناريو؛ فدومًا أرسم خطة للرواية قبل الكتابة، فأضع البداية والعقدة والنهاية وتطورات الأحداث في شكل نقاط تؤدي كل واحدة للأخرى.
لكن بالطبع يمكن أن تتغير الأحداث عما خططت لها، وقد يتحول المسار تمامًا في أثناء الكتابة، ولكن لا بد أن أبدأ وفق خريطة أسير عليها.
وما مستوى اللغة الذي تحرص على استخدامه في الروايات؟
أحاول بقدر الإمكان ألا أستخدم الجُمل الاعتيادية في السرد والوصف.. ودومًا بجواري قاموس لغوي لأبحث عن المعاني التي أجد لساني قاصرًا عنها، لأتأكد من صحة بعض التركيبات.. وأما بشأن الحوار فأكره تطويله وأحاول اختصاره قدر الإمكان.
الأدباء يهتمون عادةً بما يسمَّى “طقوس الكتابة”.. هل لديك طقوس خاصة؟
لا أقتنع بمسألة الطقوس، لكني أحب دومًا الكتابة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة أيًّا كان التوقيت؛ حيث أشعر أنه الوقت المثالي لتداعي الأفكار وجودة اللغة.
من أهم من تأثرت بهم من الأدباء؟
أعتبر الأديب يوسف إدريس مايسترو الجملة الأدبية الصحيحة؛ فهو يحمل قاموسًا مدهشًا، بالإضافة إلى خبرة اجتماعية تجعل تراكمات كتاباته مصدرًا جيدًا لإلهام أي كاتب.
وأضيف إليه بطبيعة الحال الأستاذ الكبير نجيب محفوظ؛ فإنتاجه الضخم يجعله مصدرًا أساسيًّا لوصف الشخصية المصرية، ومن الحتمي أن يطالعه أي كاتب.
وبجواري دومًا مجموعات الأستاذ سعيد الكفراوي أراجعها باستمرار لتنشيط قاموسي الشخصي؛ فهو يمتلك عمقًا فريدًا في الوصف وفي جزالة اللغة.
التزام قضايا المجتمع والإنسان يمنح القلم دورًا ومهمة راقية
كيف ترصد انتشار الرواية في الفترة الأخيرة بشكل لافت؟
المسألة خاضعة بشكل أساسي لمالكي أدوات الدعاية التجارية؛ فهم الذي يتبنون حملات موجهة تجعل حقلاً يتصدر وحقلاً يخفت.
وأظن أن سوق الرواية الأدبية التقليدية الآن في أفول، وسيصعد الكتاب العلمي بديلًا عنها، وسيواصل “أدب الفانتازيا” صعوده؛ وذلك لأن متطلبات العقلية العصرية سيناسبها ذلك.
الرواية بين المتعة الفنية والرصد الاجتماعي والفكري.. كيف ترى الدور أو الثمرة المرجوة من العمل الروائي؟
“الأدب الملتزم” قضية فنية شغلت أذهان الكتاب في كل العصور، وأرتاح إلى أن “الالتزام الأدبي”- الذي يجعل قضايا المجتمع والإنسان نصب عينيه- يمنح القلم دورًا ومهمة راقية.
أما الكتابة للكتابة أو الفن للفن، فرغم أني لا أعارضه جملة، لكن إذا صار نمطًا عامًّا فهو كارثي.
ما أهم ما تنصح به الشباب المهتم بالإبداع الروائي؟
القراءة ثم القراءة ثم القراءة؛ فهي أولى بكثير من العجلة في إمساك القلم؛ فلو ترك الشخص كتابًا واحدًا ذا قيمة ومؤسسًا على منهج وعلم ولغة وقراءة عميقة ورصيد ثقافي كبير، فهذا أفضل بكثير من ثرثرات على أوراق الكتب دون أساس ثقافي لا تسمن ولا تغني من جوع.
تنزيل PDF