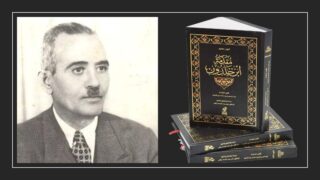كثيرًا ما شُغل الناس بابن خلدون (732ه- 1332م- 808هـ/ 1406م)، وتساءلوا عن هذه العبقرية التي أنتجت “المقدمة”؛ صاحبة النقلة النوعية، لاسيما فيما يتصل بعلوم الاجتماع والعمران والتاريخ والحضارة.. وهل كان عمل ابن خلدون وَصْلاً مع المعارف القديمة، مثل المنطق الأرسطي، أم قَطْعًا معها؟ عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي (1913- 1995م)، له إسهام مهم في رصد مظاهر “الإبداع الخلدوني” وما مثّله من “طفرة” للفكر الإنساني. وجاء اهتمام الوردي بابن خلدون أولا ًفي أطروحته التي تقدم بها لنيل “الدكتوراه” من جامعة تكساس الأمريكية عام 1950م، تحت عنوان (في علم اجتماع المعرفة)، ثم في كتابه (منطق ابن خلدون- في ضوء حضارته وشخصيته)، الذي سيكون في بعض جوانبه محورَ هذا المقال.
ينطلق الوردي في كتابه من تساؤل رئيس، هو: أكان ابن خلدون يجري في تفكيره على منهج المنطق الأرسطي الذي كان فلاسفة الإسلام يجرون عليه، أم إنه ابتكر لنفسه منطقًا جديدًا خاصًّا به، وبنى عليه نظريته؟
ويرفض الوردي ما ذهب إليه البعض، مثل الدكتور محسن مهدي، من أن ابن خلدون جرى في نظريته الاجتماعية على نفس المبادئ المنطقية التي جرى عليها أفلاطون وأرسطو ومَن تابعهما مِن فلاسفة الإسلام.. مؤكدًا، أي الوردي، أن ابن خلدون كان ثائرًا على الفلسفة القديمة بوجه عام، وعلى المنطق الأرسطي بوجه خاص.
ويضيف: لا أنكر أن ابن خلدون استعمل في مقدمته كثيرًا من المصطلحات الفلسفية والأقيسة المنطقية التي كان الفلاسفة القدامى يستعملونها؛ ولكن ذلك لا يعني أنه كان يتبع الأسس والمبادئ الفلسفية القديمة في دراسته الاجتماعية. لقد اعترف ابن خلدون غير مرة بأن المنطق القديم له فائدة للمفكر، إذ يجعله بارعًا في ترتيب الأدلة والحجج؛ لكنه عاد فقال بأن المنطق القديم لا يطابق الحياة الواقعية، وأن الواجب يقضي على من يريد فهم الحياة الواقعية أن ينظر فيها حسب منطق آخر.
بل يذهب الوردي إلى أبعد من ذلك، فيما يتصل بعرقلة المنطق القديم أيّ تقدم ممكن في البحث والمعرفة.. فيقول: أكاد أعتقد أن ابن خلدون لو كان سائرًا على نفس المنهج المنطقي الذي سار عليه الفلاسفة، لما استطاع أن ينتج لنا علمًا جديدًا. إن الإبداع العظيم لابن خلدون نشأ عن أنه استطاع أن يتحرر من المنطق القديم، وأن يتخذ لنفسه منطقًا جديدًا.. والعلوم الحديثة كلها، الطبيعية والاجتماعية، لم تستطع أن تنمو هذا النمو العجيب إلا بعد أن بدأ فرنسيس بيكون بثورته المعروفة على المنطق الأرسطي والتراث الفلسفي القديم (1) .
طفرة ابن خلدون
ويوضح الوردي أن أهمية “الطفرة” التي قام بها ابن خلدون في تاريخ الفكر الاجتماعي، تتمثل في أنه قام بأول محاولة جدية للنزول بالفلسفة من عليائها، وللدخول بها في معترك الحياة الواقعية.
يقول ابن خلدون عن الذي بحثوا في القضايا الاجتماعية قبله- كما ينقل الوردي- إنهم كانوا يتبعون منهج الوعظ أو الخطابة؛ أي إنهم كانوا يحاولون الإتيان بالأقوال المقنعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدّهم عنه، أو في حَمْلهم على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه. أما هو فلم يؤلف مقدمته لهذا الغرض أو ذاك؛ فليس همه أن يعظ الجمهور أو يدعوهم إلى اتباع الطريق القويم والأخلاق المحمودة؛ بل كان قصده أن يبحث في طبيعة الحياة الاجتماعية لكي يكتشف القوانين التي تسيطر عليها؛ سواء في ذلك أكانت تلك القوانين ذميمة أو حميدة.
ويرى الوردي أننا لا يجوز أن نستهين بهذا القول الذي جاء به ابن خلدون؛ فلو أن أحد المفكرين في عصرنا جاء به لما وجدنا فيه كبير شأن؛ إذ هو من الأسس التي تقوم عليها العلوم الاجتماعية الحديثة.. أما زمان ابن خلدون، فقد كانت الأبحاث الاجتماعية تجري على الضد من ذلك(2).
أشهر صفات المنطق القديم
يوضح الوردي أن أشهر صفات المنطق القديم، وأكثرها مساسًا بموضوعنا، أنه: منطق صوري، ومنطق استنباطي.
• صورية المنطق: فقد ميّز أرسطو بين صورة الأشياء ومادتها؛ فمثلاً، التمثال له صورة وهي شكله الظاهري، وله مادة وهي التي يتكون منها التمثال من رخام أو نحاس أو ما أشبه.. وكان المنطق الأرسطي يهتم بصورة الشيء ويهمل مادته؛ وكانت البحوث الميتافيزيقية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية وغيرها، مطبوعة كلها بطابع المنطق الصوري. فهم إذا بحثوا في العدل مثلاً تصوّروه كما يتصورون الهرم أو المثلث، شيئًا قائمًا بذاته له صفات ثابتة، ويأخذون بالبحث فيه والمناقشة حوله، كما هو في صورته المجردة، دون أن ينظروا في محتواه الاجتماعي؛ أي مادته التي تتألف من الوقائع الجزئية والتي تتغير بتغير الظروف المحيطة بها.
وكان غالبية المفكرين المسلمين في عصورهم المتأخرة، كما يقول الوردي، يَجْرُون في تفكيرهم على هذا المنوال. إنهم كما وصفهم ابن خلدون يبحثون في “صُور” قد تجرّدت من “موادّها”؛ فهم حين يتعرضون لبحث القضايا التي كانت تهز المجتمع هزًّا، كقضية الخلافة مثلاً، نجدهم يناقشونها وكأنهم يعيشون في عالم آخر. فالماوردي، يبحث في (الأحكام السلطانية) عن الخلافة تُعقَد لرجلين في بلدين مختلفين، ويستعرض آراء الفقهاء في الموضوع من الناحية الشكلية البحتة؛ فمنهم من قال إن الإمامة تُعقد للرجل الذي سبق منافسه بأخذ البيعة، ومنهم من قال إن على الرجلين المتنافسين أن يتنازلا عن الخلافة حسمًا للفتنة ليختار “أهل الحل والعقد” أحدهما أو غيرهما، إلى غير ذلك من الآراء.. فهؤلاء الفقهاء، والماوردي معهم، أخذوا يتناقشون ويتجادلون في الخلافة من حيث صورتها المجردة، كما يتخيلونها في أذهانهم.
إنهم بعبارة أخرى: يبحثون فيما يجب أن يكون عليه أمر الخلافة، لا فيما هو كائن فيها فعلاً. وبهذا وجدناهم يعيشون بأفكارهم عن الخلافة في عالَم، بينما كانت الخلافة تجري في عالَم آخر. إنهم لم يقفوا لحظة ليسألوا أنفسهم: كيف يمكن أن تجرى القرعة مثلاً بين الخليفة العباسي والخليفة الفاطمي؟ ومَن منهما يرضى بالقرعة أو يسلّم لصاحبه بها؟ وما هو موقف القواد والوزراء والحاشية الذين يحيطون بكل منهما؟ وكيف يرضى هؤلاء أن تذهب الخلافة إلى عدوهم الأكبر؟ وهل يمكن لإنسان مهما كان أن يتنازل لغيره عن المنصب العظيم أو المال الوفير إلا أن يكون مجنونًا أو وملاكًا؟(3).
• استنباطية المنطق: أي أنه يبدأ البحثَ بالاعتماد على كليات عقلية عامة، ثم يستنبط منها النتائج الجزئية الخاصة. وهو بذلك يختلف عن منهج العلوم الحديثة؛ التي قامت على أساس الانتقال من الجزئيات إلى الكليات؛ وهو ما يسمى بـ”المنهج الاستقرائي”، بينما “المنطق الأرسطي” استنباطي؛ ينتقل من الكليات إلى الجزئيات.
وأهم طريقة يستخدمها المنطق في الاستنباط هي ما يسمى بالقياس. و”القياس” يتألف عادة من ثلاثة أجزاء: المقدمة الكبرى، والمقدمة الصغرى، والنتجية. فنقول: كل إنسان فانٍ (مقدمة كبرى)، وسقراط إنسان (مقدمة صغرى)؛ إذن، سقراط فانٍ (نتيجة).
والمشكلة، كما يبين الوردي، أن المنطق الأرسطى يعتمد في قياسه غالبًا على مقدمات يعدّها بديهية ثابتة الصدق ولا يجوز الشك فيها.. بينما اتضح لاحقًا أن ما نعدّه من البديهيات العقلية هو من الأمور النسبيّة؛ إذ هي خاضعة للمألوفات الاجتماعية والتطورات العلمية. فربّ أمرٍ نعدّه اليوم بديهيًّا ثم يتبين لنا أنه مما يجوز الشك في صحته أو ضرورته العقلية؛ كما كان الناس قديمًا يعتقدون أن الأرض مسطحة.
ولهذا، أصبح القياس المنطقي مطية في سبيل الأهواء الخاصة والعقائد المذهبية. فكل من يريد أن يبرهن على صحة مذهب أو رأي معين؛ فليس عليه إلا أن يبحث عن مقدمة كبرى تصلح لاستنباط الرأي والمذهب منها.. كما حدث بين الفرق الإسلامية، حين كانت كل فرقة تعتمد في رأيها على آية قرآنية أو أحاديث نبوية تجعلها مقدمات لأقيستها المنطقية.. والفرقة الأخرى تلجأ لمثل هذا. فالقياس المنطقي، كما قال أحد الباحثين، وسيلة يستطيع الإنسان أن يبرهن بها على صحة الشيء وعلى صحة نقيضه أيضًا..!
ويخلص الوردي إلى أن “القياس المنطقي” كان سببًا من أسباب تأخر العلم؛ فالباحث الاجتماعي كان غير قادر على أن يخرج إلى الناس يَدْرُسهم كما هم عليه في الواقع.. إنه مضطر أن يستنبط ويقيس، لا أن يبحث ويستقرئ. ولهذا، تضيع من بين يديه اللمحات الخلَّاقة التي تزخر بها وقائع المجتمع (4)، ولا يمسك بها كما فعل ابن خلدون.
“المادة” عند ابن خلدون.. وعلاقتها بـ”المنطق”
في مواضع مختلفة من “المقدمة”، تأتي عبارات يستخدم ابن خلدون فيها كلمة “المادة” بصيغة المفرد وبصيغة الجمع. وهذه العبارات، كما يعتقد الوردي، ذات أهمية كبيرة من الناحية المنطقية، ولم ينتبه لها دارسو ابن خلدون.. بل منهم من فهم “المادة” في هذه العبارات، في ضوء المفهوم الحديث لمعنى المادة؛ وهو غير مقصود.
ويضيف الوردي: إن ابن خلدون يذكر “المادة” ويفهمها حسب مفهومها القديم الذي كان مألوفًا لدى الفلاسفة في زمانه. وأقرب المصطلحات الحديثة إلى مفهوم “المادة” عند ابن خلدون، هو “المحتوى” أو “المضمون”.
فقد كان المنطق القديم يهتم بشكل الأفكار أو صورتها، دون محتواها أو مضمونها؛ أي أنه كان مشغولاً بالكليات العقلية العامة، ولا يبالي بما في الواقع من محتوى “مادي”.. فجاء ابن خلدون ثائرًا على هذا المنطق “الصوري”؛ فهو يريد من المفكرين أن يكونوا أُولي منطق “مادي”.
واتضحت ثورة ابن خلدون في هذه العبارات التي وردت في كلمة “مادة”، كما يشرح الوردي.. وهي عبارات متفرقة في ثنايا “المقدمة”، ومنها على سبيل التمثيل (5):
1) ميَّز ابن تيمية بين “الإمكان الذهني” والإمكان الخارجي”، فالأول يستند على التفكير المجرد، بينما الثاني يستند على الاستقراء الحسي. وابن خلدون أتى بمثل هذا التمييز بين الإمكانين؛ لكنه يسمي الأول منهما: “الإمكان العقلي المطلق”، ويسمي الثاني: “الإمكان بحسب المادة التي للشيء”.
وقد أراد ابن خلدون بذلك انتقادَ المفكرين الذين دأبوا على التمييز بين الممكن والمستحيل من الأخبار، عن طريق التجريد الذهني؛ أي طريق النظر في الأمور حسب صورها المطلقة لا حسب موادها النسبية. إنه يريد منهم أن يقارنوا الأمور بأشباهها، ويقيسوا الغائب منها على الحاضر، كما أشار لذلك بقوله: “الأخبار إذا اعتُمد فيها على مجرّد النّقل، ولم تُحَكَّم أصول العادة وقواعد السّياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنسانيّ، ولا قيس الغائب منها بالشّاهد والحاضر بالذّاهب؛ فربّما لم يؤمن فيها من العثور ومزلّة القدم والحيد عن جادّة الصّدق”.
2) وهناك عبارة أخرى وردت بالمقدمة، تدل على ذلك بوضوح أكثر. إنه فيها ينتقد المؤرخين المتأخرين ويصفهم بأنهم مقلدون بلداء الطبع والعقل يغفلون عما يحدث في التاريخ من تغير مستمر، ثم يقول عنهم: “فيجلبون الأخبارَ عن الدّول، وحكاياتِ الوقائع في العصور الأول، صورًا قد تجرّدت عن موادّها، وصفاحًا انتضيت من أغمادها”.
ومعنى هذا أن ابن خلدون ينعى على المؤرخين الاكتفاء من الأخبار بصورها الذهنية المجردة وإهمال محتواها الواقعي. وهو يشبّههم بمن يهمل السيف اكتفاءً بغمده، مع العلم أن السيف هو المقصود، وما الغمد سوى وسيلة لحمايته.
3) وفي الفصل الذي خصصه ابن خلدون للمنطق في مقدمته، أشار إشارة واضحة إلى أن المناطقة المتأخرين شُغلوا بصورة الأفكار وأهملوا مادتها؛ وأشار أيضًا إلى أن “المادة” هي التي يجب أن تكون موضع الاهتمام والاعتماد في المنطق. إنه يقول ما نصه:
“ثمّ تكلّموا في القياس من حيث إنتاجه للمطالب على العموم لا بحسب مادّته، وحدّقوا النّظر فيه بحسب المادّة؛ وهي الكتب الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشّعر والسّفسطة. وربّما يلمّ بعضهم باليسير منها إلمامًا وأغفلوها كأن لم تكن وهي المهمّ المعتمد في الفنّ. ثمّ تكلّموا فيما وضعوه من ذلك كلامًا مستبحرًا، ونظروا فيه من حيث إنّه فنّ برأسه لا من حيث إنّه آلة للعلوم، فطال الكلام فيه واتّسع”.
وينقل الوردي تعليق عبد الواحد وافي، على هذه الفقرة، إذ يقول: “أي مع أنها هي المعتمد في الفن؛ لأنها تتعلق بمادة القياس: من حيث صدق مقدماته وانطباقها على الواقع؛ أما البحوث الأخرى فتتعلق بالقياس: من حيث صورته. ولا يخفى أن البحث فيه من حيث مادته ومبلغ صدق مقدماته، أهم كثيرًا من البحث فيه من حيث صورته وأوضاعه المنتجة. ومن ثم، يوجِّه المُحْدَثون أكبر قسط من عنايتهم إلى منطق المادة أو المنطق التطبيقي (الذي يشمل مناهج البحث Méthodologie)، بينما لا يولون المنطق الصوري إلا قسطًا يسيرًا من اهتمامهم”(6).
4) كما أن ابن خلدون كان يعتبر “أنّه قد لا يتمّ وجود الخير الكثير إلّا بوجود شرّ يسير من أجل الموادّ؛ فلا يفوت الخير بذلك، بل يقع على ما ينطوي عليه من الشّر اليسير. وهذا معنى وقوع الظّلم في الخليقة فتفهّم”. وهو يعني بذلك، كما يوضح الوردي، أن الخير مادام ذا طبيعة “مادية”، فلا بد أن يختلط بما يناقضه في الحياة الواقعية.
وابن خلدون بهذا يخالف المناطقة القدماء؛ الذين كانوا ينظرون في الخير والشر، وفي غيرهما من أمور الحياة، نظرةً صورية تجريدية. ولهذا فهم كانوا يعتبرون الأمورَ أفكارًا مثالية مطلقة، كلّ واحدة منها قائمة بذاتها ومستقلة في كيانها عن غيرها.
وينتهي علي الوردي إلى أن من مزايا ابن خلدون، أنه ينظر في الأمور باعتبار محتواها المادي المتلبِّس بشبكة الحياة، وليس باعتبار صورها المثالية المطلقة.. مما أحدث “الطفرة الخلدونية” بحسب تعبير الوردي.
خلاصة
إذن، كان هذا بيانًا لموقف ابن خلدون من المنطق القديم، ولخروجه عنه؛ لأنه كان منطقًا مكبِّلاً للعلم والمعرفة؛ سواء في “صوريته” أو في “استنباطيته”..
كما تبين أن ابن خلدون نقل الفكر الإنساني، والفكر الاجتماعي خاصة، نقلة نوعية؛ حين ركَّز على الاهتمام بمادة الشيء، أي طبيعته، وليس على صورته كما كان يفعل القدماء؛ فانتقل الفكر من “المثال” إلى “الواقع”.. من “التجريد والصورة” إلى “الطبيعة والمواد”.. مما “يجب” إلى ما هو “كائن”.
ولعلنا في مقالٍ تالٍ نبيّن كيف تصوَّر الدكتور علي الوردي محورَ “نظرية” ابن خلدون؟ وهل كانت تلك النظرية موافقة لـ”مبادئ المنطق الأرسطي” أم مخالفة لها؟
([1]) منطق ابن خلدون- في ضوء حضارته وشخصيته، د. علي الوردي، الشركة التونسية للتةزيع، 1977. ص: 2- 4، (باختصار وتصرف يسير، وهكذا في النقول التالية).
([2]) المصدر نفسه، ص: 10، 11.
([3]) المصدر نفسه،ص: 20- 23.
([4]) المصدر نفسه، ص: 24- 30.
([5]) المصدر نفسه، ص: 69- 74.
([6]) مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، مكتبة الأسرة، 2006م. هامش رقم (1564)، 3/ 1024.
تنزيل PDF