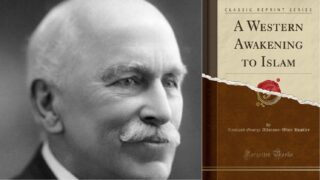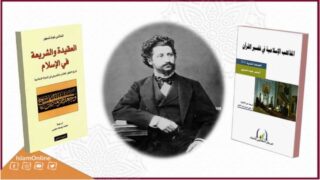منذ أنْ أعلن الشيخ مُصطفى عبد الرازق، أستاذ الفلسفة الإسلاميَّة الأوَّل بجامعة فؤاد الأول/ جامعة القاهرة حاليا وشيخ الجامع الأزهر، دعوته إلى دراسة الفلسفة الإسلاميَّة في مظانِّها الحقيقية، وتلامذتُه الأوائل قد نفرَوا إلى أعْنَف موضوعاتها، يدرسونها في اتقان وتُؤدَةٍ، ثمَّ يُقدِّمونها للحياة الإسلاميَّة المُعاصرة، وللمسلمين جميعًا، في صورة متلألئة فاتنة. إذ سرعان ما ظهرت الأبحاثُ الغنيَّة العارمة من رجالات تلك المدرسة، فوضحتْ قواعدُها، وثبُتتْ ركائزُها، وانطلق كلٌ في نطاقهِ يعْرضُ لأصالة الفكر الإسلاميِّ في ناحية من نواحي هذا الفكر الحيوي. وكان أوَّل وأقدم هؤلاء المشيخة القُدامى، العلَّامة الأستاذ محمود الخضيري (1906-1960) الذي كشف في أبحاثه، ودراساته المتنوعة، عن ملامح الفلسفة الإسلامية الحقيقية في عصورها المختلفة.
أما ثاني هؤلاء المَشيخة؛ فهو الدُّكتور محمَّد مُصطفى حلمي [1904- 1969م]. فقد ورث هذا الشيخ العتيق ميراثَ أستاذه مصطفى عبد الرازق في جامعة القاهرة وأخذ مكانه، وحمل في أناقةٍ فاتنةٍ رسالة الأستاذ الكبير. ويتبدَّى هذا واضحًا في توفُّره على فلسفة الحبِّ الإلهيِّ لدى سلطان العاشقين عمر بن الفارض [ ت 632هـ]، كما كانت كتاباتهُ عن “الحيَّاة الرُّوحيَّة في الإسلام” أكبر دليل على انبثاق هذه الحياة في جوهرها عن الإسلام وحده، وقد ملأت كتاباتهُ في التَّصوف فجوةً كبيرةً في تاريخ الفلسفة الإسلامية، موضِّحةً – فيما يقرِّر علي سامي النشار- هذا الجانب الأصيل فيها، كاشفة عن أسرارها ودقائقها.
ويكفي أن نشير هاهنا إلى أن الأديب العالمي نجيب محفوظ كان أحد تلامذة الشيخ مصطفى عبد الرازق الذي بادر إلى تعيينه بمكتبه عندما تولَّى مشيخة الأزهر، وكان محفوظ قد تقدّم لتسجيل أطروحة للماجستير تحت إشراف شيخه بعنوان: “فلسفة الجمال في الإسلام”. كما شملت رعاية الشيخ أيضا الـخُلَّص من تلامذته، فكان يقدِّم لهم كلَّ عون ممكن، ماديٍّ ومعنويٍّ، من أجل السفر إلى الخارج، والتنقيب عن نوادر المخطوطات وتحقيقها. وفي مقدِّمتهم: الأستاذ الخضيري، ومحمَّد عبد الهادي أبو ريدة، ومحمَّد مصطفى حلمي، ومحمَّد يوسف موسى، وأحمد فؤاد الأهواني، وعثمان أمين، وعلي سامي النشار… وغيرهم.
كما اتجهت عناية هؤلاء الرُوَّاد، بفضل توجيه شيخهم، إلى الاضطلاع بمهمة ترجمة نفائس النُصوص الفلسفية الغربية وذخائر بحوث المستشرقين من جهة، وتحقيق ونشر أمّهات الأعمال الفلسفية الإسلامية التُّراثية من جهة أخرى. أمَّا على صيعد الجبهة الأولى، فيكفي أن نشير إلى ترجمة الأستاذ الخضيري لعمل ديكارت “مقال في المنهج”، وترجمة محمَّد عبد الهادي أبو ريدة لكتاب آدم ميتز “نهضة الإسلام” الذي نُشرت ترجمته بعنوان “الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري”، ولكتاب دي بور “تاريخ الفلسفة في الإسلام”، ولكتاب بينيس “مذهب الذرة عند المسلمين”. وإلى ترجمة محمَّد يوسف موسى لكتاب ليون جوتييه “المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية”، ولكتاب جولدتسيهر “العقيدة والشريعة في الإسلام”.
أما على صعيد الجبهة الثانية المتعلقة بتحقيق ونشر كتب التراث، فيكفي أن نشير إلى تحقيق محمَّد عبد الهادي أبو ريدة لـ “رسائل الكندي الفلسفية”، وتحقيق علي سامي النشار لكتاب الرازي “اعتقادات فرق المسلمين والمشركين”، ولكتاب السيوطي “صون المنطق والكلام”، وتحقيق الأهواني لكتاب التعليم للقابسي.
والواقع أن كثيرين من تلامذة الشيخ قد تأثروا بأفكاره الإصلاحية، حيث استكمل هؤلاء ما بدأه، وقدَّموا دراسات جديدة تكشف عن جوانب أصيلة في الفكر الفلسفيّ الإسلاميّ. ومن أبرز التلاميذ الذين استكملوا هذا الدور محمد عبد الهادي أبو ريدة الذي كتب دراسة رائدة عن المعتزلة ممثَّلة في فكر إبراهيم بن سيار النظام، كما قدَّم علي سامي النشار كتابا رائعا بعنوان “مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسطي”، ردَّ فيه على مؤرِّخي المنطق الذين ينكرون أن يكون للمسلمين مكانة في نطاق علم مناهج البحث، والادّعاء بأنهم قد أخذوا المنطق اليوناني باعتباره المنهج الوحيد في أبحاثهم. ومؤكِّدا أيضا عدم قبول المفكرين المسلمين لمنطق أرسطو ومحاربتهم له، وأنهم وضعوا المنطق الاستقرائي كاملا، وهو المنهج التجريبي، وأن ثمة وثائق تاريخية تثبت بلا أدنى شك أن المسلمين قد استخدموا طرق التحقيق التجريبية في دراستهم للطب والعلوم الطبيعية والكيميائية والفلكية والنباتية، وأن هذا المنهج قد وصل إلى أوربا واستفاد منه علماؤها ونسبوه إلى أنفسهم، وكان ذلك سببا في إقامتهم حضارة إنسانية. وللنشار أيضا دراسة وافية في ثلاثة أجزاء بعنوان “نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام”.
ولا ننسى أيضا جهود كل من: عثمان أمين صاحب مذهب الجوانية ومؤلِّف كتاب “شخصيات ومذاهب فلسفية”، وتوفيق الطويل مؤلِّف كتاب “التنبؤ بالغيب عند مفكري الإسلام” وكتاب “التصوف في مصر إبان العصر العثماني، وأحمد فؤاد الأهواني مؤلِّف كتاب “التعليم في رأي القابسي”، وغيرهم الكثير.
وتبعًا لجهود هؤلاء الأفذاذ الكبار؛ انتهت الفكرة الخاطئة التي كانت تقرِّر عدم أصالة الفكر الفلسفيِّ في الإسلام إلى الاندثار، بحيث لم يعد لها مجالٌ يُذكر في دراسة الفلسفة الإسلامية بعد أن شغلت حيزًا كبيرًا من جهد وتفكير تلامذة مُصطفى عبد الرازق في العقود: الثالث، والرابع، والخامس، من القرن العشرين. فقد فهم هؤلاء الروَّاد الفلسفةَ الإسلامية باعتبارها التعبيرَ النهائي المُتجدِّد لأمَّة الإسلام، مثلما فهموا الحياة الرُّوحيّة باعتبارها تحقيقًا أمثل للعقيدة الإسلاميَّة الخالصة الجامعة بين الرُّوح والعقل في آنٍ معًا، وباعتبارها أيضًا الممثِّلَ الأصيل لمبحث الأخلاق في الإسلام.
وحقيقة الأمر أنَّ جميع تلامذة الشيخ الأكبر مصطفى عبد الرازق ظلوا أوفياء لنهج أستاذهم في دراسة الفلسفة الإسلامية، ومتابعين له أيضا في الردِّ على كلٍّ من:
– فريق المستشرقين الذين لم يمنحوا الحياة العقليَّة والرُّوحيَّة في الإسلام حقَّها من الدَّرس والتمحيص.
– وأغلب الإسلاميين الذين انحصر جُلُّ همِّهم في تقدير قيمة الفلسفة الإسلامية بميزان الدِّين.
ومن ثمَّ؛ كان لا بد من البحث عن اتجاهٍ – أو بالأحرى عن منهجٍ أو طريقٍ ثالثٍ- يمنحُ الفلسفة الإسلامية اعتبارها من جهة، ويكونُ بديلا عن شيوع هذين الاتجاهين من جهة أخرى. وهو ما نهضت به مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق، أحسن نهوض إبَّان القرن الماضي.
مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق وامتداداتها
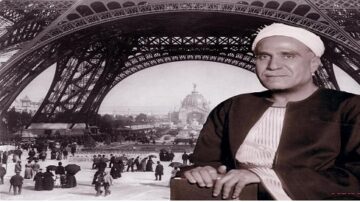
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين
اخترنا لكم

الهدي النبوي في التعامل مع حر الصيف

الغيب في القرآن وأثره في استبعاد المناهج الحداثية لتفسير النص القرآني

حوار مع الدكتورة خولة النوباني أول امرأة تعين في مجمع الفقه الإسلامي الدولي

حمّو النقاري يطرح رؤية معاصرة للمناظرة في الفكر الإسلامي والنظريات الحديثة

“العصر الذهبي للعلوم العربية”.. رحلة إلى الإبداع العلمي الإسلامي

التعليم في عصر الهوية الرقمية

ماذا تعرف عن الاحتفاء بالخريجين في تاريخنا ؟

الإجازة الصيفية للأبناء .. خطة لتحويل القراءة إلى متعة

كتاب فن الاستمتاع في الأسفار والرحلات

الأسرة والصيف.. استراحة لترتيب الأوراق
الأكثر قراءة