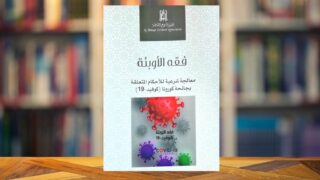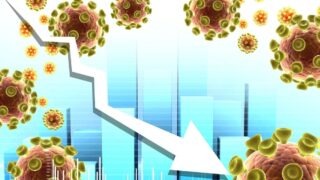ينطلق الإسلام في مسألة العلاج والتداوي من الأمراض من منطلق الحفاظ على النفس والبدن والعقل، وهي من الضروريات الخمس الأساسية التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها، وحمايتها وتنميتها، كما أرشد الله -تعالى- رسوله الكريم – ﷺ – في كتابه، فقال: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} البقرة: 195، فهذه الآية تنص على النهي عن قتل النفس، وإيذائها وإلقائها إلى التهلكة، بأي طريقة من طرائق التهلكة، وكذا قوله -تعالى-: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} النساء: 29، وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة، كقوله – ﷺ -: «لا ضررَ ولا ضِرار». رواه أبوداود.
كما أمرت السنة النبوية الشريفة بالتداوي: كما في حديث أسامة بن شريك – رضي الله عنه – قال: أتيت النبي – ﷺ – وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت، ثم قعدت، فجاء الأعرابُ من ههنا وههنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: تَدَاووا فإن الله -تعالى- لم يَضع داءً، إلاّ وضع له دواء، غير داءٍ واحدٍ: الهَرَم». رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والحاكم وصححه، ونستطيع أن نلخص المنهج الإسلامي في الطب والعلاج في النقاط الآتية:
الإيمان بالقضاء والقدر
أولاً: الإيمان بالله -تعالى- وبالقضاء والقدر، وإرجاع الأمر كله إلى الله -تعالى-؛ فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، ومالم يشأ لم يكن، ومع ذلك، فالشريعة حثت على الأخذ بالأسباب المتاحة لدفع المرض والضرر، والحيطة والوقاية قبل الوقوع والإصابة، وإذا أصيب الإنسان فله الأخذ بالأسباب المباحة والمتاحة للعلاج والشفاء.
الصّبر والمصابرة
ثانياً: الصّبر والمصابرة إذا ما أصاب الإنسان مرضٌ أو شيء، محتسباً لله -تعالى- الأجر العظيم؛ فلكل مصابٍ أجره بقدر مصيبته، وأن يكون راضيا بما قدّر الله -تعالى.
أهمية الأذكار
ثالثاً: يأمر الإسلام بالوقاية والحماية من الأمراض وأهلها، والتحصن بذ كر الله -تعالى-، كما في الطب النبوي الوقائي، فعن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ». رواه أبو داود (5088)، والترمذي (3388) ، قال القرطبي -رحمه الله- عن هذا الحديث: «هذا خبَرٌ صحيحٌ، وقولٌ صادق علمناه دليلَه دليلاً وتجربة، فإنِّي منذ سمعته عملت به فلم يضرَّني شيءٌ إلى أنْ تركته، فلدغتني عقربٌ بالمدينة ليلاً، فتفكرتُ فإذا أنا قد نسيت أنْ أتعوذ بتلك الكلمات». انظر (الفتوحات الربانية) لابن علان 3/100.
أذكار تدفع الضرر
ومن الأذكار التي تقي من السوء وتدفع الضرر بإذن الله: ما رواه عبد الله بن خبيب – رضي الله عنه – قال: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – لِيُصَلِّيَ لَنَا، فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فقَال: قُلْ. فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا. ثُمَّ قال: قُلْ. فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا. ثُمَّ قَال: قُلْ. فقُلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ! ما أَقُولُ؟ قَال: قُلْ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». رواه أبو داود (5082) والترمذي (3575، فالحاصل أن الأدعية والأذكار السابقة تحفظ المسلم من الضر والأذى بأنواعه -بإذن الله تعالى-، فمن أصابه من البلاء مع محافظته على هذه الأذكار، فذلك بقدر الله -تعالى-، وله سبحانه الحكمة البالغة في أمره وقَدَرِه.
الأمر بالتداوي
رابعاً: يأمر الإسلام بعد ذلك المسلم بالتداوي، ويوسع الإسلام دائرة التداوي بالأدوية المباحة كلها، والعلاج الطبي والعمليات ونحوها، وقد دلّ القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، على أنواع من الأدوية النافعة، كالعسل والحجامة والحبة السوداء.
لكل داءٍ دواء
خامساً: يبين الإسلام للناس جميعاً بأنَّ لكل داءٍ دواء، ولكلّ مرض شفاء، عَلِمه مَنْ علمه من الناس، وجَهِله من جهله؛ حيث يقول الرسول الكريم – ﷺ -: «إنَّ الله لم يُنْزل داءً، أو لم يَخْلق داءً إلاّ أنزل أو خَلَق له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله إلاّ السام، قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت». رواه أحمد (1/446) ورواه النسائي مختصراً (2/64) وابن حبان (1398)، وصححه الألباني في السلسلة (1650، وهذ الحديث الصحيح يُعطي أملاً لكل مريض بالشفاء مما هو فيه؛ حيث بيّن وحكم – ﷺ – بأن لكلّ داء دواء، ولكل مرض شفاء، وبذلك لا يفقد المريض الأمل، مهما كان مرضه خطيراً، على عكس ما هو الحال اليوم؛ حيث تصنف بعض الأمراض على أنه لا شفاء لها.
ضوابط وأحكام وآداب
وقد وضعت الشريعة مجموعة من الضوابط والأحكام والآداب، للمعالج الذي يعالج الإنسان، أي معالجة كانت، سواء كانت معالجة للجانب البدني، أم النفسي، نذكرها هنا بإيجاز:
– أن يكون المعالج ذا علم وخبرة وحذق بمهنته الطبية، وفي وقتنا الحاضر: ضرورة الحصول على الشهادة الطبية، والإذن بممارسة المهنة الطبية من الدولة، وهو أمر معتبر أيضاً في الشرع.
– أن يكون مخلصاً في عمله، أميناً محافظاً على حقوق الآخرين، يبذل ما في وسعه للإتقان والإبداع.
– أن يعرف الأحكام الشرعية الخاصة بالطب والمريض.
– أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية الراقية.
– أن يحترم تخصصه الطبي، مع احترامه تخصص الآخرين.
– أن يلتزم أسرار المهنة، وقيمها الأخلاقية الإنسانية التي أقرها الإسلام.
– ألا يقوم بإجراء التجارب على مرضاه، إلاّ بعد الحصول على إذنهم، وعلى موافقة جهة الاختصاص.
– أن يلتزم القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الصحية، التي تصدر عن السلطات المختصة.
تنزيل PDF