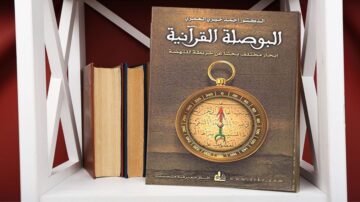بلغة جميلة وأسلوب رشيق يقدم لنا الدكتور أحمد خيري العمري، من خلال كتابه البديع “البوصلة القرآنية: إبحار مختلف بحثاً عن خريطة للنهضة“، أفكاراً رائدة حول كيفية البحث عن الخطوط والثوابت القرآنية المفقودة في حياتنا، والتي تحتاج الأمة الإسلامية البحث عنها كي تحدد وجهتها بشكل صحيح، وتُرمم مشروعها النهضوي العالمي الخالد، ليس من خلال الأطروحات والنظريات البشرية البائدة، بل من خلال المفاهيم والمبادئ القرآنية الخالدة التي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
لقد كان الدكتور العمري موفقاً في كتابه هذا إلى حد بعيد، ولعل قارئ هذا الكتاب سيكتشف بنفسه إلى أي مدى نجح المؤلف في غربلة مصادر متعددة من أجل أن يقدم لنا أطروحات مؤسسة حول ضرورة العودة إلى القرآن الكريم والبحث فيه عن الثوابت القرآنية المفقودة التي تمثل الطريق الوحيد الذي يستطيع المسلمون من خلاله إحياء ماضيهم المشرق وإعادة الأمة الإسلامية إلى المكانة التي تليق بها وبتاريخها الحافل بالريادة والإنجاز والتقدم والازدهار.
مقدمات أساسية
قسم المؤلف كتابه إلى مقدمتين أساسيتين وبابين كبيرين وخاتمة، أوضح في المقدمة الأولى أن كتابه هذا يهتم بالبحث عن “الخطوط القرآنية والثوابت المفقودة، وهو من ثم في كيفية فقدانها، في الظروف والملابسات التي أدت إلى فقدانها وأتت بخطوط أخرى مختلفة، بل مضادة للخطوط القرآنية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن تلك الخطوط المضادة “بمثابة أسلاك شائكة من الصعب تجاوزها واختراقها”.
أما في المقدمة الثانية، فقدم صوراً فوتوغرافية رائعة عن ظروف الولادة الجديدة للوعي الإنساني التي حدثت في صحراء العرب الشاسعة، إذ دوَّتْ في غار حراء كملة {اقرأ}، فانطلق المؤمنون على هديها يشيدون للإنسانية حضارة فريدة من نوعها، وبعد صراع مرير مع الجاهلية والأميّة انتقلت كلمة {اقرأ} الشاملة من كلمة سر في غار حراء إلى كلمة جهر في العقيدة الجديدة، فأصبحت رمزاً خالداً وعنواناً بارزاً في الإسلام، ثم صارت المدخل الذي فُرضت عبره كل الفرائض الأخرى.
وقد حاول المؤلف في هذه المقدمة الأساسية أن يكشف عن الأدوار والمعاني المتعددة لكلمة {اقرأ}، إنها كلمة انطلقت من أفق واسع لكنها مع ذلك مبنية على قواعد وأسس متينة وثابتة، ورغم مركزية {اقرأ} في الإسلام إلا أن هناك قصوراً في علاقتنا معها، تجلى في أن هذا المفهوم المركزي ظل في نفوس البعض ثانوياً ومرتبطاً بالقراءة التقليدية الجاهزة للمجلدات والكتب، وقد تسبب هذا الفهم القاصر في نشوء ظواهر فكرية مؤسفة.
ومما يؤكد لنا أهمية كلمة {اقرأ} أنها جاءت مختلفة تماماً عن كل الكلمات التي قيلت للأنبياء والمرسلين الآخرين، ومن الأدلة على ذلك أن الخطاب في الرسالات السابقة كان يعتمد على إعجاز حسي يتمثل في عصا تسعى أو يد بيضاء أو طائر يعود إلى الحياة، في حين أن الخطاب في الرسالة المحمدية كان يعتمد على القراءة، ومعنى هذا بعبارة أخرى أن الله في الرسالات السابقة كان يخاطب في الإنسان حواسّه، أما في الرسالة الخاتمة فقد خاطب العقلَ الإنساني دون الاعتماد على الحواس الإنسانية، وهنا يمكن القول “إن اختيار الخطاب القرآني للعقل غاية ووسيلة في آنٍ واحد ينبع من طبيعته الإعجازية أصلاً”.
العناصر المفقودة
لقد كانت كلمة {اقرأ} السبب في النقلة الحضارية التي مثلها الإسلام لعرب الجزيرة والتي تدعو بحق إلى الدهشة والإعجاب، وقد كان المؤلف صادقاً حين قال إن الدهشة والإعجاب هي آخر شيء يجب أن نستقصيه في هذا المضمار، لأن “عبارات المديح والثناء والتمجيد لتلك الفترة الزاهرة لا تزيد على أن تكون حقنة تخدير”، بل يجب أن نبدأ البحث عن تلك النقلة الحضارية وأسباب قيامها؟ وهل لا تزال عناصر وجودها قائمة؟ وكيف نستعيدها إذا فقدت؟
ولكن من أين ينطلق هذا البحث تحديداً؟ إن هذا البحث ينبغي أن ينطلق من عمق الخطاب الإسلامي الذي ذكر المؤلف أن له عناصر أساسية لكنها مفقودة، وهي: التساؤل، والبحث عن الأسباب، والإيجابية، والحس المقاصدي، والحقيقة أننا عندما نبدأ البحث سنجد أن هناك وثيقة تاريخية لها الأولوية على كل الوثائق والنظريات لأنها تحولت إلى وعي جماعي وضمير اجتماعي موافق للرؤية والبصيرة، هذه الوثيقة هي القرآن الكريم الذي يمكننا من خلاله أن نبحث عن أسرار تلك النقلة الحضارية وما تلاها من حقب زمنية، لأنه استطاع تحويل المجتمع الجاهلي الأميّ إلى مجتمع كتابي، وظل يساير “النبض النفسي والاجتماعي والحضاري للأمة الناشئة؛ نبضة نبضة، وخطوة خطوة.
وهكذا فإننا إذا اعتبرنا أن التساؤل هو أول عناصر الخطاب الإسلامي المفقودة، فلا يمكن أن ننكر أن التساؤل قديم قدم الإنسانية ذاتها، حيث كان موجوداً في الأديان التي سبقت دين الإسلام، ولكن الواضح أن تعامل الخطاب القرآني مع موضوع الأسئلة كان مختلفاً بشكل جذري، “فبينما كانت الأديان السابقة تحاول عبر الأجوبة المنزلة تحديد دور التساؤل وإنهاءَه، عمد الخطاب القرآني إلى استثمار هذا التساؤل وتأصيله في طريقة التفكير الإسلامية، بل إعادة تأسيسه، ليكون المرتكز الأول والنقطة الأولى في تكوين العقل المسلم الناشئ”، وهذا يدفعنا إلى التساؤل: كيف يمكن لدين سماوي أن يجعل السؤال -بدلا عن الجواب المنتظر- نقطة ارتكازه؟
قد لا نجد صعوبة في الإجابة على هذا السؤال عندما نكتشف أن الخطاب القرآني كان يعمد إلى إثارة تساؤلات من أجل الوصول إلى الأجوبة، ونعرف أنه طرح “تساؤله الأول بصيغة شديدة الخصوبة، وشديدة الإيحاء، ومن ثم شديدة التأثير”، ولا شك أننا نقرأ في القرآن الكريم أجوبة إلهية لتساؤلات وشكوك إنسانية وردت على ألسنة الرسل، وقد اعتمد الخطاب القرآني على أنموذج تاريخي عريق ليدخل من خلاله التساؤل إلى عقيدة الناس، وكان النموذج هو نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء وأبو التساؤلات.
والحق أن القرآن الكريم يكشف لنا أن الحوار الذي دار بين إبراهيم وأبيه أولاً وبين إبراهيم والكون ثانياً وبين إبراهيم ونفسه ثالثاً يشكل منعطفاً مهماً في تاريخ الفكر الإنساني: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.. إلخ}، كما يكشف لنا القرآن الكريم أن علاقة التساؤل بالإيمان في الخطاب القرآني ليست علاقة أولية تبدأ حتى تنتهي، بل علاقة مستمرة مترابطة يتم من خلالها الوصول إلى طمأنينة القلب والذروة العالية من الإيمان: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي.. إلخ}.
وإذا كان التساؤل هو الخطوة المنطقية الأولى، فإن البحث عن الأسباب هو الخطوة الثانية التي اتبعها الخطاب القرآني “ليبني داخل النفوس بعد أن هدم”، وقد اعتمد القرآنُ هنا على قصة ذي القرنين لتأصيل فكرة الأسباب والبحث عنها، ووردت هذه القصة في سورة الكهف: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً.. إلخ}، ونلاحظ من خلال هذه الآيات القرآنية ترفُّع القرآن عن الخوض في تفاصيل الأعداد والأرقام والأماكن، فالمهم في القصة هو التأمل في العبرة وفي الجوهر، والبحث عن الأسباب أو اتباع الأسباب.
أما الخطوة الثالثة، فهي الإيجابية التي يمكن القول إنها أوضح أثر أحدثه الخطاب القرآني على مستوى الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الجزيرة العربية، فقد شهد العرب تحولات كبيرة في خضم عقود قليلة لا تتجاوز الثلاثة، فانتقلوا من أمّة أميّة مستسلمة لواقع دوني سلبي بلا كيان إلى أمة يخضع لها الجبابرة والملوك ولها دستور عالمي نزل بلغتها، وقضى على الفروق الاجتماعية وعالج الظروف الاقتصادية.
وقد اختار الخطاب القرآني أن يزرع الإيجابية عبر مثال قصصي عريق جاء على شكل قصة معروفة وردت في التوراة لكن القرآن يستعملها بشكل مختلف، وقد وردت الإشارات إلى هذه القصة في سور قرآنية مختلفة، ومن تلك الإشارات: {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ}، ونلاحظ هنا أن المثال يختلف عن الأمثلة القصصية في التساؤل والسببية، حيث نزلت الآية تخاطب الرسول ﷺ بالذات، لأنه في المرحلة نفسها ولا بد أن يعاني مما عانى منه صاحب الحوت.
وهكذا يبدو أن قصة يونس وخروجه من بطن الحوت التي جرت في القرن الثامن قبل الميلاد تقريباً كانت مثالاً جيداً للنبي محمد ﷺ في القرن السادس بعد الميلاد، ونكتشف من خلالها أن “الخطاب القرآني يستفزنا دوماً من أجل أن نقرأ الحاضر والمستقبل”، خاصة في ظل الوضع المظلم الذي يواجهه المسلمون اليوم في ظل نظام عالمي يستغلهم ويهمشهم على المستويات كافة بسبب غياب الثوابت القرآنية من حياتنا.
النهضة القادمة
في الباب الثاني (أمس واليوم وغداً)، يحاول المؤلف أن يربط الماضي بالحاضر والمستقبل من أجل النهوض بالأمة انطلاقاً من استحضار اللحظات التاريخية الزاهرة في تاريخنا المجيد، وقد افتتح هذا الباب بالتأكيد على أن هناك لحظات تاريخية لم تنتهِ بعد بل ظلت مستمرة عبر القرون، وضرب مثالاً على ذلك بلحظة الماغناكارتا التي كانت أساساً عميقاً لليبرالية غربية، ولحظة الصراع بين الكنيسة والعلم التي أنهت الاستبداد الكنسي بالمجتمع والحكومة، ولكنه أشار إلى أنه من المؤسف أن اللحظات الإيجابيات في تاريخنا الإسلامي لم تستمر، إذ “لم نتجمد على الفتح المبين الذي هو أكبر بكثير من مجرد نصر عسكري، ولم نتجمد على (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)، بل وقفنا عند لحظات أخرى مختلفة تماماً”.
ولا شك أن هذا الأمر ينبغي أن يدفع المسلمين اليوم إلى البحث الجاد عن مشروع النهضة وكيفية إحياء اللحظات الإيجابيات في تاريخنا والعمل على استمرارها عبر القرون، فهي أكثر فائدة على الإنسانية وأولى بالاستمرار من غيرها قطعاً، وهنا لا بد من الوعي بأن أي مشروع نهضوي يسعى إلى النهوض بالأمة متجاوزاً القرآن الكريم هو مشروع محكوم عليه بالفشل الذريع، إذ لا نهضة إلا بالقرآن الكريم، ولهذا فإن “مشروع النهضة القادمة يجب أن يكون واضحاً مثل أول كلمة أنزلت من القرآن” {اقرأ}، ويجب أن ينطلق من أرضية القرآن الكريم، فالقرآن هو البوصلة التي تهدينا إلى طريق الرشاد، ولا يمكن أن نستعيد مجدنا التليد وتاريخنا المجيد وعناصر قوتنا المفقودة إلا من خلال العودة إلى القرآن الكريم والبحث في أعماقه عن أسس ومبادئ النهضة القرآنية الخالدة، ولا مجال للبحث عن تلك النهضة القادمة خارج إطار القرآن الكريم مطلقاً.
بقي علينا أن نقول إن الدكتور العمري قدم في خاتمة هذا الكتاب ملاحظات جميلة جداً حول “التعاكس والتضاد بين البوصلة القرآنية وبين المكتبة التي يفترض أنها استندت في نشوئها إلى القرآن”، ومن تجليات هذا التعاكس والتضاد أننا في الوقت الذي نجد فيه البوصلة القرآنية تشير إلى ضرورة التساؤل نجد المكتبة تصرخ: السؤال بدعة، وحين تشير البوصلة القرآنية إلى الأسباب تصرخ المكتبة: لا أسباب، وعندما تشير البوصلة القرآنية إلى الإيجابية تقول المكتبة: الله خلق أفعالنا، وحين تشير البوصلة القرآنية إلى المقاصد تخاطبنا المكتبة قائلة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن الحل في الغوص في أعماق القرآن الكريم، فهو الكتاب الخالد الذي أرسى دعائم حضارة {اقرأ} قديماً وهو الذي سيرمّمُها ويبعثها من جديد، فهيّا بنا إلى القرآن الكريم.