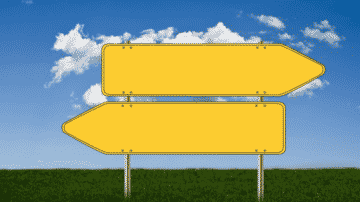النفوس الصغيرة وحدها هي التي تضيق بالاختلاف في الرأي وتعدد النظر حول القضية الواحدة، لأنها تطل على الحياة من زاوية صغيرة؛ لا تبصر سوى الأسود والأبيض، ولا ترى في الأشياء سوى الحق والباطل والخير والشر، والناس بالنسبة لها إنما هم عدو وصديق. فمن وافقها في المذهب والفكرة فهو الصديق الذي لا يخطأ، ولا يتفوه إلا بالحق، ومن خالفها في المذهب والفكرة فهو العدو الخبيث والدجال الماكر الذي لا يصدر عنه إلا الشر المحض ولا يقول إلا الباطل الخالص الذي ليس فيه أدنى نسبة من الحق !
ولئن كان هذا النظر الضَّيِّقِ، هو لدى البعض نتاج أمراض نفسية وتربوية، مثل التعصب والغرور والتعالي، والكبر والحسد، فإنه لدى جمهرة من الناس إنما هو نتاج أدواء عقلية وفكرية، مثل الجهل وقلة الاطلاع على العلوم والمعارف، وسوء الفهم، والانكفاء على مذهب فقهي واحد أو مدرسة فكرية ودعوية واحدة.
فضحالة المعارف، والانكفاء في القراءة والمطالعة على لون فكري واحد يورثان السطحية والبساطة والتعصب والضيق بالمخالف، ويحجبان عن الإنسان مساحات واسعة من الأفكار والمعارف هي غير ما هو غارق فيه. وقد لاحظ ذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله لدى طلبة المدارس الفقهية، فصرح بـ”أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورًا وإنكارًا لمذهب غير مذهبه، من غير اطلاع على مأخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة، الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين، واضطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه”(الموافقات، ج3 ص131).
وإذا كان هذا هو شأن طالب العلم الذي ضَيَّقَ على نفسه واسعا؛ فأغلق عقله على مذهب معين ومدرسة واحدة، وحرم نفسه بذلك من فضائل كثيرة وخيرات وفيرة، وأفكارٍ بكرٍ هي من إبداع آخرين خوارج عن مذهبه ومدرسته الفكرية والدعوية، فتاهت به الطرق في غياهب التعصب وضيق الأفق، فما بالنا بالجاهل الذي لم يطلع على شيء أصلا، ولا له تصور للمسائل ولا دراية بها، إلا أنه سمع الناس يقولون شيئا فردده. كيف يكون شأنه؟!
إن الاختلاف في الرأي، وتتعدد وجهات النظر في تفسير الأشياء والحكم عليها أمر طبيعي، تقتضه طبيعة تفاوت الناس في المعرفة وفي الفهم وفي إدراك المسائل وتصورها، ويقتضه كذلك إختلاف طبائعهم، فمن الناس من يميل إلا الشدة والجد الصارم ومنهم من يميل إلى اليسر والسماحة والمرح، ومن الناس من هو حرفي في فهمه ومنهم من هو مقاصدي، يميل إلى تعليل المسائل والبحث عن أسرارها.
وها هم الصحابة اختلفوا وتعددت مداركهم، فمنهم من مال إلى مجاراة ظاهر النص فصلى العصر في بني قريظة بعد ما فات وقتها، ومنهم من بحث عن مقصود النص، وفهم من حديث “لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة” أنه حث على الاسراع في السير، فصلى العصر في الطريق حين دخول وقتها، وواصل السير واللحاق بمن تقدمه في المسير. وقد أقر النبي ﷺ كلا الفريقين على فهمه، ولم يعنف أيا منهم.
فعن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ لنا، لما رجع من الأحزاب: “لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة” فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال: بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال: بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحدا منهم. (رواه البخاري ومسلم). وفي رواية ابن هشام في السيرة أن الفريق الذي أخذ النص على ظاهره، صلى العصر في بني قريظة بعد العشاء الآخرة.
فليس لنا إذا أن نَضِيْقَ بالاختلاف، ولا أن يظن بعضنا أنه بمقدوره رفع الخلاف وحمل الناس على وجهة نظر واحدة. فذلك غير ممكن واقعا وغير مقبول شرعا. وفقهاء المقاصد ومناهج الاستنباط يقولون: إن الأحكام الشرعية ثلاث مستويات: المستوى الأول: هو ما قصد الشارع إلى رفع الخلاف فيه، مثل أصول العقائد وأمهات الأخلاق، وكليات الأحكام الفقهية. والمستوى الثاني: هو ما قصد الشارع إلى عدم رفع الخلاف فيه، مثل معظم المسائل التي اختلفت فيها أنظار العلماء، فهذه لا مطمع في رفع الخلاف فيها، لأن الشارع لم يقصد إلى ذلك، ولو قصده لرفعه بنص حاسم لا يختلف عليه اثنان. والمستوى الثالث: هو الاجتهاد الذي لا محل له من النظر، وهو الاجتهاد في المسائل التي قصد الشارع إلى رفع الخلاف فيها.
فلمَ التعصب والضيق, ومحاولة رفع الخلاف في المسائل التي لا مطمع في رفع الخلاف فيها، والادعاء بأن رأيا واحد يمثل الحق المطلق الذي لا يخالفه إلا من حاد عن الطريق، وتنكب الصراط المستقيم؟!
وكان الأولى بشباب الصحوة الإسلامية أن يسترشدوا بحكمةً فَاهَ بها أحد الجهابذة الأعلام، وهو العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، “نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه”(مجلة المنار، ج17 ص955). على أن ذلك لا يمنع – كما قال الإمام حسن البنا رحمه الله- “من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة، من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب”(البنا، مجموعة الرسائل/371).