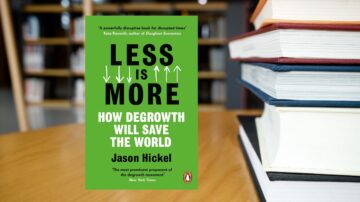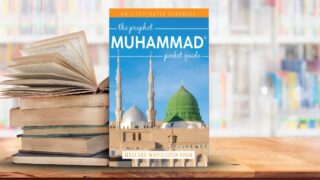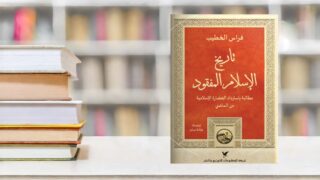المجتمعات الحديثة أقل ترابطا، بعدما تصدعت الكثير من الأواصر التي تحقق التماسك الاجتماعي، فـ الإنسان المعاصر بات منعزلا وراغبا في أن يستغرق وقته وحياته مع الشاشات والعالم الافتراضي، فتحولت التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي إلى عامل لتحقيق الفردية والانعزالية، ومن ناحية أخرى، فإن مواجهة الدين، لعقود طويلة في المجتمعات الحداثية، انعكس سلبا على التماسك الاجتماعي، وهنا يثور السؤال حول قدرة الأديان، وخاصة الإسلام، على تحقيق التماسك داخل المجتمعات حتى لا تتحول إلى مجتمعات هشة، وحتى لا تتبدد تلك المادة الإسمنتية التي تصوغ أفراد المجتمع في كتلة واحدة لتحقيق أهداف مشتركة.
شروط ضرورية
التماسك الاجتماعي هو درجة من الاحساس بالترابط يشعر بها الفرد تجاه المجموع والمجتمع، ولا يحدث ذلك إلا إذا أحس الفرد بالثقة تجاه ذلك المجتمع.
ينظر علماء الاجتماع إلى التماسك الاجتماعي على أنه درجة من درجات جودة الحياة داخل المجتمعات، وأحد المصادر المهمة في قوتها وإزدهارها، فهو يخفض الصراعات والانشقاقات إلى مستوياتها الدنيا، من خلال خلق أهداف مشتركة للفرد والجماعة.
تظهر الأبحاث الاجتماعية أن المجتمعات إذا تعرضت لتغيرات عميقة، فإن ذلك ينعكس على تماسكها، ويؤثر على نسيجيها؛ وقد تقود تلك التغيرات إلى تلاشي هذا التماسك، ويمكن التدليل على ذلك بانتقال المجتمعات من الطبيعة الزراعية لتصبح مجتمعات صناعية، وما يصاحب ذلك من إيجاد روابط جديدة بخلاف الروابط التقليدية، ووجود أهداف مختلفة عن الأهداف التي كانت تحقق تماسك الجماعة في السابق، إذ يحضر في المجتمعات الصناعية مفهوم الربح والمكاسب، والإدارة الحديثة، والقانون، والتجمعات المهنية والعمالية، ويلاحظ تراجع المكون العرقي والطائفي والديني واللوني والجهوي.
تكشف قوة التماسك الاجتماعي عن غياب أو خفوت الصراعات الاجتماعية القائمة على أساس عرقي أو ديني أو طائفي، ومن ناحية أخرى يكشف عن وجود قواسم مشتركة من التفاهم وتحديد الأهداف والغايات بين الأفراد، لذا فالتماسك الاجتماعي له وجه اجتماعي وآخر سياسي وثالث تنموي، فهو يكشف عن بناء قيم مشتركة داخل المجتمعات، ويكشف كذلك عن وجود حالة من الرضا والتفاهم في المجتمع قائمة على أسس واضحة، أبرزها العدل، لذا يُعرفه البعض بأنه “رغبة أعضاء المجتمع في التعاون مع بعضهم البعض من أجل البقاء والازدهار”، وهناك من يُعرفه بأنه “قدرة المجتمع على ضمان رفاهية جميع أعضائه، وتقليل التفاوتات وتجنب التهميش”، وهناك خمس محددات أساسية للتماسك الاجتماعي، هي: العمل من أجل رفاهة جميع أعضاء المجتمع، ومحاربة الاقصاء والتهميش، وخلق الشعور بالانتماء، وتعزيز الثقة، ووجود فرص للحرك والارتقاء داخل المجتمع.
ومن هنا فهو يعبر عن نوع من التجانس العميق والوعي وله سوابق من الخبرة التاريخية والممارسات الاجتماعية يستند إليها، فالانسان لا يعيش في جزيرة منعزلة، وهو اجتماعي بطبعه كما أكد العلامة “ابن خلدون“، لذا تبدو الحاجة للتماسك الاجتماعي لتحقيق التعاون والازدهار والأمان، ليتعاون الناس عن طيب خاطر، مدفوعين بعامل داخلي وليس بقوة قاهرة، فيتفاعلون بثقة وطمأنينة، ولهذا حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ) ، ثلاثة ركائز للتماسك الاجتماعي، وهي:
1- الإدماج الاجتماعي: ويقصد به مدى مشاركة الفرد في المجتمع، وتفاعله وتعاونه مع الآخرين، وتعد اللغة أحد أسس تحقيق هذا الاندماج.
2- رأس المال الاجتماعي: ويرتكز في المقام الأول على قيمة العلاقات الاجتماعية وأهميتها، وفعاليتها في تحقيق التعاون والثقة في المجتمع، وقدرة الأفراد على العمل معا داخل شبكة من العلاقات المشتركة.
3- الحراك الاجتماعي: ويقصد بهد قدرة الأفراد على التحرك داخل طبقات المجتمع صعودا وهبوطا، وهو ما يكشف عن حيوية المجتمع واستجابته للتغيرات التي تؤدي إلى تغيرات طبقية.
الإسلام والتماسك الاجتماعي
هناك قلق من تسارع الحداثة وانعكاساتها على التماسك الاجتماعي، فالبعض يعتبر العلمنة نوع من “اللاهوت” أي: عقيدة، والمجتمعات الحداثية واجهت الدين، وكانت الأسرة أحد ميادين المواجهة، رغم أن الدين يلعب دورا محوريا في تحقيق التماسك، وترتب على ذلك هشاشة التماسك الاجتماعي، فقد قللت العلمنة من الدور الوظيفي للأسرة، وظنت أن الدولة قادرة على القيام بهذا الدور، غير أن حضور الدولة مكان الأسرة عمق الفردية وفك الراوبط القوية بين الأفراد، تلك الروابط القائمة على التراحم، واستبدلها بروابط أخرى قائمة على القانون ومفهوم التعاقد.
ومن ناحية أخرى فإن اكتناز الوفرة الزائدة في المال، أوجد جشعا لدى الأغنياء، وخوفا من عدوان الآخرين، ودخل أصحاب الثروات المكتنزة في شرنقة الانعزال، وبنوا سياجات من الابتعاد عن المجتمع، وهذا فُكك التماسك الاجتماعي، وخُلقت صراعات عنيفة، وأحقاد لا تنتهي ولا ترتدع، وأوجد حالة صراعية قوضت النسيج الاجتماعي.
ونشير هنا إلى حقيقة مهمة، وهي أن التماسك الاجتماعي ليس حالة اقتناع عقلي، ولكنه ممارسات على الأرض، وتلك الممارسات هي التي تنشيء التماسك، ولعل هذا ما أشار إليه الفيسلوف الإنجليزي “برتراند راسل” بقوله: “التماسك الاجتماعي ضرورة، ولم تنجح البشرية بعد في فرضه من خلال الحجج العقلانية فقط“، ومن ثم فغياب التماسك يغذي الفردية، ومع الفردية تذوب فكرة المجتمع المتفاهم المتراحم، ويصبح الالتقاء على مشتركات اجتماعية والتعاون عليها، شيء من الاستحالة، وهنا نشير إلى مقولة مهمة لـ” جايسون هيكيل” Jason Hickel عالم الأنثربولوجيا في كتابه “الأقل هو الأكثر” Less Is More بأن ” المجتمعات ذات التوزيع غير المتكافئ للدخل تميل إلى أن تكون أقل سعادة” فعدم الشعور بالمساواة وغياب العدل ينشيء شعورا بالظلم، ويقوض الثقة بين أفراد المجتمع، ويغيب مفهوم الحراك الاجتماعي، ويساهم في زيادة الجرائم والإدمان والانتحار والاحباط والسخط على الحياة والمجتمع، وكثير من المجتمعات عندما يحط عليها الثراء تنمو فيها النزعة الفردية، وهنا يتأثر التماسك الاجتماعي ويهتز.
وقد حرص الإسلام على التماسك في المجتمع المسلم سواء بين المسلمين بعضهم البعض، أو بين المسلمين وغيرهم دخل المجتمع، وإذا نظرنا إلى العبادات الإسلامية، سنجدها تتخطى الحيز الفردي، إلى الحيز المجتمعي لتحقيق وحدة الهدف والغاية، وتحقيق التكافل والتراحم، وتشجيع الحراك داخل المجتمع، ففي الحديث الذي جاء في الصحيحين، قال النبي-ﷺ- : “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالحمى والسهر “، ومفهوم الجسد الواحد هو أفضل التجليات لمفهوم التماسك الاجتماعي، فالتواد والتعاطف يحقق وحدة الجسد، وإذا نظرنا إلى العبادات الكبرى في الإسلام، نلحظ أن الصلاة المتكررة خمس مرات في اليوم تحقق تماسك داخل المجتمع المسلم الذي يتراءي يوميا دون فوراق طبقية يتراص للصلاة ويسجد الجميع لله، أما الصيام فيخلق وحدة شعورية في الامتناع عن الطعام والافطار في وقت واحد، كما أن إخراج زكاة الفطرة تجعل المسلم يكتشف من حوله من غير القادرين لأداء الزكاة وإدخال السرور عليهم، أما الزكاة فهي تجلى كبير لمفهوم التراحم، فرعاية الأغنياء لغيرهم من غير القادرين، يخفض الأحقاد والصراعات، ويخلق مساحات للرحمة والتعاطف، ولذلك كان من شروطها إخراجها في مكانها أولا لسد حاجات الفقراء والمحتاجين ثم ينتقل الفائض إلى غيرهم، وفي ذلك تماسك اجتماعي.
تنزيل PDF