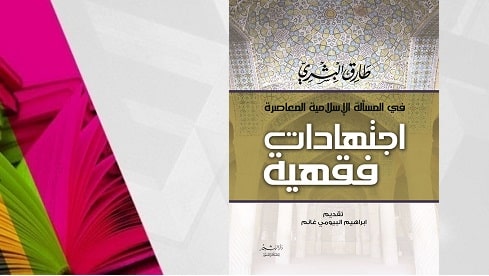“إن الشريعة فى البناء أخت العقيدة فى الأساس٬ ومع الشريعة والعقيدة معا نسير” هكذا تحدث الشيخ محمد الغزالي، عن التلازم بين العقيدة والشريعة، وهو ما نلحظه في كتاب “اجتهادات فقهية: في المسألة الإسلامية المعاصرة”[1] للمفكر والمؤرخ والقاضي طارق البشري، ويضم مجموعة من الاجتهادات الفكرية والسياسية والقانونية والتاريخية للبشري، اجتهادات شغلت العقل المسلم المعاصر ولا تزال تشغله حتى اللحظة، وعليها تجري الخلافات والانقسامات والتنازع بين النخب في العالم الإسلامي.
والبشري في هذه الاجتهادات يقدم جديدا وإضافة فيما كتب، فيضيف إلى اجتهادات الآخرين ما يثري القضية محل النقاش، الكتاب يتكون من (13) فصلا تتناول قضايا منها: التصور العقدي في الإسلام، وخصائص الثبات التغير في الشريعة الإسلامية، وحركة الإصلاح في الفكر الديني، وحقوق الإنسان، والأقليات، والإصلاح الضال والفاسد، ومؤسسات الدولة، والمرأة.
الشريعة.. والفقه
قضية الشريعة حاضرة في الديانات الإبراهيمية الثلاث، ففي اليهودية اعتنت الشريعة بوضع المبادئ الأولية للسلوك الإنساني، واتخذت طابع الحقوق العامة، أو ما يمكن تسميته الضبط الاجتماعي وأسس تنظيم الجماعة، وكانت وسيلتها في ذلك هي الجزاء العقابي، وعندما جاءت المسيحية فأكدت على النقيض فحضت أتباعها على حب أعدائهم، ومباركة لاعنيهم، وبالتالي صرفت أغلب جهدها إلى بناء الفرد من الداخل وتنمية ضميره.
أما شريعة الإسلام فاستوعبت الاتجاهين: القانون كضابط اجتماعي، والأخلاق والوجدان كضابط نفسي، وأقامت التوازن بينهما، فجمعت بين الفقه والتصوف، هذه الخصيصة جعلت شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، ولكن هناك فارق بين الشريعة والفقه، فالشريعة هي الأحكام المنزلة من الله سبحانه وتعالى على نبيه ﷺ، والتي وردت في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، أما الفقه فهو اجتهادات البشر في إدراك الشريعة، وفي استخلاص المعاني المقصودة، ووصل تلك الأحكام بأحوال البشر في كل بيئة، أي تطبيق النصوص التي لا تتغير على أحوال البشر المتنوعة ووقائعهم المتغيرة مع تغير الأزمان والأمصار، وهي تحتمل الصواب والخطأ، وتحتمل التنوع والتغير.
فالشريعة ثابتة، وهي ذات وضع إلهي ونصوصها ليست تاريخية، فهي ليست نتاج تاريخ الإنسان، فلا تتغير بتغير أحوال البشر وأماكنهم، أما الفقه فهو اجتهاد يرد عليه التنوع والتغير، فهو ذو وضع تاريخي واجتماعي، ويرى “البشري” أن عهد الصحابة الأوائل الذي لا يتجاوز نصف قرن يتميز بما يجعله مختلفا عن بقية العصور الإسلامية المتعاقبة، لذا أسماه “عصر الشريعة” فهذا العهد لنقائه كان وعاء النصوص، والنص دائما “مثال” يستمد مثاليته من ذاته، أما بقية العهود فهي عهود الفقه، ولإدراك القدرة الهائلة للشريعة على التجدد في فروعها مع المحافظة على أصولها؛ النظر إلى التنوع الهائل في البيئات التي وجدت فيها الشريعة الإسلامية واستطاعت أن تتواءم معها وتطبق فيها كلها، فاستطاع الفقهاء أن يوائموا بين الأحكام الكلية للشريعة وبين أوضاع تلك البيئات، فهذا الاختبار الواقعي للشريعة يُظهر مدى مرونتها للتصدي لكل تلك التغيرات والتنوع مع محافظتها على ثباتها.
هذه القدرة على الوحدة مع التنوع لم تكن مسبوقة في التاريخ، فالشريعة وازنت بدقة بين الوحدة وبين التنوع، وبين المحافظة والتجدد، ولعل ذلك يرجع إلى أنها صيغت على أساس “إجمال ما يتغير من الأحكام، وتفصيل ما لا يتغير” وذلك نوع من الإعجاز في هذه المعرفة وهذا الضبط الدقيق والقدرة على التمييز بين ما يتغير وما لا يتغير من أحوال الأفراد والجماعات، وكذلك الضبط الدقيق لحدود ما يجمل من الأحكام وما يفصل منها.
والمعروف أن أحكام الفقه الإسلامي تتراكم بالصلة المباشرة التي تنشأ بين الفقهاء وبين الناس، لذلك ارتبط الفقه على أيدي الفقهاء بالمشاكل العملية، واشتهر بالحس الواقعي، وارتبط بالمقاصد والغايات من جل المنافع ودفع المضار، وبهذه الروح نما الفقه، وكان نموه مستقلا عن أجهزة الدولة وعن هيمنة الولاة والسلاطين، لذا ترسخت مناهجه وأحكامه في ظل استقلال كبير وحرية واسعة.
انحسار الشريعة
وحركة التاريخ تؤكد أن لكل حكم ديني أثرا في التاريخ والمجتمع، والعقيدة نفسها يمكن أن تتأثر قوتها في قلوب الرجال ونفوسهم بالسياسات التي تُتبع في المجتمع، وبالأوضاع الحياتية والمعيشية للناس، لذلك نلاحظ أن إضعاف الإسلام في نفوس المسلمين خلال القرن العشرين لم يتخذ شكل محاربة الإسلام من حيث هو عقيدة، ولا اتخذ شكل الهجوم الصريح عليه من حيث هو نظام للحياة، وإنما تم اللجوء إلى الأسلوب الأكثر نجاحا وهو تغيير الأوضاع الاجتماعية وأنماط العلاقات بين الناس بطريقة تجعلها قائمة على التعارض مع تصورات الشريعة الإسلامية وأحكامها، وتغير سلوك الناس وعادات العيش أساليب الحياة اليومية بما يُقيم التعارض بين هذه الأساليب وأحكام الشريعة.
وقد جرى هذا الأسلوب لا بطريق الإقناع، ولكن جرى بالأساس بالترويج والدعاية والإغراء وإثارة نوازع التقليد والمحاكاة في أساليب الحياة والعيش، ولما استتبت قاعدة اجتماعية لهذه العادات والسلوكيات بدأ يظهر التعارض بينها وبين فقه الشريعة وفكرها، وبدأ الفقه الإسلامي يُحاصر ببديلين، إما أن يعترف بهذه الأساليب والأوضاع حتى ولو جاءت على حساب الشريعة وأصولها العامة، وإما أن يتهم بالعجز والجمود عن ملاحقة الواقع.
والحقيقة أن مناط الحكم على الفقه بالتجدد يتأتى من قدرته على الاستجابة للتحديات التي يفرضها الواقع والتاريخ، وأن تكون هذه الاستجابة مما يحفظ مصالح الإسلام والمسلمين، وهذا يفرض على المسلمين ضرورة الانتباه للمقتضيات الاجتماعية التي يحسن الاستمساك بها دعما للفاعلية الاجتماعية للأحكام المنزلة، كذلك ضرورة فهم الملابسات الاجتماعية والتاريخية التي خرج فيها الفقه بأحكامه، لأن ذلك يساهم في فهم كيفية إدراك المفتي للواقع، كذلك على المفتي المعاصر أن تكون اجتهاداته الفقهية بما يحقق الاستجابة للتحديات التي تواجه المجتمع في تلك اللحظة على النحو الذي يحقق النفع من خلال الربط بين الحلول الفقهية والفكرية وبين الوظائف الاجتماعية التي تترب عليها، فيرتبط علم الدين بعلم الدنيا، والعمل بالعبادة.
وطرح “البشري” إشكالية مهمة تتعلق بكيفية تحول تطبيق الشريعة إلى مشكلة في المجتمعات المعاصرة، وأن تكون قضية خلافية، ورأى أن الإسلام كان هو الوعاء الحاكم للنظام القانوني، ومن الإسلام يستمد المجتمع أسس شرعيته في الثقافة والفكر والنظم والعلاقات بين الناس، واستمر هذا الوضع حتى نهايات القرن الثامن عشر، رغم ما عانى منه الفقه من جمود وطغيان للتقليد، وتعصب مذهبي، وجاءت حركة التجديد الفكري والفقهي قبيل الغزو الاستعماري الغربي، ذلك الغزو الذي سبقه تغلغل للنفوذ الغربي في الدولة العثمانية لصياغة المجتمعات وفقا لصورة المجتمعات الغربية فكر ونظما وعلاقات حتى يسلس إقامة علاقة تبعية بين المجتمعات المسلمة والغرب، وحتى تضعف روح مقاومته في المجتمعات المسلمة، ومنذ تلك الفترة كانت حركة المجتمعات تبتعد عن الشريعة، ففي مصر صارت القوانين في غالبيتها تستمد من القانون الفرنسي، فزادت نزعة التغريب في البنية التشريعية.
انحسار الشريعة عن أن تكون هي النظام الحاكم للمجتمعات العربية والإسلامية، لم يكن بسبب عجز الشريعة عن التجديد، أو تغلب روح الجمود والتقليد، ولم يكن-أيضا- بسبب أن القوانين والنظم الوافدة من الغرب استطاعت أن تعالج المشكلات المستحكمة في المجتمعات المسلمة، وإنما ترجع أسباب هذا الانحسار إلى أن الوافد الغربي عمق تبعية المسلمين للغرب، كما أن دولة الاستقلال قامت على أساس علمانية الدولة والنظام السياسي والهياكل القانونية، ومن المعروف أن دائرتي القانون والأخلاق لا تتطابقان، فالقانون يتكون من أحكام آمرة، ويترتب على مخالفتها عقاب مادي تفرضه الدولة، أما الأخلاق فلا يحميها الجزاء المادي، وإنما يحمي القاعدة الأخلاقية الجزاء الأدبي كاستنكار المجتمع بازدراء مرتكب المخالفة، فالقانون يحكم الظاهر، أما الأخلاق فيغلب على مقاييسها الباطن والنوايا والضمير، ويلاحظ هنا أن الشريعة انحسرت في الأماكن التي انحسرت فيها العقيدة الإسلامية، لوجود صلة قوية ومتبادلة بين الإسلام كدين وبين شريعته كقانون، لذلك كان الشيخ الغزالي يتساءل ” كيف ينفذ قوانين الشريعة من لم ينفذ قوانين الأخلاق؟”
[1] الكتاب صادر عن دار البشير للثقافة والعلوم بالقاهرة في (262) صفحة من القطع المتوسط، في طبعته الأولى 2017