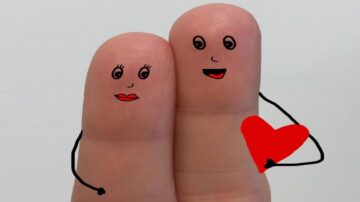يتعرض نظام الأسرة في واقعنا المعاصر لتحديات شديدة من أطرافه أي الزوج والزوجة، ومن البيئة الأوسع أي المجتمع والثقافة والاقتصاد، وغير ذلك. وفي بعض المجتمعات يشاع الكثير من الأحكام المسبقة والانطباعات، كأن يقال أن “الزواج أصلاً فكرة فاشلة”!! وهو رأي شائع ممن مروا بالتجربة، والذين يضربون مسألة المحبة بين الزوجين عرض الحائط.
لا يمكن الاعتقاد بأنه يمكن إصلاح هذا الوضع بمجرد الرصد والتحليل، ثم توجيه الإرشادات أو المواعظ لهذا الطرف في العلاقة أو ذاك، المسألة تحتاج إلى تدخل على أكثر من مستوى، ولكن يظل رسم الخرائط هو أول الحركة، فتعالوا نتأمل.
تقدير وتقييم
كيف يمكن أن يشعر كل طرف في العلاقة الزوجية بالتقدير والاحترام للطرف الآخر إلا إذا كان يتحلى هو نفسه بحسن التقدير وسلامة المعايير؟ إذا لم تستطع الزوجة أن تتصور نفسها مكان زوجها في المسئوليات والإنفاق والأعباء والواجبات الملقاة على عاتقه في علاقته بها، ونحو البيت والأولاد، إذا لم تكن واعية بتفاصيل حركته، وما يعانيه من ضغوط، وما يمكن أن يتولد عن هذه الضغوط من معاناة، وما يحتاجه نتيجة هذه المعاناة من تخفيف ومواساة، ودعم نفسي، وعون على الاسترخاء، وتجديد النشاط، وتحقيق السكن الروحي والجسدي… إلخ.
إذا فكرت الزوجة في حقوقها ولم تفكر كيف يمكن أن يمنح الرجل هذه الحقوق، وفي أي مناخ، وإذا نظرت إلى ما يأتيها منه أو ما يقوم به أو يتغاضى عنه أو يمرره أو يصبر عليه ويتحمله بوصفه معطيًا بديهيًّا، أو أنه واجبه وهو يقوم به، أو لم تشعره بالتقدير، أو يبدو منها ما يعبر عنه، فهل تنتظر الزوجة التي هذا مسلكها أن يحبها زوجها، ويمطرها بكلمات الغزل صباح مساء؟! ثم هي تتعجب بعد مواقفها وتجاهلها أن يعبس زوجها أو يهجرها في الفراش، أو يكثر من الخروج والجلوس إلى أصحابه خارج وداخل المنزل.
إذا لم يشعر الرجل الزوج بالتقدير في بيته ويصله التعبير عن هذا واضحًا وكاملاً ومستمرًّا من زوجته؛ فهل سيكون في وضع نفسي مناسب بحيث يدفعه ويدعمه ليقوم بواجباته أو أن يكون طرفًا لطيفًا خفيفًا مجاملاً، ومحبًّا وعطوفًا، ومسئولاً وراعيًا، إلى آخر القائمة التي تطلبها الزوجات؟! وبالمقابل فإن زوجة لا يصلها من زوجها إلا النقد والتهكم، واللوم والتبكيت، أو الصمت والعبوس، وهو لا يرى جهدها في البيت، وخارجه إن كانت تعمل، ولا يرى تعبها مع الأبناء، ولم يضع أو يتصور نفسه مكانها ليشعر بما تعانيه من متاعب وضغوط في معالجة التفاصيل المملة المكررة، أو ملاحقة طلبات الأولاد أو فض مشاجراتهم، أو الاستمتاع إلى الشكاوى الطفولية المزعجة ليل نهار، أو محاولة التوفيق بين العمل والبيت.
إذا اعتبر الرجل/ الزوج كل هذا من “التفاهات” والأمور البسيطة مقارنة بما يقوم به هو، ولم يشعر بالتقدير تجاه زوجته على ما تقوم به من أجل الأولاد، ثم ينتظر “أم النهار” المنهكة أن تكون “فراش ليله”، و”غانية فراشه” بعد يوم طويل من المعاناة والتعب، ثم إذا لم تكن على أكمل وجه زينة ودلالاً، هددها أنها ستبيت تلعنها الملائكة. فأي منطق هذا وأي تقدير؟! وأي تواصل هذا؟! وأي تعبير؟!
ضيق الأفق وتجاهل الآخر
يمكن إدراج هذه العلة ضمن ما كنا نسميه “الأنانية“، وفيها لا يرى المرء إلا ذاته ومتطلباته واحتياجاته وحقوقه، وينتظر من الآخرين احترام هذا الأمر، والتجاوب معه دون تباطؤ أو تقصير. فضيق الأفق، وغياب العقل هنا يبدو مزدوجًا؛ فالإنسان الأناني لا يرى أن للآخرين احتياجاتهم ومطالبهم وحقوقهم، كما أنه ينسى أو يتناسى أن حصوله على حقوقه يرتبط جذريًّا بالحالة التي يساهم في خلقها بنفسية الطرف الذي يطالبه بأداء الحقوق ورعاية الشؤون وتنمية المشاعر!.
وقد تكون هذه حالة عامة تصيب المجتمع، أو تشيع في أمة أو جماعة يبحث فيها كل فرد عن نفسه ويهتم بها وحدها؛ ربما لأن أحدًا لا يهتم به، وربما لأنه يشعر بعدم الأمان إلا إذا وصله التقدير من الآخرين، بينما يتقاعس أو تنفد طاقته قبل أن يؤدي ما عليه تجاه هؤلاء الآخرين!! والإحساس بالآخرين نعمة وفضيلة إنسانية يبدو أنها غابت فيما يغيب عن حياتنا بالتدريج من صفات الإنسان تحت ضغوط المادة، أو بفعل النسيان، ولكن هذا الإحساس يحتاج إلى تدريب يغيب عن مناهج تعليمنا، وتربية أغلب بيوتنا، وتنبيه أجهزة إعلامنا، والحصاد هو الجحيم للآخرين، ومنطق “أنا وبعدي الطوفان”، و”حروب الكل ضد الكل”، في العمل والمنزل وفي كل مكان.
البيت نزهة!
يبدو أن أغلبنا يعتقد أن الزواج هو السعادة بعينها والتي تنشأ عن ترديد صيغة “الإيجاب والقبول”، ثم الإقامة معًا تحت سقف واحد في انتظار الأستاذة “سعادة”، أو الأستاذ “استقرار”، ويبدو أن كل طرف يعتقد وينتظر من الطرف الثاني أن يقوم بمسئولياته، طبقًا للمتعارف عليه، وينتظر أن يحصل على حقوقه، أو على السعادة دون أن يعطي اعتبارًا كافيًا لما يحتاجه أو ينتظره أو يفتقده ويفتقر إليه الطرف الآخر!!
ويطول الانتظار، ويطول، وربما حصل على العكس تمامًا: شقاق ونزاع، وحزن وتعاسة وفشل وضغوط، وغالبًا ما يقفز إلى ذهنه أن الطرف الآخر قد خدعه حين قال له يومًا: “أحبك”، أو وعد عندها بالجهد والرعاية وأنه بالتالي قد انتظر، وطال انتظاره، لكن الوعود ذهبت أدراج الرياح!! وكم تمتلئ العيادات والطرقات ومكالمات الهاتف وحكايات الأصدقاء بأحاديث عن التعاسة والحزن، ونهاية عصر الرومانسية والحب، وانعدام المروءة والوفاء… إلخ.
والآخرون هم السبب بطبيعة الحال، الزوج أو الزوجة في المرتبة الأولى، ثم الزملاء والجيران وكل من حولنا، نصب عليهم الغضب والسخط؛ لأنهم أسباب تعاستنا!! ولا يتحدث أحد منا عن دوره هو في صناعة تعاسته الشخصية بما يفعله مع شريكه، أو بما كان ينبغي عليه، ولم يفعل! الكثيرون يعيشون في جحيم يظنون بفعل الآخرين، بينما هو من صنع أيديهم!!
صناعة التقدير
آلاف البشر، حكايات وقصص عن رجال “جهلة”، ونساء محدودات الأفق، ولا أعرف أرقامًا، ولكنني رأيت حالات غابت عنها الدراية، أو حسن الإدارة، أو امتلاك الإرادة ففشلت في تقدير الشريك، أو في الحصول على تقديره، أو في فهم هذه المسألة برمتها، ثم راحت تتسول التقدير من غيره؛ فانفتحت طرق للخيانة أو “المخادنة”، أو تبعثرت العلاقة الزوجية، أو انهارت الأسرة تمامًا، وتوقفت مركبتها بسبب غياب وقود التقدير، فتوقف المحرك، وربما احترق!!
وبداية من الإدراك، فإن البعض يمتلك قدرة نادرة على صف المعلومات و”الخلاصات” في ذهنه على نحو يجعله تعيسًا متخبطًا في علاقاته يشكو من الآخرين، وفيه هو نفسه يكون أغلب الداء. والبعض غافل أو متغافل، وآخرون لا يكلفون أنفسهم عناء التفكير في كيفية كسب الشريك، أو الحفاظ على محبته، أو على الأقل صيانة سلامته النفسية، ربما ليس لديهم وقت للتفكير في هذا؛ لأنه من “التفاهات”!.
وفريق يفتقد إلى مهارات التواصل والتعبير، وربما أيضًا مهارات فهم الذات والآخرين، وطالما غاب الفهم السليم فكل ما يأتي بعد ذلك مهدد بالفشل والخسران!! وتفضيل الكسل أو القعود عن المبادرة أو الاستسلام للكبرياء الضار أو الكرامة بمفهوم خاطئ، أو سوء المعرفة بطبيعة الزمان أو المكان، وبُخل المشاعر والعواطف، وغلبة الأنانية، وضعف الوازع الديني، وبقية الآفات النفسية والشخصية التي تقف كعقبات في سبيل صناعة التقدير أو إدارة إنتاج وتبادل هذه الناحية الغائبة عن بيوتنا وعلاقتنا، ولنا عودة.