يروى عن الفيلسوف الإيطالي الفريدو باريتو أنه كان يتأمل ذات يوم في شتلة فاصوليا، فقاده التأمل إلى نتيجة طريفة هي أن خُمس حجم الشتلة يمكنه إنتاج قرون الفاصوليا.. ثم أخذ باريتو يستصحب الحال إلى أماكن أخرى، فوجد الأمر مطرداً، إذ كثيراً ما تحظى أقليةٌ من الأشخاص بحظ يفوق حظ الأكثرية الباقية: فأربعة أخماس الأراضي في إيطاليا يملكها خُمس السكان، والأمر ينطبق على أمثلة لا تحصى، ذلك هو المبدأ المعروف بمبدأ باريتو “٨٠ إلى ٢٠”: ثمانون بالمئة من الأرباح تعود إلى عشرين بالمئة من العملاء، وعشرون بالمئة من الملابس في خزانتك هي ما ترتديه في ثمانين بالمئة من الوقت، وعشرون بالمئة من أسباب المشكلات تستأثر بثمانين في المئة من الأضرار، وهكذا.
خطر لي أن أطبق هذا المبدأ على الروايات والمدن، لأرى هل نستطيع أن نزعم أن عشرين بالمئة من المدن حازت ثمانين بالمئة من الروايات التي تتناول المدن؟! هذا سؤال لا أستطيع الإجابة عنه الآن، ولكني أستطيع أن أقدم إجابة أخرى: هي أن ثمةَ مدناً قليلة محظوظةً كُتِب عنها الكثير والكثير من الروايات، وأن ثمة مدناً أكثر لم تحظ بالذكر في نشرات الأخبار فضلاً عن الروايات والمذكرات والأقاصيص ونحوها.
لا يصعب على المرء أن يجد الكثير من الروايات التي تتناول القاهرة والإسكندرية، لكنه قد لا يجد -إن سلمنا جدلا أنه سيجد- إلا أقل القليل مما كتب عن الزقازيق وطهطا وقنا ومرسى مطروح. وقل مثل هذا في كل بلد من البلدان الناطقة بالعربية والناطقة بغيرها.
والحقيقة أن هذا طبيعي جداً، فالمدن كالناس: ألف منهم كواحد، وواحد كالألف! وإنك لتجد كاتباً مثل غازي القصيبي ينشأ في المنامة، عاصمة البحرين الصغيرة التي لا تتجاوز أبعادها تسعة عشر كيلاً في أربعين كيلاً، وتنمو فيها ذكرياته، وهي ذكرياتٌ ثريةٌ، وبوسعه لو أراد أن يحسن التعبير عنها ويخلدها في رواية ما، ولكنه يفتتح تجربته الروائية بـ”شقة الحرية” في القاهرة، ثم لا يلتفت إلى المنامة إلا بعد عقود، في مذكراتٍ ومقالات! وبوسع القارئ أن يعثر على القاهرة في عشرات العناوين الروائية، ولكنه سوف يعيى قبل أن يعثر على “لا أحد ينام في المنامة”، ويجتهد أن يعثر على قرين لذلك العنوان؛ فيجد ربما، أو لا يجد فيما يغلب على الظن. وما ينطبق على المنامة ينطبق على أكثر العواصم العربية حين تقارن بالقاهرة.
هكذا هي الحياة! مدينة متخمةٌ بما كُتب عنها، ومدن تشكو سوء التغذية الروائية، وأخرى قد صامت الدهر! وأكثر المدنِ من هذا الطراز، لم يكتب عنها في الماضي، والذي يرجح ألا يُكتب عنها في المستقبل.
ثمة ما يبرر دائماً حصولَ هذه “الطبقية المدنية” التي تضع كل مدينة في موضعها من الهرم الطبقي؛ فهناك التاريخ في القاهرة، والفرص في نيويورك، والموضة في باريس، والمال في لندن، والسياسة في واشنطن، وجميع ما سبق في إسطنبول!
ولكن، ليس صحيحاً أنّ المدن الكبرى وحدها هي المدن التي تستحق الكتابة عنها. ففي كل مدينةٍ وقريةٍ حكايات تستحق أن تحكى، وقصصاً يستحب أن تروى، وأبعاد معقدةً أو مبسطةً، فيها معمار، وروتين، ومفاجآت، ودراما إنسانية، وشخصيات متباينة، وحوادث متوقعة وغير متوقعة، فيها باختصارٍ عوالم يمكن لكل قلم روائي أن يبني عليها وينطلق منها.
ولد همنغواي في طرف من أطراف شيكاغو، وعاش في ميتشيغان، وباريس، وفلوريدا، ولكن روايته الأشهر ودرة أعماله الأدبية “الشيخ والبحر” دارت أحداثها في قرية صغيرة لا يؤبه لها.

واستطاع أديب أمريكي يدعى “إرسكين كالدويل” أن يبني لنفسه مجداً أدبياً باذخاً من وراء كتابته عن ولايات الجنوب الأمريكية في سلسلة من الروايات التي تعبق برائحة الطمي والطين والسنابل، طريق التبغ، وشارع السردين المعلب، وأرض الله الصغيرة، وغيرها.
وذاع صيت الأديب الروسي بوريس فاسيليف بعدما أصدر روايته “الفجر هادئ هنا” التي تجري أحداثها في قرية ما على حدود الاتحاد السوفيتي مع فنلندا.
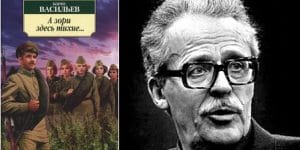
ولكن هذه المدن والقرى التي لم تنصفها الرواية: أنصفتها السير الذاتية ومنحتها مذكرات الأدباء بعض الاعتبار؛ فكان لها حظ ما من الخلود.
يخيل إليك وأنت تقرأ في سيرة ميخائيل نعيمة “سبعون” الممتدة عبر ثلاثة أجزاء، أن تلك القرية الوادعة في جبل صنين بلبنان أثرى مكان في العالم وأرحبه، مهما صعدت بك صفحات تلك السيرة وهبطت بين لبنان وفلسطين وتركيا وروسيا وأميركا؛ يظل مركز الكرة الأرضية في عين ميخائيل تلك القرية الصغيرة، ويظل محور الحياة ذلك البيت الحجري الذي عاشت فيه عائلته.
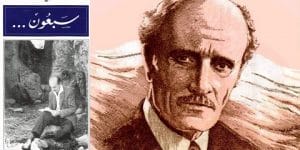
وتشعر بمثل هذا الشعور وأنت تدرج مع كمال الصليبي في سيرته الجميلة “طائر على سنديانة” فإذا بلدة “بحمدون” عالم رحب، فيه الكثير مما يستحق الكتابة عنه، ولولا أن حياة المؤلف انتقلت إلى بيروت لظننت أن بحمدون أهم من بغداد في أيام هارون الرشيد!

كم ترك الأول للآخر! وكم في هذه الأرض الواسعة من مدن، وبلدات، وأقضية، وقرى، لم تحظ بمن يدونها للعالم، ولم تُسلط عليها الأضواء، إذن لاستمتع القارئ أكثر وأكثر.. ولكنه النصيب!

