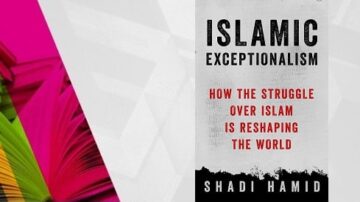كتاب “الاستثنائية الإسلامية: كيف يعيد الصراع حول الإسلام تشكيل العالم”[1] تأليف شادي حميد[2]، كتاب ذو أهمية كبرى لدارسي الحركات الإسلامية، إذ أنه من الكتب القلائل التي تجاوزت استعراض الأحداث، للبحث عن تلك الأفكار التي تحرك التاريخ، وتعطينا قدرا من الأسس التي تساهم في التنبوء بما هو قادم.
الكتاب كثيف في معلوماته وعميق في رؤيته، فهو خلاصة ما يقرب من عشرة سنوات من اهتمام المؤلف بمنطقة الشرق الأوسط وما تموج به من أحداث خاصة في مجال الدين، ينقسم الكتاب إلى قسمين، الأول: يعالج فكريا العلاقة المختلفة والمميزة بين الإسلام والسياسة، والتي يسميها الكاتب “الاستثنائية الإسلامية”، والثاني: يقدم تجارب الإسلاميين في تركيا ومصر وتونس، وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية في حل إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة.
توقع الكتاب أن يلعب الإسلام دورا كبيرا في سياسات الشرق الأوسط في المستقبل المنظور، وهو ما يفرض التعامل مع “الاستثنائية الإسلامية” بنوع من الجدية، وضرورة تجاوز الخطأ الذي وقع فيه كثير من علماء السياسة في رؤيتهم للدين والأيديولوجيا والهوية أنها نتاج مجموعة من العوامل المادية، فرؤية الدين من منظور السياسة أو الاقتصاد يحجب كثيرا من الأفكار التي تساهم في فهم واقعي للحركات الإسلامية في الشرق الأوسط.
طبيعة الدين وحقيقة الصراع
الدين والصراع في الشرق الأوسط قضية شغلت الكاتب منذ صفحاته الأولى، ورأى أن فهمها يستحيل دون الرجوع إلى العام (1924) الذي شهد إنهاء الخلافة العثمانية رسميا، إذ تولدت منذ ذلك التاريخ فكرة عند كثير من المصلحين والحركيين الإسلاميين مفادها؛ أن وحدة المسلمين الروحية تتطلب شكلا سياسيا، وكان الوجه الآخر للفكرة هو أن الأنظمة القائمة لا تستند إلى شرعية دينية، والحقيقة أن انهيار الخلافة أوجد ارتباكا كبيرا للمسلمين، الذين ظلوا لقرون طويل، وهو يرون أن عقيدتهم متعالية، وكذلك نظامهم السياسي.
هل مازال بإمكان الليبراليين أن يسودوا في الشرق الأوسط؟ ينظر كثير من المحللين إلى الصراع في الشرق الأوسط من الخارج، ويضعون افتراضا أن تلك الصراعات تدور حول السياسة والسلطة والثروة، وأن ظهور الدين في بعض الصراعات ما هو إلا قشرة تغلف حقيقة الصراع، ومن ثم فالدين، وفق تلك الرؤية، ليس محركا للصراعات، وهو أمر يرفضه الكاتب، خاصة للذين يرون أن هناك غايات تتجاوز الحياة، وأن هناك شيئا بعد الموت يستحق الذهاب إليه.
ويشير الكتاب أن إضعاف دور رجال الدين، وتحييد الدولة لهم، وتشويه سمعتهم لم يكن أمرا إيجابيا، حيث رصد كبار الباحثين في الشأن الإسلامي مثل “نوح فيلدمان” و”ووائل حلاق” أن طبقة علماء الدين استطاعت أن توفر قدرا من الشرعية للسلطة السياسية القائمة تاريخيا.
وهنا يؤكد الكتاب أن التجربة التاريخية للعلاقة بين الإسلام والسياسة تؤكد أنه أكثر صمودا أمام العلمنة، كما أن الدول القومية التي نشأت بعد سقوط الخلافة العثمانية لم تكن الحل لمعضلات بناء الدولة الحديثة، فقد أثبتت الليبرالية والقومية العلمانية أنها غير مرشحة لتوفير نظام يتمتع بالشرعية في المنطقة، فالقومية-مثلا- لم تستطع تقديم وحدة عربية أو تنمية اقتصادية، ومن الناحية الأيديولوجية لم تكن ذات قيمة جوهرية خاصة بعد ذهاب الاستعمار، إذ تآكلت الكثير من شعاراتها على وقع الهزائم والانكسارات، أما الإسلاميون فرغم أنهم غير محصنين ضد الهزائم، إلا أنهم يمتلكون ميزة لا تتوفر لغيرهم، ألا وهي فكرتهم القائلة، بمركزية دور الدين في الحياة العامة، وهي مقولة تتيح لهم النهوض الدائم من كبواتهم وإخفاقاتهم، فهذه الفكرة تعتنق دون قيد أو شرط أو استحقاقات.
ومن هنا فإن الحاجة إلى الإسلام لبناء مجتمع سياسي في الشرق الأوسط تصبح مُلحة إذا أدركنا حالة الضعف في ذلك المجتمع، والمرونة التي يتمتع بها الإسلام، وقدرته على استيعاب الكثير من الأفكار الغربية والحداثية، وهضمها وإعادة إنتاجها بما يتوافق مع رؤيته وفلسفته، ومن ثم فإن محاولة استبعاد الإسلام أو فرض العلمنة بالقوة لن تقود إلا لمزيد من العنف في المنطقة.
ولفت المؤلف الانتباه إلى أن “الإسلاموية”[3] ليست متعلقة بالإسلاميين؛ بل هي معتقد الكثير من المسلمين الذين يرغبون إلى أن يلعب الدين دورا مركزيا في التشريع والحكم، فالرؤية الإسلامية تعلن أن التدين إذا لم يترجم في شكل دعم للتشريع الإسلامي يعتبر ناقصا ومخدوشا.
هل الإسلام استثنائي؟
عقد الكتاب مقارنة بين الإسلام والمسيحية في علاقتهم بالسياسة، ورأى أن المسيحية ترى الخلاص في المسيح، ومن ثم لم ترى هناك حاجة إلى الدولة لتنظيم السلوك الخاص والعام باستثناء توفير بيئة ملائمة لتنمية الفضيلة، أما الإسلام فإنه يرى أن هناك ترابطا وثيقا بين الإيمان والعمل الصالح المتمثل في احترام تعاليم الشريعة، ومن ثم كانت الدولة ضرورة للاجتماع الديني .
ويشير الكتاب أن القرآن الكريم له عصمة عند المسلمين تختلف جذريا عن موقف المسيحيين من الإنجيل، ويؤكد أنه لم توجد أي طائفة، خلال التاريخ المسيحي، جزمت بأن الإنجيل هو كلام الله الفعلي، فما يعادل القرآن في المسيحية هو شخص يسوع (عيسى عليه السلام) وليس العهد الجديد، لذا كانت العلاقة مختلفة بين المؤمنين في الدينين وبين النص المقدس، فحتى أكثر المسلمين ليبرالية يعتقدون أن القرآن هو كلام الله، هذا الإيمان بالعصمة للقرآن له تداعياته وآثاره في عالم السياسة، وكما يشير الباحث “ميشيل كوك”:”أن الإسلام يوفر مصادر أكثر ثراء للمشاركين في العملية السياسية” فحتى المسلم البسيط عندما يقرأ القرآن سيميل إلى التفكير في العلاقة بين الدين والسياسة بشكل معين، إذ لن يمكنه النص في الميل للتفكير في الفصل بينهما، على عكس النص الإنجيلي الذي يقول:”أعطوا ما لقيصر لقيصر”[4]، فمنذ اللحظة التأسيسية للمسيحية والنص يدعم فكرة الفصل بين الدين والسياسة أو العلمنة بالمصطلح الحديث.
ويؤكد الكتاب أن الإسلام هو أكثر الديانات التوحيدية حداثة عن جدارة، ويرى أن النزعة الحداثية للإسلام والشريعة هي ما تجعل الإسلاموية ذات أهمية وصدى في عالم السياسة، فالشريعة[5] إطار يوجد داخله مجموعة من الأفكار التي تصلح كمفاهيم حداثية مثل: العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، لذا فلا يوجد سبب-حسب تعبير الكاتب- يدفع المسلمين لاختيار الحداثة كبديل عن الإسلام، لأنه بإمكان المسلم أن يكون مسلما وحداثيا في نفس الوقت.
[1] الكتاب صادر عن مركز نماء للبحوث والدراسات، ببيروت، في طبعته الأولى عام (2018) في ثلاثمائة صفحة، أما الأصل الإنجليزي فقد صدر في منتصف عام 2016
[2] شادي حميد: باحث أمريكي من أصل مصري، حصل حميد على شهادة البكالوريوس والماجستير من كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون، وشهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد، وهو مؤلف كتاب إغراءات السلطة: الإسلاميون والديمقراطية غير الليبرالية في الشرق الأوسط الجديد
[3] الإسلاموية: مصطلح أطلقه العلمانيون على الإسلاميين
[4] نص ورد في إنجيل مرقس
[5] يشير الكتاب باستمرار إلى الشريعة بمصطلح القانون الإسلامي، وهو تعبير أكثر ملائمة للقارئ باللغة الإنجليزية التي تُرجم عنها الكتاب