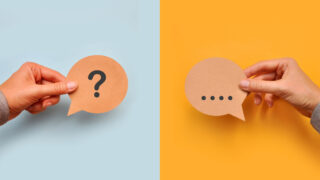في نقاش فكري بين اثنين من المتدينين كان أحدهما يواجه رأي الآخر بحجة ظنها دامغةً: المسألة محسومة؛ كتاب الله بيننا فلماذا نختلف، ولماذا تتعدد آراؤنا ما دام القرآن واحداً ؟
يجيب التاريخ بأن وجود القرآن الواحد الذي تجمع الأمة كلها على الإيمان به منذ أزيد من ألف وأربعمائة سنة لم يمنع قيام عشرات الفرق والطوائف من المسلمين، ولكل طائفة تفسيرها الخاص، وهذا ليس غريباً إذ إن أكثر الناس يقرؤون النصوص بقصد تبرير مواقفهم وليس تصحيحها، ويحكمهم المخيال أكثر من الدليل ويروضون النصوص لتوافق مألوفاتهم ويتحيزون إلى الأمثلة التي تؤكد موروثاتهم.
حين أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس إلى الخوارج قال له: “لا تُخاصِمْهم بالقُرآن؛ فإنَّ القُرْآن حمَّالُ أوجُه، تقول ويقولون”، وفي ذات المعنى يروى عن النبي ﷺ : ” لا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ ، وَلا تُكَذِّبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ , فَوَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيُغْلَبُ , وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيَغْلِبُ . هذان الحديثان عظيمان لأنهما ينسفان تصوراً سحرياً بأن استحضار النص القرآني كاف لحسم الخلاف بينما الذي يحدث أن كل فريق يشحن النص بقراءته الخاصة ويوظفه في خدمة موقفه فيلبس الناس الحق بالباطل ويغرقون في جدل الحروف والكلمات.
وكما أن في التاريخ آيةً فإن في الجغرافيا آيةً أخرى، إذ يعيش المسلمون اليوم في بلاد مترامية الأطراف، ولكل بلاد ثقافتها ونمط حياتها المختلف رغم أنهم يقرءون نفس القرآن ، لكن النسخة الثقافية من المسلم العربي غير النسخة الثقافية من المسلم الماليزي، والقرآن الذي كان أسامة بن لادن رحمه الله يصلي به هو ذات القرآن الذي كان يصلي به علي عزت بيجوبتش رحمه الله، فكان الأول مقاتلاً قضى حياته مطارداً في الجبال والكهوف وكان الثاني رئيس دولة وفيلسوفاً ومفكراً.
لا يلغي القرآن التنوع الثقافي بين أتباعه ولا يختزلهم في نمط أحادي في طريقة التفكير والحياة، لأنه ليس كتاب أيديولوجيا فكرية بل كتاب هداية روحية، فهو يتنزل بالطمأنينة وشفاء الصدور على المؤمن الذي تهيأ قلبه لتلقي رحمة القرآن، دون أن يشترط عليه الانتماء إلى مدرسة فكرية بعينها. القرآن مثل الغيث يتنزل على العربي والأعجمي والأسود والأبيض لا يفرق بين أحد منهم.
يتعلق الإيمان بالشفافية الروحية والنزاهة الأخلاقية وليس بالبنية الفكرية. إن القرآن يوحد بين المؤمنين الصادقين في اتباعه فيعلمهم الخشوع وتزكية النفس و الامتثال إلى الصدق والعدل وفعل الخير وأداء الأمانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن تمثل هذه المعاني الروحية في التطبيق العملي تحكمه المنظومة الفكرية التي تحدد للإنسان أولوياته، فالدعوة إلى الخير سيفهم كل إنسان منها ما يناسب ثقافته وحصيلة معارفه وسعة أفقه، هناك من يرى الخير في القتال في معركة وهناك من يراه في خطاب من منبر الأمم المتحدة، وهناك من يرى الأمر بالمعروف متمثلاً في حث الشباب على الفضيلة وهناك من يراه في دعوة نظام الحكم إلى العدل والنزاهة.
لكن ما هي الحكمة من كون القرآن حمال أوجه ولماذا لم تكن التركيبة اللغوية له حاسمةً فتنهي كل خلاف محتمل بين المسلمين؟
كون القرآن حمال أوجه فهذا مصدر تنوع وثراء، ومقصد القرآن أن يتسع لكل المشارب والطرائق النفسية والفكرية، وليس من أهدافه أن يحشر الناس في نمط واحد، وتعدد قراءات القرآن هو تعدد مستويات وليس تناقضاً، فكلما أبحر الإنسان في النص مزوداً بمعارف وخبرات إنسانية أعمق كلما تبدت له معان أعمق في النص، لذلك فإن القرآن ذاته يوجهنا إلى خارج حدوده فيدعونا إلى التدبر في آيات الله في الآفاق والأنفس وينبهنا إلى آيات الليل والنهار والسماء والأرض وقصص الذين خلوا من قبلنا، والذين يقرءون القرآن بأفق معرفي أوسع سيمتلكون القدرة على اكتشاف أوجه عظمته والخشوع في محرابه أكثر من غيرهم لأن الذي استثار خشوعهم ليس بنية النص وحده إنما علمهم الذي أنار بصائرهم وأراهم في الآيات ما لم يره غيرهم: “إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً.
مرونة الآيات القرآنية وظنية دلالاتها هي حجة للقرآن لا عليه، لأن الله تعالى يريد أن يفسح الميدان للاختيار الإنساني الحر، ولا يريد للإنسان أن يسير في الحياة مجبراً مقهوراً: “إن نشأ ننزل عليهم من السماء آيةً فظلت أعناقهم لها خاضعين”، ولو كانت بنية القرآن مكونةً من أوامر ونواه صارمة لا يختلف اثنان في تفسيرها لتحول المؤمنون به إلى ما يشبه الإنسان الآلي أو الجندي المأمور، لكن مرونة القرآن تعطي الإنسان الفرصة ليحقق ذاته ويعبر عن كينونته ويروي شغفه، إن القرآن يشحن الإنسان بالمعاني الخيرة والطاقة الإيجابية ثم يترك له أن يعبر عن هذه الطاقة الروحية في الوجهة التي يرسمها له موقعه في الحياة: “ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات”.
لا نستطيع عزل فهم النصوص عن الأجواء الثقافية والاجتماعية والسياسية للجماعات البشرية، فالتفسير هو ابن بيئته، وقارئ النص يراه بالنظارات التي تفصلها له ظروفه، لذلك نجد مثلاً سيد قطب مشبعاً في تفسير الظلال بفكرة الحاكمية والمجتمع الجاهلي لأنه كان يكتب من وحي تجربة الظلم والسجن التي يعيشها، ولو فسر القرآن مؤمن يعيش في بلد يحفظ له كرامته ويعطيه حقوقه لرأينا غالباً أجواءً نفسيةً مختلفةً في التفسير، هذه الطبيعة النسبية لقراءة النصوص تنبهنا إلى أن إصلاح الواقع الثقافي والسياسي وتحقيق العدل والكرامة هو الذي يهيئ المناخ لقراءة إنسانية منفتحة أكثر عدلاً وأقرب رشداً.
تنزيل PDF