في عمله المؤثر “الإسلام بين الشرق والغرب”، قام علي عزت بيغوفيتش بعمل رائع عبر استكشاف الثنائية القطبية للإسلام، معرّفاً الإسلام بوصفه توليفة للحضارة والثقافة، لدوافع الإنسان الحيوانية والأخلاقية، للجسد والروح، للحقيقي والسامي – وللغرب العلمي والفكري والشرق الديني والفني.
بيد أن تحليلاته، وقد كُتِبت في وقت مبكر من ثمانينيات القرن الماضي حين كان العالمُ مشطوراً إيديولجياً وعسكرياً إلى المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، لم تكن ذات بصيرة كافية للتنبؤ بـ تزحزح الصفائح الأرضية التكتونية السياسية التي ستحدث في غضون عشرة أعوام فقط، مؤذنة بـ “انتصار” الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية على منتقديها.
وقد شهدنا تبدّد الانقسامات التي تحدّث عنا عزت بيغوفيتش حين سادت الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية فوق “الإيديولوجيات الأقل شأناً”، مغيرة النظرة إلى الحرب الباردة بين الشرق والغرب. وقد أُشِيد بفرانسيس فوكوياما بوصفه الفيلسوف الذي صوّر روح العصر، وهو الذي جادل بأن الانتشار العالمي للديمقراطيات الليبرالية، ناهيك عن أسلوب حياة ورأسمالية السوق الحرة الغربية، قد يكون مؤشرا على نقطة نهاية التطور الاجتماعي الثقافي للإنسانية، وقد يصبح الشكل الأخير لحكومة إنسانية.
ومن ثم أتى الإيديولوجيون الذين لطالما كرروا واشتكوا من أن الإسلام يحل محل الشيوعية بوصفه المنافس اللدود لليبرالية والرأسمالية والديمقراطية وأيٍّ كان ما يسانده الغرب. ففي الحقيقة، بدلاً من القطبية بين الغرب والشرق التي تناولها عزت بيغوفيتش بصورة واسعة في كتابه، كان من المفترض أن القطبية الأزلية بين الإسلام والغرب هي التي ستطل برأسها في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.
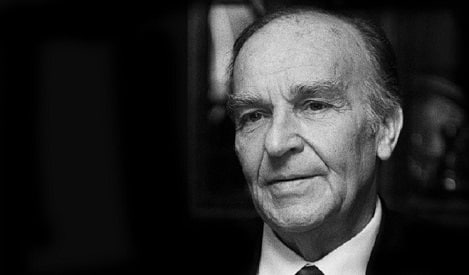
وقد خمّن صامويل هنتنغتون، الذي يُسوَّق على أنه المخلِّص المنتظَر لهذا النوع الجديد من النزاع الذي يركّز على الهوية الثقافية، أن الاختلافات الثقافية والإيديولوجية المتجذرة عميقاً ستسيطر على السياسات والعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. وبينما يسعون للبحث عن الـ “آخر” في الإسلام لأيٍّ كان ما يسانده الغرب، بما في ذلك حريته، وديمقراطيته، وليبراليته، وتسامحه الديني، وروحه العلمية…إلخ، فقد أعاد المفكرون النيو ليبراليون [الجدد] الذين يشكل هنتنغتون مصدر إلهامهم اختراع المغالطات والأساطير القديمة، التي يعود تاريخها إلى الحروب الصليبية. ولقد وضّح جورج بوش ذلك بصورة جلية في واحدة من خطاباته للاستعداد للحرب على الإرهاب.
أسطورة صراع الحضارات
ومن منظور تاريخي أوسع، فإن العلاقة بين الشرق والغرب أو، بصورة أدق، بين ما يُسمّى العالم الإسلامي والحضارة الأمريكية الأوروبية، تطغى عليها في كثير من الأحيان سردية الحروب الثقافية و الصراع الذي لا نهاية له بين الإيديولوجيات. لكن هل هذا الوجود القطبي أو العداء المتبادل شيء جوهري بصورة لا يمكن تغييرها في طبيعة كل من الحضارتين، بمعنى: هل من المقدّر لهما البقاء على مسار تصادم لا رجعة فيه؟ أم أنه وُلِد من بعض الأخطاء التاريخية الفادحة التي لا علاقة لها بالدين أو بالثقافة بحد ذاتها، ولكن لها كل العلاقة بالطموحات الإقليمية والاقتصادية والسياسية لهؤلاء الذين يمسكون بمقاليد السلطة خلال منعطفات تاريخية معينة؟ وهل تعمّقت الشقوق التي خُلِقت، مما سمح للجروح بأن تتفاقم لعدة قرون؟
إذ أنه بدءاً من الحروب الصليبية واستمراراً خلال الاستعمار وتوسع الامبراطوريات وإلى حروب البروباغاندا والنزاعات الإيديولوجية اليوم، كان هناك وفرة من الأسباب لكي يبقى العالم الإسلامي والغرب في خصام مع بعضهما البعض. فقد أسفرت حروب الغزو من قبل السلالات السابقة والقوى الاستعمارية، والتوسعات الإمبريالية (من كلا الجانبين) في سبيل الموارد الاقتصادية والهيمنة السياسية عن مواجهات عسكرية عدوانية، وتنامي كراهية متبادلة، بالتزامن مع ترسيخ انقسام إيديولوجي وثقافي متأصل الجذور.
إلا أنه رغم تشاطر اليهودية والمسيحية والإسلام لأرضية مشتركة إلى حد ما، فإن الاختلافات التي بُنِيت على ذرائع كاذبة كهذه قد أسهمت في الأسطورة القائلة إن الإسلام ينتمي إلى الشرق بينما تنتمي التقاليد المسيحية واليهودية إلى الغرب. وهذا، رغم حقيقة أن كلاً من المسيحية واليهودية (مثل الإسلام) قد نشآ في الشرق، أو في الشرق الأوسط لكي نكون أكثر دقة؛ وأنه بغض النظر عن أصلها [أصل هذه الديانات الثلاث] الذي يعود إلى الشرق الأوسط، فإن الإسلام كدين أو كأسلوب حياة، لم يُظهِر مطلقاً السمات المميزة لأي منطقة جغرافية.
الانسيابية الجغرافية الإسلامية، والمرونة الثقافية والدينامية السياسية يمكن أن تُرى من التنوع الذي نُظِر من خلاله إلى هذا الدين، ومن التنوع الذي عاشته به وخبِرته من خلاله أيضاً مختلف البلدان والمناطق الجغرافية التي رسّخ فيها نفسه بوصفه حضارة.
وقد ركزت سرديات الحرب الثقافية على استكشاف وحماية التفرد الثقافي وتعميق عدم الثقة المتبادلة، متجاهلة الفرص لإيجاد والبناء على قواسم وقيم مشتركة يمكن أن توحّد. إذ استُثمر أكثر بكثير، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وكذلك فكرياً، في تضخيم الارتياب المتبادل ليبلغ ذروة العداء، والكراهية والحروب بدل من الاستثمار في التركيز على ما يوحّد الإسلام والمسيحية، ناهيك عن الأرضية المشتركة التي تتقاسمها القيم الإسلامية وروح البحث العلمي والإنسانية التي ازدهرت في الغرب على مدى القرون الخمسة الماضية.
تواصل العداء وأصبحت هذه الأسطورة تدريجياً من ضمن التاريخ على مدى عقود من قبل مجموعة أساسية كبيرة تتألف من أدب استعماري وما بعد استعماري، ونظريات ونظريات مضادة. فأصبحت الأسطورة راسخة بحزم، وتدين إلى نسيان الحقيقة التاريخية المتمثلة في أن الغرب والشرق قد كمّل أحدهما الآخر في خلق ثقافتهم وحضارتهم. وحتى الهواء المنعش للعولمة والتكنولوجيا الحديثة، وعلى الرغم من إمكاناتها الهائلة في جمع العالم سوية، قد فشلت في احتواء هذا الجو الخانق من الارتياب المتبادل.
الانسجام والتكافل
بيد أنه وراء هذه السردية المشوهة والملتوية للمواجهات والعداء المتبادل، توجد وتستمر بالتواجد، منطقة واسعة وغير مستغلة إلى حد كبير من تعاون متبادل، وتكافل وانسجام ثقافي يربط الإسلام والحضارة الغربية ككل.
ليست الحضارة شيئاً أُنتِج محلياً في العالم العربي، بمعزل عن المناطق الجغرافية الأخرى. فالعديد من المفكرين والفلاسفة الإسلاميين المشهورين من العصور الوسطى، الزمن الذي يُعتقَد أن الحضارة الإسلامية قد بلغت فيه أوجها، كانوا من غير العرب وكان بعضهم متأثراً بالفلاسفة اليونايين القدماء. وبكونها لا من الشرق ولا من الغرب، فنقطة “مصب النهر” المجازية هذه، ملتقى كل الروافد، كانت بمثابة منبع استقى منه مفكرون مثل روجر بيكون إلهامهم لعصر النهضة.
فلا يمكن لتعريف الإسلام كحضارة، أو كأسلوب حياة ليس من الشرق ولا من الغرب، أن يقتصر على تفرد أي حضارة إسلامية وُجِدت في الماضي، وتوجد في الحاضر، وستتواجد في المستقبل. ومرة تلو الأخرى، يحدّد القرآن رسالة محمد النبوية بوصفها تأييداً واستمراراً لكل الحضارات والأنبياء السابقين، بدل القطيعة معهم.
فيؤكد القرآن أن ما أُوحِي به للنبي محمد يُقصد به أن يؤيد ويكمّل، بدلاً من أن يلغي أو يناقض ما بشّر به أسلافه. وتشهد على ذلك، العلاقاتُ الجيدة والتعايشُ المشترك بين المسلمين والمسيحيين، واليهود والأقليات الدينية الأخرى التي عاشت خلال العصور الوسطى في الكثير من [أراضي] العالم الإسلامي.
السعي نحو أفضل ما في الإنسانية
بما أن المسلمين يُعرّفون في القرآن على أنهم “أفضل مجتمع بشري”، فلا يمكن للحضارة الإسلامية أن تقبل بأي شيء أدنى بالجودة أو أن تكون متواضعة في الروح. لذلك فالحضارة الإسلامية بطبيعتها شيء مازال يتطور -مع الانسيابية الجغرافية، والمرونة الثقافية والدينامية السياسية- وهكذا فهي متوافقة مع أي شكل متقدم للحضارة.
ولقد آن الآوان لابتعاد العالم عن النظريات الطوباوية الصدامية والمثيرة للانقسام والقائلة إن إيديولوجية أو حضارة تهيمن على أخرى. فالمستقبل هو حول استكشاف القواسم المشتركة والعيش مع الاختلافات، بدلاً من تعميق الانقسام.
أما حماسة المتطرفين المسلمين، الذين يسعون إلى تحويل العالم بأكمله إلى نسختهم المتشددة من الإيمان الممهور بختم ممارساتهم، وغطرسة المحافظين الجدد فيما يتعلق بالقوة والتفوّق والعالمية والانتصار النهائي للمثاليات الغربية على كل الثقافات والحضارات، فقد قامت بضرر كبير على تعزيز السلام والتجانس بين الحضارات وبين الثقافات في العالم.

