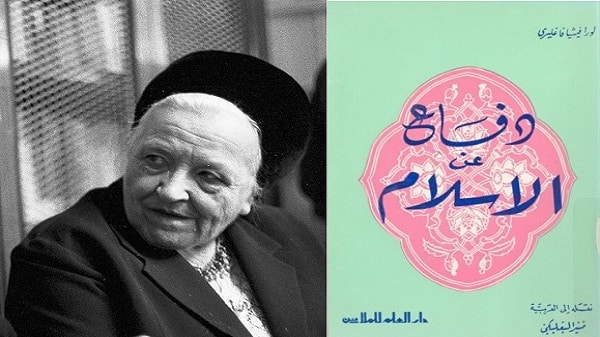ماجد عبدالرحمن البلوشي
ضمَّنا بشيخنا العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي مجلسٌ من مجالس الوعظ، استهلَّ فيه الشيخ حديثه ذاكرًا فضائل التوبة، حتى إذا أتى على حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا: “إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل”، رواه مسلم، فإذا بدموع الشيخ تتساقط مبلّلة لحيته الوقورة، وأضلاع صدره تكاد تثب من تتابع وجيب قلبه، أما صوته فقد تهدّج وأخذ يتعثر، حتى غلبه البكاء وعلاه النشيج.
ألا ما أطهر تلك الدموع المستهلات من عيون الصالحين في لحظات الخشوع لله وتعظيم أوامره!
وأخبار هذا السيِّد العالم الجليل مبهرة، لاسيّما في مقام التألّه وتعظيم أمر الله وأبواب البرِّ والمروءة وحُسن الخلق، فضلًا عن علمه الذي يُنير العقل، ووعظه الذي يُحيي القلب، وهي بحاجة إلى مقال خاص.
ثمَّ افتح – أيها القارئ الكريم – قلبك، وتأمل في قوله: “يبسط يده”، فهي تحفيز من الله لعبده المخطئ بتذليل السبل المؤدية إلى رضوانه، ففي تلك اللفظة معنى الانبساط والاتساع، وفيها معنى الإحاطة والرعاية والتودّد، وكأنَّ التائب يسلك طريقه إلى ربه على بُسطٍ فاخرة ممتدة مد البصر، في موكبٍ وضّاءٍ، محاطًا بعناية الله، محفوفًا بقبوله.
وإذا كان المسلم حالَ اغترابه الجسدي مُكتَنَفًا بصحبة الله له: “اللهم أنت الصاحب في السفر”، فهل يُسلمه الله إلى حتفه في حال اغترابه الروحي بالذنوب واستيحاشه بالمعاصي، وهي أشد ضراوة وافتراسًا من فتك الاغتراب الجسدي؟ كلا والله، بل لا يزال سبحانه يمدُّه بأسباب التوبة المفضية إلى استرجاع سعادته الشعورية واستقراره الداخلي، فضميره يخزه بالتأنيب، ونفسه تلومه على التقصير، وروحه تؤزه إلى الطهارة، حتى يجيء طائعًا إلى ظِلال التوبة ومنتجعها الأغنِّ.
هذه هي نفس المؤمن، حيّة نابضة باللوم، تُتري زجره على مقارفة الذنب، وتُديم تقريعه لفوات الطاعة، ولعِظم هذه الطبيعة النفسية ومكانتها عند الله، اقترن القسم بها مع يوم القيامة العظيم، فقال سبحانه: “لا أُقسم بيوم القيامة، ولا أُقسم بالنفس اللوامة”، قال إمام المفسرين مجاهد: “بالنفس اللوامة” أي تندم على ما فات وتلوم عليه، وقال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير والشر.
ولو لم تكن التوبة من أحب الأعمال الصالحة إلى الله، لما ابتلى بالذنوب والخطايا أشرف عباده إليه وهم الأنبياء المرسلون، حتى تنكسر نفوسهم بين يديه، ويسمع بحاح أصواتهم التائقة إلى رضوان الله عليهم، قال سبحانه: “وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى”.
وقال سبحانه عن نبيّه موسى عليه السلام: “قال ربِّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنّه هو الغفور الرحيم”، تدبّر في هذا السياق القرآني الرقيق كيف كرر المغفرة ثلاث مرات ليجعلها حقًا مؤكدًا من الله لكل تائب، وعقّب على طلب المغفرة بالفاء: “فغفر له”، أي أنَّ المغفرة جاءت عقب استغفاره مباشرة دون تراخٍ أو تأخير، وأيضًا لم يذكر خطيئة موسى إلا مرة واحدة على لسانه، وكأنه لم يقربها! فمهما كان عِظم الخطيئة فهي طي النسيان وقيد المغفرة!
وفي قصة داود عليه السلام يقول سبحانه: “وظن داوود أنّما فتنّاه، فاستغفر ربه وخرَّ راكعًا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإنَّ له عندنا لزلفى وحسن مئاب”.
وفي قوله تعالى: “ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى” إشارات واضحة إلى اصطفاء الله لعباده التائبين، واختيارهم بعناية.
فإذا آنست من نفسك جيشانًا روحيًّا، واستيقظ الندم في وجدانك، وراح ينتشلك من وحل الخطيئة، فاعلم أن هذه لحظة اصطفاء إلهية اختصك الله بها، فاغتنمها ولا تتأخر، وأقبل على الله بحالتك كما أنتَ، هشَّ الروح، كسير النفس، عاثر الخطى، ملطّخ الجوارح، مستعبر العين، فإنه يجبر عثرتك، ويُقبل عليك بأسرع من إقبالك عليه: “ومن أتاني يمشي، أتيته هرولة”.
ولا تستهن أيّها التائب المنيب بدموع انكسارك بين يدي الله، فهي مراقٍ ترقى بها في الدرجات العُلى، وكم من دفقةِ دمعٍ افترّت عنها عين التائب، في ساعة انكسار وضعف في خلوة عن الناس، فاجتازت المآقي ثم صافحت الوجنتين قبل أن يغيض أثرها، فنسيها صاحبها في غمرة ما ينسى من شؤون الحياة، إلا أنَّ الله لم يغفل عنها، بل وقعت منه موقعًا كريمًا، وتلقاها سبحانه بالقبول، ليجعل عاقبة حرارة الدمعة السخينة بردًا وسلامًا على صاحبها، وظِلًا ظليلًا يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح: “سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله”، وذكر منهم: “ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه”.
على أنَّ التوبة ليست مجرّد حالة شعوريّة عابرة، أو ندم لحْظي، لكنّها وثبة وجدانيّة قوية، وقفزة للتحرر من أغلال الشيطان والنفس والهوى، تتلبّس صاحبها وتهزُّ ضميره هزًّا عنيفًا فتنبهه من سُبات الغفلة، وتمدُّه بأسباب اليقظة وترفده بإكسير السعادة، فيستعيد نشاط الحياة ويمتلئ بالحيوية والطاقة، فما تزال تغريه بالمعالي وتقطره إلى المكارم حتى ترفعه من دَرك الشقاء السفلي إلى علياء العناية الإلهية.
وأيًّا ما كانت حال الإنسان في فتوره وتراخيه وهيمنة الهوى عليه وتسلط الخطيئة على قلبه، فلا ييأس ولا يرفع راية الاستسلام، فلن يكون أحطَّ من حال العرب قبل الإسلام، في استباحة الشرك، وإراقة الدماء، وإدامة الفواحش، وتعاطي الموبقات، حتى انقدحت شرارة الإسلام ودقّت ساعة التغيير، وكثير منهم قد كبر سنه ووهى عظمه وتراخت عزيمته، فاغتسلوا في أنهارها، وتضلّعوا من كوثرها، فنفخت فيهم روح المضاء وجدّدت فيهم معنى الحياة وخلعت عليه أثواب العزيمة، فانبثوا في أقطار الدنيا فاتحين ومعلّمين وداعين إلى الهدى.
فلولا اتخاذ قرار التغيير وترك المماطلة والتسويف، لما كانت خديجة أمًّا للمؤمنين، ولا أبو بكر يُدعى من أبواب الجنة الثمانية، ولا عمرُ أميرًا للمؤمنين، ولا حمزة سيد الشهداء، ولا خالد سيف الله المسلول.
ولهذا أجاد سهل بن عبدالله التستري عندما عرّف التوبة بلازمها فقال: التوبة: ترك التسويف! وقد صدق رحمه الله، فكم قتل التسويف من الهمم، وأمات من العزائم، وأورد المهالك.
إنَّ من مقاصد التوبة المهمة أن يخلع الإنسان عن كاهله ما يُثقله من أردية الانقياد للأهواء والأنفس والملذات الحسية والمعنوية التي تعرقل تحصيل إنجازاته في الدنيا، وتحقيق نجاته في الآخرة، ثم يُسلم وجهه وقياد أمره إلى الله، ويجمع تشعّثه عليه، محسنًا في قصده، مستأنفًا صالح عمله، متوكّلًا عليه.
فتكون عاقبة ذلك في الدنيا أن يوطّئ الله له العمل الصالح، ويسهّله عليه، فينتقل حاله من شخص رَثِعٍ في الدناءة راضٍ بالهوان، كان مستكينًا إلى مراد الشيطان، مستعينًا بأهواء النفس، وهمته لا تجاوز نزوات يومه وشهوات وقته، إلى آخر حارثٍ للوقت همّامٍ بالمعالي، ذي توق طامح تلامس هامته الثريّا، ويعمر الأرض بإنجازاته ويغمرها بحسناته، فلا يعرف مأسدة إلا ضرب فيها بسهم أو طار إليها بعزم، فكأنَّ الله أحياه بعد مماته، وإليه النشور.
وهذا معنى قوله تعالى عن التائبين: “إلا من تاب وآمن وعمل صالحًا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورًا رحيمًا”، فكل ما على العبد فعله أن يتوب توبة نصوحًا، ليأتيه مدد السماء بإعانته على الفلاح والإنجاز وتحقيق الأهداف في حياته الجديدة، ويا له من مدد!
فأقبل على الله بخضوع وإخبات يقبل الله عليك، واصدق مع الله بتجرد ويقين يصدق الله معك، واعلم أنَّ الصالحين مهما علت مراتبهم، وأيًّا ما كانت سوابق أعمالهم، وسوابغ أفضالهم، إلا أنّهم يرتعون في مرابع ديمومة التوبة، فهي من أقصر الطرق الموصلة إلى رضوان الله، فيدأبون عليها وتعتادها ألسنتهم، وفي الحديث عن سيّد التوّابين وسيّد المتطهرين محمد ﷺ: “والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة”.
ولمحتِ الشريعة أنَّ التائب قد يعتريه شعور ملح بالحاجة إلى البوح والاعتراف بخطيئته، حتى يخفَّ أثرها عن وجدانه، فأرشدته إلى من يستحق الفضفضة وشكاية الحال، ألا وهو الله سبحانه وتعالى، فهو يستر عباده ويضع عليهم كنفه، قال سبحانه واصفًا إقرار آدم وحواء بذنبيهما في لحظة بَوح خجلى: “قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين”، ولهذا كان سيّد أدعية الاستغفار متضمِّنًا بَوح العبد بخطيئته واعترافه بها: “أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.
وعلّم النبي ﷺ أحبَّ الخلق إليه أبا بكرٍ أن يبوح بمجترحه من الخطايا ويفضفض بها إلى ربه، وذلك في الدعاء المأثور المشهور: “اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم”.
والله يحبُّ أن يغفر لعباده، ويُذيقهم برد عفوه، وينفي عنهم خبث المعاصي، ولأجل ذلك عَمَر حياتهم بمحطات تمحو السيئات وتجلو صداها عن القلب، منها التوبة، والاستغفار، والمصائب والهموم، والأعمال الصالحة، ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض، والصدقة عنهم، إلى غيرها من موجبات تكفير الخطايا، وهذه المحطات للمسلم في هجير الخطايا مغتسلٌ باردٌ وشرابٌ، وقد ألمَّ بها وسردها مسردًا حسنًا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة النبوية.
وإذا أحبَّ الله من عبده أمرًا فعلى العبد العاقل المبادرة إلى امتثاله، قال لقمان الحكيم لابنه: “يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة”، وقد كان لقمان عبدًا حبشيًا، وابتلاه الله بعيوب ظاهرة في هيئة جسده، غير أنّه لصلاحه وتديّنه وحكمته رفعه فوق أكثر الأمم عنصرية وتحيّزًا وهم بني إسرائيل فصار قاضيًا عليهم، وحكمًا فصلًا بينهم.
ومتى ما رفع الله عبدًا رفعه! حتى يبلغ به سقف عرشه، ويُخلّد ذكره في ديوان الصالحين، ولو تواطأت قوى الأرض على خفضه، أو تآمرت على وضعه، لما استطاعت إلى ذلك سبيلًا.
ومن مأثورات الحكمة عن لقمان مما يصلح لحال التائبين، قوله: “إن الله إذا استُودِع شيئًا حفظه”، فعلى التائب المقبل على ربه أن يستودعه قلبه وحاله وشأنه كله، فسيحميه الله له ويحرسه من نوازع الشهوات وجواذب الأهواء، والله خير الحافظين.
وفي تفسير ابن كثير – وهو التفسير الذي لم يُؤلف على نمطه مثله كما عبّر السيوطي – فصولٌ مهمة عن لقمان الحكيم في أخباره ومآثره وحِكَمِه، وهذا من خبايا الزوايا في تفسير ابن كثير، وما أكثرها وأشدَّ تميّزها وأحراها بالجمع والإفراد.
ألا أيها العبد الخطّاء المذنب، وكلّنا خطاؤون مذنبون: عفّر بين يدي سجودك لله جبهتك ووجهك، ومرّغ أنفك في تراب الخضوع، وابلل ثراه بدموع الثكلى الواله، واحلل عقدة من كبرياء النفس الزائفة، ولا تكتم الله شيئًا من حالك، بل خاطبه خطاب الذليل المنكسر، واستغفر الله وتب إليه تجد الله غفورًا رحيمًا.