يعد التكامل المعرفي أحد المفاهيم الأساسية التي أسهمت في تشكيل الحضارات، وهو يقوم على الربط بين مختلف العلوم، والاستفادة من التخصصات المتنوعة لفهم الظواهر الاجتماعية، وتحليل المشكلات، وإيجاد الحلول المناسبة لها. في ظل التحديات التي يواجهها الفكر الإسلامي اليوم، أصبح من الضروري استعادة المنهج التكاملي الذي ساد في عصور النهضة الإسلامية، حيث لم يكن هناك فصل حاد بين العلوم الدينية والعلوم الإنسانية والتجريبية.
في هذا السياق، عقدت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر بالتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر ندوة علمية بعنوان “أثر التكامل المعرفي سبيلا للنهوض الحضاري”، وذلك مساء يوم الاثنين 18 فبراير 2025 في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بالدوحة.
شهدت الندوة حضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور بدران بن لحسن مدير مركز ابن خلدون بجامعة قطر، وعدد من أساتذة الجامعات وجمع من الجمهور الكريم.
وتندرج هذه الندوة ضمن الموسم الثقافي الأول من سلسلة ندوات “التكامل المعرفي”، والتي تسعى إلى إعادة النظر في كيفية تحقيق التكامل بين العلوم الإسلامية والإنسانية والتطبيقية، وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. وقد ركزت الندوة على تحليل هذا المفهوم من خلال دراسة نموذجين فكريين بارزين في التراث الإسلامي، وهما:
- “المقدمة” لابن خلدون، وقدمها الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر. وهو شخصية علمية بارزة تقلد عدة مناصب أكاديمية وحصل على عدة جوائز منها شخصية العام الثقافية لجائزة الطيب الصالح العالمية للإبداع الكتابي، 2022م وله عدة مؤلفات.
- الموافقات” للإمام الشاطبي، وقدمها الأستاذ الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي، الأستاذ بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة بجامعة قطر، وهو شخصية علمية بارزة، سبق له أن تقلد وزارة الشؤون الدينية في تونس، وله أكثر من 60 كتابا منشورا، إضافة إلى إشرافه على حوالي 150 رسالة دكتوراه وماجستير.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة هي الثانية ضمن هذه السلسلة، حيث سبقتها ندوة تناولت التكامل المعرفي من خلال شخصيات فكرية مختارة، مثل الإمام الغزالي ومالك بن نبي، اللذين يمثلان نماذج فكرية جمعت بين التراث الإسلامي والمعرفة الحديثة. وتُعقد هذه الندوة مرتين في العام لتعزيز البحث العلمي والتبادل الفكري بين الباحثين والمتخصصين.

التكامل المعرفي في بنية العلوم الإسلامية
بعد افتتاح الندوة بآيات من كتاب الله الكريم، ألقى الدكتور بدران بن لحسن، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر، كلمة افتتاحية ركّز على أهمية التكامل بين العلوم الإسلامية والإنسانية، وضرورة إعادة النظر في كيفية الاستفادة من هذا التكامل في إعادة بناء الفكر الإسلامي المعاصر.
أكد الدكتور بدران أن العلوم الإسلامية لم تنشأ منعزلة عن بعضها البعض، بل كانت مترابطة منذ البداية، حيث كان العلماء يجمعون بين الفقه، والفلسفة، وعلوم الكلام، والرياضيات، والتاريخ. لم يكن هناك فصل صارم بين هذه العلوم، بل كان التكامل المعرفي هو القاعدة الأساسية للفكر الإسلامي، مما مكّن الحضارة الإسلامية من تطوير العلوم وإنتاج معارف جديدة.
وأوضح الدكتور بدران كيفية تفاعل المسلمين مع علوم اليونان والهند وفارس، مشيرًا إلى أنهم لم يكتفوا بمجرد النقل، بل قاموا بـتحليلها ونقدها وتطويرها، وإعادة دمجها في المنظومة الإسلامية. وأكد أن هذا النهج أنتج معارف متكاملة ساهمت في تقدم العلوم في العصور الوسطى، وهو ما يمكن الاستفادة منه اليوم في إحياء الفكر الإسلامي المعاصر.
وأضاف الدكتور بدران أن الانفصال بين العلوم الحديثة أدى إلى تشظي المعرفة الإسلامية، وضعف قدرتها على إيجاد حلول شاملة للقضايا الراهنة. ودعا إلى ضرورة إعادة إحياء التكامل بين العلوم الشرعية والإنسانية والتطبيقية، بحيث تصبح العلوم الإسلامية أداة لتحليل الواقع، وإيجاد حلول علمية للتحديات الحديثة.
المحور الأول: التكامل المعرفي في مقدمة ابن خلدون
تناول الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، فكرة التكامل المعرفي من خلال تحليل كتاب “مقدمة ابن خلدون“، الذي يُعتبر من أهم المصادر الفكرية في التاريخ الإسلامي. وبدأ مداخلته باقتباس وصف للحضارة الإسلامية ينسب للأستاذ علي المزروعي بأنها قائمة على العلاقة التلازمية بين الدين والعلوم والمعرفة والأخلاق والتواصل مع الحضارات الأخرى، وهذا من وجهة نظره يعبر عن جوهر التكامل المعرفي أو ما أطلق عليه “التواصل المجتمعي المتكامل”.
ولفت الدكتور أبو شوك أن ابن خلدون أمضى نحو 24 عامًا في تونس، وهي الفترة التي شهدت تكوينه العلمي الأساسي في العلوم العقلية والشرعية، وتنقله بين مدن فاس، وغرناطة، وإشبيلية، وقسنطينة، ثم إلى تلمسان حيث تفرغ للكتابة. وظهر تأثر ابن خلدون بتراث المؤرخين والجغرافيين وأدب الرحلات، مما ساعده على وضع أسس “المقدمة”.ووفقًا لما ذكره في سيرته الذاتية، فقد كتب ابن خلدون “المقدمة” في خمسة أشهر. لكن المثير للاهتمام أن هذا العمل أصبح موضوعًا لأكثر من 300 أطروحة أكاديمية، مما يعكس قيمته العلمية الفريدة.
وبعد انتقاله إلى مصر، قام ابن خلدون بتنقيح “المقدمة”، وأضاف إليها فصولًا جديدة، ثم أهداها إلى السلطان أبي فارس عبد العزيز بن الحسن المريني عام 1397م، قبل تسع سنوات من وفاته.
محتويات مقدمة ابن خلدون وتصنيفها
وذكر الأستاذ الدكتور أحمد أبو شوك، بعد مراجعة المخطوطات المعتمدة من قبل الباحثين في تحقيق “المقدمة”، نجد أنها تنقسم إلى نسختين رئيسيتين:
- النسخة التونسية: أهداها ابن خلدون إلى السلطان الحفصي أبي العباس أحمد الأول قبل رحيله إلى مصر عام 1382م. ولم تظهر هذه المخطوطة للعلن إلا بعد خمسة قرون، حيث قام العالم الأزهري نصر الدين الطوريني بتحقيقها ونشرها تحت اسم “النسخة المصرية.
- النسخة الباريسية: اكتشفها الباحث الفرنسي الفرنسي إلين مارك كارتمير ( 1782 م – 1857 م )، الذي بدأ في ترجمتها ونشرها لكنه توفي قبل إكمال عمله، وظهرت هذه النسخة لاحقًا في القرن التاسع عشر.
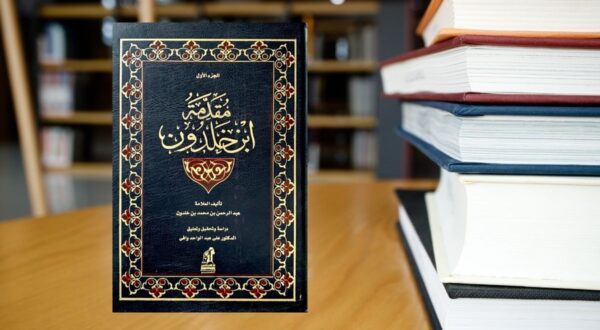
وقد قام العالم الأزهري علي عبد الواحد وافي بجمع النسخ المتوفرة وتحقيقها ونشرها في ثلاثة مجلدات عام 1957 م.
وبين الأستاذ الدكتور أحمد أبو شوك الدور الذي قام به علي عبد الواحد وافي بإعادة تصنيف “المقدمة” وفق نظام الأبواب وجعلها مقسمة إلى ستة أبواب رئيسة هي:
- طبيعة العمران البشري: تناول فيه مفهوم التاريخ وأخطاء المؤرخين السابقين.
- الفرق بين أهل البداوة والحضارة: حيث اعتبر البادية أكثر أصالة لاعتمادها على الضروريات.
- الدولة والسلطة: تناول مفهوم الملك والخلافة، والتغيرات التي تطرأ على أنظمة الحكم.
- البلدان والمدن: بحث في التغيرات التي تطرأ على المجتمعات الحضرية.
- الجانب الاقتصادي: ناقش دور الاقتصاد في تطور المجتمعات.
- العلوم والصنائع: تحدث عن نشأة العلوم وأثرها في الحضارة.
مفهوم التاريخ عند ابن خلدون والتكامل بين العلوم
من خلال دراسة “المقدمة”، نجد أن ابن خلدون حدد أهدافه في ثلاث نقاط رئيسية:
- استقراء الظواهر الاجتماعية والتاريخية لاستخلاص القوانين التي تحكمها.
- اكتشاف العوامل المؤثرة في تطور المجتمعات وتغيرها.
- التأكيد على أن دراسة التاريخ لا تقتصر على نقل الأحداث، بل يجب أن تعتمد على التحليل المنطقي للكشف عن القوانين التي تحكم الظواهر البشرية.
وعند مراجعة آراء العلماء والمفكرين حول “المقدمة”، نجد أنها استندت إلى ثلاثة مناهج رئيسة:
- المنهج الوصفي: يعتمد على وصف الظواهر دون تحليلها، كما في كتاب “الفصل في الملل والأهواء والنحل” لابن حزم.
- المنهج التحليلي: يسعى لاستنتاج المبادئ الأساسية من خلال استقراء سلوكيات البشر، كما في “تهذيب الأخلاق” لابن مسكويه.
- المنهج الاستشرافي: يهدف إلى تصور المجتمعات المثالية، كما في “آراء أهل المدينة الفاضلة” للفارابي.
أسبقية ابن خلدون على مدرسة الحوليات الفرنسية
أشار الأستاذ الدكتور أحمد أبو شوك أن لابن خلدون قدم السبق على مدارس الفكر الغربي الحديثة مثل مدرسة الحوليات الفرنسية التي لم تظهر إلا في القرن العشرين، واستشهد بما ذكره المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري، حيث أشار إلى أن ابن خلدون سبق مدرسة الحوليات الفرنسية في كثير من المجالات غير أن مؤسسيها لم يكونوا على دراية كافية بما قدمه ابن خلدون. أما عالم الاجتماع العراقي علي الوردي، فقد ركز على أهمية توطين العلوم الاجتماعية في البيئة العربية والإسلامية، مشددًا على أن العلوم الإنسانية ليست مجردة كما هو الحال في العلوم الطبيعية، بل تستند إلى معطيات خاصة تختلف بين المجتمعات. ومن هنا، فإن النظريات الغربية لا تصلح دائمًا لدراسة المجتمعات العربية والإسلامية.
المحور الثاني: التكامل المعرفي في موافقات الشاطبي
في القسم الثاني من ندوة ” أثر التكامل المعرفي سبيلًا للنهوض الحضاري” تناول الأستاذ الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي، أستاذ قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة قطر، مفهوم التكامل المعرفي من خلال دراسة نموذج كتاب”الموافقات” للإمام الشاطبي، وهو ليس مجرد كتاب في أصول الفقه، بل هو مشروع معرفي شامل يسعى إلى ربط الأحكام الشرعية بمقاصدها الاجتماعية والإنسانية.
التعريف بكتاب “الموافقات” وأهميته
استهل الأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي مداخلته والتي جاءت تحت عنوان “التكامل المعرفي من موافقات الشاطبي وأثره المعاصر”، التعريف بمفهوم “الموافقات” وناقش الأستاذ الدكتور الخادمي الأسس النظرية للإمام الشاطبي والتي وضعها في كتابه والقائمة على التكامل بين النصوص الشرعية والواقع الإنساني، بحيث لا يكون الفقه مجرد قواعد نظرية، بل يكون مترابطًا مع مقاصد الشريعة ومتفاعلًا مع حياة الناس اليومية.
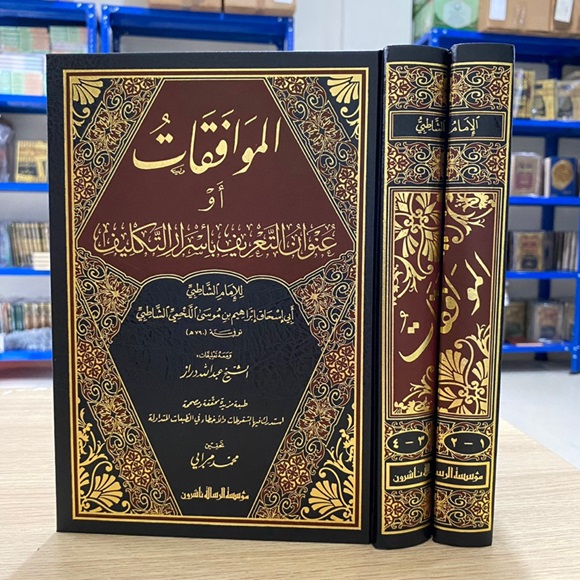
وأشار الأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي إلى أن الإمام الشاطبي في بداية الأمر أراد تسمية كتابه “التعريف بأسرار التكليف”، لكنه عدل عن ذلك بعد رؤيا منامية دفعته إلى اختيار اسم “الموافقات. وهذا العنوان يحمل دلالة عميقة، حيث يشير إلى التوافق بين إرادة الخالق سبحانه وتعالى وإرادة الإنسان المكلف، بما يحقق المصلحة العامة والخاصة.
ماهي مرتكزات التكامل المعرفي في “الموافقات” ؟
استعرض الأستاذ الدكتور الخادمي أهم مبادئ التكامل المعرفي التي اعتمد عليها الشاطبي في بناء نظريته التكاملية وأوجزها في سبعة محاور رئيسة :
- التكامل بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية: يرى الشاطبي أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الكون نظامًا متكاملًا قائمًا على السنن الإلهية، وهذا النظام ينعكس في الشريعة، التي تتوافق في جوهرها مع الفطرة الإنسانية.
- التكامل بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف: إجابة على سؤال: هل للإنسان مقاصد في أفعاله؟ أجاب الشاطبي بأن الإنسان بطبيعته يسعى إلى تحقيق مصالحه، لكن هذه المصالح يجب أن تكون مرتبطة بمقاصد الشارع، بحيث تحقق الخير في إطار ما شرعه الله تعالى.
- التكامل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: الحكم التكليفي يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. أما الحكم الوضعي يتعلق بالشروط والموانع والأسباب التي تؤثر على تطبيق الأحكام الشرعية.كمثال على هذا التكامل: الزواج، إذ له حكم تكليفي (قد يكون واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا حسب الحالة)، كما أن له حكمًا وضعيًا (يعتمد على الشروط والموانع التي تجعله صحيحًا أو غير ذلك).
- تحقيق المناط: وهو مبدأ يربط الأحكام الشرعية بالواقع العملي، مما يجعل الفقه مرتبطًا بحياة الناس اليومية، فلا يكون مجرد نصوص جامدة بعيدة عن التطبيق.
- اعتبار مآلات الأفعال: لا يُنظر إلى الفعل في ذاته فقط، بل إلى نتائجه وآثاره. فمثلًا، قد يكون الفعل مباحًا في أصله، لكنه يصبح محرمًا إذا أدى إلى مفسدة عظيمة، وفقًا لقاعدة “سد الذرائع”.
- التكامل بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات: قسم الإمام الشاطبي المصالح إلى ثلاثة مستويات: الضروريات: مثل حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل، والحاجيات وهي ما يسهل أمور الحياة، لكنه لايعد ضروريًا، والتحسينيات: الأمور التكميلية التي تضفي راحة وجمالًا على الحياة.
- التكامل بين العلم والعمل: شدد الشاطبي على أن العلم لا ينبغي أن يكون نظريًا فقط، بل يجب أن يُترجم إلى سلوك عملي يحقق مقاصد الشريعة في الواقع.
الخاتمة
أكدت ندوة “أثر التكامل المعرفي سبيلا للنهوض الحضاري” على ضرورة إعادة دراسة فكر ابن خلدون والشاطبي لفهم كيفية تحقيق التكامل بين العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، وتعزيز دور المعرفة الإسلامية في ظل التحديات المعاصرة التي تتطلب فهمًا عميقًا للنصوص الشرعية، مع إدراك دقيق لمتغيرات الواقع.

