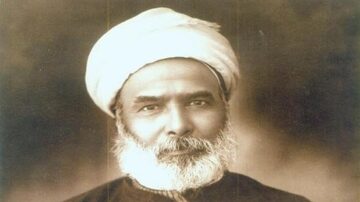يربط الإمام محمَّد عبده في تفسيره لآية العهْد والميثاق : { الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّـهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} .[البقرة: 25] بين رفض السُّنَن الإلهيَّة وتحقُّق معْنيي: الفسُوق، والفساد، حيث يتساءل، في معرض حديثه عنه، قائلا: “وأيُّ إفسادٍ أكبر من إفساد مَنْ أهمل هدايةَ العقل وهدايةَ الدِّين، وقطَع الصِّلة بين المقدِّمات والنتائج، وبين المطالب والأدلة والبراهين؟ مَنْ كان هذا شأنُه فهو فاسِدٌ في نفسِه ووجوده في الأرض مُفسِدٌ لأهلها؛ لأنَّ شرَّه يتعدَّى كالأجرب يعدي السَّليم”.
وفي السِّياق ذاته يقول الإمام : “فإذا كان معْنى الفسوق : الخروجُ عن سنن اللَّه تعالى في خلْقه التي هداهم إليها بالعقل والمشاعر، وعن هداية الدِّين بالنِّسبة إلى الذين أوتُوه خاصَّة؛ فعهد اللَّه تعالى هو ما أخذهم به بمنحهم ما يفهمون به هذه السُّننَ المعهودة للنَّاس بالنَّظر والاعتبار، والتَّجربة والاختبار. أو العقل والحواس المرشدة إليها، وهي عامَّة، والحجَّةُ بها قائمة على كلِّ من وُهِبَ نعمة العقل وبلغ سنَّ الرُّشد سليم الحواس. ونَقْضُهُ عبارة عن عدم استعمال تلك المواهب استعمالا صحيحا؛ حتَّى كأنَّهم فقدوها وخرجوا من حكمها. فالعهْد فطريٌّ خلقيٌّ، ودينيٌّ شرعيٌّ، فالمشركون نقضوا الأول، وأهل الكتاب الذين لم يقوموا بحقِّه نقضوا الأول والثاني جميعًا، وأعْني بالنَّاقضين : منْ أنكر المثل من الفريقين. واللَّه تعالى قد وثَّق العهد الفطريَّ بجعل العقول بعد الرُّشد قابلة لإدراك “السُّنَن الإلهية” في الخلق، ووثَّق العهْد الدِّينيَّ بما أيَّد به الأنبياء من الآيات البيّنات، والأحكام المحكمات. فمنْ أنكر بعثة الرُّسُل ولم يهْتد بهديهم فهو ناقِضٌ لعهد اللَّه، فاسِقٌ عن سُنَنِه في تقويم البنية البشرية وإنمائها، وإبلاغ قُواها وملكاتها حدَّ الكمال الإنسانيِّ الممكن لها”.
والواقع أنَّ هذا النصَّ مفتاحيٌّ للغاية في سياق فهم ما يعنيه الأستاذ الإمام بمفهوم “السُّنن الإلهية” من جهة، وارتباط ذلك المفهوم بمسألتين أساسيتين هما : آليةُ استنباط السُّنن الإلهية، وغائيةُ العمل بها من جهة أخرى. فمُقتضى السُّنن الإلهية يرتبط ارتباطا مباشرا بكلٍّ من : الإيمان، والنَّظر. أمَّا الإيمان؛ فيشمل إلى جانب الإقرار بالوحي والنُّبوة ما يتضمَّنه الوحيُ من الأمثال التي يضربها اللَّه للنَّاس من أجل استنباط العِبَر. وأمَّا النَّظر؛ فهو الوسيلة، أو الآلية، التي يتحقَّق بها فهْم المراد من سنن اللَّه تعالى في الخلق والأمم. وأخيرًا تتمثَّل الغاية المثلى التي يتغيَّاها المسلم من وراء ذلك كلِّه في ما عبَّر عنه الإمامُ بالقول: “تقويم البنية البشرية وإنمائِها، وإبلاغ قواها وملَكَاتِها حدَّ الكمال الإنسانيِّ الممكنِ لها”.
ولذلك؛ يلحُ القرآن الكريم أشدَّ إلحاح على ضرورة إعْمال النَّظر العقلي، والتَّفكير والتذكُّر والتَّدبُّر، فلا تقرأ منه قليلا إلّا وتراه يَعْرض عليك الأكوانَ، ويأمرك بالنَّظر فيها واستخراج أسرارِها، واستجلاء حِكَم اتفاقها واختلافها. وضمن هذا السِّياق يقول الإمام، في معرض تفسيره للفظة “الأمر” في الآية الكريمة : {وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ } الأمرُ نوعان: أمرُ تكوينٍ؛ وهو ما عليه الخلق من النِّظام والسُّنَن المحْكَمَة، وقد سمَّى اللَّه تعالى التَّكوينَ أمرًا بما عبَّر عنه بقوله: (كنْ). وأمرُ تشْريعٍ؛ وهو ما أوْحاه إلى أنبيائه وأمرَ النَّاس بالأخذ به. ومن النَّوع الأول : أمرُ التَّكوين، أو السُّنَن، ترتيبُ النَّتائج على المقدِّمات، ووصْلُ الأدلة بالمدْلولات، وإفضاءُ الأسباب إلى المسبِّبات، ومعرفةُ المنافع والمضارِّ بالغايات. فمنْ أنكر نبوة النَّبي بعدما قام الدَّليل على صدقه، أو أنكر سلطان اللَّه على عباده بعدما شهدتْ له بها آثارُه في خلْقِه، فقد قطع ما أمر اللَّه به أن يُوصل بمقتضى التَّكوين الفطري”.
ويقول الإمام محمد عبده أيضا في معرض تفسيره للآية الكريمة:{ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} [البقرة: 40] : “عَهْدُ اللَّه تعالى إليهم يُعْرَف من الكتاب الذي نزَّله إليهم، فقد عهد إليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئا، وأن يُؤمنوا برُسله متى قامت الأدلة على صدقهم، وأن يخضعوا لأحكامه وشرائعه. ويدخلُ في عموم العهْد عهْدُ اللَّه الأكبر الذي أخذه على جميع البشر بمقتضى الفطرة؛ وهو التدبُّر والتَّروي، ووزن كلِّ شيءٍ بميزان العقل والنَّظر الصحيح؛ لا بميزان الهوى والغرور. ولو التفت بنو إسرائيل إلى هذا العهْد الإلهيِّ العام، أو إلى تلك العهود الخاصَّة المنصوصة في كتابهم، لآمنوا بالنَّبي ﷺ واتّبعوا النُّور الذي أُنزل معه وكانوا من المفلحين”.
يتحصَّل مما سبق، أنَّ حديث القرآن الكريم المتكرِّر عن أخبار الأمم السَّابقة ومصائرها يؤكِّد بما لا يدع مجالا للشكِّ أنَّ سُنَن اللَّه تعالى التي أوْدعها في الكون لا تتغيِّر أو تتبدَّل. فقد “علَّمنا اللَّه تعالى هذا بما قصَّ علينا من أخبار الأمم، وأنعم على أمتنا – التي لا تختصُّ بشعبٍ ولا جنس- بهذا القرآن الكريم، فكان لهم به نِعَمٌ لا تُحْصى من الكتاب والسُّنَّة؛ منها : أنَّهم كانوا مُسْتضعفين فمكَّن لهم في الأرض وأوْرثهم أرضَ الشُّعوب القوية وديارهم وجعل لهم السُّلطان عليهم. ومنها : أنَّه جعلهم أمَّة وسطا لا تفريط عندها ولا إفراط؛ ليكونوا شهداء على النَّاس الذي غلُّوا وأفرطوا، والذين قصَّروا وفرَّطوا. ثمَّ لما كفرتْ بأنعُم اللَّه أنزل بها ألوانا من البلاء والنِّقم … ثمَّ إنَّ الفتن لا تزال تحلُّ بديارها، وتُنْقِصُهَا من أطرافها، وسوطَ عذاب اللَّه يصبُّ عليها، وقد مرت عليها قرونٌ وهي لا تعْتبر بما مضى، ولا تتربَّى بما حضر؛ بل جهلت الماضي فحارتْ في الحاضر، لا تعْرف سببه ولا المخْرج منه! أليس من العجيب أنَّ الجمهور الأعظم من المشتغلين بالعلم منها هم أجهلها بتاريخها؟ … ويعتذرون بالقضاء والقدر عن معرفة الأسباب، ويكلون إلى القضاء والقدر النَّجاة منه، أو البقاء فيه؟!”.
ويعْرض الإمام محمَّد عبده لأوجه عناية أمَّة الإسلام بعلم التَّاريخ، وصولا إلى العلَّامة ابن خلدون، ثمَّ يقول : “فالتَّاريخ هو المرشد الأكبر للأمم العزيزة اليوم إلى ما هي فيه من سعةِ العُمْران، وعِزَّة السُّلطان.
وكان القرآن هو المرشد الأول للمسلمين إلى العناية بالتَّاريخ ومعرفة سنن اللَّه في الأمم منه. وكان الاعتقاد بوجوب حفظ السُّنَّة وسيرة السَّلف هو المرشد الثاني إلى ذلك. فلما صار الدِّين يُؤخَذُ من غير الكتاب والسُّنَّة أُهْمِلَ التَّاريخ، بل صار ممقوتا عند أكثر المشتغلبن بعلم الدِّين، فإن وُجد من يلتفت إليه فإنَّما يكون مُتَّبِعًا في ذلك سُنَّة قوْمٍ آخرين”.