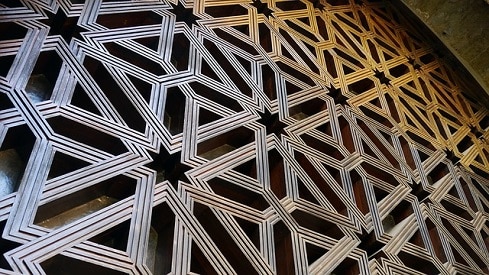لم يخفُت يوما أوار الصراع بين العلمانية والإسلام ، وما يُظن له خفوت، فالعلمانية تبغي التمدد على حساب الإسلام، وتريده أن يأرز إلى محراب المسجد لا غير في صورتها الليبرالية المتسامحة، والإسلام لا يقبل إلا التوجيه الشامل في كل مناحي الحياة.
وبعيدا عن هذا الصراع المحتدم، الذي ننتصر فيه للرؤية الإسلامية بلا مواربة، فإننا نحب أن نعالج هنا ظاهرة ، ربما لا تكون حديثة الولادة، لكنها في نظرنا من المسائل الأُنف التي لم تُعالج بعدُ.
هذه الظاهرة يمكن أن يُطلق عليها (المبالغة في التديين) في مقابل (العلمنة) وهي بهذا الإطلاق تعني بمفهوم مباشر : تمديد وزيادة مساحة التشريع.
ربما نجد في أدبياتنا معالجة لظاهرة (التنطع)، وهو الزيادة في التدين الشخصي لا التديين العام، فالتنطع، هو تزيد في التدين الشخصي.
أما (الغلو في التديين) فهو زيادة مساحة الدين على حساب مساحة الدنيا.
فالدين في هذه المقالة، يُقصد به ما يُقابل الدنيا، وقد عرف علماؤنا هذه المقابلة حينما قسموا كليات الإسلام إلى [ ( الدين) + النفس، والنسل، والعقل، والمال].
فالمفردات مهما كثرت وتنوعت على خارطة الدين، فإن الدين يعطيها واحدًا من أحكامه الخمسة ( الوجوب، والتحريم، والاستحباب، والكراهية، والجواز).
لكن تبقى وراء ذلك الخارطة الدنيوية، التي تعطيها الدنيا واحدا من أحكامها (المسموح، والممنوع، والعيب المذموم، والمجرّم، والمقبول، والمفضّل .. ونحوها). وتستمد هذه الأحكام مرجعيتها من العرف والقانون ولوائح العمل والذوقيات العامة ونحو ذلك.
ولا شك أن بعض مفردات الخريطتين تتقاطع معا، مثل تعظيم صلة الرحم، وتثمين الصدق وغيره من الأخلاق الفاضلة.
ويمكن رصد مظاهر الغلو في التدين في عدة نواح:
الأولى : الناحية الاجتماعية.
الثانية : الناحية القانونية.
الثالثة : الناحية السياسية.
تديين حب الوطن
فقضية مثل (حب الوطن) هذه قضية فطرية، بمعنى أن الإنسان ينشأ عادة محبا لوطنه، بغض النظر عن مقومات هذا الحب، فقد يكون وطنه أفقر الأوطان على مستوى الموارد، وأبعدها عن الأمن والأمان، لكنه بالرغم من ذلك يحبه.
لكن تديين هذا الحب بمحاولة حشد مجموعة من النصوص والاعتساف في استنباط دلالة منها على أن الدين يأمر بحب الوطن، هو ما يدخل في (الغلو في التدين) فإن الرسول ﷺ حينما وقف على مشارف مكة يقول : ” «إنك أحب بلاد الله إلي الله، وأحب بلاد الله إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت» هذا الكلام لا علاقة له بحب وطن النشأة والمولد ، ولكنه تمجيد لمكة على وجه الخصوص؛ لأن حبها جزء من الدين، فلا علاقة لهذا الحديث بحب الوطن.
وحسب الإنسان عادته التي تقتضيه أن يحب وطنه ومدرسته، ولا داعي هنا لإقحام المسألة في الدين، ونشدان نص من الوحي يضفي على هذا الحب مسحة من الدين، هو ما نقصده بالغلو في التدين.
تديين المصالح المرسلة
مسألة مثل قواعد السير وقوانين المرور ، هي من الأمور التي تسمى في الفقه بالسياسة الشرعية، التي يكون من حق الإمام – السلطة التشريعية في عصرنا- تنظيمها، وإلا فعل من شاء ما شاء، وغلّب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة.
ومن حق الإمام شرعا أن يسن من العقوبات الزاجرة والرادعة ما يضمن به تنفيذ هذه الإجراءات؛ فمثل هذه الأمور لا تترك للضمائر.
ويدخل في السياسة الشرعية هنا كل ما تحدده الدولة من الأمور المدنية، كتحديد سرعة السير في الطرق حسب أنواع السيارات، وتحديد مدى الارتفاع المسموح به في البناء وغير ذلك، كل هذا من صلاحيات الحكومة في الإسلام متى كانت هذه الإجراءات تحقق مصالح الناس، وتحاصر الفساد والضرار.
لكن، هل تنتقل هذه الأمور المدنية إلى أمور دينية بحتة، بحيث يأثم الإنسان إذا خالفها، ويعاقبه الله عليها في الآخرة بالنار، كما هو الشأن في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات؟ أم يُكتفى فيها بالعقوبات المدنية المقررة في الدنيا. هذا مبحث من المباحث التي لم تأخذ حقها في البحث والاجتهاد بحسب ما اطلعت عليه .
منذر قحف
وأفضل ما رأيت في ذلك، رؤية شرعية، قدمها الدكتور منذر قحف- عالم الاقتصاد الإسلامي المعروف، في بحثه الذي قدمه لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة، عن الكفالة التجارية، وتعرض في آخر بحثه لهذه المسألة.
ومفاد رؤيته التي قدمها أن من حق الحكومة أن تسن القوانين التي تحقق المصلحة، كما أن من حقها أن تسن معها العقوبات المدنية التي تضمن تنفيذها، وتعاقب المعتدي عليها، إلا أن المواطن إذا خالف شيئا من هذه القوانين فإنه لا يأثم، وحسبه ما يناله من عقوبة الدنيا، إلا إذا كان في هذه المخالفة بعد أخلاقي سيقع فيه، مثل الكذب أو الغش أو الاحتيال، فحينئذ يأثم الإنسان إذا وقع قي شيء من ذلك؛ لأنه يكون قد ارتكب أمرا محرما تحريما مباشرا.
استثناء وتردد
ويدعم هذه الرؤية بما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في حق من يقيم في بلاد الكفر، فقد جوز له الإمام أبو حنيفة التعامل مع الكفار بالعقود الفاسدة التي تحرمها شريعتنا كالربا، بشرط عدم الوقوع فيما فيه شين، كالسرقة والنصب والاحتيال، فهذا لا يجوز للمسلم ممارسته في بلاد الإسلام وبلاد الكفر على السواء.
ويستثني الدكتور منذر – أيضا- من هذه القاعدة الأمور التي عرفت لها أحكام مخصوصة منصوصة في الشريعة، فهذه الأمور لا يجوز مخالفتها وإلا وقع صاحبها في إثم شرعي.
إلا أنه لا يجزم بهذه القاعدة لاصطدامها بأمرين اثنين:
الأول: أن في هذا الأمر تشجيعا على الفوضى مما يؤدي إلى الفساد في الأرض، وهذا أمر محرم لا محالة.
الثاني: أن هذه الرؤية تتعارض مع إيماننا بأن الإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة، سواء النواحي المدنية البحتة أو الشرعية.
وقد يجاب عن التخوف الأول بأن وازع السلطان قد يكون أقوى من وازع الضمائر في استقرار البلاد ودرء الفساد، كما أُثر عن سيدنا عثمان قوله: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وها هي الدول المتقدمة تكتفي بالعقوبات المدنية دون تخويف من العقوبات الأخروية، ولم نر أن ذلك أدى إلى الفوضى أو الفساد.
كما يمكن أن يجاب عن التخوف الثاني بأن إيماننا أن ديننا يغطي جوانب الحياة كلها، لا يقتضي بالضرورة أن يجعل كل المخالفات حراما، يعاقب صاحبها بالنار، وقد رأينا فقهاءنا في مسائل كثيرة، يفرقون بين الالتزام القضائي والالتزام الديني، فيقولون: واجب قضاء لا ديانة.
شرط الواقف ونص الشارع
ومن الاجتهادات المشرقة في هذا الباب، رفض ابن القيم رفضا شديدا لمقولة : “شرط الواقف مثل نص الشارع” فقد قال:
“ثم من العجب العجاب قولُ من يقول: إن شروط الواقف كنصوص الشارع ! ونحن نبرأ إلى الله من هذا القول، ونعتذرُ مما جاء به قائله، ولا نعدلُ بنصوص الشارع غيرَها أبداً. وإنّ أحسنَ الظن بقائل هذا القول: حملُ كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالةِ، وتخصيصِ عامِّها بخاصّها، وحملِ مُطلَقِها على مُقيَّدِها، واعتبارِ مفهومها كما يُعتبر منطوقُها. وأما أن تكون كنصوصِهِ في وجوب الاتّباع وتأثيمِ من أخَلَّ بشيء منها، فلا يُظن ذلك بمن له نسبةٌ مّا إلى العلم” .[ إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (3/ 64) ]
فابن القيم هنا ينتقد من أراد أن يجعل شروط الواقف على وقفه مثل نصوص الشرع في القدسية، بحيث يأثم من خالفها كما يأثم من يخالف نصوص الشرع.
وفي الختام أجدني مضطرا للتصريح بأنني ضد العلمانية بجميع نسخها، الليبرالية منها والمتطرفة، لكن هذا ليس معناه أن الدنيا كلها دين.