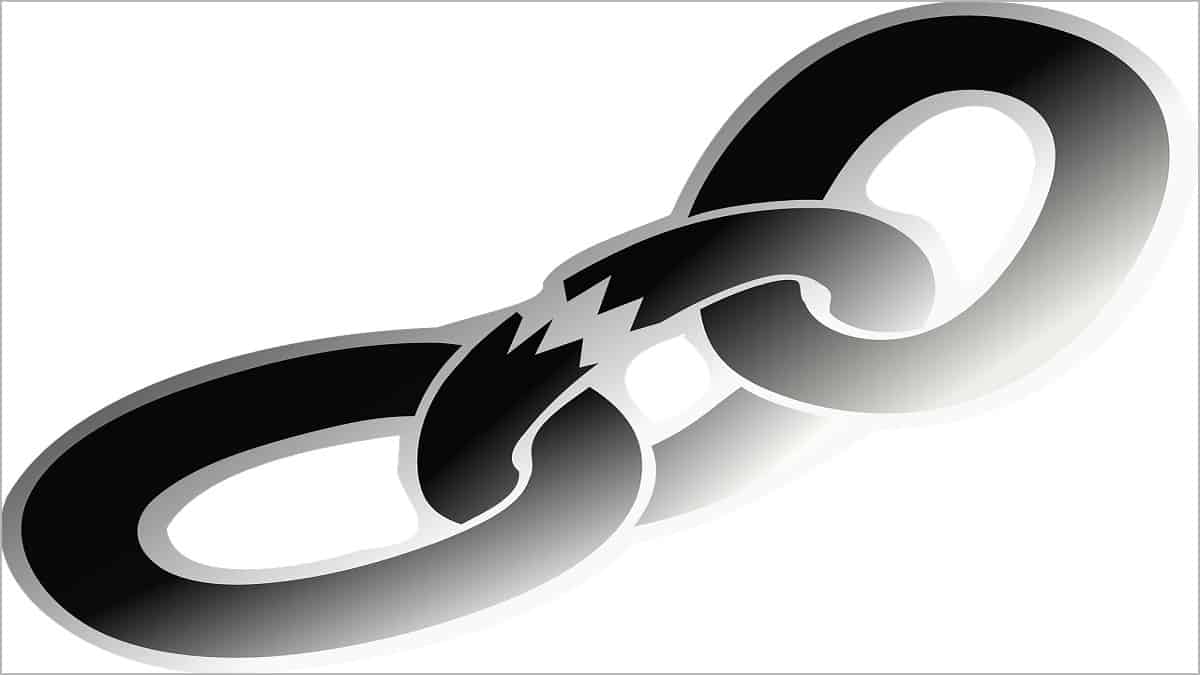الضعف الإنساني أمر واضح للعيان، مشاهَدٌ ملموس؛ وقد سجَّل القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله تعالى: {وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا} (النساء: 28).
ومع أن البعض، في انتشاءٍ بلحظةِ قوةٍ أو غِنى أو عافية، قد ينسى ذلك، بل ويسرف على نفسه في ادعاء النقيض؛ فإن حقائق الأيام وتوالي الأحداث كفيل بأن يذكِّر الناسي، ويردّ الغافل إلى هذه الحقيقة الثابتة من حقائق الوجود..
وضعف الإنسان نستطيع أن نلمس مظاهره في عجز الإنسان وقلة حيلته عن تدبير أمره، وعن القيام بكل ما تطمح إليه نفسه.. وفي احتياجه لغيره من بني جنسه، لاستيفاء حاجاته ومتطلبات ضروراته.. وفي عدم قدرته على مقاومة ما يصيبه من آفات وأمراض، إلا بِشِقِّ النّفْس؛ بل ربما حار الطب في كشف الداء، وعجز عن وصف الدواء!
إن أعتى الدول قد تقف كليلةً عن مواجهة تغير طارئ في الكون؛ من تفجر بركان، أو هبوب عاصفة، أو حدوث زلزال، أو انتشار وباء.. حتى لتقف هذه الدولة أو تلك التي يقع بها هذا الطارئ مستنجِدةً بغيرها من الدول، تطلب منهم المساعدات، وقد كانت بالأمس تتيه فخارًا عليهم بما مُكِّن لها من علم وقوة!.. وكفى بذلك دليلاً على ما يتصف به الإنسان من ضعف!
وإن تلك الوحشة التي تلمّ بالإنسان، وتبعث الحزن والأسى في نفسه، وربما من دون أن يدري لها سببًا.. وإن هذا الألم الذي يصيب المرء لفقد عزيز، أو فوات مقصود.. أو هذا العجز الفكري الذي يحول بينه وبين فك معضلات الكون والحياة.. كل هذا وغيره لمما يؤكد حقيقة اتصاف الإنسان بالضعف، وأنه- أي الضعف- ليس حالة طارئة، وإنما هو طبع أصيل فيه، ووضع ثابت له، وإنْ تغيرت درجاته ومظاهره، من شخص لآخر، ومن حالة لأخرى.
فالإنسان ليس إلهًا، ولا مالكَ أمرِ نفسِه، ولا خارق القُوى “سوبرمان”، وإن زعمت غير ذلك فلسفات نيتشه وغيره! وإنما أمره بيد خالقه سبحانه، وطاقاته محدودة، وطبيعته تقف بعيدة دون حدود الكمال!
ورغم ذلك كله، ما أحرى الإنسان- سواء على مستوى الفرد، أو المجموع- أن يذكر هذا الضعف الإنساني ولا ينساه؛ إذ له جوانبه المضيئة رغم ما يشير إليه من عجز وانعدام حيلة! فالضعف الإنساني كفيل بأن يَردَّ للإنسان صوابه متى انحرف فكره أو شردت أخلاقه؛ وهو كفيل أيضًا بأن يدفعه للتناغم مع بني جنسه، لاسيما الفقراء والضعفة منهم، وألا يستعلي على أحد بما أُوتي من حظ في القوة أو المال أو العافية؛ بل هو كفيل كذلك بأن يدفعه لاستكناه حقائق الكون واستنباط قوانينه، ليسدَّ مِن حاصل ذلك ما يشعر به من عجز، ويكمل ما ينقصه من احتياجات.. وكفى بتلك من فوائد!
أما كيف يتغلب الإنسان على ضعفه، فذلك له خطوط أساسية نشير لأهمها..
حسن الصلة بالله تعالى
فأول ما يجب على المرء ليغالب ما يلازمه من ضعف، هو أن يحسن صلته بالله تعالى، ويحرص على ألا تنقطع هذه الصلة أو تضعف؛ فإن الضعيف محتاج إلى قويّ يستند عليه ويستمدّ منه ما فاته من قوة؛ والله تعالى هو القوي العزيز الذي لا يحتاج لأحد ولا يغالبه أحد؛ فليس مثل ركن الله ورحابه مأوى للإنسان؛ يستند إليه ويستمد منه العون والقوة.
ولهذا كان “التوكل” أحد الأخلاق الأساسية التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم؛ إذ هو خلق يذكّر المرء بضعفه الذي لا يُجبَر إلا بالاستعانة بخالقه القوي سبحانه: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (المائدة: 23)، {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (التوبة: 51)، {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (الطلاق: 3). وفي السنة النبوية: “لو أنَّكُمْ تَتَوكَّلُونَ علَى اللهِ حقَّ توكُّله، لرزقَكم كما يرْزقُ الطَّيرَ؛ تغدوا خِماصًا وتَرُوحُ بِطانًا”([1]).
وعندما يَشْرَع الإنسان في الخروج من البيت مُستفتِحًا يومه بادِئًا رحلة السعي والعمل، يُسنّ له أن يردد هذا الدعاء: “بسمِ اللهِ، توكلْتُ على اللهِ، لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ”، فيقال له: “كُفِيتَ، ووُقِيتَ، وتَنَحَّى عنه الشيطانُ”([2]). فالمسلم بهذا الدعاء ينخلع من ضعفه متوكلاً على الله تعالى، لاجئًا إلى رحاب القوي العزيز.. وهل بعد ذلك خوف أو فزع أو وهن!
وكان سعيد بن جُبَيْرٍ يقول: التَّوَكُّل عَلَى اللهِ جِمَاعُ الإِيْمَانِ. وَكَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، وَحُسْنَ الظَنِّ بِكَ([3]).
حسن التعاون مع النوع الإنساني
الإنسان، مهما أوتي من قوة وحظوظ، لا يستطيع أن يستقلَّ بأمور حياته، ولا أن ينفصل عن مجتمعه المحيط به؛ ولهذا لا مفرَّ له من أن يتعاون مع بني جنسه، ويأتلف مع نوعه؛ فحينئذ تتساند القُوى وتتكامل، ويأخذ كل فرد من المجموع ويعطي له..
ولهذا فُطِر الإنسان على الأُنس بغيره، والألفة مع شبيهه.. نرى هذا في “الوحدة الصغيرة”، أي الأسرة، كما نراه في “الوحدات الكبرى”، أي في المعاهدات والتحالفات بين الدول..
يقول الفارابي تحت عنوان: (القول في احتياج الإنسان إلى الاجتماع والتعاون): “وكلُّ واحدٍ من الناس مفطور على أنه محتاج، في قوامه، وفي أن يبلغ أفضل كمالاته، إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلِّها هو وحده، بل يحتاج إلى قوم يقوم له كلُّ واحدٍ منهم بشيء مما يحتاج إليه. وكلُّ واحدٍ من كلِّ واحدٍ بهذه الحال، فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان ينال الكمال، الذي لأجله جعلت الفطرة الطبيعية، إلَّا باجتماعات جماعة كثيرة متعاونين، يقوم كلُّ واحدٍ لكلِّ واحدٍ ببعض ما يحتاج إليه في قوامه؛ فيجتمع، مما يقوم به جملة الجماعة لكلِّ واحدٍ، جميع ما يحتاج إليه في قوامه وفي أن يبلغ الكمال؛ ولهذا كثرت أشخاص الإنسان، فحصلوا في المعمورة من الأرض، فحدثت منها الاجتماعات الإنسانية”([4]).
والتعاون على البر والتقوى والفضائل قيمة إسلامية كبرى، ينمِّيها الإسلام بين أبنائه بعضهم مع بعض، وبينهم وبين الآخرين؛ فهناك قواسم مشتركة علينا أن نبحث عنها، ونزيدها متانة: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة: 2).
وإذا كان الإنسان متصفًا بالضعف اتصافًا ثابتًا، فإنه يستطيع أن يخفِّف من حدة هذا الضعف بالتعاون والتساند مع الآخرين، وليس بالانكفاء على نفسه، والتعالي على غيره.
وإن الكوارث التي تحلُّ بالإنسانية، ولا تفرِّق بين أمة وأخرى، لهي مدعاة ليحل التعاون محلَّ الشقاق، ولنرى التوافق بدل التخالف.. وإلا فإن الضعف الإنساني سيزداد، والمصائب لن تندفع، وسيشقى الضعفة والعجزة بها خاصة!
لقد استعاد النبي ﷺ أجواء “حلف الفضول” الذي شهده حين كان شابًّا، فقال: “لَقَدْ شَهِدْت فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبّ أَنّ لِي بِهِ حُمْرَ النّعَم؛ِ وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الإِسْلَامِ لَأَجَبْت”([5]).
ومدح ﷺ تعاون الأشعريين حين تنزل بهم النازلة؛ فقال: إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ؛ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ”([6]).
ولهذا، نحن محتاجون- في مواجهة الضعف الإنساني على المستوى العام- إلى تدعيم “المجتمع المدني” بما له من دور تطوعي فاعل، ومسارعة في تقديم العون والإغاثة؛ فالمجتمع المدني له دور مهم مطلوب لا غناء عنه مهما كانت المؤسسات الرسمية قوية ونافذة.. بجانب أنه يعبِّر عن حيوية المجتمع، ويستنفر قواه الحية، وطاقاته الكبيرة في فعل الخير وتدعيم الأواصر بين فئاته..
بل نحن محتاجون إلى “أحلاف فضول” نواجه بها ضعفنا الإنساني أفرادًا ومجتمعات.. وعلى مستوى الذات والآخر!
إن ذلك حق لا ريب فيه..!
([1]) رواه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب.
([2]) رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك.
([3]) سير أعلام النبلاء، الذهبي، 4/ 325.
([4]) آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، الفارابي، ص: 69، طبعة مؤسسة هنداوي.
([5]) سيرة ابن هشام، 1 /134. و”حلف الفضول” هو أحد أحلاف الجاهلية؛ والفضول جَمْع فضل. قيل في سبب تسميته أنه اجْتمع فِيهِ رجال أَسمَاؤُهُم الْفضل: ابْن الْحَارِث، وَابْن ودَاعَة، وَابْن فضَالة. وقد تحالفوا عَلَى أَن لَا يَجدوا بِمَكَّة مَظْلُوما من أَهلهَا، أَو من غَيرهَا إِلَّا قَامُوا مَعَه. وَقيل: عَلَى أَنهم يُنْفقُونَ من فضول أَمْوَالهم، فسمُّوا بذلك حلف الفضول. راجع: البدر المنير، ابن الملقن، 7/ 329.
([6]) رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري.