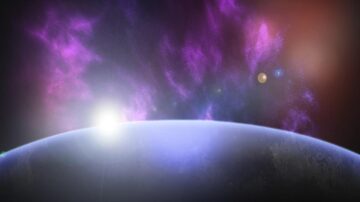الخلود من الأفكار التي سيطرت على الإنسان، منذ بدأ الخليقة، وهي أحد المداخل التي ولج منها الشيطان إلى الإنسان، ليغويه، ويغريه بالمعصية، قال تعالى:” فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ”(1) والوسوسة، هي: صوت الحلي من الذهب، وكأن حديث الشيطان مُحبب إلى النفس، ومغري بسماعه، والاقتناع بمنطقه.
وإذا كان الخلود المادي للإنسان مستحيلا، فقد عرفت الإنسانية محاولات من أشخاص للخلود، وكان التاريخ أحد تلك الأبوب، فبالبعض اختار أن يخلد ذكره بالأعمال الصالحة النافعة، واختار آخرون باب الدماء والأشلاء، وكم كان “جلال الدين الرومي” مُحقا عندما قال:” عندما نموت لا تبحثوا عن قبورنا علي الأرض، ابحثوا عنها في قلوب من أحبونا”، فالكثير من الناس يرى أن المقبرة المزخرفة، بديعة التصميم والبناء، أو القصر المنيف، سيخلد اسمه بين الناس، لكن الصادقين المبصرين بحقائق الوجود وغايته، لا يغريهم هذا التوجه، ويرون أن القلوب النقية هي مقابرهم، والمعروف الجميل هو نهجهم، وصحائف الأعمال هي المستقر لاحسانهم المُخلص، وهولاء يرفضون أن يعيشوا على هامش الخلود، فالسماء ترقب حركتهم ونياتهم، والقلوب ينقش عليها ما يفعلون.
عيش المؤمن على هامش الحياة، ليس مطلبا إسلاميا، فالهوامش تختلف عن المتون، والمؤمن يعتقد أنه مستخلف في هذه الأرض، والاستخلاف يعني القيادة، وللقيادة شروطها ومتطلباتها، والرضا بالدونية لا يرضى السماء، ولذلك تحدث القرآن الكريم في عدة مواضع عن أحسن العمل، وعن رفضه أن يتأخر المسلم أو يتوقف، قال تعالى: ” لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ”(2) ، لم تتحدث الآية الكريمة عن التوقف، لأن التوقف نوع من التأخر والتراجع، يقول “ابن القيم” في “مدارج السالكين”: “إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة، فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولابد، فالعبد سائر، لا واقف، فإما إلى فوق، وإما إلى أسفل، إما إلى أمام، وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف ألبتة”.
وذكر القرآن الكريم أحسن العمل في عدة مواضع، منها: قوله تعالى في الآية السابعة من سورة “هود” “ليَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا” التي قال فيها تفسير “المنار”: “فيُظهر أيكم أحسن إتقانا لما يعمله، ونفعا له وللناس به، وذلك أنه سخر لكم كل شيء، وجعلكم مستعدين لإبراز ما أودعه فيه من المنافع والفوائد المادية والمعنوية، ومن حكم خالقه ورحمته بعباده فيه، ومستعدين للإفساد والضرر به”، وفي الآية الثلاثين من سورة “الكهف”:” إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا “، وفي الآية الثانية من سورة “الملك”: “لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا”، وقد تنوعت آراء العلماء في تفسير أحسن العمل، فقيل: “أحسن عقلا، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله” وقيل: “أخلصه وأصوبه”، وقيل: “أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها”، ويلاحظ أن الآيات الكريمات تحدثت عن إحسان العمل وليس عن كثرته، لأن الإحسان في العمل هو ابتلاء الإنسان مع الخير والشر.
في كتابه “الجانب العاطفي في الإسلام” يقول الشيخ محمد الغزالي:”إن إجادة الأعمال كلها غاية من وجود الإنسان على ظهر هذه الأرض!”، ولذلك جاء في الحديث الذي رواه “البيهقي”: ” إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه”، ذكرت بعض كتب السيرة النبوية، أن الحديث قاله النبي-ﷺ- بعدما دفن ابنه “إبراهيم” ورأى حجرا بجانب القبر، فسواه بالأرض بيديه الشريفة، إذ لم تغب فكرة إحسان العمل عنه –ﷺ- حتى في ذلك المصاب الكبير.
ومن هنا كان الاتقان والاحسان مطلبا إسلاميا، ومداعاة للخلود للفرد والأمة، ولذلك كان العلماء، يرون أن العلم غير كاف إذا لم يتحرك إلى سلوك فاعل في الحياة، لأن المطلوب مع العلم حسن العمل، في كتابه “صيد الخاطر” يقول “ابن الجوزي“: “رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب، إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل، وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها، وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه، لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمِه هديَه وسمتَه، فافهم هذا.
واقترب الشيخ “فريد الأنصاري” في كتابه ” جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح” من ذلك المعنى أكثر، في قوله:” ولن يكون التدين – من حيث هو حركة النفس و المجتمع- جميلاً إلا إذا جَمُلَ باطنه وظاهره على السواء، إذ لا انفصام ولا قطيعة فى الإسلام بين شكل و مضمون، بل هما معاً يتكاملان، و إنما الجمالية الدينية فى الحقيقة هى: “الإيمان” الذى يسكن نوره القلب، ويغمره كما يغمر الماء العذب الكأس البلورية، حتى إذا وصل إلى درجة الامتلاء فاض على الجوراح بالنور، فتجمل الأفعال والتصرفات التى هى فعل “الإسلام”، ثم تترقى هذه فى مراتب التجمل، حتى إذا وصلت درجة من الحُسن – بحيث صار معها القلب شفافاً، يُشاهد منازل الشوق و المحبة فى سيره إلى الله- كان ذلك هو “الإحسان”، والإحسان هو عنوان الجمال فى الدين”.
ولذا فالنفس الصافية، لابد أن تحسن العمل، يقول “المنفلوطي” في كتابه “النظرات”: “لا أستطيع أن أتصور أن الإنسان إنسان حتى أراه محسناً؛ لأني لا أعتمد فصلاً صحيحاً بين الإنسان والحيوان إلا الإحسان”، وكما يقول “عبد الله بن المقفع” في كتابه “كليلة ودمنة”: ” والكريم تنسيه الخلة الواحدة من الإحسان، الخلال الكثيرة من الإساءة”، وتلك هي القلوب التي دعا “جلال الدين الرومي” بالبحث عنها والخلود فيها.
وكأمثلة عن الإنسان والخلود ، نجد أن التاريخ احتفظ بكثير من هؤلاء الأشخاص الذين حفروا خلودهم بإحسان العمل، فمثلا والد الصوفي الكبير “أبو حامد الغزالي” كان عابدا متصوفا محبا للعلم، لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان يرعى فقراء الصوفية وطالبي العلم وينفق عليهم، وكان يتضرع أن يرزقه الله بابن فقيه واعظ، فكتب الخلود له ولابنه “أبو حامد الغزالي”، يقول الشيخ محمد الغزالي: “إن الإحسان لا يضيع غرسه، ولن تتخلى العناية الإلهية عن أصحابه، مهما كبت بهم الحظوظ، وتعثرت بهم فى المراحل الأولى”، تكاد تلك المقولة أن تكون قانونا اجتماعيا، يقول الفقيه القانوني الكبير “عبد الرزاق السنهوي” في مذكراته، : “ليس من النادر أن ترى من غُرِسَت في قلبه عاطفة الإحسان، ولكن من النادر أن ترى من يحسن ويعرف كيف يحسن”.
أما الشيخ “علي الطنطاوي” فيلمس حقيقة نفسية في إحسان العمل بقوله: “وليست قيمة الإحسان بكثرة المال؛ إن المال ينفع الفقيرَ، ولكنه لاينزع من قلبه النقمة على الحياة ولا يَسْتَلُّ منها بغض الأغنياء، ولا يملؤها بالحب، إن الذي يفعل هذا كلَّه هو العطف، وأن تُشعر الفقير بأنه مثلك، وأن تعيد إليه كرامته وعزة نفسه، ورُبّ تحية صادقة تلقيها على سائل، أحب إليه من درهم، ودرهم تعطيه فقيرا، وأنت تصافحه، يكون آثَرَ عنده من دينار تدفعه إليه متكبرا مترفعاً، يدك تمتد إليه بالمال، ووجهك يجرّعه كأسَ الإذلال.
(1) سورة طه: الآية 120
(2) سورة المدثر: الآية 37