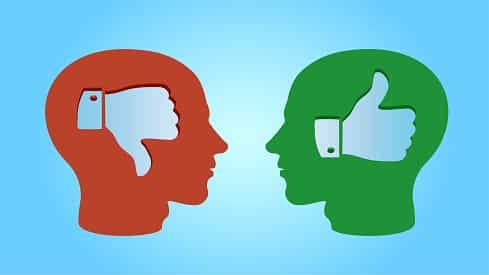هل نحتاج أن نخرج من قفص الأيديولوجيا؟ وهل يجب معرفة السمات الفارقة بين التحيز المعرفي والتحيز الأيديولوجي؟إن طرح مقولة “التحيز المعرفي” في مجال حوار الحضارات بالخصوص وفي المجالات الثقافية والعلمية بعموم هو طرح معرفي مضاد لمقولة “المركزية الثقافية” غير المعرفية التي كرستها الحداثة الغربية في أزمنتها الحديثة من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين وخاصة في مفاهيمها الرئيسية، مثل: مفهوم التقدم وخطيته، والعلمنة والفردية؛ وهو ما مثل حجزا -بدرجة كبيرة- على أي إمكانية للإبداع خارج نسقها، وصار الاتباع لها قانونا ملزما، بقصد أو بلا قصد، حتى جاءت معظم أطروحات النهضة والحداثة العربية، وربما غير العربية، هامشا على متنها في معظم الوقت، ومن المؤكد أن الهامش لا يقوى أن يكون فعلا وتأثيرا خاصة وإذا كان في خلفية مغايرة ومختلفة.
قيمتان مهمتان
ربما يصح أن كل نظرية فكرية أو فلسفية تتبيأ ببيئتها الجديدة التي تنتقل إليها، أي تأخذ طبيعة بيئتها المكانية والزمانية الموجودة فيها أو المنتقلة إليها، ولكن ما يقصده وينحو إليه مفهوم التحيز المعرفي الذي صكه وسبق إليه المفكر الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري، ليس هو توافق الفكرة الجديدة مع ما انتقلت إليه أو استوردت له أو تحوراتها في أثناء نمائها فيه، كما سعى ويسعى كثير من أصحاب الأيديولوجيات والفكريات المختلفة لتحقيقه في واقعنا العربي؛ فقد سمعنا عن اشتراكية عربية، وليبرالية عربية، وإسلام ليبرالي، وتأويلي وما شابه من علم اجتماع عربي ونظرية نقدية عربية وما شابه، ولكن قصد إلى ما هو فوق ذلك أن نبدأ أفقيا من الإبداع الذاتي ورأسيا من القراءة غير المستلبة؛ وهو ما يحقق قدرتنا على إدراك قيمتين مهمتين:
أولهما: متعلق بالهوية.. نحن في اختلافنا عنهم، والذات في اختلافها عن الأغيار، وكون ذلك أصلا معرفيا وإدراكيا مبدئيا يمنعنا من الانبهار والاستلاب تجاه الآخرين، كما يمنحنا حسن تقديرنا لأنفسنا ولهم.
وثانيهما: قدرتنا على الفعل والإبداع الخاص، غير المنقطع مع ما توصل إليه الآخرون، ولكن في نفس الوقت متصل بكينونتنا الخاصة وصيرورتنا الممكنة والمأمولة.
ولكن وكما أن الموضوعية الصماء التي تعمم نماذجها الإدراكية عبر حدود الجغرافيا والتاريخ عنوة خطأ علمي فادح يصلح في هيمنة السياسة ويؤدي إليها، فإن التحيز المغلق أيديولوجيا وثقافيا مركزية مضادة تنكر المشترك الإنساني المتصل والذي لا شك أن مساحته أكبر من مساحة الحدود والفواصل، كما أن التحيز الأيديولوجي والثقافي هو تحيز استعلائي يعتمد آلية الإقصاء القبلي وفق تصوراته عن الجواهر الثابتة للشعوب والثقافات الأخرى، أو تعميم الصور النمطية السلبية لها ولثقافتها. لذا نرى أنه من المهم التفريق مبدئيا بين التحيز المعرفي والتحيز الأيديولوجي.
بين التحيز المعرفي والأيديولوجي
رغم أن التحيز -عند قراءته لأول وهلة- يبدو ضد الموضوعية وبالتالي يبدو كقذيفة من قذائف السجال الأيديولوجي بين الوافد والموروث، فإنه وكما أثبتت تطورات البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، أول الموضوعية هو الاعتراف بالذاتية وبالخصوصية؛ فالموضوعية الصماء وإنكار الخصوصية والتحيز هي أول نقيصة لدعوة الموضوعية العلمية.
إن تاريخ الفكر العالمي يكشف عن أن شرط الإبداع هو المراجعة ومراعاة الخصوصية، بل أول العالمية هو الانطلاق من الخصوصية ومن هنا نفهم بروز الأدب اللاتيني والإفريقي، ولكن بأدوات معرفية ومنهجية تدرك المختلف والمؤتلف بين الثقافات والأفكار، دون استلاب تجاه الآخرين وتقديس لهم، أي تبعية لمركزيتهم الغالبة أو تقديس للذات وإنشاء مركزية مضادة ترفض كل الآخرين.
فلولا قطيعة “أرسطو” مع أستاذه “أفلاطون” ما نشأ ما نسميه في تاريخ الفلسفة العلم اليوناني أو المعجزة اليونانية، ولولا انقسام “الهيجلييين” يمينا ويسارا بعد “هيجل” ما نشأت الماركسية والفيورباخية من جهة والوجودية بأشكالها المختلفة من جهة أخرى.
مما يكشف أن الموضوعية ليست مقولة نهائية وليست شرط صحة ممتدا فوق حدود الجغرافيا والتاريخ، تلك المراجعات التي تتم على مختلف الأنساق الأيديولوجية الكبرى، بل إن كثيرا من مؤسسي هذه الأنساق وروادها لم يكونوا أيديولوجيين مغلقين بل أعلنوا أنهم ضد أدلجة أفكارهم، بل لعلهم كانوا واعين أن مقولاتهم الفلسفية لم تخل من تحيزات اللحظة والبيئة.
فـ”ماركس” كان يقول “أنا لست ماركسيا” كما كان حديثه واعترافه بضعف معرفته بالإسلام وبلاد الشرق الأوسط دليلا آخر على ذلك، أو حديثه الخاص عن نمط الإنتاج “الآسيوي”، مع تقديرنا أن مقولاته في عمومها أو في خصوصها ليست ملزمة.
وكان “فوكو” يقول “أنا لست بنيويا”، بل إن مختلف العلوم والأيديولوجيات شهدت وتشهد مراجعات للنموذج الإدراكي أو المعرفي الحاكم نحو مزيد من الاجتهاد لرؤى تتجاوز الحداثة بل وتتجاوز مدرسة “ما بعد الحداثة” ذاتها، ولا تتقيد بفكرتها النسبية ومنحاها التقويضي العدمي.
إن الاجتهاد يعني ببساطة حرية العقل، وأن كل ما هو إنساني له بُعد ثقافي وحضاري، وتعبير عن نموذج حاكم ليس من المفيد نفي مسلماته والتعمية عليها بل الأهم كشفها ومناقشتها وتقويم الإسهام العلمي والفكري بناء على اتساقه معها.
ولكن نرى أنه من الضروري التفريق بين التحيز المعرفي والتحيز الأيديولوجي؛ فالتحيز المعرفي ينتمي ابتداء للمجال الثقافي الاجتماعي ولنظرية الثقافة، حيث تحضر الخصوصيات الاجتماعية والتاريخية كامنا لا يمكن تجاوزه وبارزا لا يمكن تجاهله، ومشكلا رئيسيا ومائزا بين الأنساق المعرفية والثقافية المختلفة؛ فهو في هذا ينتمي لإرادة المعرفة فعلا وممارسة وليس لإرادة الأيديولوجية.
كما أن التحيز المعرفي “إنسانوي” في صفته حيث يسعى لتأكيد البعد الإنساني -بعيدا عن دعوى المركزية- بتأكيد بعده الثقافي والحضاري الخاص في الآن نفسه، ولكنه تأكيد يتفارق عن سمات التحيز الأيديولوجي في عدد من النقاط يمكننا أن نوجزها فيما يلي:
1- أن التحيز المعرفي هنا ينتمي لنسقه المعرفي “الثقافي والحضاري الخاص”، كما يستخدم أدوات معرفية في التحليل والطرح والبناء الذاتي فكريا وعلميا. والعلمي التي لا تنطلق من إجابات جاهزة وإرادة إيديولوجية مصمتة يوجهها عقل أداتي يجيد السرد والإسناد والوصف ولا يجيد الاكتشاف والابتكار والتجاوز.
2- التحيز الأيديولوجي تحيز استعلائي وتقديسي يدعي دوما الاكتفاء النظري وامتلاك الحقيقة المطلقة، أما التحيز المعرفي فهو تحيز الذات المتسائلة التي تناقش قناعاتها بصفة دائمة ولا تركن إلا لما يستطيع الإجابة الدائمة عن الأسئلة المطروحة والتساؤلات المستجدة. لذا نرى أن التحيز المعرفي هو مجال للتساؤلات بينما يأتي التحيز الأيديولوجي تجسيد لدعوة الاكتفاء النظري ومجال الإجابات.
3-يتميز التحيز الأيديولوجي بالطابع السجالي والنهج المؤامراتي في التفكير؛ فعينه دائما على الآخر عدوا ومتآمرا شريرا، بينما يأتي التحيز المعرفي عينا على الذات، وعينا على الآخر في الآن نفسه، وفق أدوات معرفية تساءل الإجابات الجاهزة هنا وهناك وتسعى لإجابات أكثر علمية وأكثر قبولا وغير مركزية ولا استعلائية ولكن معرفية.
فالتحيز المعرفي رؤية معرفية وليس رؤية أيديولوجية، دعوة للاجتهاد والإبداع وليس دعوة للانتصار الثقافي أو الأيديولوجي وفق آليات العقل الأداتي والوظيفي في الاستلاب نحو الآخرين والاكتفاء بتوصيف المخلصين لوصايا أنبيائهم أو عداء الكافرين بهم.
4-التحيز الأيديولوجي تحيز للمركزية والتحيز المعرفي تحيز للإنسانية؛ فالأول ينفي المركزية بشكل كبير لإثبات مركزية مضادة ثقافية أو جغرافية، بأدوات الانتصار الأيديولوجي المعهودة السلب والإضافة، بمعنى التركيز على جوانب السلب في الآخرين وفي صيغة تعميمية غالبا، وتصور الذات المخلص الأخير.
ومن هنا يمكننا أن نفهم تصور “زكي الأرسوزي” عن “الرحمانية” و”الرسالة الخالدة للأمة الخالدة” كحالة تتحقق بتحقق الوحدة العربية، أو حديث “أنطوان سعادة” عن “المدرحية” كوعد بحضارة مكتملة الجوانب الروحية والمادية عند تحقق الوحدة، ورغم أن التصورين غلب عليهما الاكتفاء النظري والمزايدة والمحاكاة على تجارب الفتوحات العربية والصعود العربي والعنصر العربي النقي وكان للتجربة الجاهلية بالخصوص عند “الأرسوزي” و”عفلق” مؤسسي البعث شأن خاص لكون العرب فيه كانوا أمة نقية لا تشوبها شوائب الآخرين؛ فالأدوات كانت في غالبيتها أدوات شعارية وعاطفية، وليست أدوات معرفية قادرة على الرسوخ العقلي والمستقبلي في الآن نفسه، وإن نجحت في كسب كثير من اللحظات وربما الأزمات التي لم يمكن إقامة الحلم أو الهدف عليها.
إن البعض تحيز أيديولوجيا ورأوا فيما صنعته القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر صوابا، بل إستراتيجية، وصفها أحد المعلقين السياسيين يوما أنها الإستراتيجية الوحيدة في الحركات الإسلامية المعاصرة؛ لأنها اختارت ضرب العدو “الغرب” داخل أرضه وليس على أرضنا! بل إن البعض يرى أن إقامة نظرية نقدية أو اجتماعية عربية يعني الاكتفاء بمصادر عربية قديمة فقط، هذا تحيز أيديولوجي؛ فالقضية ليست تفاصيل ولا إسنادات ولكنها في المقام الأول –ووفق مفهوم التحيز المعرفي– رؤية حضارية وصراع حضاري وليس صراع حضارات.
بين الحداثة وما بعدها
يكاد مفهوم “التحيز المعرفي” يرتبط أكثر بالمنطقة الوسيطة بين الحداثة الغربية وما بعدها؛ فهي تطوير مواز لاتجاهات نقدها وتجاوزها في الغرب، هذا النقد الذي بدأ كشف حسابه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على كل المستويات، والتي تعد مدرسة ما بعد الحداثة التي بدأت في مجال العمارة والفنون ثم امتدت لمجالات الأدب والفكر بعد ذلك، أعلى موجات هذا النقد راديكالية، حيث تم رفض المعنى الذي حملته هذه الحداثة وما زالت تتزيا بزينته -في العراق وفلسطين وجوانتانامو– فكانت يوتوبيا المعنى الذي انقلب جحيما، فكان الهروب من المعنى نحو العدم.
ولكن كما ادعت الحداثة والعلمانية بمختلف أشكالها ومدارسها الاكتمال ونهاية التاريخ والطريق إلى “السوبرمان” أكثر من مرة، كانت هناك مدرسة الحداثة العليا عند “هابرماس” و”جادامر” وغيرهم من رواد مدرسة فرانكفورت الذين سعوا لأنسنة المعنى بدلا من رفضه، وإن من رؤية ماركسية.
كما نشأت اتجاهات عديدة من مرجعيات دينية وروحية وإنسانية وليبرالية ترفض تيار العلمنة السائد وتبحث عن الفضيلة والأخلاق وتستعيد الدين القديم أو تبحث عن دين جديد.. تبحث عن معنى مختلف أكثر إنسانية وصدقية ولا ترفض “المعنى بكليته”.
من هنا بينما يظل التحيز الأيديولوجي أسير الحداثة الغربية –وإن كان سجالا ضدها– في تقديس مركزيتها ومعناها الأحادي والكوني، يأتي التحيز المعرفي متجاوزا لها وباحثا عن حداثة عليا وإنسانية غير خاضعة لهيمنة المركزيات ولا سطوة النسبيات، مؤمنة بالحقيقة الإنسانية في بعدها الثقافي والحضاري والرباني ومؤنسنا للحوار الحضاري والثقافي بعيدا عن الاستلاب للغرب أو العداء المؤبد ضده، ومستوعبا في الآن نفسه لموجات نقده، أو كشف حساب حداثته، وكذلك حداثتنا التي رهنت نفسها له ولحداثته.
وظننا أن مفهوم التحيز المعرفي الذي صكه صاحبه في أواسط التسعينيات ودعا له، كان من الممكن أن يوفر الكثير من الجهد على رواد الحداثة العربية الذي ظلوا مشدودين على التوتر الوجودي وكان رجوعهم وعودتهم المعرفية لذواتهم تحررا من أسر الغرب؛ فهذا المفهوم يفسر لنا لماذا كتب رفاعة الطهطاوي كتابه الأول “تلخيص الإبريز في تلخيص باريس”، ثم كتب كتابه الأخير “نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز” في سيرة النبي محمد ﷺ، وبينما كان أول كتب زكي نجيب محمود “خرافة الميتافيزيقا” أو “موقف من الميتافيزيقا” كما سماه فيما بعد، كان آخر ما كتبه “رؤية إسلامية” الذي أكد فيه تحوله الذي بدأه على خجل في كتابه “عربي بين ثقافتين” وغيره منذ أواسط السبعينيات.
وكذلك بدأ “عبد الرحمن بدوي” بكتابه “نيتشه” وأنهى حياته بكتبه في دفاعه عن القرآن والنبي محمد والسنة ضد مطاعن المستشرقين الذين طالما أثنى على جهودهم ووافقهم عليها. إن التحيز المعرفي كمفهوم تحليلي يمكنه أن يساعدنا على إنجاز الكثير وفهم الكثير كذلك.