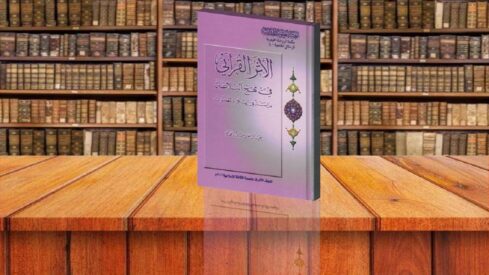لا نسعى من خلال هذه المقالة إلى حسم الخلاف التاريخي حول مؤلف كتاب “نهج البلاغة” هل هو علي بن أبي طالب أم الشريف الرضي؟ ولا إلى ثارة القضايا العقدية التي دفعت بعض العلماء والأدباء والمؤرخين إلى القول باستحالة أن يكون هذا الكتاب من تأليف علي بن أبي طالب، وإنما نسعى إلى الكشف عن جوانب من الأثر القرآني في كتاب “نهج البلاغة” الذي رُوِي أن الخليل بن أحمد قال إنه “أعظم كتاب أدبي وديني وأخلاقي واجتماعي بعد القرآن والحديث النبوي الشريف”، وسيكون عمدتنا في ذلك كتاب “الأثر القرآني في نهج البلاغة: دراسة في الشكل والمضمون” الذي قسمه مؤلفه عباس علي حسين فحام إلى بابين، ركز في الأول على الأثر القرآني في “نهج البلاغة” من ناحية الشكل، وفي الثاني على الأثر القرآني في “نهج البلاغة” من ناحية المضمون.
الأثر القرآني من ناحية الشكل
في الباب الأول تتبع عباس فحام الأثر القرآني في كتاب نهج البلاغة من ناحية الشكل من خلال: الألفاظ والبناء الجملي، والأداء البياني، وجرس الألفاظ، وسنحاول فيما يلي أن نشير إلى شيء من ذلك.
أولاً، الألفاظ والبناء الجملي: تحت هذا العنوان قام عباس فحام بتتبع أثر المفردة القرآنية في “نهج البلاغة” من خلال: الاختيار والاقتباس والنقل، فأثبت أن صاحب كتاب نهج البلاغة اقتفى “الأسلوب القرآني في اختيار اللفظة الأقدر على الإحاطة بالمعنى والأكثر انطباقاً عليه”، وكان يلجأ إلى اقتباس الألفاظ القرآنية والاستعمال القرآني للألفاظ، كما كان أحياناً ينقل اللفظة من محيطها القرآني لتوظيفها في سياق جديد ومن ذلك نقله لفظة (الفقر) من قوله تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} (البقرة – 268) ليقول: “ولا تُدخِلنَّ في مشاورتك بخيلاً يَعدِلُ بك عن الفضل ويَعِدُك الفقر”.
وتوقف عباس فحام مع تأثير الجملة القرآنية الواضح في بناء جملة صاحب “نهج البلاغة” وحصره في شكلين، يتمثل الأول في إعادة صياغة الجملة القرآنية ومثاله: “والله سبحانه وتعالى قد امتنَّ على جماعة هذه الأمة فيما عَقَدَ بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها ويأوون إلى كنفها”، وهذا الكلام إعادة صياغة للجملة القرآنية الواردة في قوله تعالى: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ}، أما الشكل الثاني فيتمثل في بناء الجمل القصيرة والطويلة ومن الأمثلة عليه قول صاحب “نهج البلاغة”: “أيها الناس لا يجرمنكم شقاقي ولا يستهويَنكم عصياني”، وهذا القول أخذه من قول الله تعالى: {وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ}.
ثانياً، الأداء البياني: وتوقف عباس فحام مع الأثر القرآني في كتاب “نهج البلاغة” من خلال التطرق إلى الأداء البياني الذي يتضمن: الاستعمال المجازي، والبعد التشبيهي، والتركيب الاستعاري، فكشف لنا أن صاحب “نهج البلاغة” استعمل أساليب المجاز بشكل واسع وكان استعماله لتلك الأساليب صدى للمجاز القرآني الذي كانت آثاره بادية، فأخذ قوله: “والزموا السوادَ الأعظم فإن يد الله على الجماعة” من قول الله تعالى: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}.
وحين ننظر في البعد التشبيهي في “نهج البلاغة” سنلاحظ تأثير التشبيه القرآني فيه من خلال عدة ظواهر، أولها التشبيه التمثيلي الذي كان أغلب استعمالات التشبيه في “نهج البلاغة” الذي يبدو أن صاحبه أخذ قوله: “وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم، وقد أوذنتم منها بالارتحال وأُمِرتم فيها بالزاد” من قوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}.
وكان تأثر صاحب “نهج البلاغة” في استعاراته بتعبيرات القرآن الكريم بادياً، فقد كان يضع “الأصل القرآني نصب عينيه، ثم يعمل على توليد فروع كثيرة من الصور عليه”، ولعله أخذ قوله: “فانظر إلى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر واختلاف هذا الليل” من قوله تعالى: {إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ}.
ويمكن أن نلاحظ آثار الكنايات القرآنية في “نهج البلاغة”، الذي كان صاحبه “يقتبس بعضها وينقل بعضها الآخر إلى توظيف جديد”، من خلال قوله: “ووضعت في قرار مكين إلى قدر معلوم وأجل مسقوم” الذي لا شك أنه أخذ من قول الله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ}.
ثالثاً، جرس الألفاظ: وتوقف عباس فحام مع جرس الألفاظ وآلياته وظواهره الفنية (السجع والتكرار والجناس)، فأثبت أن كلام صاحب “نهج البلاغة” اشتمل على “موسيقى سجعية كثيفة أخاذة سلك بها سبيل القرآن في سهولته وعدم قهر المعاني فيه”، ومن الأمثلة على ذلك قوله: “الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مخلوٍّ من نعمته، ولا مأيوس من مغفرته، ولا مستكَنفٍ عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة، ولا تُفقَد له نعمة”.
ولأن التكرار أو التكرير من الأساليب المعروفة عند العرب ومن محاسن الفصاحة وظاهرة بينة في القرآن الكريم الذي نزل بلسان العرب، فقد استخدم صاحب “نهج البلاغة” عدة أنوع من التكرار، فمن أمثلته على تكرار الحرف (اللام مثلاً) قوله: “حق وباطل لكل أهل، فلئن أمر الباطل لقديماً فعل، لئن قلَّ الحق لربما ولعلَّ ولقلَّما أدبرَ شيء فأقبل”، ومن أمثلته على تكرار اللفظة قوله: “انتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله، فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية”، ومن تكرار الأفعال قوله: “وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم” (ص241).
ولا جدال في أن الجناس أسلوب أصيل من أساليب اللغة العربية، “وهو في القرآن عامل ثراء موسيقي باعثه المعنى وعائديته على اللفظ والمعنى معاً”، ولهذا فقد جاءت كل ضروب الجناس القرآني في “نهج البلاغة” حسب عباس فحام، فمن الجناس التام قوله: “فالبصير منها شاخص والأعمى إليها شاخص، والبصير منها متزود والأعمى لها متزود”، ومن الجناس الناقص قوله: “وألجئ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك” فبين (إلى) و(إلهك) جناس ناقص، ومن جناس التصحيف قوله: “فإن الدنيا رَنقٌ مشربها رَدِعٌ مشرعُها، يونقُ منظرها ويوبق مخبرها”، ومن جناس التحريف قوله “فإن التقوى في اليوم الحِرْزُ والجُنة وفي غدٍ الطريق إلى الجَنة”.
الأثر القرآني من ناحية المضمون
أما الباب الثاني من الكتاب فقد خصصه عباس فحام للحديث عن الأثر القرآني في “نهج البلاغة” من ناحية المضمون، فتحدث عن مجالات الأثر القرآني في نهج البلاغة، وعن الشاهد القرآني وأساليبه ووظائفه، ونستعرض ذلك على النحو التالي.
أولاً، مجالات الأثر: ذكر عباس فحام في أكثر من سياق أن كلام صاحب “نهج البلاغة” كان صدى للمضمون القرآني، وبالتالي فإن مجالات الأثر القرآني في “النهج” متعددة وغير خافية، وأولها تعظيم الله وتنزيهه وإثبات وحدانيته وبيان صفاته، ومن ذلك قوله: “ما وحده من كيَّفه ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنى من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه”.
أما المجال الثاني فهو عالم الموت والحياة الذي ينطلق صاحب “نهج البلاغة” في نظرته إليه “من الحقيقة القرآنية القائمة على مفهوم الاستخلاف والتخويل”، يقول مخاطباً من يذمّ الدنيا: “أيها الذَّام للدنيا المغتر بغرورها، المنخدع بأباطيلها أتغتر بالدنيا ثم تذمها، أنت المُتجرّم عليها أم هي المتجرّمة عليك (…). إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها”.
ويتحدث صاحب “نهج البلاغة عن خلق الإنسان فيقول: “أهذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشُغُف الأستار نطفة دِهاقاً وعلقة مَحاقاً وجنيناً وراضعاً ووليداً ويافعاً، ثم منحه قلباً حافظاً ولساناً لافظاً وبصراً لاحظاً ليفهم معنى معتبراً ويقصِّر مزدجراً، حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نَفَر مستكبراً وخبط سادراً ماتحاً في غرب هواه كادحاً سعياً لدنياه في لذَّات طربه وبدوات أربه”، والظاهر أن هذه المعاني العظيمة مأخوذة من قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ}، وآيات قرآنية أخرى تتحدث عن مراحل تخلق الإنسان.
أما فيما يتعلق بمعاني خلق الكون، فنجد صاحب “نهج البلاغة” يقول: “كبس الأرضَ على مور أمواج مستفحلة ولُجج بحار زاخرة تلتطم أواذيُّ أمواجها (…)، وسكنت الأرض مدحوَّة في لُجَّة تياره”، ولعله أخذ هذه المعاني من قوله الله تعالى: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا}، ويحدثنا صاحب “نهج البلاغة” عن خلق الأرض فيقول: “ثم لم يدَعْ جُرُزَ الأرض التي تَقصُر مياه العيون عن روابيها، ولا تجد جداول الأنهار ذريعة إلى بلوغها، حتى أنشأ لها ناشية سحابٍ تُحيي مَواتَها وتستخرج نباتها”، وهذا الأسلوب القرآني البديع مأخوذ من قوله تعالى: {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا}، وقوله: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ}.
وإذا كانت الآيات القرآنية حافلة بالحديث عن الجهاد والمجاهدين، فإن كتاب نهج البلاغة قد تضمن الكثير من التعبيرات التي تحيل إلى تلك الآيات القرآنية، ولعل صاحبه أخذ قوله: “والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم” من قوله تعالى: {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}.
ويبدو أن موضوع التقوى كان حاضراً بل أخذ الحيز الأكبر في كتابه “نهج البلاغة” حيث نجد صاحبه يقتبس قوله: “إن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يُشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سُكِنت وأكلوا بأفضل ما أُكِلَتْ” من قول الله تعالى: {وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ}.
ثانياً، الشاهد القرآني: ورغم أننا نعتقد أنه أصبح من الواضح الآن للقارئ أن “انسياب التأثير القرآني إلى نهج البلاغة أخذ أبعاداً”، إلا أننا سنلقي نظرة سريعة على طريقة استعمال صاحب “نهج البلاغة” للشاهد القرآني وتوظيفه له، لنكتشف أبعاداً أخرى للتأثير القرآني الواضح في كتاب نهج البلاغة.
إن الناظر في كتاب نهج البلاغة يدرك تعدد استعمالات صاحبه للشاهد القرآني، فتارة نجده يصرح بنسبة الشاهد القرآني (لفظ الجلالة) مثل قوله: “وإياك المنَّ على رعيتك بإحسانك (…)، فإن المن يُبطل الإحسان والتزيُّدَ يذهب بنور الحق، والخُلْفَ يوجب المقتَ عند الله والناس، قال تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}، وتارة لا يصرح بنسبة الشاهد القرآني مثل قوله: “فصمداً صمداً حتى ينجليَ لكم عمود الحق {وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ}”، ويلجأ أحياناً إلى التذييل (أي اختتام الكلام بآية قرآنية) فيقول: “ما فات اليوم من الرزق رُجيَ غداً زيادتُه، وما فات من العمر لم يُرْجَ اليومَ رجعتُه، الرجاء مع الجائي واليأس مع الماضي فـ{اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.
والظاهر أن وظائف الشاهد القرآني متعددة عند صاحب “نهج البلاغة” وتهدف إلى تقوية المعنى وتعضيد الحجة، ومنها: إصلاح الذات وتهذيب النفس كقوله: “وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه، وارتهنكم ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع، فكيف بكم لو هانت بكم الأمور وبُعثرت القبور {هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ}”.
وغير بعيد من وظيفة إصلاح الذات وتهذيب النفس تأتي وظيفة الترغيب والترهيب، فمن الترغيب قول صاحب “نهج البلاغة”: “{وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا} قد أُمِنَ العذابُ وانقطع العتابُ، وزُحزحوا عن النار واطمأنت بهم الدار ورضُوا المَثوَى والقرار، الذين كانت أعمالُهم زاكية وأعينُهم باكية.. إلخ”، ومن الترهيب قوله: “فاتعظوا عباد الله بالعبرِ النوافِعِ واعتبروا بالآي السواطع، وازدجروا بالنُّذُر البوالغ وانتفعوا بالذكر والمواعظ”.
وتُعدُّ الوظيفة العبادية من وظائف الشاهد القرآني الأساسية وتعني الأمر بالصلاة والمحافظة عليها وأدائها في وقتها على أكمل وجه، قال صاحب “نهج البلاغة”: “تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها {كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}”، وللشاهد القرآني وظائف أخرى يضيق المقام عن ذكرها، منها الوظيفة الاحتجاجية والوظيفة العقلية.
ويمكن أن نختتم هذه المقالة بالإشارة إلى أن عباس فحام قدم في خاتمة كتابه “الأثر القرآني في نهج البلاغة: دراسة في الشكل والمضمون” مقترحات وصفها بالموضوعية، منها “إعادة قراءة نهج البلاغة كأثر مبكر للقرآن الكريم في الكلام العربي عامة والأدب العربي خاصة” وإدخاله مادة أساسية في الدراسات الأكاديمية، لكي يساهم في صقل الألسن وتطوير الخطابة والكتابة.