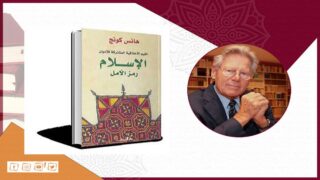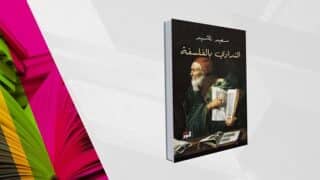عرفت الأديان السماوية حضورا مميزا للمرأة، ففي قصة إبراهيم-عليه السلام- كانت زوجتيه “سارة” و”هاجر”، وفي قصة موسى- عليه السلام- كانت أمه وأخته و”آسية” زوجة فرعون، وفي قصة عيسى-عليه السلام- كانت “مريم” عليها السلام-، وفي سيرة محمد-صلى الله عليه وسلم- كانت السيدة خديجة وعائشة وفاطمة وأمهات المؤمنين-عليهم الرضوان-، فالمرأة حاضرة في الدين تأسيسا وتبشيرا وجهادا طويلا، فلم يكن حضورها عابرا، أو هامشيا، ورغم ذلك يسعى البعض لعزلهن عن الدين، وكأنه شيء ذكوري، وهناك من يُصدر صورة مشوهة عن الدين في موقفه من المرأة: ماهية، وتشريعا وتاريخا.
والحقيقة أن الدين جاء للإنسان ذكرا وأنثى، وفتح أبواب الكمالات أمامهما، وشجعهما على التنافس في الخير والتقى، وفي الخبرة التاريخية لمسيرة الدين في الحياة وقعت تأويلات للنصوص الدينية أساءت للمرأة، وشيدت تصورات مشوهة عن كينونتها، انعكست سلبا في مجال الحقوق والكرامة الإنسانية، فتعرضت المرأة لغبن واضح في بعض الفترت، غير أن تلك التأويلات كانت نتاجا لثقافات تملكتها رؤية تنتقص المرأة، وحاولت أن تغطي تلك السوءات بغطاء من الدين لتقنع الناس بصحة موقفها.
والإسلام، باعتباره، الدين الخاتم، جاء برؤية انقلابية للمرأة، فجعل كينونتها مساوية للرجل، من غير انتقاص، ومنحها حقوقها، وأوصى بها خيرا، وترفق بها في تكاليفه، وشيد منظومة من الأحكام والحقوق محاطة بسياج من التخويف والردع، حتى لا يتعدى أحد على النساء، واستمر عطاء الإسلام حتى في الأزمنة الحالية، التي فُتحت فيها الأبواب للمرأة للخروج في أنشطة الحياة المختلفة، غير أن تلك الأبواب لم تفتح إلا للنساء ذات البهاء، والقادرات على تحقيق المنفعة، أما إذا ذبل الجمال، وقلت المنفعة، فإن تلك الأبوب توصد أمامها، وتتنكر لها الوجوه.
وكتاب “بنات إبراهيم: الفكر النسوي في اليهودية، والمسيحية، والإسلام”[1] تحرير “إيفون يازبيك حداد” و”جون إسبوزيتو”، يقدم قراءة نسوية للأديان الإبراهيمية الثلاثة: اليهودية، والمسيحية والإسلام، حيث اختص كل دين ببحثين، وهو يحاول أن يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في حديثه عن الدين وموقع المرأة في نصوصه التأسيسية وتأويلاته عبر الأزمان المختلفة.
المرأة بين اليهودية والمسيحية
كانت الرؤية اليهودية للمرأة ربما تعود جذورها إلى فلاسفة الإغريق والرومان، الذين نظروا إلى المرأة بانتقاص واحتقار؛ بل وأخرجوها من حيز الإنسانية إلى الحيوانية، غير أن اليهودية أسست رؤيتها على لحظة الخلق الأولى للإنسان، فحملت المرأة مسئولية الخطيئة الأولى، ووصفتها بعض المزامير بالقول:”في الإثم ولدت، وفي الخطيئة حبلت بي أمي”، وتأسيسا على ذلك اعتبرت أن الحمل والولادة والرضاعة، وما يعتري المرأة من حيض ونفاس، عقوبة على الخطية الأولى، التي أغوت فيها “حواءُ” “آدمَ” وحثته على الأكل من الشجرة المحرمة، لذا تصف الأسفارُ المرأةَ بأنها قرين الشيطان، وتمضى الأسفار لتقرن المرأة بدوام المعصية وتحدي الإرادة الإلهية، ودوام العقوبات الإلهية عليها، تلك العقوبات التي هوت بإنسانيتها إلى الحضيض، فتنعت الأسفار النساء بأنهن “سخيفات”، ومصدرا للإثم.
وقد انعكست تلك التصورات في الفقه والتشريع اليهودي، والذي شدد في أحكامه على المرأة في فترة الحيض والنفاس، فاعتبرتها نجسة، وتصير نجاستها مضاعفة إذا ولدت أنثى، كما حرمتها من الميراث في حال وجود أخ لها، لذا فمكانتها شديدة التدني في اليهودية، كما حُرمت من تعلم الشريعة، لأن ذلك بمثابة إلقاء اللؤلؤ في فم الخنزير.
أما المسيحية، فكان لها تصوران وماهيتان، أحدهما للمسيح-عليه السلام-، والآخر لـ”بولس”[2]، فتصور المسيح يمثله ما قاله لأتباعه عندما رأى إمرأة اقترفت الخطيئة،: “من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر” وهو موقف مفعم بالشفقة، كما كانت بعض النساء من الحواريين، أما “بولس” فالمرأة عنده مسئولة عن الخطيئة الأولى، وطالب النساء بالخضوع للرجال، ومنعهن من الوعظ، ويذهب بعض الباحثين أن “بولس” هو من أدخل التصورات اليهودية عن المرأة إلى المسيحية، والتي استغرقت جميع حقبها، أما القديس “يوحنا فم الذهب”[3] المتوفى (407م)، فيقول عن المرأة: أنها “شرا لا بد منه، وإغواء طبيعيا، وكارثة مرغوبا فيها، وخطرا منزليا، وفتنة مهلكة، وشرا عليه طلاء، فحواء هي أداة الشيطان المحببة التي يقود بها الرجال إلى الجحيم.
وقد توارثت المسيحية نظرة الإزدراء للمرأة عن اليونان، حتى “توما الإكويني المتوفى (1274م)” أحد كبار فلاسفة المسيحية في العصور الوسطى، يقول عن المرأة:” لاقيمة لها، ولا شأن، وهي جسد بلا روح”، وذهب بعض آباء الكنيسة أن المرأة ما هي إلا ذكر معيب، وهي فكرة تكلم بها أرسطو، وفي ذلك تقول “زيجريد هونكه” في كتابها “شمس الله تشرق في الغرب”:” لقد ظلت الكنيسة على معاداتها للمرأة، إلى أن تواصل الغرب إلى قهر هذه العداوة عن طريق صلته بالعالم الإسلامي، والذي كان يعتبر في ذلك الحين، أعجوبة غير قابلة للتحقق”.
المرأة في الإسلام
الحقيقة أن السياق الإسلامي عرف تصورات سلبية عن المرأة، لكن يكمن اختلافها عن التصورات اليهودية والمسيحية في أنها لم تكن في بنية النص المؤسس للإسلام سواء في القرآن أو السنة النبوية، وإنما كانت قراءات للنص تأثرت بالثقافة والسياق الاجتماعي الذي تمت فيه قراءة النصوص المتعلقة بالمرأة، أو ما يسميه “ابن تيمية” بـ”الشرع المؤول” وهي آراء بعض العلماء، فبعض المفسرين والفقهاء نظروا للمرأة نظرة دونية ووضعوها في مرتبة الحيوان، ففي تفسير فخر الدين الرازي، تحدث أن النساء خلقن كالدواب والنبات وغير ذلك من المنافع، وفي التراث الشيعي فيصور “صدر الدين الشيرازي” ماهية المرأة بالحيوانية، حتى الإمام المبرد” إمام أهل اللغة في كتابه “الكامل في اللغة والأدب” فيقول:” لا تدع أم صبيك تضربه؛ فإنه أعقل منها وإن كان طفلا”، وعرف الفقه اسلامي نظرة متوجسة ضد المرأة انعكست في بعض الأحكام، خاصة تقييد خروج المرأة من البيت أو تعلمها، غير أن تلك الرؤية والأحكام لم تكن نابعة من الوحي، ولكنها اجتهادات تأثرت بالثقافة المجتمعية التي نبتت فيها.
ويلاحظ في الإسلام أن الوضع الحقوقي للمرأة كان شديد الامتياز فلم يحدث جور على حقوق المرأة خاصة في الإرث، ويذهب البروفيسور ألماريك رامسي Mr. Almaric Rumsey في دراسته عن “الأحكام المحمدية في المواريث”[4] الصادر عام 1880م ، أن نظام الإرث في الإسلام أكثر تطور وتحضرا وتفصيلا لانتقال الملكية من الأنظمة المعروفة في العالم المتحضر، كما عرف المجتمع الفقهي والعلمي عشرات المحدثات والحافظات التي أخذ عنهن كبار العلماء معارفهم، وفي دراسة للدكتور “محمد أكرم ندوي”بعنوان “النساء المحدثات في الإسلام” أثبت أن هناك حوالي ثمانية آلاف عالمة من المحدثات، لم يثبت على أي واحدة منهن في أي وقت كذب ولا تلفيق.
والقرآن الكريم المرأة، لم يعادي المرأة ولم يذمها، أو يهدر كرامتها، أو يحملها وزر غواية “آدم” وإخراجه من الجنة، ولم يعتبرها نجسة[5]، كما أن الخطاب القرآني وجه حديثه إلى النساء والرجال على السواء، وفي المجال الاجتماعي قدم بر الأم والإحسان إليها على الأب، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، وجعل تربية البنت وتأديبها من مسببات دخول الجنة، وأوصى النبي-صلى الله عليه وسلم- بالنساء خيرا.
تناول الكتاب قضية تعدد الزوجات، والحقيقة أن تلك المسألة من القضايا التي تذهب النسويات المسلمات فيها إلى مجالات لتبرير الأمر، أو تأويله بطريقة لا تتفق مع التشريع، بل هناك من يذهبن إلى ضع قيود لم ترد، ويرفض الاعتراف بقضية تعدد الزوجات، ونشير هنا إلى موسوعة “قصة الحضارة” للمؤرخ الأمريكي “ول ديورنت” عند حديثه عن “حرب الثلاثين عاما”[6] في أوروبا، فقد انخفض عدد الرجال في ألمانيا بمقدار الثلث، فعقد مؤتمر “فرنكونيا” في فبراير 1650 بمدينة نورنبيرغ، وأقر تعدد الزوجات، نظرا للاختلال السكاني بين الرجال والنساء، وتحدث “غوستاف لوبون” في كتابه “حضارة العرب” الصادر 1884م عن تعدد الزوجات في الإسلام، وقال: “ولا نذكر نظامًا أنحَى الأوربيون عليه باللوم كمبدأ تعدد الزوجات، كما أننا لا نذكر نظامًا أخطأ الأوربيون في إدراكه كذلك المبدأ… إن مبدأ تعدد الزوجات ليس خاصًّا بالإسلام، فقد عَرَفَه اليهود والفرس والعرب وغيرهم من أمم الشرق قبل ظهور محمد، ولم ترَ الأمم التي اعتنقت الإسلام فيه غُنْمًا جديدًا إذن..ولا أرى سببًا لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبةً من مبدأ تعدد الزوجات السِّري عند الأوربيين، وأُبصِر العكس فأرى ما يجعله أسمى منه”.
[1] الكتاب صادر عن دار “ابن النديم للنشر والتوزيع” بالجزائر، ودار “الروافد الثقافية-ناشرون” ببيروت، ويقع في 262 صفحة، وطبعته الأولى 2018م.
[2] بولس الطرسوسي ويعرف عند المسيحيين بأنَّه بولس الرسول أو القديس بولس ، هو أحد قادة الجيل المسيحي الأول وينظر إليه البعض على أنه ثاني أهم شخصية في تاريخ المسيحية بعد المسيح عليه السلام
[3] كان بطريرك القسطنطينية واشتهر كقديس ولاهوتي. عُرف باليونانية بـ «ذهبي الفم» لفصاحته
[4] عنوان الدراسة باللغة الإنجليزية: Moohummudan Law Of Inheritance And Rights And Relations Affecting It
[5] الطمث في الرؤية الإسلامية ليس عقابا للمرأة على خطيئة قديمة، ولكنه حكمة اقتضتها طبيعة بقاء النوع والتناسل، وتجلى ذلك في موقف النبي الكريم تعامله في مع زوجاته أثناء فترة حيضها، فقد كان يتلو القرآن الكريم في حجر زوجته عائشة ويسمح لها بتمشيط شعره الكريم أثناء فترة حيضها، ولم يمنعها لمس أي شيء، وقال لها: “إن حيضتك ليست في يدك”، وكان -صلى الله عليه وسلم- يشجع الحائضات أن يخرجن ليشهدن مظاهر العيد وفرحة المسلمين وبهجتهم.
[6] حرب الثلاثين عاما Thirty Years’ War هي سلسلة صراعات دامية مزقت أوروبا بين عامي 1618 و 1648م