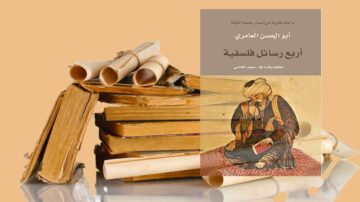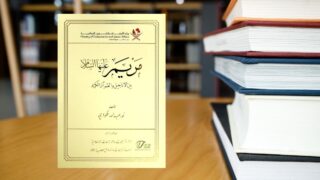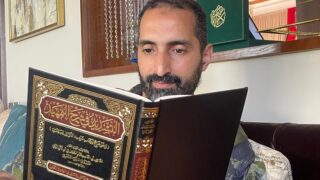قاد اتساع رقعة بلاد المسلمين وانضمام عناصر سكانية متفاوتة عرقيا ودينيا ولغويا ضمن رعاياها إلى محاولة التعرف على طبيعة هذه الشعوب من خلال فهم العقائد التي تدين بها وكيف نشأت وتطورت، وهو ما أسفر عن تنشيط البحث في علم الأديان والفرق أو ما يسمى “الملل والنحل”، وظهرت منذ القرن الثالث طائفة من الكتب تبحث إما في عقيدة أو دين محدد، أو تقارن بين عدد من الأديان، متوخية إما تفنيد مزاعم أهل الأديان بخصوص الإسلام أو إبراز أفضلية الإسلام عمن سواه من الأديان، وضمن هذا السياق يبرز الفيلسوف النيسابوري أبو الحسن العامري باعتباره واحدا من مؤسسي علم مقارنة الأديان وذلك في كتابيه “الإعلام بمناقب الإسلام” و “الإبانة عن علل الديانة”.
السيرة الذاتية والآثار الفكرية
هو أبو الحسن محمد بن يوسف العامري، ولد بنيسابور في أوائل القرن الرابع الهجري -على ما يُعتقد- وتوفي بها عام (381 ه)، ولكنه لم يقض كل حياته بها، لأنه مثل علماء عصره كان محبا للترحال تواقا لطلب العلم من أماكن شتى، ولذلك وصف بأنه “كان من الجوالين الذين نقبوا في البلاد، واطلعوا على أسرار الله في العباد”، وقد استقر به المقام في الري وبخارى لبعض الوقت عاش فيهما أخصب فترات حياته الفكرية، ويذكر التوحيدي طرفا من نشاطه بالري قائلا “ولقد قطن العامري الري خمس سنوات جمعة [متوالية] ودرس وأملى وصنف وروى”، وأما بخارى فكانت عاصمة السامانيين، وهم قوم محبون للعلم والأدب، عاش العامري إلى جوارهم فترة طويلة مستفيدا من مكتباتهم، وألف خلالها جملة من أهم كتبه، ومنها كتاب الإعلام بمناقب الإسلام الذي أهداه لأحد الأمراء السامانيين.
ومع ذيوع صيت العامري في زمانه، حتى أن الشهرستاني صنفه ضمن كبار فلاسفة الإسلام إلا أن كتب التراجم والطبقات المعروفة خلت عن ذكره ربما لاشتغاله بالتفلسف، وكان كتاب التراجم والطبقات يترددون في الترجمة للفلاسفة، ولكن وردت الإشارة إليه لدى التوحيدي وابن مسكويه، وينتمي العامري فكريا وفلسفيا إلى مدرسة الكندي الفلسفية، حيث درس على يد البلخي (الجغرافي المعروف) الذي تتلمذ على يد الكندي، وهي مدرسة تناظر مدرسة الفارابي وابن سينا الفلسفية التي تبنت مقولات الفلسفة اليونانية وسعت إلى تغليفها بغلاف إسلامي، أما مدرسة الكندي فهي ذات منطلقات إسلامية خالصة وخاصة في مجال الميتافيزيقا، وهي وإن استفادت من الفلسفة اليونانية إلا أنها فندت ما بها من أفكار تغاير الأفكار الإسلامية.
وللعامري عدد من المؤلفات -جلها مفقود وبعضها الآخر لم يزل مخطوطا- سردها في مفتتح كتابه (الأمد على الأبد) الذي دونه قبل وفاته بست سنوات، وهي تتوزع على النحو التالي:
- مصنفات في العقيدة، مثل: الفصول في المعالم الإلهية، والعناية والدراية، وإنقاذ البشر من الجبر والاختيار.
- مصنفات في مقارنة الأديان، مثل: الإعلام بمناقب الإسلام، والأمد على الأبد، والإبانة عن علل الديانة.
- مصنفات في التفسير، مثل: الإرشاد لتصحيح الاعتقاد، وهو يدرس إعجاز القرآن.
- مصنفات في الأخلاق وعلم النفس، مثل: الإتمام لفضائل الأنام، والفصول الربانية في المباحث النفسانية.
- مصنفات في العلوم الطبيعية، مثل: تفاسير المصنفات الطبيعية، والإبسار والأشجار وهو في علم النبات، والإبصار والمبصر وهو يندرج ضمن علم البصريات.
وبالنظر في مصنفاته يمكن الاستنتاج أن العامري كان موسوعي الثقافة حيث صنف في فروع المعرفة المختلفة، ولم ينتهج نهج الفلاسفة في الاقتصار على العلوم الفلسفية وإنما جمع إليها الطبيعيات والإسلاميات، كما أنه عالج في كتبه قضايا فكرية ذات صلة بالواقع، وبعضها له صدى في عصرنا مثل قضية الصراع بين أهل الأديان، وعلاقة الدين بالعلم.
منهجه في مقارنة الأديان
في كتابه الإعلام بمناقب الإسلام يحدد العامري الأديان التي يقارن بينها وعناصر المقارنة ومنهجه في التناول، أما الأديان التي وقع اختياره عليها فهي الأديان الستة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وهي: ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة)، أما الأديان التي لم يرد لها ذكر في القرآن فلم يعتبرها، وهو ما يبرهن على انطلاقه من مرجعية إسلامية، وأما عناصر المقارنة فهي تشمل ما يسميه (أركان الدين) أي العناصر التي تشكل جوهر الدين والتي تشترك فيها جميع الأديان، وهي:
- العقائد وتشمل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
- العبادات وتشمل: الصلاة والزكاة والصيام والحج .
- الشرائع وتشمل: المعاملات والزواجر (الحدود)، وهذا الجزء لم يتناوله في كتاب الإعلام وإنما أفرد له كتابا مخصوصا هو الإبانة عن علل الديانة.
ولما كانت رؤية الدين لديه لا تقتصر على هذه النواحي الثلاث التي يتشكل منها وإنما يشمل التجليات التي أسفر عنها الدين في المحيط العام الذي طبق فيه، فقد شملت المقارنة أربعة عناصر إضافية هي: النظام السياسي، والنظام الاجتماعي، والنظام الثقافي الذي أنتجه، وكذلك الإسهام الحضاري لأتباعه.
ولا يكتف العامري بهذه العناصر وإنما وضع أسسا لضبط عملية المقارنة أثناء التناول، ومنها:
- التقيد بعناصر المقارنة الأصلية والفرعية المذكورة آنفا على الترتيب المذكور، دون تقديم أو تأخير.
- الالتزام بمقارنة العناصر المتشابهة أو ما يسميه (الأشكال المتجانسة في الأديان): أي أنه يقارن الأصل بالأصل والفرع بالفرع، فمن الخطأ مقارنة جانب ما من دين بجانب لا يوازيه في دين آخر كأن يقارن شريعة بعقيدة وهكذا.
- الالتزام بمقارنة كل دين على أساس مبادئه وأصوله المقبولة لدى جل معتنقيه، فهو يتجنب آراء الفرق الهامشية والآراء الشاذة التي لا تعبر عن جوهر الدين، وقاده هذا إلى مقارنة الإسلام كما يؤمن أهل السنة والجماعة مع استبعاد آراء ومعتقدات الإسماعيلية والباطنية وغيرهما.
وإضافة إلى ما ذكره العامري فإننا يمكن أن نستنبط بعض خصائص منهجه التي لم ينص عليها، ومن أمثلتها: الالتزام بقواعد البحث العلمي الدقيق فهو يسعى من خلال المقارنة إلى الإجابة عن سؤال رئيس ألا وهو لماذا اعتنق الإسلام دون سواه من الأديان، وهو يدعو المسلمين إلى التفكر في شأن الدين وألا يرث المسلم دينه بل يختاره عن يقين وإيمان، والغاية من وراء المقارنة إثبات أفضلية (أشرفية) دين الإسلام عن بقية الأديان، وهو بهذا لا يخفي تحيزه وقناعاته وإنما يضبطها بقواعد صارمة لا تميز بين الإسلام وغيره وهو ما يجعل من النتائج التي يتوصل إليها موضوعية إلى حد بعيد، وهو يفتتح كل فصل بمقدمة نظرية تلخص مضمونه ثم يشرع في تناول البحث منتقلا بذلك من العموم إلى الخصوص، ويورد الأمثلة عند كل نقطة ليتضح مقصود كلامه ولا يصرف عن وجهه الصحيح، ويعنى بتعريف المفاهيم فضلا تقيده بلغة البحث الموجزة المحددة وعدم ميله إلى الإطناب والسرد، وهذه الخصائص وغيرها تثير تساؤلا لدى الباحث المعاصر فكيف استطاع العامري أن يستبق عصره ويتوصل إلى قواعد المنهج العلمي الصارمة ويتقيد بها في زمن لم تدون فيه هذه القواعد ولم تصبح واجبة الاتباع .
مقارنات في العبادات
لما كان تتبع ما ذكره العامري من مقارنات أمرا يضيق عنه المقام فإنا نتخير قسما واحدا من هذه المقارنات ونتوقف عنده وهو المقارنة في مجال العبادات، ومن خلاله يتبين نهجه في إجراء المقارنة بصورة عملية.
يستهل العامري الفصل الخامس المعنون (القول في فضيلة الإسلام بحسب الأركان الاعتقادية) بمقدمة نظرية تشير إلى وجود علاقة ارتباطية بين التوسط والاعتدال وبين قابلية الدين للبقاء والاستمرار، فيقول “إن أحق الأديان بطول البقاء ما وجدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين، ليجد كل من ذوي الطبائع المختلفة ما يصلح به حاله في معاده ومعاشه، ويستجمع له منه خير دنياه وآخرته، وكل دين لم يوجد على هذه الصفة بل أُسس على مثال يعود بهلاك الحرث والنسل فمن المستحيل أن يسمى هينا فاضلا”. وهو يتناول بالتحليل خصائص العبادات الإسلامية مقارنا بينها وبين ما يوازيها من عبادات في الأديان الخاضعة للمقارنة، وهي:
- الصلاة : ويسميها “العبادة النفسية” لاشتمالها على إخلاص النفس لله والخضوع له، والصلاة في الإسلام تفضل الصلوات في الأديان الأخرى من وجهين: أنها وسط بين المغالاة في الكثرة (كصلاة الرهبان) أو القلة (كصلاة المجوس) ولهذا فهي بعددها تتيح للمسلم أن يحصل أسباب المعاش مع قضاء حق الله في التعبد، وهي كذلك بهيئتها تمثل الخضوع الكامل، وهي مخصوصة ببداية ونهاية ومصونة بكلام محدد، أما صلوات الأديان الأخرى فتنقصها هذه الخصائص فبعضها ركوع بلا سجود وبعضها غير معلوم البداية والنهاية، وبعضها مجرد تلفظ كالصلاة في المسيحية.
- الصيام: ويطلق عليه “العبادة البدنية” وهو يفضل صيام الأديان الأخرى من وجهين: أنه وسط بين الطول (صوم المسيحية) والقصر ( صوم المجوس)، وأنه من حيث الكيفية فهو وسط ومعتدل لا يؤدي لنحول الجسد (كصوم الثنوية والمسيحية)، وليس كصوم اليهود لا يعرف له نظاما مستقرا وأوقات مخصوصة لا يعلمها إلا الأحبار.
- الزكاة: ويعرفها بأنها “عبادة مالية توجب على الإنسان الإنفاق على ذوي الحاجة من دخله من مصادر الثروة الثلاثة: الحيوانية والنباتية والمعدنية” وهي عبادة موجودة في جميع الأديان عدا المسيحية والمانوية، والزكاة في الإسلام تفوق الأديان الأخرى ويكفي لبيان ذلك الإشارة إلى اقترانها بالصلاة عماد الدين، وهي تتميز بالاعتدال إذ لا تتجاوز ربع العشر، أما في اليهودية فتصل إلى العشر في النبات والحيوان، وأما المجوس فتوجب إعطاء الأزواج لبعضهم ثلث المال.
- الحج: ويسميه “العبادة المشتركة” لأنه يجمع جميع خصائص العبادات السالفة، فهو عبادة بدنية ونفسية ومالية وسياسية، وبحسب العامري فإنه رمز اتحاد الأمة والتفافها حول غاية محددة، وليس في الأديان الأخرى “نسكا أجمع لوجوه البر ومكاسب الأجر من نسك المسلمين”.
مما سبق يمكن النظر إلى أبي حسن العامري بوصفه أحد مؤسسي علم مقارنة الأديان، وذلك لأن جل العناصر التي وضعها للمقارنة والمنهجية التي اتبعها اعتمدت في أعمال من تبعوه كالشهرستاني وغيره، بل لا تزال محل اعتبار دارسي الأديان في العصر الراهن.