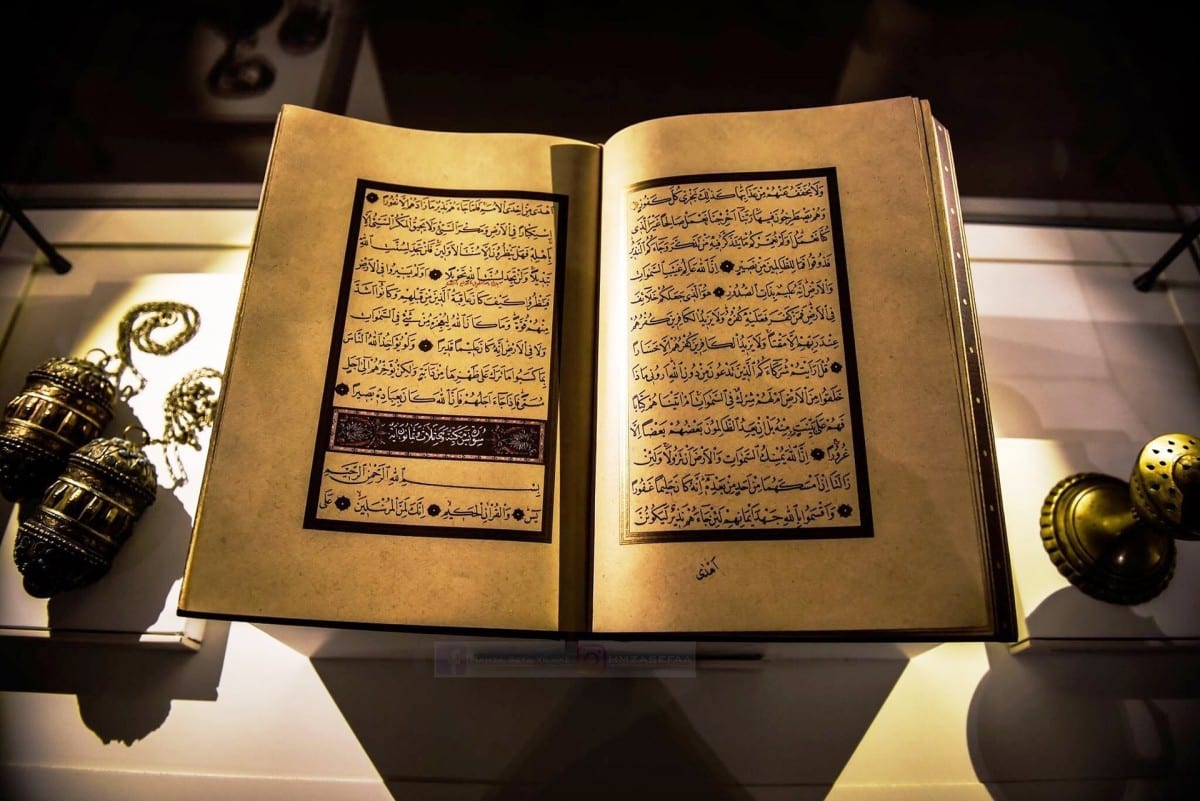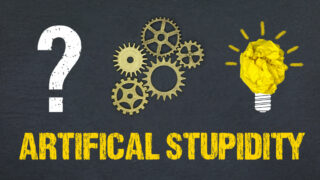نستكمل هنا جوانب الحقيقة الثالثة التي يتعامل معها الوحي وطبيعة ومنهجية هذا التناول, ونؤكد في هذا المجال أن الإنسان في التصور التوحيدي له ثلاثة أبعاد أساسية تشكل ماهيته, هذه الأبعاد هي:
- الوعي والمعرفة: إن أحد أبعاد الإنسان هو الوعي والمعرفة، وبين جميع الموجودات فإن الإنسان وحده فقط وفقط يمتلك الوعي والمعرفة، معرفة بنفسه وبالعالم. ولكن أكبر الاستعدادات الموجودة عند الإنسان، هو الاستعداد الإلهي، ففي العالم وفي الوجود، الله فقط هو “العالم” والإنسان – واللطف في درجات ونوع – “المعرفة الذاتية” و “معرفة الكون”، وهذان الوصفان يختصان بالله وبالإنسان1.
- الحرية: والحرية هنا تعني أن جميع الكون يتحرك ويدار على أساس سلسلة العلة والمعلول. فكل ظاهرة نراها فهي تأتي بعلة جبرية لسابقتها، وهذه تكون علة لمعلول آخر، إذا فكل عمل يظهر أو يكون له وجود فهو له علة وهو سوف يصبح علة أيضاً لمعلول آخر، فمثلًا النفط علة لشعلة الإضاءة والحرارة، إذًا فالإضاءة والحرارة هما بالجبر جاءا من احتراق النفط، والحرارة كانت معلولة للنفط فهي ستكون علة لتسخين الماء، إذًا وجود جميع الظواهر يكون جبرياً. والإنسان أيضاً باعتباره ظاهرة مادية [في تجسدها] فهو جاء أيضًا نتيجة سلسلة من العوامل المتتابعة. و الاستعداد الذي يملكه الإنسان يجعله يتوق إلى الحرية من سلطة الجبر ويجعله يلعب دورًا في مسير سلسلة المراتب الجبرية للعلة والمعلول. فهو هنا يلعب دور العلة2.
ج. الإبداع أو الخلاقية: إن الإنسان يمتلك قدرة إبداع، ومن الممكن أن يكون أحد معاني الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال وجميع الموجودات فأبينها وقبلها الإنسان، هي “قدرة الإبداع” والتي هي في يد الله سبحانه وتعالى، ولم تقبلها أي من الموجودات سوى الإنسان3.
خصائص الحقيقة الإنسانية في المنظور التوحيدي
ومن ناحية أخرى فقد وُهِبَ الإنسان -من الله تعالى- مجموعة من الصفات والقدرات والخصائص تجعله قادرًا على خوض غمار الوضعية في الحياة الواقعية, وهي صفات/خصائص أصيلة في الإنسان حتى لو لم يكن في بعض حياته, أو بعض أزمنته على استخدامها وتوظيفها, وهذه الخصائص هي4:
- وجود أصيل: أي أن له “ذات مستقلة” من بين جميع الموجودات الطبيعية والميتافيزيقية، وله “جوهر نوعي شريف”.
- إرادة مستقلة:وهذه أكبر قوة خارقة للعادة أو غير قابلة للتفسير في الإنسان. والإرادة بهذا المعنى: هو أن الإنسان، باعتباره “العلة الأولية والمستقلة”[ في سير التاريخ] يتدخل ويعمل في التسلسل الجبري للطبيعة، التي جعلت المجتمع والتاريخ تابعًا مطلقًا لها في تسلسل العلية. الحرية والاختيار، وهما من الصفات الإلهية، من أبرز مميزات الإنسان.
ج. موجود واع: والوعي بمعني أنه يفهم واقعية العالم الخارجي بقوة “التفكير” العجيبة المعجزة، ويكتشف الخفايا المكنونة عن “الحس”، ويمكنه أن يحلل ويعلل كل حقيقة أو واقعة، دون أن يبقى في مستوى “المحسوسات” و “المعلولات”، وأن يطلع على ما وراء المحسوس، ويستدل على المعلول نحو العلة وهكذا. يتحدى حدود حسه، ويوسع حدود عصره نحو الماضي والمستقبل اللذين لم ولن يكن حاضراً فيهما، وأن يحصل على تصور صحيح وواسع وعميق عن محيطه.
د. موجود واع ذاتيًا : أي إنه الموجود الوحيد الحي الذي له علم حضوري بالنسبة لنفسه. ويمكنه أن يدرس نفسه باعتباره موجودًا مستقلًا عن نفسه، يعللها ويحللها، ويعرفها، ويقيمها.
ه. موجود مبدع: إن هذا الإبداع الممتزج بعمله، يجعله أمام الطبيعة تمامًا وإلى جانب الله. هذا الإبداع هو الذي جعل له هذه القوة الخارقة للعادة التي تمكنه من اجتياز الحدود الطبيعية وإمكانياته المحدودة، ووهب له البعد الوجودي العجيب وغير المحدود، ومتعه بما لم تمتعه به الطبيعة.
ز. موجود “ذو أمنية” أو أنه يعشق الأماني المثالية: بمعنى أنه لا يستسلم ولا يتوقف أمام “ما هو كائن”، بل يسعى لتغييره إلى “ما يجب أن يكون”، ولهذا يتفنن دائمًا، ويفتخر بأنه الموجود الوحيد الذي يصنع البيئة ولم تصنعه هي. وبعبارة واحدة: أنه يفرض “عقيدته” دائمًا على الواقع، وبهذه الكيفية لم يكن في حالة الحركة المستمرة والحركة نحو الكمال فحسب، بل – بعكس الكائنات الحية الأخرى – يقرر بنفسه مسيرة تكامله، وله علم مسبق بذلك.
ح. موجود أخلاقي: هنا يأتي البحث المهم عن “القيمة”, والقيمة هي عبارة عن رابطة بين الإنسان وإحدى “الظواهر”، أحد “الأساليب”، أحد “الأعمال”، أو إحدى “الحالات”، التي يتوفر فيها دافع أفضل من “الربح”. ولهذا يمكن تسميتها بنوع من “الرابطة القدسية” المعجونة بـ”الحرمة والعبادة” إلى حد أن الإنسان في هذه الرابطة يشعر بأن حتى التضحية بوجوده وحياته، له ما يبرره.
ويرى علي شريعتي – أيضًا- أن الإنسان بالمعنى الفردي وبالمعنى الجماعي – ليس على الدوام وعلى الإطلاق وليد بيئته أو ربيبها. ويقصد بالبيئة، البيئة الطبيعية بمعناها المادي، والبيئة الجغرافية و الإقليمية كما يتحدث عنها الجغرافيون، والبيئة التاريخية كما يفسرها المعتقدون بحركة التاريخ، وأيضًا البيئة الاجتماعية كما يتحدث عنها علماء الاجتماع، والبيئة الطبقية كما يتحدث عنها الماركسيون. كما أن الإنسان ليس مخلوقًا جبريًا خاضعًا للوراثة كما يعتقد علماء الأحياء والوراثة والفاشيون. وفي نفس الوقت لا يمكن إنكار دور كل هذه العوامل الاجتماعية والمادية والطبقية. ولكن مع الاعتراف بكل هذه العوامل يمكن القول : بأن الإنسان يستطيع أن يكون من صنع نفسه، أي أن يكون شريكًا في بناء ذاته.
لكن الإنسان التكاملي الحيوي، الساعي نحو الحرية، يسبق كل هذه العوامل الجبرية والعلمية والمادية، ويتغير من صورة “المعلول” إلى صورة “العلة” بقدر نضج إرادته ووعيه الذاتي. ومن هنا فإننا حينما نذكر لفظة “إنسان”، فإنما نقصد اكتشاف تلك العلة التي لعبت في مسيرة الطبيعة والتاريخ دور العامل والخالق والصانع والمدبر والمستخدم الواعي. ومثل هذا الإنسان يستطيع أن يسيطر على المسار المادي والعلمي للتاريخ بقدر ما تعبأ إرادته بالإضافة إلى وعيه ومعرفته المادية والطبيعية.
ومنطلق القرآن الكريم في فهم الإنسان متفق تمامًا مع هذا التفسير، يقول تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التِّين:4] أي: إننا خلقنا الإنسان بالنسبة لاستعداده وإمكانيات تكامله في أعلى مرتبة علمية، ثم رددناه بعد ذلك إلى أدنى الدرجات. فالقرآن، لا يتناول الإنسان كمثل مجرد ومطلق، وخارج عن النظام المادي والعلل والعوامل العينية والعلمية. كما أنه لا يتناوله كظاهرة عفوية تظهر من التسلسل الجبري للتاريخ أو الطبيعة أو الوراثة. أي أن الإنسان بالقوة ظاهرة سامية فوقانية لكنه بالفعل ظاهرة مادية ترابية بيولوجية. إن خلقة الإنسان في القرآن ليست من جبلة مادية فحسب، بل مادية دنيوية، أي أنه واقعيًا من تراب، ومعنويًا في أدني مرتبة {صَلْصَالٍ كَالفَخَّارِ} [{الرَّحمن:14] و {حَمَإٍ مَسْنُونٍ} [الحجر:26]. لكنه بالقوة يستطيع أن يرتفع إلى حدود العلة المستقلة عن القوانين المادية، ويصل إلى مرحلة استثمار الجبر الطبيعي والوراثة والتاريخ والمجتمع، ويكون مدبر الدنيا المادية، أي صاحب السيادة على الوجود، ويقطع هذه المسيرة العلمية من “التراب” إلى “الله”5.
تنزيل PDF