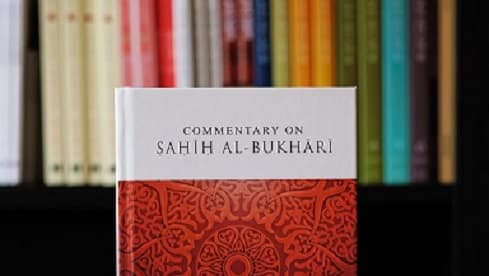يتعرض صحيح البخاري هذه الأيام لحملة من التشكيك وإثارة الشبهات، مع حالة من الغموض بالنسبة لدوافعها وغاياتها، والعلاقات التي تجمع بين أصحابها، الذين كأنهم تفرّغوا اليوم أو فُرّغوا لهذه المهمة.
هؤلاء بالعموم لم يُعرف عنهم الاهتمام ببحوث السنّة النبوية، ولذلك يُستبعد أن يكونوا قد توصلوا بالفعل إلى هذه الشبهات نتيجة لحلقات البحث والدراسات العلمية، بل ربما يكون الواحد منهم قد بات وهو لا يعرف شيئاً عن البخاري، ثم يستيقظ في الصباح ليمارس شهوته في هذا النقد وهذا الطعن، وقد انتشر مؤخّراً تسجيل مرئي لشيخ معمم يطعن في البخاري وهو لا يعرف اسمه، فيسميه «جُمعة أبو عبدالله محمد بن إسماعيل»، لأنه قرأ على غلاف الكتاب عبارة «جَمَعه أبو عبدالله…».
يقول لك آخر: إنه يريد أن يرسّخ في الأمة مرجعية القرآن الكريم، ولذلك فهو يضعّف كل حديث يعارض القرآن ولو كان في صحيح البخاري، هنا تظن لأول وهلة أنك أمام باحث مختص في القرآن الكريم وتفسيره، عارف بأصوله وفروعه، ومحكمه ومتشابهه، ومكّيّه ومدنيّه، ومتضلع قبل كل هذا بلغة القرآن وأسلوبه، لكنك تُفاجأ حينما تعلم أن هذا وأمثاله ربما لا يحسنون تلاوة القرآن أصلاً، وربما جاءوا بالمضحكات حينما يحاولون تفسير كلمة أو آية من آيات القرآن.
بعضهم تراه يردد كلمات وعبارات، تفهم من مجملها أن عقدته مع البخاري تكمن في تصوّره أن التشبث بالبخاري يعني عنده الجمود على الماضي والعجز عن مواكبة العلوم الحديثة ومتطلبات العصر، ولشدة ما تراه متحمساً لهذا الاتجاه تتخيل كأنه يواجه يومياً مئات الحافظين لصحيح البخاري، والذين لا شغل لهم إلا مذاكرة ما يحفظونه منه بمتونه وأسانيده، حتى أشغلهم ذلك عن غيره، ولا أدري كيف برزت أمام ناظريه هذه المشكلة في وقت نرى فيه هذا الجيل -إلا ما ندر- منشغلاً بأمور أخرى لا تمتّ إلى البخاري بصلة، فمتابعة لعبة الكرة مثلاً مقدّمة عندهم على متابعة دروسهم وواجباتهم، ناهيك عن أولئك الذين غرقوا في أوحال الرذيلة والمخدرات، ثم لنسأل هؤلاء: ما الدراسة العلمية التي أوصلتكم إلى هذا التشخيص؟ وكم نسبة هؤلاء الشباب الذين شغلتهم أحاديث البخاري قياساً ببقية شباب الأمة؟
أخيراً وليس آخراً، ربما ترى صنفاً آخر يتضايق جداً من البخاري، لا لشيء إلا لأنه لم يفهم لماذا حظي البخاري بهذه المكانة، ولماذا كان صحيحه أصحّ كتاب بعد القرآن الكريم، فتراه يتساءل بغضب وانفعال: لماذا هذا الغلو؟ لماذا هذا التقديس؟ وهذه التساؤلات يمكن أن نتفهمها، خاصة مع شيوع حالة من المفاهيم والتصورات المغلوطة عن البخاري وعن غير البخاري، لكن أليس من الغريب أن يكون الإعلام الغربي هو الذي يروّج لمثل هذه التساؤلات؟ ثم تجد من يعكسها عليك بالنص؟ خذ مثلاً هذه العبارة التي نشرتها قناة الحرة العربية على موقعها الرسمي، والتي يرددها أيضاً كثير من الناقدين والطاعنين: «حينما يتم نقد البخاري أمام رجال الدين، فإن أوصالهم ترتعد لأن ذلك سوف يهدم كهنوتهم الديني، الذي يسيطرون به على عقول العامة»!
إن هذا الاضطراب والتخبّط لدى هؤلاء يكشف أيضاً عن جهل عريض في أصول هذه العلوم ومبادئها الأولية، ولذلك لا ترى هذا الطعن إلا منهم ومن أمثالهم، ممن لا علم لهم بالسنّة وعلومها.
إن علماء السنّة قد أصّلوا أصولاً وقعّدوا قواعد في النقد الشامل والدقيق، بما لا مثيل له في أية أمة من الأمم، ويكفي هنا التذكير بعلم «الجرح والتعديل» الذي ضبط معايير التوثيق والتضعيف، وبحث في كل الرواة بأسمائهم وأنسابهم وصفاتهم ومستوياتهم، دون أن يستثني منهم أحداً مهما كان، ثم لم يكتفوا بذلك بل راحوا ينقدون النصّ نفسه بمسالك علمية دقيقة، منها البحث في مراتب الدلالة، والبحث في قواعد التعارض والترجيح، والبحث في مشكل الحديث، وغير ذلك.
ولتقريب الصورة لغير المختصين، أذكر أن شيخنا المحقق صبحي السامرائي -رحمه الله- قد اقترح عليّ وعلى صديقي د. عمر عبدالعزيز أن نعمل على تحقيق وتخريج رسالة من رسائل ابن أبي الدنيا -رحمه الله- وكان ذلك سنة 1984، وكانت الرسالة بعنوان «حسن الظنّ بالله» وهي رسالة صغيرة، لكننا تعلمنا منها الكثير، والأهم أننا تعلمنا الأدب مع هؤلاء العلماء، حيث لمسنا بأيدينا الجهد الاستثنائي الذي لا يمكن أن يقدّره مقدّر أو يتخيله متخيّل، وعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن معدّل السند في كل حديث خمسة رواة، وأن مجموع الأحاديث فيها 100 حديث فقط، فهذا يعني أن الرسالة هذه ستضم 500 راوٍ، وبحذف المكرر تكون مهمتنا الأولى البحث في 300 راوٍ، وتمييز كل واحد منهم، والتأكّد أن هذا الاسم هو المقصود، وذلك بمعرفة ولادته ونشأته ورحلاته ووفاته وشيوخه وتلامذته… إلخ، لأنك قد تجد مائة راوٍ يشتركون في اسم واحد، ثم ندقق فيما قاله العلماء عنهم واحداً واحداً… إلخ، لقد كانت تجربة شاقة جداً مع ما فيها من متعة وأنس، وهنا كنت أتساءل: أي جهد بذله أولئك الأعلام حينما نقلوا لنا كل هذه الثروة بمئات المجلدات وبأعلى درجات الدقة والعناية، ثم حينما يتفق كل هؤلاء على أن صحيح البخاري هو أصحّ كتب السنّة على الإطلاق، فماذا يعني هذا؟ من هنا ندرك لماذا لا يأتي الطعن إلا من خارج هذه الدائرة، ممّن لا معرفة له لا بنقد السند ولا بنقد المتن.
إن البخاري ليس هو من قال: إن كتابي هذا هو أصح الكتب في هذا العلم، وإنما هذه هي شهادة أهل الاختصاص على مرّ القرون، دون أن يملك البخاري أية سلطة للتأثير على هذه الشهادة، كما أن هذه الشهادة ليست غريبة في أي مجال علمي، فبكل تأكيد هناك مصادر معتمدة في علم الطب بناء على شهادة الأطباء، وهنالك مصادر معتمدة في الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء، فهل يجوز أن نشكّك في كل ذلك، بحجة أن هؤلاء الأطباء أو غيرهم من كل الاختصاصات غير معصومين وغير مقدّسين؟
إننا حقيقة أمام أزمة لا تمسّ البخاري ولا كتب السنّة فقط، وإنما تضرب القواعد العلمية لكل علم من علوم الأرض، بحيث يختلط العلم بالجهل، والأسس المنهجية بالنزعات العبثية والفوضوية.
المسألة ليست مسألة تقديس للبخاري، ولو كانت المسألة كذلك لاتجه الناس إلى موطّأ الإمام مالك إمام دار الهجرة، أو مسند ابن حنبل إمام أهل السنّة، بل لقدّسوا مرويّات البخاري نفسه في كتبه الأخرى، فالمسألة عند العارفين مسألة علمية منهجية، لا علاقة لها بالأشخاص مهما علا كعبهم، وعظمت منزلتهم.
إننا هنا ربما نكون بحاجة إلى أن نبسّط الأمر لغير المختصين، فنقول: إن البخاري لا يختلف أبداً عن هؤلاء الأعلام، وربما فيهم من تفوّق عليه في أكثر من مجال حتى في علوم السنّة نفسها، لكن منهجية البخاري في كتابه هذا هي التي ميّزت الكتاب، فالعلماء لهم مناهج مختلفة في تدوين السنّة، منهم من يجمع مرويّات كل صحابيّ على حدة، ومنهم من يجمعها بحسب الموضوعات، ومنهم من يجمع الأحاديث ولا يحكم عليها، ومنهم من يجمعها ويحكم عليها في مواضعها، كما فعل الإمام الترمذي، فهو يروي الحديث مذيّلاً بحكمه عليه، فيقول مثلاً: هذا حديث صحيح أو حسن أو غريب أو منكر، أما الإمام البخاري فقد أفرد الصحيح فقط في كتاب مستقل، وتبعه الإمام مسلم على ذلك، وهذا لا يعني أن الأحاديث الصحيحة عند البخاري أو مسلم أكثر منها عند الترمذي أو أحمد، الموضوع مختلف تماماً، كنت أشرح الأمر لطلابي بمثال تقريبي، لو قارنّا بين مجموعتين في مقرر واحد لأستاذين مختلفين، لكن الأستاذ الأول جاء بمجموعته كلها، والثاني جاء بالمتميزين فقط، فكيف سيكون حكمنا على المجموعتين وعلى الأستاذين؟
إن البخاري نفسه قد بنى كتابه الآخر في الحديث «الأدب المفرد» بمنهجية مختلفة ضمّت الصحيح وغيره، وهو كتاب عظيم الفائدة، لكن العلماء لم يرفعوه إلى مستوى كتابه الأول، بل فضّلوا عليه كثيراً من كتب السنّة، وهذا دليل واضح على أن المسألة لا علاقة لها بتعظيم الأشخاص أو تقديسهم.
وهنا لا بد من الإجابة عن سؤال قد يرد في هذا المجال: لماذا لم يأخذ بقية المحدثين بمنهجية البخاري ما دامت هي الأعلى والأفضل؟ ولماذا لم يلتزم البخاري نفسه بمنهجيته هذه في كتبه الأخرى؟ ولاختصار الجواب نقول، لو اقتصر المحدّثون على هذه المنهجية لفات الأمة خير كثير، فالأحاديث التي هي دون الصحيح لا تعني أنها باطلة أو مكذوبة، وقد يرتقي كثير منها إلى درجة الصحيح باعتضادها ببعضها، ثم إن شروط البخاري في الصحيح متشددة جداً حتى في مستوى الأحاديث الصحيحة، والعلماء قد يرون التشدد والاحتياط في أحاديث العقائد والأحكام المتعلقة بالحقوق والدماء والأموال، لكن هذا التشدد لا نحتاجه في الفضائل والنوافل، خاصة إذا كان لها أصل في الشرع ومتوافقة مع قيمه ومبادئه.
أما انتقادات الإمام الدارقطني لصحيح البخاري، والتي يدندن حولها هؤلاء المبطلون، فيا ليتهم قد قرأوها بالفعل، ويا ليتهم قد قرأوا أيضاً مناقشة العلماء لهذه الانتقادات، خاصة مناقشات الإمام ابن حجر العسقلاني، لنتأكد أنهم جادّون في البحث عن الحق والحقيقة.
إن انتقادات الدارقطني تثبت أن شهادة العلماء لصحيح البخاري جاءت بعد نقد وتمحيص ومناقشات تخصصية معمقة، وليس عن تقديس أو انبهار، يؤكد هذا أيضاً إجلال العلماء جميعاً للدارقطني على ما جاء به من انتقادات.
هناك من يردد سؤالاً آخر مؤدّاه، ماذا نفعل إذا وجدنا في البخاري ما يعارض القرآن الكريم، أو يعارض العقل؟ وهذا السؤال بدأ يتردد مع هذه الموجة كجزء من حملة التشويه ومحاولة النيل من مكانة البخاري وصحيحه، بل النيل من السنّة النبوية كلها، باعتبار أن صحيح البخاري هو أصحّ كتب السنّة، فالتشكيك به تشكيك بما سواه بطريق الأولى، ثم هو اتهام لكل علماء الأمة المتفقين على صحة الصحيح، أنهم ما كانوا يفهمون القرآن الكريم، ولا يفهمون البديهيات العقلية، وكأنهم ساروا صمّاً وعمياناً وراء البخاري، ومن المفارقات الغريبة هنا أن الأمة وهي تعيش اليوم أسوأ محطاتها التاريخية جهلاً وتخبطاً وتخلفاً، يظهر فيها من يتطاول على الأمة في عصورها الذهبية التي كانت فيها سيّدة العالم قوّة وعلماً وحضارة!
لقد فات هؤلاء أن علاقة السنّة بالقرآن وعلاقتها بالعقل من أشهر المباحث العلمية في تراثنا الإسلامي الأصيل، فهذا الإمام ابن الجوزي يضع قاعدته الذهبيّة: «كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع»، وهنا يأتي الإمام زُفَر تلميذ أبي حنيفة ليفرّق تفريقاً دقيقاً بين العقل وبين مجرد الرأي، فيقول: «إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر»، وهذا الإمام الغزالي -وهو من هو في المدرسة العقلية- يقول بالمعنى نفسه: «القياس على خلاف النصّ باطل قطعاً»، ثم يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ليبسط القول في كل ذلك بكتابه العظيم «درء تعارض العقل والنقل».
لقد عرف المسلمون هذه المباحث منذ الصدر الأول، فها هو البخاري نفسه يؤصّل لذلك، ولنقرأ هذه الرواية في صحيحه عن مسروق قال: قلت لعائشة -رضي الله عنها-: يا أمّتاه، هل رأى محمد ربّه؟ فقالت: لقد قفّ شعري ممّا قلت، أين أنت من ثلاث من حدّثكنّ بها فقد كذب، من حدّثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»، ومن حدّثك أنه يعلم ما في غدٍ فقد كذب، ثم قرأت: «وما تدري نفس ماذا تكسب غداً»، ومن حدّثك أنه كتم فقد كذب، ثم قرأت: «يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك»، فانظر إلى هذه المنهجية الدقيقة في محاكمة الرواية إذا ناقضت القرآن، ثم يأتي هؤلاء اليوم ليوهموا البسطاء أنهم قد تنبّهوا لقضية خطيرة لم يتنبّه لها الأوائل!
أما أولئك الذين يرفعون شعار الاحتكام إلى القرآن فقط، ومن ثم هم يرفضون البخاري والسنّة النبوية من أساسها، فهؤلاء يناقضون القرآن قبل السنّة، فالقرآن هو الذي ألزمنا بطاعة رسول الله -ﷺ- والتأسي به، فقال: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول»، وقال: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»، ثم من الناحية العملية، كيف يمتثل هؤلاء لقول ربهم: «أقيموا الصلاة»، والقرآن لم يفصّل لنا أحكام الصلاة ولا أركانها ولا شروطها؟ وهكذا قُل في أغلب العبادات والأحكام العملية.
من هنا ندرك أن استهداف السنّة إنما يقصد به استهداف الإسلام كله، واستهداف هوية الأمة وثوابتها والأواصر التي تجمعها، وهذا لا يعني سدّ باب البحث والنقد العلمي بأصوله وضوابطه، فبين النهجين والمقصدين بعد ما بين المشرقين والمغربين.
تنزيل PDF