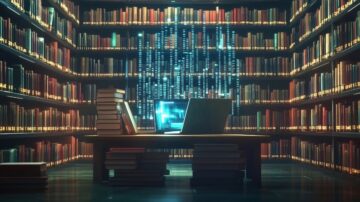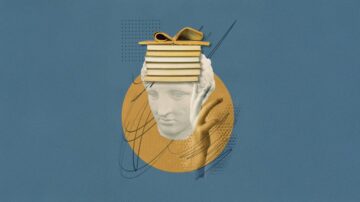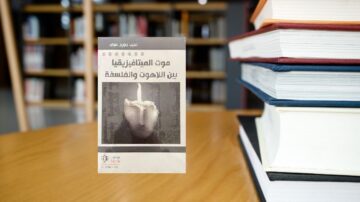لا خلاف بين العلماء على أهمية المصلحة في التشريعات الإسلامية، وأن الأحكام والتصرفات الدينية منها والمدنية جميعها وضعت ابتداء لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، لذلك ظهرت الجملة “الشريعة الإسلامية كلها مصالح”، لأن التشريعات الإسلامية في جميع مجالاتها الدينية والمدنية موضوعة لتحقيق مصالح الناس سواء من حيث تكثير المنفعة أو دفع أضداد المنفعة وهي المفاسد.
وسارت هذه الجملة بمقام القاعدة عند العلماء، بل هي أم القواعد المقاصدية وأعمها وأوسعها[1]، بحيث لا يتصور الخلف عن هذه القاعدة في أحاد جزئيات الشريعة، وقد وصفها ابن عاشور بأنها (قاعدة كلية في الشريعة)[2]. وافتتح بها الشاطبي الجزء الخاص بالمقاصد في كتابه الموافقات[3].
ونال هذا الأصل الإجماع بين العلماء عدا ما ينقل من مخالفة الظاهرية، وكل عالم أخذ طريقا معينا في تقرير هذا الأصل.
نبدأ بالقرافي في كتابه “الفروق” وصف مراعاة المصلحة بأنها عادة الله تعالى في الخلق وفي وضع التشريعات، يقول: “إن عادة الله تعالى في الشرائع أن الأحكام تتبع المصالح”[4]. ويتجلى من ذلك أن الفعل حين يعتبر عادة فإنه يكون صفة ملازمة للفاعل في كل وقت وحين، ولذا يستحيل أن يخلو حكم في الشرع من مصلحة تناسبه.
ومن شواهد هذه العادة الثابتة من الشارع في تغليبه للمصلحة في جميع الأوامر والخلق، إرسال الأنبياء من البشر لترشيد أقوامهم إلى مصالحهم، وإن تضرر أحد برسالاتهم إلا أن المنفعة التي جاءت بها كانت غالبة يقول ابن تيمية: ” الرسل – صلوات الله عليهم – بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان”[5].
وأكد على المعنى ذاته ابن القيم حين وصف الشريعة أن “مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها”[6].
وابن عاشور من جهته يقرر أن الشريعة وإن بدا من بعض تشريعاتها حرج وضرر وتفويت لمصالح بعض المكلفين مثل تحريم الخمر وتحريم الانتفاع بماله عن طريق البيع، لكن مع التأمل ستظهر مصالحها الكامنة التي راعها الشارع[7].
ثم يعمق هذا التأصيل الدكتور البوطي حيث قرن المصلحة بالنزعة الفطرية التي يختص بها الإنسان، فإنه كما يسعى الإنسان بطبيعته وراء ما يحقق منافعه الشخصية وغيرها في هذه الحياة، يأتي الإسلام – وهو دين الفطرة – بشرائع ترعى وتلبي هذه المنافع، ويضع لها قوالب قانونية متوزانة، وكانت رعايته للمنفعة على أتم مظاهرها وأوسع طاقاتها لتكون محورا لما شرعه الله تعالى لعباده من شرائع وأحكام، وأساسا لجميع ما خطه لعباده من أخلاق وفضائل”[8].
والشاطبي خصص رعاية مصالح الخلق بالنوع الأول: “قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء”، إشارة إلى أن المصلحة هي القصد الأول للشارع وما عداه تفاصيل له؛ لأن “تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام ضرورية .. وحاجية.. وتحسينية”[9]، وهذه الضروريات هي أصل المصالح وبقية الأنواع متممات لها[10].
ويفصّل كل نوع من مراتب هذه المصالح:
1 – أما المصالح أو المقاصد الضرورية فهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، ويترتب على فقدانها اختلال وفساد كبير في الدنيا والآخرة. وبقدر ما يكون من فقدانها بقدر ما يكون الفساد والتعطل في نظام الحياة.
2 – المقاصد الحاجية أو المصالح الحاجية – هي التي يتحقق بها رفع الضيق والحرج عن حياة المكلفين، والتوسعة فيها. مثل: الرخص للمسافر لسبب السفر، وإباحة الصيد.. وغيرهما[11].
3 – التحسينية، ,هي المصالح التي تليق بمحاسن العادات، مثل التقرب بالنوافل، وآداب الأكل والشرب.. وغيرها[12]. وهي لا ترقى أهميتها إلى مستوى المرتبتين السابقتين، وإنما شأنها أن تتم وتحسن تحصيلهما ويجمع ذلك محاسن العادات ومكارم الأخلاق والآداب[13].
والحاصل من ذلك كله أن المصلحة تمثل محورا أساسيا في الشريعة الإسلامية؛ لذلك اعتبرت أحد مصادر التشريع الإسلامي، وتتأكد هذه الحقيقة من خلال الأصول والقواعد التشريعية المتنوعة التي ترجع إلى اعتبار المصلحة. ومن أصرحها وأشهرها هو أصل (المصلحة المرسلة) التي اعتمدها بعض المذاهب، بل اعتبرها جميع المذاهب في التحقيق دون خلاف[14].
ومن الأصول التي اعتبرت فيها المصلحة: الاستحسان فإنه يرجع في أكثر صوره وتطبيقاته إلى اعتبار المصلحة، يقول ابن رشد: ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة، والعدل”[15].
ومن القواعد الشرعية التي تثبت حجية المصلحة في التشريع الإسلامي:
أ – الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع[16
ب – الضرر يزال
جـ – الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت[17].
د – تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة[18].
وما سبق إيراده من الأمور تؤكد اهتمام الشارع بمصلحة الخلق، وأن الشريعة لم تأت بتكاليف تخالف مصالح البشر وتعارضها، وإنما وضعها الشارع لتلبية مصالح العباد، فالشريعة مصلحة كلها من حيث تحقيقها لمصالح البشر الدنيوية والأخروية.
[1] معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، مجموعة المؤلفين (3/326).
[2] مقاصد الشريعة الإسلامية (3/ 197)، مرجع سابق.
[3] الموافقات (2/ 9)، تحقيق مشهور حسن.
[4] القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، (3/95)، عالم الكتب، بدون طبعة و تاريخ.
[5] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى (8/94)، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، 1416هـ – 1995م.
[6] ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أعلام الوقعين عن رب االعالمين، (3/ 11)، دار الكتب العلمية، لبنان، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، الطبعة الأولى، 1411هـ – 1991م.
[7] مقاصد الشريعة الإسلامية (3/ 36).
[8] ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية (24).
[9] الموافقات (2/17)؛ نظرية المقاصد عند الشاطبي (145).
[10] الموافقات (2/25).
[11] الموافقات (2/21)؛ نظرية المقاصد عند الشاطبي (145).
[12] الموافقات (2/23).
[13] نظرية المقاصد عند الشاطبي (145).
[14] الاجتهاد والمصلحة والنص (31)؛
يقول القرافي وهو ينقل هذا الاستعمال لدي أرباب المذاهب الأخرى غير المالكية، الذين صرحوا بالإنكار لكن اعتبروها في مجال الاستنباط:
” أما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفوارق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار بل يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة “. انظر: القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة (1/152)، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى، 1994 م.
[15] ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/201)، دار الحديث، القاهرة، بدون طبعة، 1425هـ – 2004 م ؛ الاجتهاد والمصلحة والنص (31).
[16] الزركشي، محمد بن عبد الله، البحر المحيط في أصول الفقه (8/8)، دار الكتبي، الطبعة الأولى، 1414هـ – 1994م
[17] الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين (2/110)، دار المعرفة ، بيروت، بدون طبعة وتاريخ؛ معلمة زايد (5/369)، والصيغة منها.
[18] الزركشي، محمد بن عبد الله، المنثور في القواعد الفقهية (1/309)، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 1405هـ – 1985م
تنزيل PDF