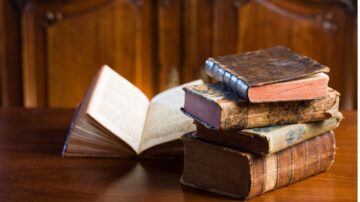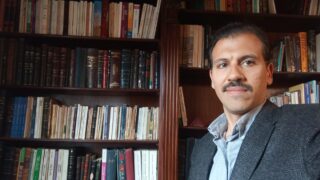أخذ حقل الدراسات التاريخية العربية في التطور والنمو منذ عقود على يد نفر من المؤرخين جمعوا بين الاطلاع على ما أنتجته المدارس التاريخية الغربية والانهماك في دراسة التراث، وجاءت دراساتهم ثمرة لهذا المزج بين الثقافتين، فهم وإن أفادوا من النظريات الغربية التي حاولت تعريف التاريخ ووضعت قوانين تفسره إلا أنهم خالفوهم في ذلك وتبنوا تعريفات ومناهج مغايرة، وفي السطور التالية أتناول آراء المؤرخين العرب حول تعريف التاريخ وكيف نفسره ونكتبه.
مصطلح التاريخ
يتفق المؤرخون على أن كلمة التاريخ لا تحمل معنى اصطلاحيا محددا تشير إليه، كما لا تحمل معنى لغويا واحدا ينصرف إليها الذهن عند سماعها، فعلى مستوى اللغة تعني التعريف بالوقت، وقد تعني مرور الزمن وما حفل به من أحداث، وقد تعني لحظة فارقة في الزمن بسبب أهميتها على نحو ما يذهب إليه البعض من وصف حدث ما بأنه “حدث تاريخي” بالنظر إلى أهميته وتداعياته، ومن ناحية أخرى لا يتفق المؤرخون على تعريف محدد لمصطلح التاريخ ويرجع المؤرخ المصري قاسم عبده قاسم ذلك إلى أن التاريخ علم متنوع المشارب ومعقد ومركب شأنه في ذلك شأن البشر الذين يهتم بتسجيل فعالهم [1].
وهو يفترض أن محاولة تحديد مصطلح التاريخ ينبغي أن تأخذ في الحسبان ثلاثة مستويات من الاستخدامات لكلمة تاريخ:
- الأول الدلالة إلى مجمل النشاط الإنساني أي كل ما أنجزه البشر من أعمال طوال تاريخهم، ولكن خطورة الأخذ بهذا المعنى الشامل للكلمة كما يقول يعني أن يصبح كل حدث تاريخا وهو أمر غير مقبول.
- والثاني النظر إلى التاريخ بوصفه سجلا للحوادث في تتابعها الزمني وليس الحوادث نفسها، وهو أكثر شيوعا واستخداما من سابقه، وهو ينطوي على مستويين فرعيين: أولهما التاريخ من حيث هدفه أي معرفة التبريرات والتفسيرات وراء الحوادث، وثانيهما التاريخ من حيث موضوعه أي باعتباره سجلا للأحداث وتسجيلا لها وهو ما يعرف باسم “صناعة التاريخ”، ذاهبا إلى أن هذا المستوى أقرب للدلالة على المفهوم القرآني للتاريخ الذي يطلب من المؤمنين السير في الأرض والتأمل واستخلاص العبر.
- والثالث الإشارة إلى التاريخ بوصفه علما ونظاما دراسيا، وهو استخدام حديث نشأ في الغرب وليس شائع الاستخدام في الشرق[2].
ماهو تعريف مصطلع التاريخ ؟
ويتفق المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري على ما ذهب إليه قاسم عبده قاسم من اختلاف الآراء في تعريف التاريخ، فهناك من يعتقد أنه البحث عن الحقائق الثابتة، وهي نظرة كانت تسود القرن التاسع عشر لكنها تقلصت كثيرا في عصرنا، وهناك من يعتبره تفسير الحقائق وربطها، فالمؤرخ يختار الحقائق أو بالأحرى يبحث عن حقائق معينة ويجمعها، ثم يكسبها مفهومه التاريخي، وفي الحالتين يكون المؤرخ هو محور الموضوع، ولهذا فإن التاريخ هو “عملية متصلة للتفاعل بين المؤرخ وحقائقه أو هو حوار متصل بين الماضي والحاضر”[3].
التاريخ وكيفية تفسيره
يتصل تفسير التاريخ إلى حد بعيد بالتطور الأكاديمي الغربي، كما يقرر عبد العزيز الدوري، فقد ظهرت في أعقاب الثورة الفرنسية اتجاهات لربط التاريخ بالعلم الطبيعي، حاولت أن تبحث في التاريخ عن قوانين تفسر تطور المجتمعات، ونتيجة لذلك ظهرت نظريات حاولت أن تفسر التاريخ على ضوء: العقل المسيطر، البطل، الجماهير، العامل الاقتصادي وما إلى ذلك.
ويفترض الدوري أنه نظرا لارتباط هذه النظريات بتطور المجتمعات الغربية فإنه “ليس من الدقة أن نأخذها مجردة عن ظروف نشأتها، وإنما أمامنا طريقان:
الأول أن نتبنى نظرية من النظريات ونجد لها التبرير والتأييد في التاريخ، أي نحاول إيجاد ما نريد في التاريخ “ولكن هذه الطريق تجعل التاريخ وسيلة لخدمة أغراض خارجة عنه”.
والثاني، النظر إلى التاريخ بذهن مفتوح وأن نحاول استقراءه للتوصل إلى النتائج، وهذه حالة لا تفترض ذهنا خاليا تماما بل المؤرخ جزء من مجتمع له مشاكله وتياراته الثقافية وهو يتأثر بها.
ويعتقد المؤرخ الإسلامي عبد الحليم عويس أن تفسير التاريخ يكافئ مصطلح فلسفة التاريخ، وهي تعني محاولة اكتشاف قوانين الله في الاجتماع والإنسان والكون، ويتضمن تفسير التاريخ جانبين: جانب التاريخ وهو الوقائع الظاهرة وحركة الأيام وتقلبها، وجانب ما وراء الوقائع الظاهرة من أسباب وتعليلات.
ما الفرق بين المؤرخ ومفسر التاريخ ؟
ويخالف المؤرخ العراقي صالح أحمد العلي ما ذهب إليه عويس من التمييز بين المؤرخ ومفسر التاريخ، ذاهبا إلى أن دراسة الأسباب واستخلاص النتائج هي ما ينبغي أن يكون عليه عمل المؤرخ للأسباب التالية:
- لأن الأقدمين اهتموا بتسجيل الحوادث مفردة، دون الاهتمام ببيان صلتها بالحوادث الأخرى، فلابد للمؤرخ والدارس المعاصر من أن يقوم بالبحث في الأسباب والنتائج، وإيجاد الصلة بين الأحداث التي تبدو ظاهريا متباعدة.
- أن لكل حادثة أسبابا معينة ودوافع معينة، كما أن نتائج كل حادث قد تباين نتائج غيرها، فقد تكون نتائجها متعددة أو محدودة، ظاهرة أو باطنة “كما أن لكل حادثة عدة أسباب وعدة نتائج، وهذه الأسباب والنتائج تختلف في أهميتها، ومن واجب المؤرخ ألا يكتفي بتعداد الأسباب بل أن يقدر مدى أهمية كل سبب، ويبين السبب التافه من المهم، وكذلك النتائج.. وكل ذلك يتطلب ذكاء وفطنة”.
- لأن كل النظريات التي حاولت أن تفسر التاريخ بعامل واحد أو عوامل قليلة، استخلصت نتائج بسيطة وهزيلة وبدورها لم تستطع أن تفسر التاريخ لأنه معقد بتعقد الإنسان، ويحتاج إلى دراسة شاملة تأخذ في الاعتبار الإنسان ونوازعه النفسية والبيئة المحيطة به بكل جوانبها، ولا تزال هذه الدراسة بعيدة المنال[5].
مذاهب في تفسير التاريخ الإسلامي
وإذا كانت الآراء السابقة تحدثت عن تفسير التاريخ عموما فإن عبد العزيز انتقل إلى التخصيص حين تساءل هل لدينا تفسير للتاريخ الإسلامي، وذهب في إجابته أن المؤرخين القدامى قدموا بعض التفسيرات للتاريخ التي شكلت المذاهب العامة للكتابة التاريخية.
وهي كالتالي:
- ذهب بعض المؤرخين أن التاريخ البشري بما فيه التاريخ الإسلامي هو تعبير عن المشيئة الإلهية في توالي الرسالات وآخرها الرسالة الإسلامية، وهو ما نجده لدى الطبري في تاريخه.
- وهناك من اعتقد أن التاريخ الإسلامي هو تعبير عن دور الإشراف العرب الذين حملوا رسالة الإسلام، ويتمثل هذا الاتجاه البلاذري.
- وهناك من فسر التاريخ على ضوء العامل الأخلاقي ورأي فيه العبرة بتصرفات البشر وسبيلا لتلافي الأخطاء كما ذهب مسكويه.
- وهناك من رأى في التاريخ تعبيرا عن فعاليات الأمة بطوائفها وطبقاتها من زهاد وعلماء وكتاب كما نرى في تآليف ابن الجوزي والذهبي.
- وهناك تفسير حضاري اجتماعي كتفسير ابن خلدون الذي يرى أن المجتمعات تبدأ برباط العصبية وتتدرج إلى التوسع ثم الازدهار الحضاري ثم الترف الذي يؤذن بالضعف والانهيار.
كيف نكتب التاريخ ؟
إذا كان المؤرخون القدامى كانت لهم تفسيرات في تفسير التاريخ فإن هذه التفسيرات لم تعد كافية لكتابة التاريخ في عصرنا، ولذا يقترح الدوري أن تتوفر في الدراسة التاريخية المعاصرة عناصر عدة، منها:
1- أن لا تكون دراسة خارجية، أي من قبل أناس خارج المجتمع العربي، لأنه ينقصها الفهم الداخلي والشعور بروح التاريخ العربي.
2- أن لا تكون لدينا فرضيات خارجة عن هذا التاريخ وعن المجتمع الذي صنعه، إذ لا نريد أن نخضع تاريخنا لنظريات وفرضيات بعيدة عنه، بل الأجدر أن تكون فرضياتنا مشتقة من هذا التاريخ ومن محاولاتنا لفهمه.
3-أن نفهم تاريخنا بروح النقد والتفهم، إذ لا نريد إضفاء صفة القداسة عليه لأنه تاريخ بشر، لكننا كذلك لا يمكننا هدم وتقويض حقائقه على مذبح الشك.
4-أن ندرك أن التاريخ يتصل بالحاضر، فالحاضر يثير مشكلات ويكون بعض المفاهيم وهي تؤثر في دراستنا، كما أن للماضي مفاهيمه وتياراته ومن المتعذر فصل الجانبين فهما متكاملان ومتفاعلان.
5-أن لا ننظر إلى تاريخنا نظرة الظواهر الطبيعية الثابتة، فهو وإن كان يتسم بالحيوية والنشاط في بعض الفترات إلا أنه كان أقل حيوية في فترات أخرى، وقد تكون فترات أكثر تأثيرا في وعينا من فترات أخرى.
6-أن نعي أن أي مجتمع وحدة تتداخل فيها العوامل وتتبادل التأثير، فالجوانب السياسية والاقتصادية، والفكرية والنفسية تلعب دورها في التاريخ ولا يمكن إغفال جانب منها أو التقليل منه عند الدراسة[6].
الخلاصة، أن المؤرخين العرب المحدثين بحثوا في مصطلح التاريخ وكيفية تفسيره، كما حاولوا تطوير منهجية لكتابته تلائم الخصوصية الحضارية.
[1] قاسم عبده قاسم، الرؤية الحضارية للتاريخ: قراءة في التراث التاريخي العربي، القاهرة: دار المعارف، 1984، ص 15.
[2] نفس المرجع السابق، ص 24-26.
[3] عبد العزيز الدوري، التاريخ والحاضر في: جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين، تفسير التأريخ، بغداد: مكتبة النهضة، ص 3.
[4] عبد الحليم عويس، تفسير التاريخ: المصطلح والخصائص والبدايات الأولى، بيروت: مجلة المسلم المعاصر، مج 11، ع 41، 1984، ص 35.
[5] صالح أحمد العلي، تفسير التاريخ، في: جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين، تفسير التأريخ، بغداد: مكتبة النهضة، ص 27-29.
[6] عبد العزيز الدوري، المرجع السابق، ص 11-13.
تنزيل PDF