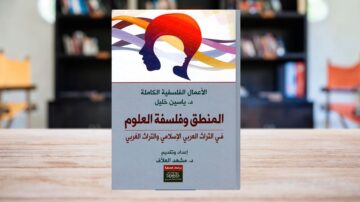تتجاوز دوافع كتاب ” المنطق وفلسفة العلوم ” حدود السرد التاريخي الضيق، لتقدم رؤية تحليلية تكشف عمق المنهج العلمي عبر الحضارات. في جزأيْن تحت عنوانين متكاملين حيث يعمد الدكتور ياسين خليل إلى تفكيك الأسطورة القائلة بأن التراث العربي الإسلامي كان وسيط ناقل للمعارف اليونانية الجامدة، ويثبت أنّه ساحةُ إبداع نقدي أصيل.
ينفتح الكتاب على حوار معرفي جريء مع عمالقة المنطق وفلسفة العلوم في الغرب، ليمنح القارئ رؤيةً ثنائية الأبعاد، فيبدأ أولا بتقديم الحجج المدعمة بالأدلة حول الأصالة المنهجية للعرب والمسلمين، ثم ينخرط في حوار نقدي موضوعي مع كبار الفلاسفة والمنطقيين الغربيين..
في هذه الأسطر نستعرض كتاب“المنطق وفلسفة العلوم” بجزأيه.
الجزء الأول : المنطق وفلسفة العلوم في التراث العربي الإسلامي
يبدأ خليل بتعريف التراث الحضاري بوصفه جملةً جامعةً لكل إنجازٍ فكري ومادي، مشددًا على أن الحضارة العربية، المحددة باللسان والفكر لا بالعرق، جزءٌ أصيل ومستقل من الحضارة الإنسانية الكبرى. يرفض المؤلف اعتبارها تابعةً للتراث اليوناني، ويركّز على أن للمفكرين العرب منهجياتٍ خاصة مستمدة من بيئتهم الفكرية وثقافتهم المحلية.
تعزّز مكانة اللغة العربية في الكتابة العلمية إذ يصفها وعاءً معرفيًا وركيزةً للهوية وعاملًا أساسيًا لتوطين المصطلحات. ولعلّ أبلغ دليلٍ على ذلك إنشاء المصطلحات الخاصة التي رفعت مستوى العلوم المترجمة، فصارت في دوائر البحث لغةً قائمةً بذاتها، تواكب خصوصيات الخطاب العربي ومستوعبًا دقيقًا لمتطلبات التعبير المنطقي والفلسفي.
التجربة الاستقرائية بين الكيمياء والطب والفلك
يطرح الكتاب سؤالًا محوريا هل كان للعرب منهج علمي خاص بهم؟ ويجيب بالإيجاب مستعرضا كيف طوّر العلماء المسلمون مناهج تجريبية واستقرائية بدائية في مجالات الكيمياء والطب والفلك، مخالفةً النهج الاستنباطي اليوناني. يسلط الضوء على تجارب ابن الهيثم في البصريات، حيث اعتمد على الملاحظة الدقيقة والتجربة المنهجية لصياغة قوانينٍ بصرية حسّاسة. وكذلك إبداعات جابر بن حيان في الكيمياء، الذي أسس عمليات التقطير والتبخير بغرض التحقق العملي من الفرضيات، مما أضاف بعدًا تجريبيًا مغايرًا تمامًا للتراث اليوناني النظري.
المنطق العربي من الترجمة إلى الإبداع
يتتبع خليل مسار المنطق الأرسطي في العالم الإسلامي، مبينًا كيف تحوّل هذا المنطق من نصٍ مترجَم إلى أداةٍ نقديةٍ حيّة. يبرز دور الفارابي الذي أضاف تصنيفات جديدة لعلم المنطق، واجتهد في ملاءمة مصطلحاته مع اللغة العربية، مستعرضًا تقسيماته للأصناف المنطقية، وإسهامه في دمج المنطق بالمعرفة الموسوعية.
ثم يأتي ابن سينا، الذي طور أساليب استدلالية لفهم العلاقات السببية، فأضحى كتابه “الشرط والنقيض” مرجعًا فريدًا في المناقشة الفلسفية. ولا يقل ابن حزم أهميةً، إذ ابتكر نظرية “الحجة القطعية” التي أسهمت في تعزيز اليقين المنطقي، مُظهِرًا قدرة العقل العربي على إثراء المجال المنطقي بطرائقٍ لغويةٍ خاصة.
وما يعزز هذه المكانة أن كتب المنطق العربية انتقلت في العصور الوسطى إلى أوروبا، حيث طوّرتها حركات السكولاستيين ليشهد المنطق المدرسي ازدهارًا ملحوظًا، فتجاوزت دائرة الحوار اليوناني القديم نحو مناهجٍ أكثر تنظيماً ودقة.
التحديات المعاصرة لإحياء التراث العلمي
ينتقل خليل من التحليل التاريخي إلى استشراف واقعنا العلمي الراهن، معتبرًا أن الجامعات والمؤسسات الحديثة مطالبةٌ بإعادة إحياء التراث العلمي العربي عبر برامج بحثية واستراتيجيات تعليمية متجددة.
ويوضح الكاتب أن هيمنة اللغات الأجنبية على المناهج الأكاديمية، بالإضافة إلى ضعف الصلة بين التعليم العالي واحتياجات المجتمع المحلي، تشكل عوائق أساسية. ويؤكد أن التعريب لا يقتصر على الترجمة الحرفية، بل هو “توطينٌ للعلم”، أي نقلٌ للمعرفة إلى بيئتها الثقافية الأصلية، مما يعزز قدرة الباحث على الابتكار والتجديد بلغته الأم.
كما يناقش قضايا التعريب ومعضلاته، معتبرًا أن المشاريع الترجميّة بدون إطار منهجي شامل تفشل في توفير بيئة معرفية متماسكة، وينادي بضرورة إنشاء مصطلحاتٍ علمية جديدة ومعاجم متخصصة تدعم الباحثين والطلبة على حدّ سواء. ويرى أن تعزيز النشر العلمي باللغة العربية، وربط الدراسات الأكاديمية بسوق العمل المحلي، يُعزّزان ثقة الباحث العربي بقدراته ويعززان حضور تراثه في محافل العلم العالمية.
الجزء الثاني : حوار نقدي مع التراث الغربي
فتح خليل حوارا نقديا مع رموز المنطق وفلسفة العلوم في الغرب في الجزء الثاني من كتابه، وبدأ بجوتلوب فريجه، معتبرا إسهاماته تأسيسا للمنطق الرياضي الحديث عبر لغة اصطناعية منطقية تحمل مفاهيم الدلالة والمعنى، وممهدةً لظهور المنطق الرمزي. ثم انتقل إلى برتراند رسل، موضحا كيف بنى فلسفته التحليلية على نظرية الذرية المنطقية التي تفترض أن الواقع مبني من طرائق تعبيرية بسيطة، وبيّن تأثيره العميق على حركة فيينا وفلاسفة الوضعية المنطقية.
فلاسفة الفيزياء وتحدي الميتافيزيقا
ناقش خليل فلسفة آرثر إدينغتون الذي حاول ربط مبادئ ميكانيكا الكم والنسبية بمعاني فلسفية ترتكز على علاقة العقل البشري بأدوات الرصد. ثم سلط الضوء على إرنست ماخ، ذلك الفيلسوف والعالم التجريبي الذي انتقد مفاهيم نيوتن المطلقة، ودعا إلى تطهير العلم من الميتافيزيقا والتركيز على الظواهر القابلة للرصد، وشرح كيف أثرت أفكار ماخ على أينشتاين ومهدت الطريق لنظريات الحالة النسبية.
الوضعية المنطقية ومذهب الاصطلاحية الصورية
تحت شعار مبدأ التحقق اجتمعت “جماعة فيينا” على اعتبار أن المعنى العلمي لا يتجاوز ما يمكن التحقق منه تجريبيا. في هذا السياق، يصنف خليل نفسه ضمن مناصري “الاصطلاحية الصورية”، التي ترى أن الكثير من المفاهيم العلمية ليست كيانات ميتافيزيقية، بل اتفاقات اصطلاحية بين الباحثين، لصياغة القوانين بصياغة دقيقة رياضيا ومنطقيا.
خلاصة
يمنح الكتاب القارئ فرصةً لاكتشاف المنهج المستقرئ العربي، والإبداع المنطقي الإسلامي، والنقاش الفلسفي الغربي في إطارٍ متوازن، بعيدًا عن التعصب وأرجحية أي حضارة على أخرى، مما يجعل من قراءته تجربةً فكريةً ثرية تعيد بناء الثقة بالذات العلمية العربية وتفتح آفاقًا جديدة لبحث نقدي معمق.