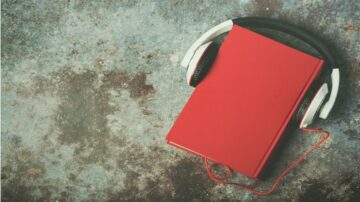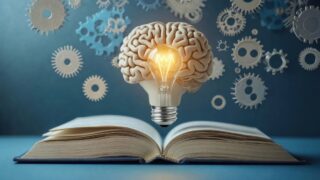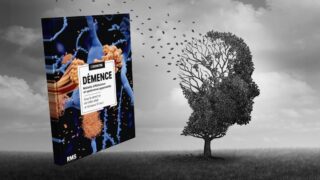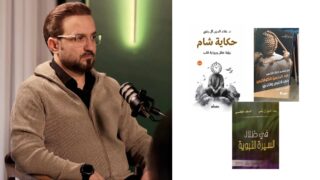علوم الموسيقى فن من الفنون الجميلة التي تعبر عن الطبائع الإنسانية، وهي تنقسم إلى مجموعتين: فنون تخاطب السمع وهي الموسيقى والشعر، وفنون تخاطب البصر وهي العمارة والنحت والتصوير، وفيما مضى اعتبر الشعر أرقى الفنون الجميلة لكن الموسيقى باتت تنازعه هذه المنزلة واحتج المدافعون عنها بأنها تؤثر في الحيوان كما الإنسان، ولهذا وصفت بأنها طبيعية وأن النفس الإنسانية تميل إليها.
وأول من اعتنى بالموسيقى وخصها بالبحث والتدوين فلاسفة اليونان، ولكن العرب في جاهليتهم لم يكونوا أقل اهتماما بالموسيقى لارتباط الشعر العربي بالبحور والإيقاعات الموسيقية، وتواصل الاهتمام بعد ظهور الإسلام يشهد على ذلك اهتمام الخلفاء بأصحاب المغنى والمعازف والشعراء، ونشاط حركة ترجمة تراث اليونان الموسيقي بالتزامن مع انبعاث حركة التصنيف الموسيقي العربي، وقبيل أن نتحدث عن مظاهر النهضة الموسيقية في الحضارة الإسلامية تجدر الإشارة بإيجاز إلى بعض نواحي الجدل الإسلامي بشأن الموسيقى من خلال ما كتبه الإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) باب آداب السماع والوجد.
الموسيقى والسماع عند الإمام الغزالي
والفكرة التي ينافح عنها الغزالي هي أن السماع والموسيقى ليسا من المحرمات، وهو يسوق حججا شرعية وعقلية ليبرهن على ذلك؛ وحجته الشرعية “أن قول القائل السماع حرام معناه أن الله تعالى يعاقب عليه، وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقل بل بالسمع؛ ومعرفة الشرعيات محصورة في: النص أو القياس على المنصوص، وأعني بالنص ما أظهره ﷺ بقوله أو فعله وبالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله، فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول بتحريمه وبقى فعلاً لا حرج فيه كسائر المباحات.
وأما الحجة العقلية فأولها استظهاره من قوله تعالى (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) الدلالة “بمفهومه على مدح الصوت الحسن، ولو جاز أن يقال إنما أبيح ذلك بشرط أن يكون في القرآن للزمه أن يحرم سماع صوت العندليب لأنه ليس من القرآن، وإذا جاز سماع صوت غفل لا معنى له فلم لا يجوز سماع صوت يفهم منه الحكمة والمعاني الصحيحة”.
وثانيها ادعاءه أن الغناء يؤثر في الإنسان كما يؤثر فيمن لا يعقل ويسوق لذلك مثالين، الطفل الصغير في مهده حين تهدده أمه فينصرف عن بكائه ليستمع إليها، والجمل “مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثراً يستخف معه الأحمال الثقيلة، … فتراها إذا طالت عليها البوادي واعتراها الإعياء والكلال تحت المحامل والأحمال إذا سمعت منادي الحداء تمد أعناقها وتصغي إلى الحادي ناصية آذانها وتسرع في سيرها” ويستخلص من ذلك “أن من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج”.
ويذهب الإمام الغزالي أن الغناء يصح بلا نكير في عدد من المواضع وحكمه فيها يدور بين الندب والإباحة، ومنها:
- غناء الحجيج، فإنهم يدورون في البلاد بالطبل والشاهين والغناء، وذلك مباح لأنها أشعار نظمت في وصف الكعبة والمقام وزمزم وسائر المشاعر وغيرها وهي مما يهيج الشوق إلى حج بيت الله تعالى.
- أناشيد الحث على الجهاد، وهي مما اعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو والجهاد.
- والرجزيات التي يستعملها الشجعان وقت النزال، والغرض منها تشجيع النفس وتحريك النشاط في الأنصار للقتال، وفيه مدح الشجاعة والنجدة.
- غناء الرعاة، ويعرف باسم الحِداء، وهو مما يستعين به الرعاة لتحفيز الأبل على السير وبعث النشاط فيها.
- الغناء الاجتماعي، كما في أوقات السرور مثل الغناء في: أيام العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب، وفي الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود وعند ختانه وعند حفظه القرآن العزيز، وكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور به.
لكن الإباحة لديه ليست مطلقة فالغناء ينقلب محرما إن اعترضه خمسة عوارض، كأن يكون الغناء لامرأة لا يحل النظر إليها ويخشى الفتنة منها، أو تكون الآلة من شعار أهل الشر والفساد وهي: المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه الأنواع الثلاثة محرمة لديه، أو كان الشعر الذي يتغنى به فحش وخنا، أو أن تغلب على المستمع شهوته وخصوصا إذا كان شابا، وأخيرا أن يكون المستمع من العوام الذين لم يتمكن حب الله من قلوبهم فيؤثر اللهو والسماع على العبادة والقربات.
منزلة الموسيقى بين العلوم
لم يجد المسلمون إذن غضاضة في الاهتمام بالموسيقى، وخصوصا عندما تصبح احدى طرق تهذيب النفس أو وسيلة لإظهار الفرح والسرور في المناسبات الاجتماعية، ويبدو أنهم لم ينظروا إليها بوصفها نشاطا ترفيهيا وإنما علما من العلوم، ومن أوائل من ذكر ذلك الخوارزمي وهو من أهل القرن الرابع في موسوعته (مفاتيح العلوم) التي أحصت العلوم في عصره علما علما، حيث تناول علم الموسيقى من ثلاث وجوه، هي: الآلات وأسمائها وهي إحصاء دقيق وشرح للآلات الموسيقية في القرن الرابع، وما كتبه الحكماء حول الموسيقى، وأخيرا الإيقاعات الموسيقية والفروق بينها.
وتحدث ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) في القرن التالي عن موقع علم الموسيقى بين العلوم، وأن العلوم عند أهل الديانات على ثلاثة أقسام:
- علم أعلى، وهو علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أوله الله في كتبه.
- وعلم أوسط، وهو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره، ويستدل عليه بجنسه ونوعه، والفلاسفة يرون أن العلم الأوسط أربعة هي: الحساب والتنجيم والطب والموسيقى “ومعناه تأليف اللحون وتعديل الأصوات ورن الأنقار وأحكام صنوف الملاهي”
- وعلم أدنى، وهو علم لا للدنيا وللآخرة مثل الشعر والاشتغال به.
يستفاد مما ذكره ابن عبد البر أن العرب صنفوا الموسيقى ضمن فئة العلم الأوسط واعتبروها فرع عن العلوم الرياضية، وظل هذا التصنيف سائدا حتى القرن الحادي عشر الهجري- وربما بعده- حيث تحدث حاجي خليفة عن علم الموسيقى باعتباره ” علم رياضي” يبحث في: أحوال النغم من حيث الاتفاق والتنافر، وأحوال الأزمنة المتخللة بين النقرات من حيث الوزن وعدمه؛ ليُعرف كيفية تأليف اللحن.
ويشتمل علم الموسيقى لدى خليفة على بحثين: أحوال النغم أو ما يسمى علم التأليف، والأزمنة أو ما يطلق عليه علم الإيقاع والغرض منه: حصول معرفة كيفية تأليف الألحان، وهو في عرفهم أنغام مختلفة الحدة، والثقل، رتبت ترتيبا ملائما، وغاية علم الموسيقى ليست المتعة وإنما هي “تأنيس الأرواح، والنفوس الناطقة، إلى عالم القدس، لا مجرد اللهو، والطرب” كما يفترض حاجي خليفة.
ويتصل بالموسيقى علم آخر هو “علم الآلات الموسيقارية العجيبة” يبحث في الآلات الموسيقية ويذكره صاحب (كشف الظنون) ضمن العلوم المتداولة في عصره، وهو علم يتعرف منه كيفية صنعها وتركيبها، وأورد فيه ثلاث مجموعات من الآلات الموسيقية :
- الطبول وآلات القرع من مثل: الكوس، والطبل، والنقارة، والدائرة.
- والمزامير: ومنها الناي، والسورنا، والنفير، والمثقال، والقوال، وآلة يقال له: بوري، ودودك.
- وذات الأوتار: ومنها الطنبور، والربابة، وآلة يقال لها: قبوز، وجنك، وغير ذلك.
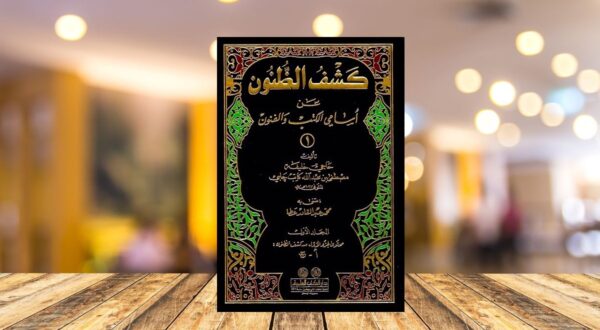
العرب والتصنيف الموسيقي
هناك الكثير من الكتب الموسيقية التي ذكرتها المصادر الأدبية وأشارت إليها وجلها مفقود لم يعثر عليه، وأقدمها يعود إلى عهد الخلافة الأموية ويسمى (كتاب النغم) ليونس الكاتب (ت: 148)، ويمكن تصنيف ما وجد منها ضمن فئات، وبيانها كالتالي:
- مصنفات من وضع الفلاسفة: اتجه الفلاسفة المسلمون إلى التصنيف في الموسيقى، ولعل أبرز من صنف فيها الكندي (256ه) وله ست كتب هي: الكتاب الأعظم في التّأليف، رسالة في اللّحون والنّغم، رسالة في أجزاء خبريّة في الموسيقى، رسالة في خبر صناعة التّأليف، كتاب المصوّتات الوتريّة من ذات الوتر الواحد إلى ذات العشرة أوتار، مختصر الموسيقى في تأليف النّغم وصنعة العود أو قول على اللّحون، وسار على نهجه الفارابي (ت: 339ه) وله سبع مؤلفات موسيقية منها: المدخل إلى صناعة الموسيقى (المقالة الأولى)، رسالة في علم الموسيقى، كتاب الموسيقى الكبير، كتاب في الإيقاعات.
- مصنفات في علم الموسيقى: وهي مصنفات تتناول الموسيقى والعلوم المرتبطة بها كعلم اللحن وعلم الإيقاع، ومنها: (النغم والإيقاع) لـ إسحاق الموصلي (ت: 235ه) و(مختصر فن النغمة) لثابت بن قرة (288 ه) صاحب التآليف الموسيقية الفريدة، و(العود والملاهي) (وكتاب في الموسيقى) وكلاهما ليحيى بن علي المنجم، و(مختصر في فن الإيقاع) لأبي الوفاء البوزجاني من أهل القرن الرابع، و(رسالة في علم الأنغام) لشهاب الدين العجمي، و(الأدوار) لصفي الدين الأرموي (ت: 693ه)، ورسالة في علم الموسيقى لصلاح الدين الصفدي (ت: 764ه)، وكتاب (رسالة في تشريح آلات الصوت) لحنين بن إسحاق.
- مصنفات في الآلات الموسيقية: وهي كثيرة وأشار إليها كُتاب الببليوغرافيا ولكن جلها مجهول المؤلف أو المترجم لأن عدد لا بأس به منها تمت ترجمته عن اليونانية، ومن أمثلتها: صنعة الأرغين (الأرغن) للزمري، ورسالة صنعة الجُلجل، ورسالة في صنعة البوق وجميعها مجهول المؤلف وذكرها المؤرخ الموسيقى فارمر، و(كتاب في آلة الزمر) لثابت بن قرة.
تحملنا هذه المصنفات على الاعتقاد أن الموسيقى لم تكن علما هامشيا أو مهملا لدى العرب، وأن دائرة التصنيف فيها اتسعت وتنوعت بحيث لم تقتصر على الجانب النظري وإنما شملت كذلك الجانب العملي، وقد حفلت بالمصنفات بالرسوم التوضيحية والنظريات الموسيقية والمصطلحات، وهو الأمر الذي يبرهن أن العرب أسهموا في تطوير علوم الموسيقى ولم يكونوا مجرد نقلة لتراث اليونان.
تنزيل PDF