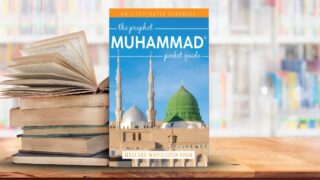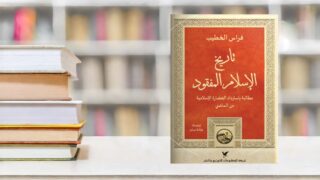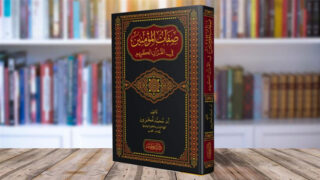صدر مؤخرا كتاب جديد للدكتور نايف بن نهار بعنوان “من العلمانية إلى الخلقانية”، يدعو بين طياته بضرورة التخلّص من مصطلح “العلمانية”، واستبداله بمصطلح جديد “سكّه” الكاتب سكاً هو “الخَلْقانية” باعتباره الأكثر دقة وتعبيرا ليكون مفهوما بديلا مستمدا من ذاتنا الحضارية، بعيدا عن الغربنة والسياقات الإشكالية.
يطرح الدكتور نايف بن نهار مصطلح الخلقانية، وهو يطمع أن يحرر العقل العربي والمسلم من أغلال مصطلح العلمانية الذي كان أسيرا له لأكثر من مئة عام، دون أن نشعر أننا تقدمنا خطوة واحدة في مناقشة هذا المصطلح وفهمه الفهم الصحيح.
فإذا حصل التمايز بين السلطة المتشرعة والسلطة اللادينية، فإن الاعتقاد بالسلطة اللادينية هو ما يسميه الكاتب نايف بن نهار “الخلقانية”، والذي يقصد به “الموقف الذي يدعو إلى جعل المرجعية التشريعية العليا محصورة في الخلق، فلا مدخل لتشريع الخالق مطلقًا. فأنت إذا أقصيت الدين عن السلطة فإن النتيجة المباشرة أن المرجعية التشريعية العليا ستؤول للخلق حصرًا”.
وإذا كانت العلمانية حين تطلق في السياق الإسلامي يُقصَد بها فصل الدين عن السلطة، وإذا كان هذا المعنى غير خليق بالعلمانية، فإن المصطلح الذي ينبغي أن يكون بديلاً للعلمانية في السياق الإسلامي هو مصطلح الخلقانية، لأنه هو الذي يعبّر تعبيرا دقيقًا عن مقصود فصل الدين عن السلطة، من خلال عزوه المرجعية التشريعية للخلق دون الخالق، وهذا هو مطلوب الفاصلين بين الدين والسلطة.
كاتب وكتاب
الدكتور نايف بن نهار كاتب وأكاديمي وأستاذ جامعي قطري، مدير “مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية” الذي يعتبر أحد المراكز البحثية الرئيسية بجامعة قطر، لديه العديد من المؤلفات نذكر منها: “مقدمة في علم المنطق”، “مقدمة في علم النحو”، “الديموقراطية كما هي”، “مقدمة في علم أصول الفقه”، “مقدمة في علم العلاقات الدولية”.
أما كتابه الجديد “من العلمانية إلى الخَلْقانية” الصادر إلكترونيا منذ أيام قليلة، والذي يقع في حدود 380 صفحة، فهو متاح للتحميل المجاني على رابط منشور في تغريدة للكاتب على حسابه الرسمي في “تويتر”، حيث طلب ممن يقرأ الكتاب ويجد ملحوظات فليمنَّ عليه بإرسالها إلى بريده الالكتروني حتى يتمكن من التصحيح قبل طباعة الكتاب ورقيًا.
يقسم الكتاب إلى ستة أقسام، تناول المؤلف في القسم الأول، الذي جاء بعنوان “مع الكتاب”، عرض الفكرة الأساسية للكتاب وتلخيص الفكرة المركزية، وفي القسم الثاني بعنوان “مع العلمانية” شرح الكاتب العلمانية كمصطلح وكتأريخ وكمفهوم، قبل أن يتوسط في مهمة فك الاشتباك بين مفاهيم فصل الدين، ويتطرق إلى مسألة الانتقال من العلمانية الإجرائية إلى العلمانية المؤدلجة، ومن العلمانية إلى السلطة اللادينية، ثم يعرض منطقية العلمانية في سياقات بعض الدول.
وفي القسم الثالث الذي جاء بعنوان “مع العلماني”، سلط الكاتب الضوء على العلمانيين العرب من خلال ما أسماه خطيئة الاستيراد العشوائي، وتعرض لمسائل مثل تفكيك الاستبداد وتفكيك الهوية، وكشف أوهام ومغالطات العلماني العربي الداعم للاستبداد والمحتكر للعقلانية، وأيضا العلماني المتحدث باسم الدين.
القسم الرابع خصصه المؤلف لمصطلحه الجديد “الخلقانية” وتناول فيه عولمة الخلقانية كامتداد لعولمة فرضيات خاطئة وتحدث عن إشكالية المنطلق ومأزق المرجعية، الأحادية والمتكاملة، ومرجعية العلم ومرجعية الدين.
في القسم الخامس بعنوان “مع الإسلام” تناول الكاتب مسألة الخصوصية الإسلامية في جدل الدين والسلطة، واتخذ من مقاربة سبينوزا نموذجا لتجاوز الخصوصية الإسلامية، كما تحدث عن مسوغات فصل الدين عن السلطة في السياق الإسلامي، ومسألة المطالبة بالسلطة اللادينية.
وفي القسم السادس والأخير بعنوان “مع الأسلمة”، قسمه الكاتب إلى ثلاث عناوين أو مقاربات هي: المقاربة النصية والمقاربة البراغماتية، ثم المقاربة المنطقية وهي تحديدا مقاربة الدكتور عادل ضاهر التي اتخذها الكاتب نموذجا لبحثه.
تجديد العلمانية بمصطلح قرآني
الكتاب ينطلق من فكرة أساسية يطرحها الدكتور نايف بن نهار هي أننا في العالم الإسلامي نحتاج إلى مصطلح جديد يعبّر عن محل الخلاف تعبيرا مباشرا، ومحل الخلاف عندنا – حسب رأي الكاتب – يتمركز في مسألة أساسية، وهي طبيعة تموضع الدين دستوريًا، هل المرجعية التشريعية العليا للخالق أم محصورة في الخلق؟ هذه منطقة الخلاف الحقيقي، لكن مصطلح العلمانية لا يقودنا إلى هذه المنطقة.
لأجل ذلك يقترح الكتاب مصطلح “الخَلْقانية” التي تعني الاعتقاد بأن المرجعية التشريعية محصورة في الخلق. ويفسر الكاتب مصدر استمداد هذا المصطلح، من قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الأعراف-54) فهذه الآية الكريمة تخبرنا أن الخلق لله، والأمر الذي يدبّر هذا الخلق هو أيضًا لله تعالى، فلم يترك الله الخلق هملاً بلا قانون.
ويضيف الكاتب بأن الذين يطالبون بفصل الدين عن السلطة هم عمليًا يرون الأمر للخلق وليس للخالق، ولأنهم يحصرون التشريع في الخلق دون الخالق فهي خَلْقانية إذن. لذلك مصطلح ” الخَلْقانية” هو الأكثر كفاءة في التعبير عن طبيعة جدل الدين والسلطة في السياق العربي والإسلامي، ويجعلنا في مواجهة مباشرة مع الإشكال.
3 أسباب للتخلص من مصطلح العلمانية
يقول الكاتب إنه إذا كنا نريد فعلا الانتقال من الجدل المفاهيمي التأريخي إلى الجدل المعياري الحاضر فلا بد من استئناف مصطلحي، أما اللجوء إلى المداخل المصطلحية التي تحيلنا إلى سياقات ثقافية مختلفة فهذا أساس البلاء الذي جعل الباحثين العرب اليوم يفهمون الثقافة الغربية أكثر مما يفهمون ثقافة مجتمعاتهم.
ويوضح الكاتب أن هناك ثلاثة أسباب جعلته يدعو للتخلص من مصطلح “العلمانية” وتعويضه بمصطلح “الخلقانية”:
- السبب الأول: لأن مصطلح العلمانية لا يمتلك الكفاءة الدلالية للتعبير عن طبيعة جدل الدين والسلطة في السياق العربي والإسلامي.
- السبب الثاني: لأن المصطلح يعبّر عن مرحلة تاريخية من مستويات الفصل الديني انكمشت بعد الثورة الفرنسية.
- السبب الثالث: لأن العلمانية مصطلح زئبقي يصعب الإمساك به.
ويطرح الكاتب جملة من الأسئلة تدور حول غموض هذا المصطلح: هل السئلةالأفهل العلمانية هي فصل رجال الدين عن السلطة أو فصل الدين نفسه؟ وهل هي فصل الديني عن السلطة أو عن السياسة أو عن الفضاء العام؟ ويقول إن العلمانية تُطلق خطأً على كل هذه المستويات، وهذا هو أساس اللبس الذي يجعل معظم حواراتنا حول العلمانية حوارات تائهة.
العلمانية مصطلحًا..الغربنة نتيجةً
يقول الكاتب نايف بن نهار أن العالم العربي لا يعاني من عبء الأفكار فحسب، بل يعاني أيضا من عبء المصطلحات. ويتحدث عن أزمة في هذا المجال يعتبر مصطلح العلمانية أحد تجليّاتها، فهو مصطلحٌ قد أربك الثقافات كلها علـى وجه العموم. فكلمة العلمانية إنْ أنت فتحت عينها “عَلمانية” ستجد أنها تعود إلى “العالم”، وما دلالة العالم هنا؟ هل المقصود أنه يؤمن بالعالم دون الغيب؟ وهذا ما يجزم بالمآل الإلحادي للعلمانيين، أو أنَّ المقصود بالعالم الدنيا، أي ما يقابل المؤسسات الدينية، وتاليًا تكون المعركة مع الثيوقراطيين تحديدًا؟ أما إذا كسرنا العين فالعودُ في هذه الحالة إلى “العلم”، وهذا يشق طريقًا مباينًا تمامًا في مفهوم العلمانية، إذ إن كانت العلمانية نسبةً للعلم فلن يكون بينها وبين الإسلام أي توتر في العلاقات، بل ستكون خادمةً لمقاصده.
ويؤكد الكاتب أننا في السياق الإسلامي لسنا معنيين أصلاً بهذا المصطلح، إذ إنه لا يعبّر عن حالة متحققة في الواقع، وإنما المصطلح الذي يعبّر تعبيرا مباشرا عن طبيعة الصراع في العالم الإسلامي هو مصطلح “الخلقانية”، لأن الخلاف في العالم الإسلامي ليس: هل يحكم رجال الدين أو لا يحكمون؟ وإنما الخلاف حول: هل تكون المرجعية التشريعية العليا للخالق أو للخلق؟ والمصطلح الخليق بهذا المعنى هو المصطلح الذي يعبّر عن كمون التشريع في الخلق دون الخالق، وهو مصطلح “الخلقانية” لا العلمانية.
أما الإصرار علـى مصطلح “العلمانية” فلن يضيف لنا في العالم الإسلامي سوى أعباء وهمية، وسيكون المسؤول الأول عن تيه الحوارات بين النخب والفاعلين في مجتمعاتنا.
أما مصطلح “الخلقانية” فهو يعتذر لكل تلك الأعباء مدعيًا أنه ليس معنيًا بها، وإنما هي مسؤولية الإنسان الغربي الذي نشأت تلك الأعباء في سياقه وتعبيرا عن احتياجاته ومعطياته الثقافية والسياسية. ثم إن حجم الغموض والنزاعات حول العلمانية جعل مساحة المراوغة بين المثقفين كبيرة جدًا، فصار الجدل حول العلمانية جدلاً عقيمًا ينتهي قبل أن يبدأ، أما الآن مع وجود مصطلح يدل علـ محل النزاع دلالة مباشرة فإن الحوار سيبدأ وينتهي دون أن يخطو خطوة خارج السياق الإسلامي والعربي، وسيشتبك طوعًا أو كرًهًا مع قضايا واقعه ومعطيات ثقافته.
وينتهي الكاتب إلى أن ما نسميه “العولمة” ليس في حقيقته سوى “الغربنة”، إذ لم نشهد في هذا العالم عولمة أي قيم غير غربية، ولا معارف غير غربية، ولا ممارسات غير غربية، فأين العولمة إذن؟ لأجل ذلك كان الأدق أن يُسمـ ما نشهده «الغربنة»، أي جعل الإنسان الغربي نموذجًا لبقية العالم في كل مجالاته.
الخلقانية مصطلحًا..الإسلام حضورًا
يقول الدكتور نايف بن نهار إن مصطلح الخلقانية مصطلح مستمدٌ من ذاتنا الحضارية ويؤول إليها، إذ إن اللفظ مستمد من النص المؤسس للحضارة الإسلامية، وهو الوحي. وفي الوقت نفسه يعبّر عن الإشكال الذي نواجهه اليوم في مجتمعاتنا بنحو مباشر، فهو بذلك لا يبالي بأعباء التاريخ الي تثقل مصطلح العلمانية مما لا علاقة له البتة بسياقنا الإسلامي والعربي. وهذا يعي أنَّ مصطلح الخلقانية سيجعل الباحث في مواجهة مباشرة مع محل النزاع وأساس الإشكال، وهو: هل تكون المرجعية التشريعية العليا للخالق أم للخلق؟ هذا هو محل النزاع والخلاف، فمن قائلٍ إن المرجعية العليا يجب أن تكون للخالق، وقائل إنَّ المرجعية كامنة في الخلق دون الخالق، وهكذا أحالنا مصطلح الخلقانية إلى محل النزاع إحالةً مباشرة.
أما العلمانية فإن أي باحث عربي يريد الحديث عنها فإنه مضطر للاشتباك مع قضايا تاريخية واجتماعية وسياسية ضاربة في جذورها في المجتمعات الغربية، ولا يكاد باحثان يتفقان علـى معنى العلمانية وحدودها، فأنت حين تريد الإجابة عن سؤال العلمانية تأييدًا أو رفضًا فإنه تعتريك الحاجة إلى أن تجيب علـى عشرات الأسئلة، وتضطر أن تمر علـى مناطق مفخخة غالبًا لا تنجو منها، ولذلك دائمًا تفترق الطرق في مناقشة سؤال العلمانية عند تأريخها أو مفهومها، أما الوصول إلى مرحلة الحكم المعياري عليها فهذه مرحلة لا تُرى بالعين المجردة في حواراتنا المعاصرة إلا تجوزا.
لماذا الخلقانية؟
يؤكد الكاتب أن السلطة إذا كانت “لادينية”، فإنَّ ذلك يعني أن مرجعيتها محصورة في الخلق، وإذا كانت محصورًةً في الخلْق فهي إذن “خلقانية”، هذا هو المصطلح الذي يؤكد الكاتب أنه “يسكّه” في هذا الكتاب بديلاً عن العلمانية، فهو الأخلق والأجدر بأن يكون المصطلح المعبّر عن فكرة فصل الدين عن السلطة. ذلك لأن العلمانية فصلٌ لرجال الدين عن السلطة لا للدين نفسه، أما فصل الدين نفسه فهذه سلطة لادينية، ويقول المؤلف لأن السلطة اللادينية تعيد المرجعية للخلق دون الخالق فقد أسميناها “الخَلقانية”، أي السلطَة التي تجعل المرجعية في الخلق لا في الخالق. فالله عزوجل يقول: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ والمتشيّعون لفصل الدين عن السلطة يقولون الأمر للخلق لا لله تعالى، فلأنهم يعزون الأمر إلى الخلق حصرا فهم خلقانيون إذن. وسوف نشرح ذلك تفصيلاً في مبحث فك الاشتباك بين مفاهيم فصل الدين. إذن فصل رجال الدين عن السلطة يسمـى علمانية، وفصل الدين نفسه يسمـى سلطة لادينية/خلقانية.
فك الاشتباك بين المفاهيم وضبطها لحل الخلاف
يضع نايف بن نهار لكتابه الجديد مهمتين أساسيتين: الأولى ضبطُ مفاهيم الفصل الديني بمستوياته المختلفة، والمهمة الثانية تحرير محل النزاع في جدل الدين والسلطة وما يترتب على ذلك من مقاربات مختلفة الاتجاهات.
ويرى أن غاية الضبط المفاهيمي من أهم غايات التأليف، إذ إن غياب المفاهيم المنضبطة يعني غياب اللغة المشتركة التي من خلالها نفهم بعضنا بعضًا بما يسمح لنا بالحكم علـى الأفكار دون توهّم الاختلاف. وليست مبالغة أن معظم الخلافات الفكرية بين الباحثين هي خلافات في محل النزاع وليست عليه، فلأننا نتحاور في مفاهيم غير منضبطة ولا محررة فإن أحكامنا لم تشترك كلها في إصابة المفهوم نفسه، وإنما كل حكم أصاب مفهوًمًا مختلفًا فأنتج حكمًا مختلفًا، فأدى ذلك إلى اختلاف الأحكام، لا لاختلاف الأدلة والمواقف القيمية، بل لعدم اتحاد المفاهيم في عقول المختلفين. فالمثقف يصدر حكمًا علـى العلمانية وأغياره يصدرون، ويتلاحون ويتجادلون بالتي هي أسوأ، ثم يكتشفون أنهم غير مختلفين أصلاً، وإنما قصد شيئا، وشيئا آخر قصدوا، ولو اتحدت تصوراتنا لتضاءلت اختلافاتنا.
وقد حاول هذا الكتاب ضبط مفاهيم الفصل الديني بما عساه أن يسمح بتداول معياري أكثر انضباطًا، وقد نتج عن ذلك – كما يقول مؤلف الكتاب – فك الاشتباك بين خمسة مفاهيم أساسية: العلمانية، والسلطة اللادينية، والسياسة اللادينية، واللائكية، واللادينية .حيث أن كل مصطلح من هذه المصطلحات يعبّر عن مفهوم مختلف، كلها تعبّر عن حالة من الفصل الديني، لكن ليست كلها تعبّر عن العلمانية. فالأول يعبر عن الفصل السلطوي، والثاني يعبر عن الفصل الدستوري، والثالث يعبر عن الفصل السياسي، والرابع يعبّر عن الفصل المجتمعي، والخامس يعبر عن الفصل الفردي.
الإسلام كمرجعية تكاملية لا أحادية
وامتدادا لهذه المهمة سعـى كتاب “من العلمانية إلى الخلقانية” للبحث في سؤال المرجعية البديلة، أي: من الذي يقوم بدور المرجعية النهائية إن أقصينا الدين؟ إذا قلنا العلم فالعلم مفيد لكنه ليس حاسمًا، لأنه لا يشتغل إلا في الماديات، ونحن نتحدث عن المرجعية في إدارة الاجتماع الإنساني. وإذا قلنا العقل فهو في السياق السياسي غير حاسم كذلك، لأننا إذا قلنا إن العقل هو المعرفة البدهية التي يتفق عليها العقلاء فهذه المعرفة لا تنفعنا في إدارة الدولة، وإذا قلنا إن العقل هو معرفة ليست بدهية فهذا يعي أنها نسبية، وإذا كانت نسبيةً فقد انتفت عنها أهلية تمثيل العقل تمثيلاً حصريًا، لأن ما تراه يمثل العقل ربما لا أراه كذلك. فلأن العقلانية نمط تفكير وليست أفكارًا بعينها، فإن الإحالة إلى العقلانية إحالة إلى إجابات لا متناهية.
وسنرى في هذا كتاب “من العلمانية إلى الخلقانية” أن ميزة الإسلام أنه مرجعية تكاملية لا أحادية، فهو لا يعتمد العقل وحده، ولا العلم وحده، ولا كليهما منبتّين، بل مجموع ذلك مضافًا إليه الوحي الإلهي. فلأن الإنسان في المنطق الإسلامي ليس أحادي البعد one dimensional man، وإنما محتاجٌ لله تعالى، ولأن الوحي الإلهي لا يتجسّد في الواقع إلا بتوسّط العقل الإنساني، فإن النتيجة أن التكامل لا يكون إلا بحضور الوحي والإنسان، وغياب أي منهما خللٌ يرهق الإنسان والمجتمعات.
ويشير الكاتب في الأخير إلى أن العلمانية لها حضور تاريخي إجرائي واقعي، وحضور معاصر أيديولوجي ذهني، الأول توقف والثاني مستمر. وحين يبدأ النقاش حول العلمانية فإنه يعود غالبًا إلى “العلمانية التاريخية”، أي إلى تلك الصيرورات التي لا ينتهي النقاش فيها، وهذا ما يجعل النقاش نقاشًا تأريخيًا لا مضارعة فيه، وهو وإن كان مهمًا لكنه ألغى الأهم، والأهم هو البحث عن العلمانية في الذهنية المعاصرة كي يُبنى عليها عملٌ.
من أجل ذلك – يقول الكاتب – نحن بحاجة في العالم العربي إلى جدل استئنافي لا جدل امتدادي، جدل يستأنف من لحظتنا التاريخية، ولا يجعلنا امتدادًا لسياقات تاريخية أخرى لا يمكن الانتهاء منها، وليس ذلك في العلمانية فحسب، بل في كل المنتجات المستوردة من خارج العالم الإسلامي، وإلا فسنبقـى ندور حول أنفسنا بلا فائدة. وهذا ما جعلنا في هذا الكتاب نحرص علـى تعريف العلمانية تعريفًا حديًا ومباشرا حتى نكون في مواجهة مباشرة مع الإشكال تصورا وحكمًا.
وينبه الدكتور نايف بن نهار إلى مسألة أساسية: أن كتابه هذا ليس معنيًا بتقديم النموذج الإسلامي في مسألة السلطة، إذ إنه في المقام الأول عملٌ تفكيكي لا تركيي، ومفاهيمي لا معياري، فهو إذن لا يسعـى لبناء نموذج سياسي إسلامي بقدر ما يسعـى لتفكيك ما يعتقد أنه إسلامي تحت عنوان العلمانية.
تفاؤل مشروع..مشروع تفاؤل
ولا يخفي الكاتب تفاؤله لرؤية الحوار العربي والإسلامي في مسألة الدين والسلطة بشكل وعمق مختلف بعد مصطلح “الخلقانية”، ويقول بأننا سئمنا من الحوارات حول العلمانية وإغراقها بالبحث التاريخي الذي يشعر المسلم والعربي بالاغتراب معه والوحشة منه، بما يجعل النقاش لا يمتلك أرضية مشتركة، وليست مبالغة أبدًا أن نقول إن البحث في العلمانية يجعل الباحث العربي يعرف الثقافة الغربية أكثر مما يعرف ثقافة مجتمعه، مع أنه يبحث فيها سعيا لمعالجة إشكالات مجتمعه.
تنزيل PDF