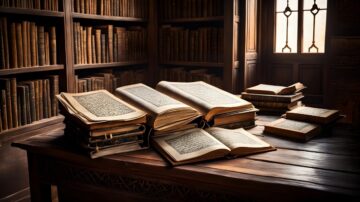يحاول نصر أبو زيد دائما أن يجد لنفسه أساسًا في فكر المعتزلة على حد رؤية البعض من خلال إرجاعه فكرة تاريخية النص القرآني إلى كون القرآن مخلوقًا، فهو يحاول تعريف مصطلح التاريخية، وإلقاء الضوء على مدلولها في ظل العودة إلى مفهوم خلق القرآن عند المعتزلة ومحاولًا البيان بالمدلول الحقيقي في ظل استحضار للدلالة فقد ذهب المعتزلة إلى أنَّ القرآن محدث مخلوق ليس له صفة من صفات الذات الإلهية القديمة، القرآن كلام الله، والكلام فعل، وليس صفة، فهو من هذه الزاوية ينتمي إلى مجال صفات الأفعال الإلهية، ولا ينتمي إلى مجال صفات الذات، ذلك أن خلق القرآن حدث في الزمن التاريخي؛ لأن كل الأفعال الإلهية أفعال في العالم المخلوق المحدث؛ أي: التاريخي، والقرآن الكريم كذلك ظاهرة تاريخية من حَيْثُ إنَّه واحد من تجليات الكلام الإلهي، وإنْ يَكُنْ أشمل هذه التجليات، وينتهي هذا السياق التأسيسي (التوفيقي الملفق) إلى تعريف المدلول الحقيقي في زعمه لمصطلح تاريخية النص القرآني، وهي دلالة الحدوث في الزمن؛ إذ التاريخية هنا تعني الحدوث في الزمن حتى ولو كان هذا الزمن هو لحظة افتتاح الزمن وابتدائه، إنَّها لحظة الفصل والتمييز بين الوجود المطلق المتعالي والوجود الإلهي والوجود المشروط الزمني، وإذا كان الفعل الإلهي الأول فعل إيجاد العالم هو فعل افتتاح الزمان فإنَّ كل الأفعال التي تلت هذا الفعل الأول الافتتاحي تظل أفعالًا تاريخية بحكم أنَّها تحققت في الزمن والتاريخ وكل ما هو ناتج عن هذه الأفعال الإلهية محدث بمعنى أنَّه حدث في لحظة من لحظات التاريخ [1].
ونلاحظ مدى الخلط والإغراق في مصطلحات فلسفية لا ندري الهدف من ورائها، فليست نصوص القرآن بهذا الغموض، ولا تحتاج لكل هذه الفلسفة والإغراق فيها للوصول إلى مراميها وتفسيرها وتحقيق مقاصدها.
والحقيقة أنَّ الفارق واسع في المنهج والغاية بين المعتزلة ونصر أبوزيد، فالمعتزلة القدامى لا يُنكرون الوحي، ولا يُنزلون النص إلى منزلة كلام البشر وأنسنته، هم يسلمون بأصله الإلهي. هم فقط يؤولونه فهمًا واعتقادًا مع الاحتفاظ له بالقدسية فيما يتعلق بالنص الموحى به (القرآن)، أمَّا السنة فإنهم وإن رفضوها فلهم مبرر قد نتفق أو نختلف معه، لكن تبقى له وجاهته؛ لأنَّها إما تعارضت مع النص القرآني أو العقل البشري، وهم حينما ينفونها، ولا يقبلونها يجردونها من أهم شيء، وهو نسبتها إلى رسول الله بوصفه نبي الحق المعصوم، والفارق كبير وواضح جدًّا.
وهكذا نجد أن نصر حامد أبو زيد ﻗد بنى ﻤﺸروﻋﻪ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻗراءة النص الديني ﻋﻠﻰ ﻓكرة تأنسن ﻫذا النص وتاريخيته، مستدلا لدﻋواﻩ بظاهرة أسباب النزول، وأن ارتباط النصوص بأسباب النزول دليل ﻋﻠﻰ تاريخية النص، و جدله مع الواقع الذي نزل فيه، وﻫذا الجدل مستمر بعد تجاوز تلك الأسباب وبقاء النص، وذلك ﻋن طريق التأويل المفتوح لهذا النص، و مراعاة الوقائع المختلفة ومتغيرات الزمان والمكان، وﻤن ﻫﻨﺎ يكون النص التشرﻴﻌﻲ عالميًّا، ومستجيبا لحاﺠﺎت كل ﻋﺼر، متجاوزا الزمان والمكان الذي نزل ﻓﻴﻪ، والنص يحمل دوالًا تسمح بتجاوز المعنى اﻷول الذي فسر به ؛ ﻷنَّ طﺒﻴﻌﺔ اللغة ذاتها أنها تعبر ﻋن الواﻗﻊ تعبيرا رمزيا .
إن تاريخية النص تعني أنه ﻻ يحمل معنى واحدا يقف ﻋﻨدﻩ المفسرون ﻋﺒر العصور، بل النص ﻓﻲ حالة جدل وتفاعل مستمر مع الواقع، حيث بدأ ذلك التفاعل ﻋن طريق أسباب النزول ﻓﻲ ﻋﺼر نزول الوحي ، ثم تبقى طبيعة النص اللغوية الرمزية قابلة وخاضعة للتأويل ﻋﺒر العصور، استجابة لوقائع وظروف أخرى لم تكن موجودة ﻓﻲ ﻋﺼر التنزيل، فيكون النص مفتوحا ﻋﻠﻰ معان متعددة بحسب اختلاف القراءات والتأويلات من ﻋﺼر لآخر.
يقول نصر أبو زيد: ما يؤكد ﻫذﻩ الفكرة أن القرآن قد نزل مستجيبا لحاﺠﺎت الواﻗﻊ وحركته المتطورة، خلال ﻓﺘرة زادت ﻋﻠﻰ العشرين عاما، وﻤﻊ تغير حركة الواﻗﻊ وتطوره بعد انقطاع الوحي تظل العلاﻗﺔ بين الوحي والواﻗﻊ ﻋﻼﻗﺔ جدلية، يتغير ﻓﻴﻬﺎ معنى النص، ويتجدد بتغير معطيات الواﻗﻊ.
فهذا المنهج يرفض المعنى الواحد الذي يدل ﻋﻠﻴﻪ النص، ويذهب لتعدد المعاني والدلالات وﻋدم انحصارها، ويرفض ما يسمى القراءة البريئة للنص، بمعنى تلك القراءة التي تزعم أنَّ ﻫﻨﺎك حقيقة موضوعية واحدة ﻴﺒﺤث ﻋﻨﻬﺎ القارئ ﻓﻲ جميع ﻋﺼور التفاعل مع هذا النص.
ﻴﻘول د. نصر أبو زيد: انطﻼﻗًﺎ من الوعي بهذه العلاقة الجدلية بين الماضي والحاﻀر، وبين الباحث وموضوعه، ﻻ بد من التسليم بأنه ﻻ توجد ثمة ﻗراءة بريئة، وهو يؤكد أقوال من سبقوه فطﻴب تيزيني ﻴؤكد ﻓﻲ كتاﺒﻪ «اﻹﺴﻼم والعصر» أن القول بقراءة بريئة أو خطاب بريء ﻋﻠﻰ صعيد الفكر والتراث الإسلامي يمثل خطا معرفيا.
ويقرر هذا المعنى محمد أركون حين يقول: السخف الحقيقي الذي نأباه ﻋﻠﻰ أنفسنا أن نحدد أخيرًا المعنى الحقيقي للقرآن.
وقد وصف القرآن ﻓﻲ كتابه ( تاريخ الفكر العربي الإسلامي ) بأنه نص مفتوح ﻋﻠﻰ جميع المعاﻨﻲ، وﻋﻠﻰ كل البشر، وكون من العلامات والرموز. ويرى أصحاب هذه المناهج أن ادعاء وجود معنى موضوعي يتبعه القارئ أو المؤوِّل يحول النص إلى نص جامد لا حياة فيه، ويعطله عن التفاعل مع الوقائع المستجدة ويسلب عنه صفة الصلاحية لكل زمان ومكان.
وتُخضع هذه المناهج – في رؤية البعض – العلاقة بين النص والمعنى لنظرية «موت المؤلف»، وهي نظرية ترمز لموت المعنى الذي يقصده المتكلم الأول بالنص وإهداره وعدم اعتباره عند قراءة النص، وبعث الحياة في النص من جديد عن طريق التأويل الواسع الذي لا يقف عند معنى واحد، بل يتسع ويتعدد بتعدد القراء على اختلاف تأويلاتهم [2].
إنّنا لا يمكن أن نساير هذه المناهج، فهى لا تفرّق بين اختلاف طبيعة النصوص القرآنية ومستويات الخطاب فيها، فهم يرون أنّها تصلح لتعدد القراءات وتوليد المعاني باختلاف الزمان والمكان، لكنهّم لا يفرقون بين النصوص التي تتعلق بالحياة في كافة مستوياتها، وتلك النصوص المحددة للعبادات والحل والحرمة، وكذلك النصوص قطعية الدلالة فى إثبات الحكم الشرعيّ كالحدود، كما أنّ التغيّر في المعاني والمضامين بما يؤثّر على مستويات الخطاب فى الشريعة الإسلامية، إنّما يخضع أساسًا لمبدأ العلية، أي وجود علة الحكم الشرعي من عدمه في بيئة معينة وزمن معين، من دون أن يتعلّق الأمرُ بالنص، فالنصّ واحد ومعنى واحد وحكم واحد، ولكنَّ التطبيق له علته، ولا يمكن تجاوز النص ومعناه وحكمه، إلّا في حالة انتفاء العلة.. هنا، الأمر لا يتعلق بالنص، ولا نحتاج الى تفكيكية ولا بنيوية ولا موت المؤلف ولا التاريخانية، وإنّما نحتاج إلى إعمال التراث الفقهي وعلم الأصول ومناهج التفسير التي وضعها علماءُ الإسلام.
وهكذا فإن هذه ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻠﻴﺔ ﺗﻬدف ﺇﻟﻰ ﺗطبيق ﻣﺒﺎﺩﺉ وآليات التأويليات المعاصرة ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨطاب ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﻭﻧﻘﻞ مفاهيم ﻭﻣﺼطﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، الإنسانية، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨص ﺍﻟﻘﺮآﻧﻲ بطريقة إسقاطية دون ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍلنص ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﻭدﻭﻥ أﻥ ﻳﻀﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ هذا ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ هذا ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ، ﻭهو ﺍﻟمعطى ﺍﻟﺘﻔﺎﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨص ﺍﻟﻤﻘﺮﻭء الذي ﻫﻮ ﺍﻟنص ﺍﻟﻘﺮآﻧﻲ الكريم ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟدخيل ﺍﻟمطبق ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ هذا النص وﻗﺮﺍءﺗﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ مستخلص ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭتحكمه ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ فلسفية [3].
فالانسياق المباشر من وراء تقمص هذه المناهج الجديدة في التفسير، دون مراعاة الخلفيات والتوجهات في نشأتها، أو في مرجعيتها، من شأنه أن يحمل كثيرًا من المخاطر، وأن يوقع كثيرًا من المغالطات، والانزلاقات التي قد تخفي المعنى، وتحجبه عن متلقي النص… بحيث قد يؤدي هذا الاختيار إلى إخراج النص عن أهدافه ومقاصده الكبرى التي من أجلها نزل… ويجعله نصًّا عقيمًا، يفتقد وصف الامتداد الزماني والمكاني الذي يعد من أبرز أوصاف النص القرآني، وخصائصه… كما أنَّ الهدف من هذا الاختيار، هو إلغاء القانون والمعيار الضابط لقراءة النصوص عامة، والدينية خاصة. بحيث صادر أصحاب هذا الاتجاه القواعد والمعايير الناظمة لتلقي النصوص، واكتساب المعاني منها… وعدوا أنَّ السلطة في قراءة النصوص هي للقارئ بمفرده. بحيث لا يشاركه أحد في قراءته وتلقيه للنص…
وهو ما يجعل المعنى نسبيًّا في جميع النصوص، بما في ذلك النصوص الدينية والشرعية والقانونية [4].