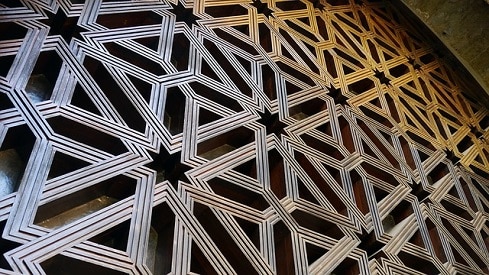في ندوة مختصرة لخّص المفكّر القطري المعروف الدكتور جاسم سلطان أسئلة الشباب حول إشكالات النهضة، ومحاولات الخروج من المأزق الراهن بالأسئلة الثلاثة الآتية:
1 – متى تكون المفاهيم الدينيّة عائقاً عن النهوض؟
2 – من أين يبدأ الإصلاح؟ من القمّة نزولاً نحو القاعدة؟ أم من القاعدة صعوداً نحو القمّة؟
3- ما جدوى العمل إذا كنّا محكومين بالقوى العالمية والدولية والتي لا تريد لنا النهوض؟
وعلى صحيفة “العرب” أحببت أن أساهم في صياغة الجواب، وبحسب تسلسل الأسئلة:
بداية نعم، المفاهيم الدينية ممكن أن تكون جزءاً من الحل وسبباً للنهوض، وممكن أن تكون جزءاً من المشكلة وسبباً في الهبوط، ذلك لأن المفاهيم الدينية لا تعبّر عن الدين نفسه، وإنما هي تصوّرات المتديّنين عن الدين بحسب وعيهم وثقافتهم، وأذكر بهذا الصدد مقالة قديمة -لا يحضرني اسم كاتبها- كان يعلّق فيها على احتفال الإسلاميين ببوادر سقوط الاتحاد السوفيتي ودور «الجهاد الأفغاني» في ذلك، ومما أذكره أنه قال: هل غياب القطب المنافس لأميركا من مصلحتنا نحن المسلمين؟ ألا يمكن أن يتفرّغ الأميركيون بعد ذلك لنا وحدنا؟ ثمّ نبّه إلى نقطة أخرى بقوله: هل بحثتم في الأسباب الداخلية التي أدّت إلى تدهور التجربة السوفيتية، والتي يمكن أن يكون على رأسها؛ المركزية الشديدة التي دمّرت الطاقات، وقتلت الإبداع، وقضت على روح التنافس الإيجابي، وأضعفت المشاركة الفعلية في صناعة الحل، وكل ذلك عندنا، فهذه هي ثقافتنا الدينية وطريقتنا في العمل “البيعة” و “السمع والطاعة” بلا مراجعة ولا تقويم، والتي لا تسمح للأفراد -في كثير من الأحيان- حتى بالسؤال، فيظن “الأخ” أنه يسير خلف قيادة عالمة بكل شيء، وقادرة على كل شيء، ليكتشف فيما بعد -وبأول اختبار- أن كثيراً من الناس العاديين كانوا أوعى من قادته!
لقد كان ذلك المقال مبكراً في نقد الظاهرة، وموجهاً بشكل خاص ومباشر إلى الجماعات الإسلامية الحركية، لكننا اليوم في الحقيقة نعاني من مفاهيم دينية شائعة ومؤثّرة لكنها مغلوطة وعلى كل المستويات، وهي تمثّل عقبة أو عقبات في طريق النهوض، بداية من طريقة التفكير في تصوّر المشكلة وقراءة الواقع والإمكانيّات المتاحة، وصولاً إلى خلط المفاهيم الدينية، واضطراب التفسيرات الغيبية، والتي تجعل الإنسان كأنه يعيش في متاهة لا يحكمها عقل ولا يضبطها قياس، فالله -مثلاً- لم ينصر المسلمين في معركة أحد، بسبب ذنب “اجتهاديّ” ارتكبه الرماة، أو بسبب تقصير الصحابة في سنّة السواك -وهذا خطاب متكرر- لكننا نرى أن الله ينصر الحجّاج مع شدّة ظلمه، ويفتح على يديه ما لم يفتحه على يد أحد غيره.
شيخ يكتب بحثاً “علميّاً” عن “العين” ليثبت بالأدلة الدينيّة أن أكثر من 50 % من المسلمين يموتون بسبب العين، وعليه فربما لا يحتاج السوريون إلا إلى رقية شرعية من هذا الشيخ.
وآخر يقول: الحمد لله الذي سخّر الكفّار لأنواع الصناعات لنستعين بها ولنتفرّغ لعبادته!
وجماعة تنتكس في الانتخابات البرلمانية، فيكتب موجهها التربوي: هذا هو التمحيص الربّاني «وقليل من عبادي الشكور».
لا شك أن الدين بهذه المفاهيم سيكون عائقا وليس حلّاً.
من أين يبدأ الإصلاح؟ من القمة نزولاً نحو القاعدة؟ أم من القاعدة صعوداً نحو القمة؟ هذا هو السؤال الثاني من أسئلة النهضة، وهو سؤال صعب، والإجابة عنه أصعب، ذلك لأن القمة ليست واحدة، كما أن القاعدة ليست واحدة، والعلاقة بين الطرفين كذلك ليست واحدة.
إن هذا السؤال يفترض بالأساس وجود خلل في القمة والقاعدة، ويفترض أيضاً أن هناك جهة ما تريد إصلاح هذا الخلل، لكنها متحيّرة بمَ تبدأ.
في ضوء هذه الفرضيات، يبدو من المنطق أن تكون البداية بهذه الجهة نفسها، وهنا لا تكفي النوايا الحسنة ولا مجرد الرغبة في الإصلاح، ولا حتى الاستعداد للتضحية، ما لم يستند كل ذلك إلى قراءة الواقع قراءة صحيحة، وتحديد الأهداف في ضوء هذه القراءة، ثم تحديد الوسائل المناسبة لهذه الأهداف، ثم الإعداد العلمي والتربوي الذي يتمثل هذا المشروع بمبادئه وقيمه وأهدافه ووسائله، وهذا هو الخطاب القرآني (عليكم أنفسكم)، و(قل هو من عند أنفسكم)، الذي يؤكد أن هذه هي البداية الصحيحة، بالمعنى الإيجابي للاعتناء بالنفس، وليس بالمعنى السلبي الانعزالي.
لقد أتيحت للدعوات الإصلاحية المعاصرة فرص كبيرة على مستوى القمة وعلى مستوى القاعدة، لكن النتائج في الأغلب كانت مختلفة ومحبطة، ففي السودان مثلاً ومصر وأفغانستان وصل دعاة الإصلاح إلى قمة الهرم، أما في الجزائر فقد اكتسحوا القاعدة الجماهيرية اكتساحاً شبه كامل بنسبة 88 %، والثورة السورية كذلك، أما اليمنيون فقد أتيحت لهم الفرصتان معاً، كسبوا القاعدة الجماهيرية العريضة، واشتركوا في قيادة البلاد عقب إعلان الوحدة بين اليمنين الشمالي والجنوبي، وهناك حالات أخرى كان الظن فيها أن الإصلاح لا يواجه إلا استبداد الحاكم، وأنه فور سقوطه ستفتح أبواب الجنان، هكذا كان التصور في العراق وليبيا، فلما سقط صدام ثم القذافي كان كأنما فتحت أبواب الجحيم، فالسقوط أوجد حالة من الفراغ الكبير، وقد ملأ هذا الفراغ أصحاب المشاريع الجاهزة من القوى المحلية أو الأجنبية.
من المفارقات هنا، أن الحركات التي دعت إلى إصلاح القاعدة الجماهيرية أولاً «الفرد والأسرة والمجتمع» مثل جماعة الإخوان، كانت أقدر على الوصول إلى القمة من حزب التحرير مثلاً، الذي تبنى النظرية المعاكسة، وعمل على التغيير الرأسي، وسفه بقسوة كل مشروع لا يبدأ بالرؤوس! هذا يؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين المبادئ النظرية، وبين الواقع الذي تتحكم فيه قوى أخرى وأولويات قد تكون مختلفة تماماً، ولذلك فإن حجر الزاوية في الإجابة عن هذا السؤال إنما هو معرفة الواقع، وليس النظريات والتصورات المسبقة.
إن استهداف الخلل أينما وجد -في القمة أو القاعدة- هو واجب المصلحين، وهناك من المصلحين من هو أقدر على مخاطبة القمة، ومنهم من هو أقدر على مخاطبة القاعدة، فلا أرى وجهاً للتعارض، لكن إصلاح القمة -لو تيسر- فهو لا شك سيختصر كثيراً من الجهد والوقت، هذا إذا كنا نتحدث عن الإصلاح، أما إذا كان الحديث عن التغيير، فهذه هي الساحة الأخطر التي تتطلب وعياً استثنائياً، وتلاحماً شعبياً، وعلاقات متوازنة إقليمياً ودولياً، وإلا كانت منزلقاً للعبث والفوضى، وفي التاريخ القريب عبرة.
ما جدوى العمل إذا كنّا محكومين بالقوى العالمية والدولية، والتي لا تريد لنا النهوض؟ هذا هو السؤال الثالث من أسئلة النهضة، وهو وإن كان -كما يبدو- مبسّطاً ومباشراً، لكنه في الحقيقة يستبطن أسئلة وتصورات دينية وسياسية مركبة ومعقّدة.
في الجانب الديني، هنالك ارتباك واضح، أساسه الخلط بين مفهوم الإيمان بالغيب والتوكل على الله، وبين تقدير الواقع وتحدياته وتوازناته، فهناك من يعتقد أنه مع التوكل على الله وصدق النية فإنه يكفي الأخذ بأدنى الأسباب المتاحة، ويستشهد بعموميات قوله تعالى: (إن تنصروا الله ينصركم)، وأن مريم -عليها السلام- هزّت الجذع فتساقط الرطب، وعليه فيمكن للمسلمين اليوم أن ينتصروا جملة واحدة على أميركا وروسيا ومن وراءهما، فإن لم يتحقق ذلك كانت المشكلة في درجة الإخلاص ومقدار التوكل، وربما فات هؤلاء أن القرآن قصّ علينا قصة أصحاب الأخدود، وكيف تمكنوا من القضاء على الثلّة المؤمنة بالحرق دون أن يتدخل القدر، وإنما اكتفى القرآن بالتعقيب: (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)، فالاختلال الكبير في ميزان القوى هو وحده المسؤول عن هذه الفاجعة الأليمة، إذ لم يذكر القرآن سبباً يتعلق بأولئك المؤمنين، بل لقد ذكر القرآن صراحة: أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيّين! والنبيّون هم مثلنا الأعلى في الإيمان والتوكّل.
عند السياسيين، هناك جدل آخر لا يقل اشتباكاً واشتباهاً عن الجدل الديني، يتلخّص فيما بات يعرف بـ «عقدة المؤامرة»، فهناك من يعتقد عقيدة راسخة بالقدر الأميركي أو الماسوني الذي يتحكم بأنفاس الخلائق، وهناك من يسخر من هذا القدر، ويعتقد أن المؤامرة الغربية أو الماسونية أشبه بقصص الجن وأساطير العفاريت، وبين الفريقين يجلس أصحاب المنهج الوسطي التوفيقي، وعن يمينهم وعن شمائلهم فئات وفئات وأفكار وأفكار لا تحصى.
إن هذه المجادلات -الدينية والسياسية- أضافت عبئاً جديداً وثقلاً مضافاً، فمع كل حدث هنالك انشطار واتهام واتهام مضاد، هل كانت الحروب العربية الإسرائيلية حروباً جادة، أم كانت مسرحية متفقاً عليها؟ ولو كانت جادة فهل كانت معقولة في ظل الدعم الغربي اللامحدود لإسرائيل؟ والمقاومة العراقية للاحتلال الأميركي كذلك، وتجارب الربيع العربي، ومعارك اليمن الأخيرة، وتجارب الحركات الإسلامية الصاعدة والنازلة، كلها تخضع لهذا النمط من المجادلات والاتهامات والشتائم المتبادلة.
إن تقدير مواقف الآخرين منّا ومن مشاريعنا، ينبغي أن يخضع لدراسة موضوعية وتفصيلية شاملة، فالآخر الذي نتكلم عنه ليس واحداً، حتى ضمن الدولة الواحدة، ونحن كذلك لسنا حالة واحدة، فأهل العراق والشام ينظرون اليوم إلى حزب الله وميليشياته الطائفية أنهم من جبهة -الآخر- المعادي، بينما ينظر له بعض الفلسطينيين أنه جزء من -الأنا- المقاوم والممانع! وهذه محل خلاف عميق حتى ضمن المدرسة الدينية أو السياسية الواحدة!
ومع كل هذه الفوضى العابثة والمصالح الجزئية الضيقة في تقديرنا لمواقف الآخرين، لا زال فينا من يصرّ على حمل اللافتات الشمولية، وتبني الخطاب الذي يعني فيما يعنيه مواجهة العالم كل العالم، لأن “الكفر ملة واحدة” ، ومواجهة الداخل كل الداخل، لأن هذا الداخل كله أنظمة فاسدة وحدود مصطنعة، ومواجهة حتى الأخ المختلف معنا لشكّنا في صدقه وباطن نيّته!