كثيرة هي التحديات التي تواجه العقل المسلم في الوقت الراهن، خاصة التي تتعلق بالأفكار الوافدة والفلسفات الحديثة، التي يتضاعف تأثيرها بدرجة كبرى على الشباب.. ومن هنا، كانت الحاجة إلى تحصين العقل المسلم، وإكسابه القدرة على مناقشة هذه الأفكار وفرزها، والوقوف على أرضية صلبة من الفكر الإسلامي؛ مما يُعنى به “علم الكلام” من بين العلوم الإسلامية المتعددة.
ولهذا، فمن المهم متابعة الجديد في الدراسات الكلامية، لاسيما الغربية منها، لأنها تطلعنا على مناهج دراسية جديدة، وعلى نظرة مغايرة لقضايا هذا العلم وإشكالياته.
وفي هذا السياق، يأتي كتاب (المرجع في علم الكلام)، الذي صدر عن جامعة أكسفورد، بتحرير المستشرقة زابينه شميتكه، وحظي بترجمة رائعة من الدكتور أسامة شفيع السيد، نال عنها جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي لعام 2018م.
وأسامة شفيع مدرس بقسم الشريعة بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، حصل على الماجستير سنة 2003، عن أطروحته (الفكر الفقهي عند محيي الدين ابن عربي)، كما حصل على الدكتوراه من جامعة Rouen Normandie، بفرنسا، عن أطروحته (امتناع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي). وفي هذا الحوار نتعرف معه على أهمية (المرجع في علم الكلام)، وما يقدمه للدراسات الكلامية المعاصرة، وعلى قضايا أخرى تتصل بالتجديد في هذا العلم.. فإلى التفاصيل:
حصلتم مؤخرًا على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، عن ترجمتكم كتاب (المرجع في تاريخ علم الكلام).. كيف استقبلتم هذا النبأ؟ وماذا يمثله لكم؟
لا أكتمك سرًّا أني حين كنت أعمل في هذه الترجمة، لم تكن الجائزة بعيدة عن آمالي.. وكنت أشعر بقيمة الكتاب من عدة جهات، منها أن الكتاب حديث الظهور، فقد صدر عام 2016م، وأنه صدر عن جهة محترمة علميًّا هي جامعة أكسفورد، ومنها أنه ضخم واشترك فيه 37 باحثًا من بلاد شتى.. ومنها ما يتعلق بنعمة الله عليّ في الترجمة والأداء، فمتابعة “سوق الترجمة” تُشعرك بالأرضية التي تقف عليها، من حيث التقدم أو التأخر أو التوسط.
فالجائزة لم تكن بعيدة عن طموحي، بل كانت مرجوَّة، وبخاصة أنني تقدمت إليها في العام السابق، عن كتاب (النشأة الثانية للفقه الإسلامي: المذهب الحنفي في فجر الدولة العثمانية الحديثة)، الذي ترجمته بالاشتراك مع أخي وصديقي الدكتور أحمد محمود. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لم يفز، فإنه كان متقدمًا في المكانة بين الكتب المرشحة.
وهذا التوقع بالفوز لا ينفي طبعًا الشعور الكبير بالفرح حين حصلت على الجائزة، لأنها جائزة كبيرة أدبيًّا وماديًّا. وقد سعدت بها سعادة مضاعفة، لأنني نلتها- بحمد الله- في سن صغيرة بالنظر إلى المعتاد في أمثال هذه الجوائز. ومما زاد سعادتي أن أحد المسئولين عن الجائزة تعجب عندما رآني، وقال لي ممازحًا: ظننتك شيخًا في عامه التسعين!
كيف استقبلت الأوساط العلمية والأكاديمية ترجمتكم؟
ما يصلني عن الكتاب أن من يقرؤه يحمده، ويحمد الجهد المبذول فيه بفضل الله.. وإذا كان الحصول على الجائزة يقتضي بداهةً أن طائفة من الأكاديميين قد اطلعوا عليه، أعني لجان التحكيم التي تتكون من أساتذة متخصصين، فإن في الفوز بها شهادة علمية بحق الكتاب.. وقد أسعدني أن الأستاذ المحكم لقيني في الحفل وأثنى كثيرًا على الترجمة وناداني مرحبًا: “أهلاً بصاحب الترجمة المُعَلِّمَة”، ووصفها بأنها “ترجمة بديعة”، وطلب مني ترجمة بالفرنسية فأهديته ترجمتي لكتاب (الشرق والغرب) للفرنسي المسلم رينيه جينو (عبد الواحد يحيى).
وقد نُقل إليَّ- عن طريق دار النشر- ترحيبُ المتخصصين بالكتاب وثناؤهم عليه.. وفي المقدمة الضافية للكتاب أثنى أستاذنا العلامة حسن الشافعي على الكتاب وعلى الترجمة.
ما الجديد الذي يقدمه (المرجع في تاريخ علم الكلام)؟
في المقدمة المفصَّلة التي كتبتها محررة الكتاب زابينه شميتكه، شكت من عدم عناية المستشرقين بعلم الكلام على غرار عنايتهم بالعلوم الإسلامية الأخرى، كالفقه والتفسير.. وعللت ذلك بقلة المصادر إلى عهد قريب، وأن كثيرًا منها لم يزل مخطوطًا، مما صرف الناس كثيرًا عن علم الكلام.. ولكن في الفترة الأخيرة بدأ اكتشاف كثير من المخطوطات وتحقيقها، وهو ما ضاعف الجهود في هذا المجال.
والجديد الذي يقدمه هذا الكتاب هو فكرته، من حيث إنه كتاب مرجعي، يشترك فيه 37 باحثًا من شتى بقاع الأرض، كل واحد منهم يكتب في الموضوع الذي درسه وتوفَّر على معرفة تفاصيله، ضمن رؤية تكاملية وضعتها الأستاذة المحررة؛ من حيث النشأة ثم ما تلاها من مراحل، وصولاً إلى علم الكلام في الوقت الحالي وجهود التجديد فيه، أو ما يُسمَّى بعلم الكلام الجديد.
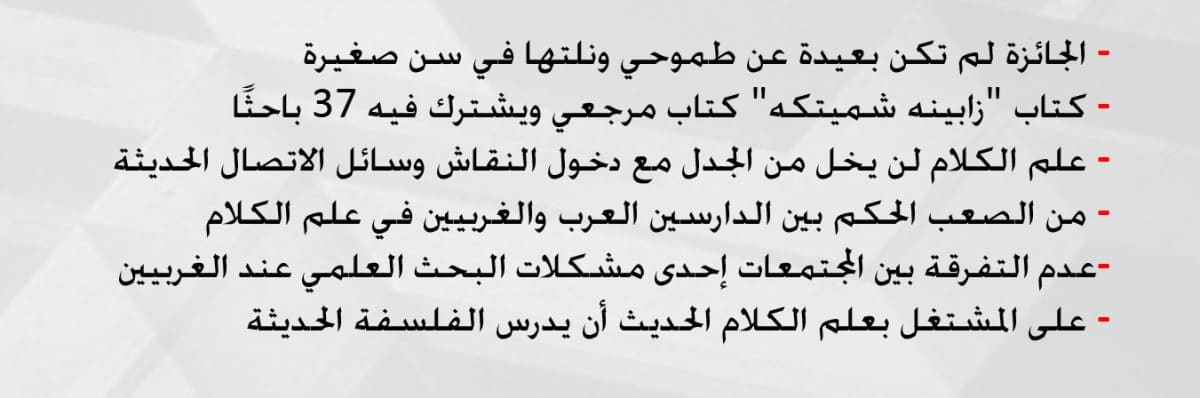
فميزة الكتاب أن كل من شارك فيه يكتب في الموضوع الذي انقطع له وتخصص فيه، ويكتب ما انتهى إليه من آراء؛ حتى إن المذهب الكلامي الواحد يكتب فيه أكثر من مشارك، مما يعطي رؤى ثرية متكاملة في الموضوع.. وهذا العمل الجماعي بهذه الصورة، وبخاصة مع توافر محرر جيد وإمكانات مادية، يعطي تصورًا هائلاً أو واسعًا لتاريخ العلم. ولكيلا يكون الكتاب مقصورًا على “تاريخ” علم الكلام، حوى فصلين تضمنا مباحث “نظرية” تهتم بالأفكار الكبرى في هذا العلم.. وهذان الجانبان مهمان في “التأريخ” لأي علم؛ فتُعطَى أولاً رؤية “بانورامية” لتاريخ العلم، ثم يُقدَّم “تاريخ تفصيليّ” لبعض قضاياه ونظرياته.
وقد قال أستاذنا الدكتور حسن الشافعي في تقديمه، عن هذا الكتاب: “إنه عمل بالغ الأهمية من الناحية الأكاديمية، ويمتاز بنظرة شاملة ومعاصرة إلى تاريخ هذا العلم وواقعه المعاصر.. ويتناول مجالات قلَّما نعرض لها نحن في بحوثنا العربية: ومن أبرزها العناية بالبوادر والمقدمات التي سبقت المذاهب الناضجة المستقرة”.
إذن، ما الفرق بين تناول الدارسين العرب ونظرائهم الغربيين لـ”علم الكلام”؟
هذا سؤال واسع جدًّا، ومن الصعب أن يقوم المرء بدور الحكم بين الدارسين العرب والغربيين؛ لأنه هذا يقتضي دراسة كل الجهود على هذين الصعيدين.. لكن يمكن لنا أن نقول: يوجد هناك فرق عام لا يتصل بعلم الكلام خاصة، وإنما يتصل بالعقلية الغربية والعقلية الشرقية، ويتصل بـ”الانتماء”.
فالغربي حين يدرس هذا العلم، يدرسه وهو غير منتمٍ لأي من الفرق الكلامية، بل إنه لا يكون مسلمًا أصلاً في الغالب؛ فلا يحكِّم معتقده في البحث العلمي.
وفيما يتصل بما أشرنا إليه من وجود فارق بين العقلية الغربية والعقلية الشرقية: نحن نقتصر- في العموم- على الوصف، في حين يهتمون هم بالبحث عما وراء الموصوف؛ أي يهتمون بتحليل الأفكار بينما نكتفي نحن بوصفها.. ولعل السبب في هذا مرجعه إلى أصول النشأة ونُظم التعليم.. وهنا أود أن ألفت النظر إلى أنني بهذا الكلام لا أمدح ولا أذم، وإنما أصف واقعًا أراه. كما أن هناك كتابات عربية تلتزم بالمنهج التحليلي والنقدي، وقد استند الكتاب إلى بعضها.. لكن نحن نتحدث بصفة عامة.
فالطالب الغربي ينشأ من صغره على فكرة التحليل، وعدم الاكتفاء بالظاهر، ويُربَّى على البحث عما وراء العبارات، واستخلاص النتائج بحرية شديدة، ولو انتهى إلى نتائج قد تكون “فادحة” إذا قيلت في بيئة أخرى.. هو يلتزم فحسب بالمقدمات العلمية، ولا بأس بالنتائج التي تفضي إليها هذه المقدمات.
تناوَلَ الكتاب الوقائع التاريخية- مثل محنة خلق القرآن- بما أبرز العلاقة بين الحركة العلمية والأوضاع السياسية والاجتماعية.. كيف جاء ذلك؟ وكيف يمكن تجنب التأثير السلبي لهذه العلاقة على مسار البحث العلمي؟
الكتاب طرح رؤية أوَّلت ما حدث في محنة خلق القرآن بأن الفقهاء كانوا قد سيطروا على العامة، وأراد المأمون أن يرد للأمراء هيبتهم فنكَّل بمن خالفه من الفقهاء ورجال الدين.. وهذه رؤية تنم عن عدم دراية كافية بالمجتمع العربي والإسلامي، وتقيسه على المجتمع الغربي الذي ينتمي إليه الباحث. وهي رؤية علمانية مادية لتفسير هذه المحنة؛ وإلا فهل يُعقل أن يتحمل الإمام أحمد ما تحمل لمجرد الحفاظ على ما يقال عن “المكانة والنفوذ” للفقهاء ورجال الدين، أو التنازع على السلطة.. أم أن الأمر يتعلق بالعقيدة والتضحية في سبيلها، مما لا يفهمه من ينطلق من منظور مادي فقط؟!
ومن الوارد جدًّا أن يكون الخليفة المأمون، وهو رجل مثقف، قد أراد أن يفرض ما رآه صوابًا، وليس الأمر استردادًا للسلطة والنفوذ.. ومن الجائز أن يكون قد نكَّل بالعلماء وهو يرى أنه يتقرب إلى الله بذلك.
فعدم التفرقة بين المجتمعات إحدى مشكلات البحث العلمي عند الغربيين؛ وقد أشار لذلك أكثر من باحث عربي، منهم المؤرخ الكبير الدكتور قاسم عبده قاسم. وعدمُ تصور طبيعة المجتمع الديني المسلم، يوقع الباحثين الغربيين في أخطاء؛ لأنه حتى الذين يتصورونه منهم مجتمعًا “دينيًّا”، يفهمونه على الصورة المسيحية؛ وهذا غير صحيح بالنظر إلى المجتمع الديني المسلم.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، فالحق أن من الصعب تجنب التأثير السلبي للأوضاع الاجتماعية في مساراتها المتعددة، على البحث العلمي.. لأنه حتى في الغرب، كان الاستشراق هناك لوقت قريب أداة من أدوات السياسة، وإنْ تحرر من ذلك الآن كثيرًا.. فلا مفر من بقاء حالة الشد والجذب بينهما.. ويبقى الأمر متعلقًا بوجود دور الباحث الذي يتمسك برأيه متى اعتقد أنه صواب.
ما أبرز الاتجاهات الحديثة في “علم الكلام” كما رصدها هذا الكتاب؟
في الفصل الأربعين من الكتاب، وهو أطول الفصول، رصدت الباحثة روتراوت فيلانت الاتجاهات الحديثة في تجديد علم الكلام، من بلاد شتى، مرورًا بالإمام محمد عبده الذي حرص على تذويب الفوارق بين مدارس علم الكلام، كما في كتابه (رسالة التوحيد)، وما تابعه عليه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا، وإن كان الأخير أقرب للسلفية من أستاذه.. ووصولاً إلى مسارات البعض حديثًا في تقديم “علم كلام جديد” يتحرر من كل شيء، حتى دخل في هذا المجال من ليس من أهله!
ولكن الفكرة الأوضح في تجديد علم الكلام هي أن القدماء كانوا يشتغلون بهذا العلم ردًّا على الفلاسفة اليونان ومن تبعهم من فلاسفة الإسلام، وكان هؤلاء الفلاسفة يعرضون لمشكلات معينة، ودَفْعُ هذه المشكلات يكون بطريقة معينة.. لكن اختلف الأمر الآن، وصرنا أمام موجات إلحادية ومدارس فلسفية جديدة.. فإذا كان علماء الكلام القدماء قد عُنوا بدراسة الفلسفة القديمة ردًّا على الفلاسفة، فمن الواجب على علماء الكلام المُحْدَثين أن يدرسوا الفلسفة الحديثة ليستطيعوا الرد عليها..
وهنا نعود إلى أصل نشأة علم الكلام، وهي أنه نشأ دفاعًا عن العقيدة؛ فإذا كان العدو قد تغير، فلابد من تغيير أساليب مواجهته.. ونحن الآن بصدد أفكار جديدة، وعلى رأسها قضية النزاع بين الدين والعلم، وما تستتبعه من قضايا مثل “الإعجاز العلمي” في القرآن الكريم.
وإذا كان الأمر كذلك، فعلى المشتغل بعلم الكلام الحديث أن يدرس الفلسفة الحديثة، ويطلع على العلم التجريبي ونتائجه ونظرياته، بعد أن يكون قد رسخت قدمه أولاً في العلوم الشرعية، واطلع على المدارس الإسلامية ليوظفها جميعًا، على ما بينها من خلاف، في الدفاع عن الإسلام، كما فعل الغزالي في كتابه (تهافت الفلاسفة)؛ فقد كان منهجه الاستفادة من الفرق الإسلامية، حتى التي لا يعترف بصوابها، في الرد على الفلاسفة، لأن الأمر كما قال: “عند الشدائد تذهب الأحقاد”.
جاءت نشأة “علم الكلام” من رحم الانقسام أو مقترنةً به، وصار ذا طابع جدلي.. كيف يمكن تجاوز ذلك لينحصر الخلاف في قاعات الدرس، وليكون “علم الكلام” ساحة للنقاش والرأي الفكري الثري؟
هذا عسير جدًّا؛ إذ بات من السهل الآن، بفعل وسائل الاتصال الحديثة، نقل النقاش من قاعات الدرس إلى الفضاء المفتوح، أي إشراك العامة في حديث الخاصة؛ مما يُحدث ضجيجًا وجدلاً.
فعلم الكلام لن يخلو من الجدل، وخاصة مع دخول العامة في النقاش العلمي، وكذلك دخول أنصاف المتعلمين، الذين يكونون أكثر جرأة على إثارة الجدل، وعدم احترام العلماء.. وإذا أضفنا طبيعة علم الكلام ذاته، وهو أنه علم جدلي نشأ للدفاع والمحاججة؛ تبين لنا صعوبة ذلك.. ومع هذا، فعلينا التخفيف من هذا الأمر ما وسعنا الجهد.

