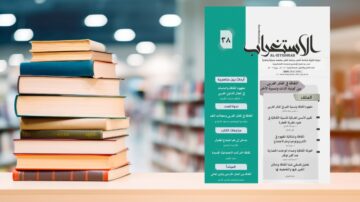يعد مفهوم الثقافة من أكثر المفاهيم تعقيدا وإشكالية في الفكر الحديث، رغم أنه كان ذات يوم مؤشرا للرقي الفكري والروحي. تحول اليوم إلى ساحة معركة فكرية تحاصرها تساؤلات جوهرية معاصرة: هل القيم الإنسانية ذات طابع كوني يتجاوز حدود الزمان والمكان؟ أم أنها مجرد نتاج تاريخي وثقافي مقيد بـ “النسبي”؟ هل المجتمع مجموعة من الحقائق الموضوعية الثابتة؟ أم شبكة معاني رمزية ينسجها أفرادها؟ وهل يعبر التنوع الإنساني الضخم عن جوهر بشري مشترك أم عن هوة من التباين النسبي تستعصي على المعالجة؟
لقد خصص العدد الثامن والثلاثون من مجلة الاستغراب ملفه الرئيس للإجابة على هذه الأسئلة والذي جاء بعنوان : “الثقافة في الفكر الغربي بين كونية الذات ونسبية الآخر”، علما أن المجلة دورية فكرية محكمة تصدر عن المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية.
ثنائية النظر إلى الثقافة
سلطت افتتاحية المجلة الضوء على الانقسام بين نموذجي فهم متضادين للثقافة حيث تضع افتتاحية حسين إبراهيم شمس الدين إطارا عاما لإشكالية مفهوم الثقافة، مبينة تذبذب استعمالاته بين معنى نخبوي ومعنى نمط حياة وتعرض افتتاحية العدد انقساما منهجيا بين رؤيتين :
- الثقافة كتمثل خارجي : مجموعة ظواهر اجتماعية وحقائق يمكن دراستها موضوعيا، وهو الموقف السائد في المدرسة البنيوية، الوظائفية، والماركسية.
- الثقافة كبنية رمزية داخلية : ينظر للثقافة كبنية رمزية داخلية، “شبكة من المعاني” يصنعها الأفراد ويفسرونها، حيث تحظى السوسيولوجيا التأويلية الفيبرية والتفاعلية الرمزية بهذا الاتجاه، وتتحول الثقافة من واقع اجتماعي جامد إلى ظاهرة ديناميكية متغيرة بحسب التفاعل البشري.
وتؤكد الافتتاحية أن هذا التباين ليس مجرد اختلاف إجرائي في العلوم الاجتماعية، بل يستند إلى مقدمات فلسفية حول الوجود والمعنى، ما يستدعي مساءلة وجود الثقافة، وعلاقة النسبية بالقيم والمعايير، وحدود الاعتباريات قياسا على الحقائق التكوينية.
دراسات ومحاور
يجمع الملف مجموعة بحوث تتناول المفهوم من زوايا فلسفية وسوسيولوجية وأنثروبولوجية، وتجري مقارنات نقدية من منظور الفكر الإسلامي.
الثقافة وإشكالية المفهوم في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع
يؤكد بحث الدكتورة عبير أحمد في ملف المجلة على أن تعريف الثقافة في الغرب ليس أداة حيادية، بل ثمرة صراعات تاريخية وسياسية بين فرنسا وألمانيا. في فرنسا حيث ربطت الثقافة بالتقدم العقلي الإنساني والكونية أثناء عصر الأنوار، وكانت الثقافة واحدة للجنس البشري وتدل على رقيه.
وعلى النقيض في ألمانيا، أعيد تعريفها لتصبح قيمة روحية تنتمي للأمة، وهو تصنيف ينفصل عن الحضارة، ولا يعترف بالتقدم المادي سوى كقسوة سطحية، معيدا تشكيل الثقافة أداة لإثبات الذات القومية في مواجهة التأثير الفرنسي، بشحنة أيديولوجية طبقية. هذا الصراع خلف إرثا فكريا ما زالت تبعاته تفرض ثنائيات مثل الثقافة مقابل الحضارة، والكونية مقابل النسبية، مما يصعب المصالحة بين فهم عالمي موحد وتعددية الثقافات.
النزوع إلى النسبية والقيم في الفكر الغربي
في دراسة للدكتور عباس حمزة حمادي، يتتبع المسار الفلسفي الغربي الذي أدى من الذاتية الفلسفية اليونانية مرورا بفصل السياسة عن الأخلاق أو الميكافيللية، وبناء المعرفة التجريبية والعقلانية الذاتية ، وصولا إلى المذاهب الحديثة التي ربطت القيم بأسباب عرضية مثل الظروف الاقتصادية أو الرغبات النفسية، مما أنتج أزمة نسبية أخلاقية قائمة حول القيم ثم يعقد مقاربة نقدية مع فكر السيد محمد باقر الصدر تستند إلى مبادئ عقلية فطرية وتشريعية تعيد وصل البعد القيمي بأسسه الأنطولوجية، وتقرأ آثار التفكك المعياري في البنية الاجتماعية.
الفطرة كأساس معرفي وأخلاقي مشترك
يشير بحث الدكتورة عين الله خادمي وعلي حيدري إلى أهمية الفطرة كأساس فلسفي وفكري للثقافة في سياق نقد النسبية، إذ تحمل الفطرة استعدادات فطرية تدعم إدراك المبادئ الأخلاقية والحقائق الأولية. ويستند البحث على أن الفطرة ترفض:
- النسبية المفهومية عبر ثبات قواعد منطقية كلية.
- النسبية الاعتقادية عبر معايير عقلانية تضبط المعتقدات.
- النسبية القيمية عبر تأسيس أخلاقي يرى المبادئ الأخلاقية بذاتها بفطرية واضحة.
وتعتبر الدراسة استمرار المفاهيم الإنسانية عبر الثقافات دليلا على وجود جوهر إنساني كوني متفق عليه، يتحدى النزعات النسبية.
العولمة الثقافية وصدام الموجات الحضارية
تناولت الباحثة أسماء أحمد محمود “العولمة الثقافية وصدام الموجات الحضارية عند ألفن توفلر” وتطرقت لأدوات الهيمنة الثقافية عبر نظرية الموجات الحضارية لألفن توفلر التي تقسم تاريخ الإنسان إلى ثلاث موجات: زراعية، صناعية، ومعلوماتية. تدخل هذه الفكرة في تفسير الصراعات الحديثة، حيث تستخدم حضارة “الموجة الثالثة” تفوقها المعرفي والثقافي لتبرير سيطرتها على الآخرين، وتصبح الثقافة سلعة ووسيلة للهيمنة، يترافق هذا مع إضفاء طابع “علمي” أو “مستقبلي” على الهيمنة الغربية لتقديمها كضرورة تاريخية مع طرح أسئلة حول مصير الهويات المحلية في ظل تمدد الأنماط الثقافية الجديدة.
منشأ الثقافة وإمكان تخطيطها
ناقش بحث رضا ماحوزي “تحليل فلسفي لمنشأ الثقافة وإمكان التغيير فيها والتخطيط لها” سؤال: هل تنشأ الثقافة تلقائيا أم يمكن هندستها اجتماعيا؟ وإلى أي مدى تقبل عناصرها المكونة من قيم وأعراف وروموز التفعيل الإرادي والتخطيط؟ وعرض الباحث ماحوزي مبررات القول بإمكان التغيير المقصود، مع التنبيه إلى حدود التحكم وآثاره الفلسفية والاجتماعية.
تفكيك الالتباس الدلالي والمخرج الاصطلاحي
شخص بحث “مفهوم الثقافة والتباساته في المجال التداولي الغربي.. نقد الالتباس الدلالي والمخرج الاصطلاحي القرآني” للدكتور الطاهر محمد الشريف التشوش الاصطلاحي المتراكم حول الثقافة في التداول الغربي الحديث، وانتقد الشريف هذا التشوش معتمدا منهجا تحليليا نقديا، فناقش مثلا العلاقة بين الثقافة والدين وكيف اعتبر بعض المفكرين الغربيين الثقافة بديلا أو رديفا للدين في تفسير الظواهر الاجتماعية. واقترح العودة إلى منظومة المفاهيم القرآنية لتقديم مقابلات أكثر ضبطا ووضوحا، بما يخفف التنازع بين الدلالات ويتيح أرضية مشتركة للتعريف.
مواد مساندة في العدد
اشتمل العدد 38 من مجلة الاستغراب على حوار مع البروفسور محمود الذوادي بعنوان: «الثقافة في الفكر الغربي ومجالات النقد»، قدم فيه قراءة مركزة لمواضع القوة والقصور في مقاربات الثقافة الغربية، وأهمية فهم الذات الحضارية في تواصل ندي مع الآخر.
كما قدم العدد أيضا عرضا لأهم النظريات حول الثقافة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وأهم الموضوعات التي تتناولها العلوم الإنسانية في شأن الثقافة مثل قضايا الهوية، واللغة، والدين، والاقتصاد، بما يخدم القارئ غير المتخصص كخريطة سريعة للمداخل النظرية.
خلاصة
يعرض العدد 38 من مجلة الاستغراب مادة شاملة حول مفهوم الثقافة وإشكالياته: من التاريخ المفهومي والتداول الأكاديمي، إلى النسبية القيمية ومساءلتها على ضوء الفطرة، مرورا بصلات الثقافة بالعولمة والتحول الحضاري، ووصولا إلى إمكان التغيير والتخطيط الثقافي.