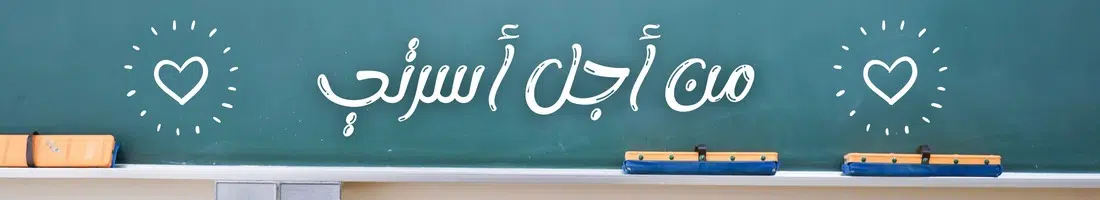الاستقامة على أمر الله تعالى: هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة، فصارت الاستقامة جامعة لخصال الدين كلها[1].
والاستقامة كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء. وتتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. فهي لله وبالله وعلى أمر الله[2].
وهي وسط بين الإفراط والتفريط، وكلاهما منهي عنه شرعا. وقد أوجب الله جل ثناؤه على عبده الاستقامة وأمره بالدوام عليها، والحرص والمثابرة عليها. ولذا شرع أن يسألها المؤمن ربّه سبحانه في كل ركعة من صلاته: { اهدنا الصراط المستقيم} [الفاتحة: 6].
فعندما جاء سفيان بن عبد الله رضي الله عنه إلى النبي ﷺ قائلا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: “قل آمنت بالله ثم استقم“[3].
على أن الاستقامة تقوم على أصلين عظيمين هما: الاقتصاد في الأعمال، والاعتصام بالسنة. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة، وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها. وإن رأى فيه حرصا على السنة، وشدة الطلب لها ولم يظفر به منقطعا عنها، أمره بالاجتهاد والجور على النفس، ومجاوزة حدّ الاقتصاد، قائلا له: إنّ هذا خير وطاعة، والزيادة والاجتهاد فيها أكمل، فلا يزال يحثّه ويحرّضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها، فيخرج عن حدّها. وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة. لكن الأول إلى بدعة التفريط والإضاعة، والثاني إلى بدعة المجاوزة والإفراط[4].
وعندما جاوز عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الحدّ في العبادة، وشدّد على نفسه، نصحه النبي ﷺ بأن يجتهد باقتصاد؛ لأن له حق على نفسه وزوره وضيفه، فقال عليه الصلاة والسلام: “إن لكل عمل شرَّة، ولكل شرّة فترة: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك“[5].
فكل الخير في اجتهاد باقتصاد، وإخلاص مقرون بالاتباع، كما قال بعض الصحابة: اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة[6].
وأصل الاستقامة على أمر الله تعالى استقامة القلب على التوحيد. فمتى استقام القلب على معرفة الله تعالى وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده ورعاياه. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبّر عنه[7].
والاستقامة في جوهرها تعني تمحور المسلم حول المبادئ والقيم والمُثل التي يؤمن بها، مهما كلّفه ذلك من عنت ومشقة، ومهما فاته من مكاسب مادية. فإذا أراد العبد أن يحيا وفق معتقداته، ورغب إلى جانب ذلك أن يحقق مصالحه المادية إلى الحدّ الأقصى، فإنه ذلك يحاول الجمع بين نقيضين، وسيجد أنه لابد في بعض المواطن من التضحية بأحدهما حتى يستقيم الآخر. وإنّ تحقيق المصلحة الدنيوية على حساب المبدأ يعدّ انتصارا لشهوة أو مصلحة آنية. أما الانتصار للمبدأ على حساب المصلحة المادية، فإن ذلك يبعث في نفس صاحبه الشعور بالسعادة والرضا والنصر، والحكمة والانسجام والثقة بالنفس.
ومما يعين على الاستقامة: الإخلاص لله تعالى، ومحاسبة النفس، والمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد؛ إذ هي من أسباب السمو الروحي، واجتناب الفحشاء والمنكر، وطلب العلم الشرعي؛ لأنه الوسيلة لمعرفة الله تعالى والمصباح الذي ينير الطريق أمام العبد، واختيار الصحبة الصالحة، وحفظ الجوارح عن المحرمات، ودعاء الله تعالى بتثبيت القلب على الدين، والاستقامة على دينه. ولزوم منهج الوسطية والاعتدال.
ومن ثمرات الاستقامة: الفوز بوَلاية الله تعالى، وطمأنينة القلب، وسعة الرزق في الدنيا، وانشراح في الصدر، والحياة الطيبة. وأزف البشرى لأهل الاستقامة في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث. ولهم في الجنة مما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم. فما أعظمه من فضل، وما أشرفها من منزلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن نبلغها بكرمه ومنّه وفضله.