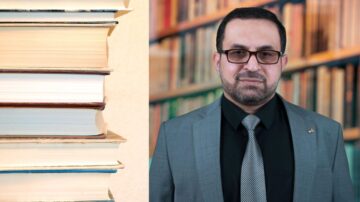يقول الدكتور آماد كاظم البرواري: إن القرآن الكريم تضمن أسمى أساليب البلاغة الخطابية، فهو يخاطب كل فئة بما يناسب معتقداتها ومستواها المعرفي والإدراكي، ويخاطب مدارك الإنسان كلها عقله، وقلبه، وفطرته، وحواسه.
وأوضح أن القرآن يخاطب كل طبقة من طبقات البشر في كل عصر من العصور، وكأنه متوجه توجهًا خاصًّا إلى تلك الطبقة بالذات؛ فالقرآن متصف بالتكامل المعرفي من حيث أسلوبه الخطابي الجامع بين العقل والعاطفة والوجدان والفطرة والحواس.
في هذا الحوار نتعرف مع د. آماد كاظم البرواري على طريقة القرآن الكريم في مخاطبة الإنسان، وفي المحاججة العقلية والبرهنة على قضاياه، كما نتطرق إلى عناية القرآن بالعقل والحض على التفكر والتدبر.
وضيف الحوار أكاديمي متخصص في المحاججة الفلسفية- جامعة زاخو. وهو من مواليد إقليم كوردستان العراق، وحصل على الماجستير من جامعة الموصل بالعراق، على الدكتوراه من جامعة مالايا بماليزيا. وله عشرة مؤلفات باللغتين العربية والكوردية؛ منها: المحاججة العقلية في برهنة حقائق القرآن- مطارحات النورسي للفكر المادي. جدلية إعجاز النص القرآني لغويًّا وفكريًّا- اعتراضات ومعالجات. ظاهرة التأثير والتأثر بين التوجيه النحوي والمعنى وأثرها في اختلاف المفسرين. تفكيك ظاهرة الإلحاد بالحجاج العقلي والعلمي. قراءة نقدية تفكيكية للشبهات المثارة حول القرآن والسنة.. فإلى الحوار:
كيف خاطبنا القرآنُ الكريم.. هل من طريق العقل أم العاطفة أم كليهما؟
إن الوحي الإلهي المتمثل في القرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة للبشرية جمعاء؛ لذا تضمن أسمى أساليب البلاغة الخطابية، فيخاطب كل فئة بما يناسب معتقداتها ومستواها المعرفي والإدراكي، ويخاطب مدارك الإنسان كلها عقله، وقلبه، وفطرته، وحواسه، بأساليب خطابية تناسب المستويات المختلفة والطبقات المتفاوتة، بحيث تحس كل طبقة أنها هي المعنية من الخطاب.
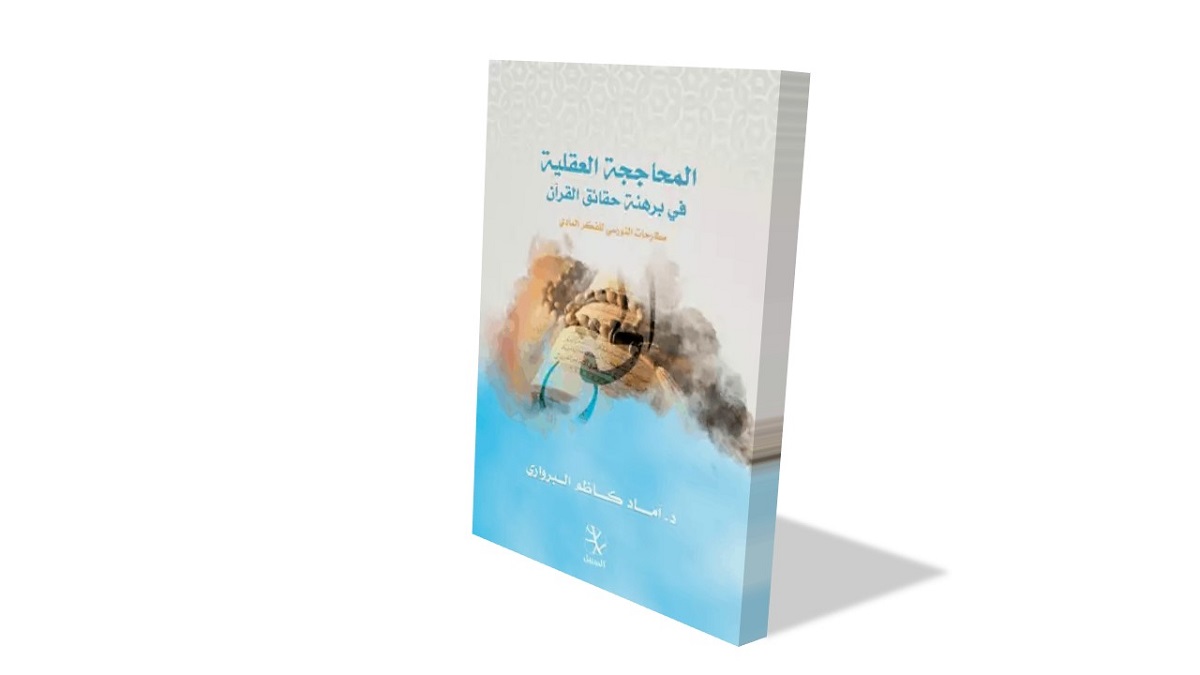
فقد خاطب الشعراء وأهل اللغة بما يتقنونه من الفنون اللغوية، وخاطب أهل الكتاب بما يجدونه مكتوبًا في كتبهم، وخاطب الفلاسفة ببرهنة الحقائق الإيمانية بحجج جدلية عقلية وأقيسة منطقية ملزمة لهم، وخاطب العرافين والكهان بأخبار غيبية غائبة عنهم؛ ولازالت أساليب خطابه تتجدد يومًا بعد يوم، فإن القرآن الحكيم يخاطب كل طبقة من طبقات البشر في كل عصر من العصور، وكأنه متوجه توجهًا خاصًّا إلى تلك الطبقة بالذات؛ فالقرآن الكريم متصف بالتكامل المعرفي من حيث أسلوبه الخطابي الجامع بين العقل والعاطفة والوجدان والفطرة والحواس.
وهل برهنة القرآن الكريم على حقائقه سلكت طريقًا واحدًا؟
إن المتمعن في الخطاب القرآني يدرك أنه يسمو الخطابات الفلسفية والأدبية، ويتميز بأسلوبه الحجاجي المتنوع بحسب مقتضى حال المتلقي، إذ سلك طرقًا متنوعة في المحاججة، منها: طريقة المناظرة والجدل، وطريقة الحوار، وطريقة القصة. وقد اتصفت حججه بالبرهانية المنطقية، والجدلية الملزمة، والخطابية المؤثرة، وتتميز بإبرازها في صور متعددة. وتتميز أدلته النقلية بسهولة الفهم، وحججه العقلية بالوضوح، وبراهينه بإلزام الخصم، وأقيسته المنطقية بأنها قليلة المقدمات، صائبة النتائج، وقاطعة للشكوك.
وقد حوى القرآن الكريم مراتب حجاجية كثيرة نذكر منها:
1- الحجة البرهانية
وهي الحجة القائمة على الاستدلال المباشر والقياس الصحيح، وهي تفيد اليقين الجازم؛ لكونها مكونة من مقدمات يقينية آيلة إلى نتائج يقينية، إذ اليقين في المقدمات والنتيجة سيان، وهي من أعلى مراتب الحجج، وتسمى بالقياس البرهاني.
ومن أمثلة الحجة البرهانية في القرآن الكريم قياس إعادة الخلق على بدئه كما في قوله تعالى: {اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} (الروم: ١١)؛ فهذا قياس برهاني للدلالة على إمكان إحياء الأموات، وهو أنه تعالى لما كان قادرًا على أن يخلقنا ابتداءً من غير مثال سابق، فلأن يكون قادرًا على إيجادنا مرة أخرى مع سبق الإيجاد الأول كان أولى. وهذه الدلالة تقريرها في العقل ظاهر، وأنه تعالى ذكرها في مظان عدة من كتابه، منها قوله سبحانه: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} (يس: ٧٩). ووجه الاحتجاج أن إيجاد الأحياء من العدم، هي مقدمة صحيحة عند الكفار؛ فالذي قدر على خلق الكائنات ابتداءً من العدم، قادر على إعادة إحيائها مرة ثانية بالقياس الأولى..
2- الحجة الجدلية
وهي الحجة القائمة على مقدمات مشهورة مسلَّمة عند المخاطب، ملزمة للخصم. ومرتبتها دون اليقين، وفوق الظن الراجح. وتسمى بالقياس الجدلي.
– القرآن الكريم يتميز بأسلوبه الحجاجي المتنوع بحسب مقتضى حال المتلقي
ومن أمثلتها في القرآن الاستدلال المباشر بانتفاء صفة العدل عقلًا في التماثل بين الصالحين والطالحين والمحسنين والمسيئين، كما يفهم من الاستفهام الإنكاري في قوله عزّ وجل: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36)} (القلم: 35، 36)؛ وهذا الاستفهام الإنكاري نفي للمساواة بينهم، وحجة غير مباشرة على ضرورة إقامة الحساب بالعدل بين الخلائق في يوم القيامة. ووجه الإلزام في الآية هو أن قول المشركين: (إن الله تعالى سيفضلنا على المسلمين في الآخرة، أو يساوي بيننا)، يستلزم منه الإيمان بوجود الآخرة والحساب، وإيمانهم هذا يستلزم الإيمان بالخالق العادل، وهذا بحد ذاته حجة عليهم في انتفاء المساواة بين محاربتهم لله، وإطاعة المسلمين له.
3- الحجة الخطابية
وهي الحجة القائمة على مقدمات مبنية على الظن الراجح لكنها غير ملزمة للخصم. والظن الراجح على مراتب، أعلاها قريب من اليقين، وأدناها قريب من الشك.
ولم يرد في القرآن الكريم- بحسب تتبعنا -حجج خطابية منفردة في برهنة الحقائق الإيمانية بل وردت مقترنة بالحجج البرهانية والجدلية أي أنها حجج اعتضادية ولست أصلية. ومن الحجج الواردة في القرآن الكريم مضافة إلى الحجج البرهانية، والجدلية لبرهنة حقيقة التوحيد قوله تعالى: {ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (الروم: 28).
في هذه الآية ضرب الله مثلًا للذين جعلوا له شركاء، هو استفهامه لهم: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكًا له في ماله وولده حتى يكون هو ومملوكه سواء، فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلِمَ رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها شركائي وهم عبيدي. ووجه الاحتجاج أن الله سبحانه احتج عليهم بأمر يستنكفون عنه ورافضين له ظنًا منهم أن ذلك تقليل من شأنهم، فاستنكر الله عليهم تكبرهم على عبيدهم من البشر مثلهم مع إرضائهم ذلك لله مع عبيده وهو خالقهم.
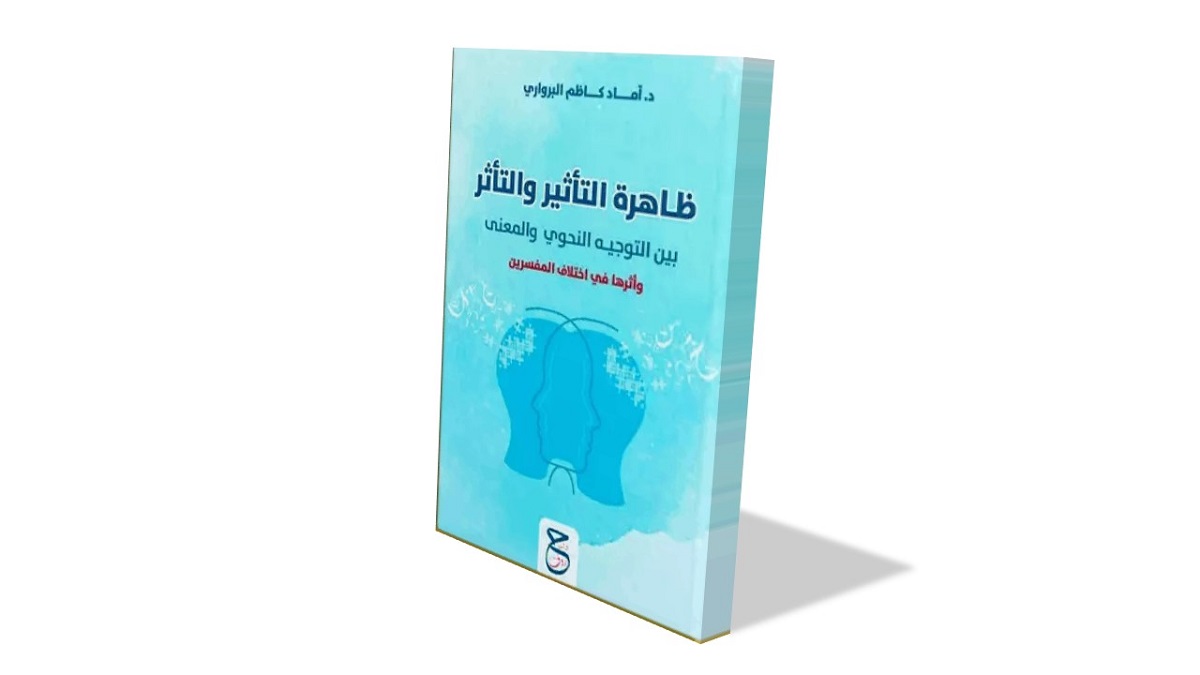
اهتم القرآن الكريم بإيراد حجج المخالفين ومناقشتها. . ما دلالة ذلك؟
نعم اهتم القرآن اهتمامًا بالغًا بالحوار مع المخالف ودعوته الى الحق ومحاججته بمعايره، والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم. وسنذكر مثالاً واحداً على سبيل التمثيل لا الحصر. فقد أورد الله الحجة المغالطة لنمرود في محاجّته لإبراهيم عليه السلام، فقد جاء في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (البقرة: 258).
– دعا القرآن إلى التفكر وإعمال العقل والاستدلال بالبراهين العقلية في الحجاج
فالحجة الصادرة من نمرود حجة مغالطة؛ لأنها بنيت على مقدمة خاطئة، وهي تفسير حقيقة الإحياء بالتخلي عن المسجون، والإماتة بقتله.. فلا يخلو حال نمرود إما أنه لم يفهم حقيقة الإحياء والإماتة، أو فهم إلا أنه قصد المصادمة والمباهتة، وكلاهما يوجب العدولَ إلى دليلٍ يفضحُ معارضته ويقطعُ حجاجه. ونرى أن انتقال إبراهيم عليه السلام إلى الحجة الثانية لم يكن إقرارًا منه على حجة نمرود، بل كان ذلك إلزامًا له بحجته في ادعائه الربوبية، مبينًا أن الذي يحيي ويميت يكون قادرًا على التصرف في الوجود في خلق ذواته، وتسخير كواكبه وحركاته، فأمره بتحويل نواميس الكون، وذلك بإتيان القمر من المغرب على خلاف العادة. فلما عجز عن ذلك تبين فساد حجته الأولى وبطلانها.
القرآن الكريم يحضّ على إعمال العقل، وبصيغ متعددة؛ من التدبر والتفكر والتعقل.. نريد توضيح ذلك؟
يكمن اكتراث القرآن للعقل ورفع منزلته في كونه وسيلة التفكر والتدبر والفهم والإدراك وتمييز الخطأ من الصواب؛ لهذا دعا القرآن الكريم في آيات غفيرة إلى التفكر وإعمال العقل والاستدلال بالبراهين العقلية في الحجاج على برهنة وجود الله ووحدانيته والنبوة والغيبيات. وثمة دلائل وفيرة على اعتناء الإسلام بالعقل، نذكر منها:
• اتخذ الإسلام العقل مناطًا للتكليف، إذ الأحكام الشرعية من الواجبات والمحرمات لا تفرض إلا على العقلاء، وكذلك أحكام البيوع والمعاملات والعقود والعهود لا تنعقد إلا بتوفر شروط الأهلية ومنها العقل.
• عدّ الإسلام العقل واحدًا من الضروريات الخمس التي يجب المحافظة عليها، ويحرم التقصير فيها أو التعدي عليها.
• حثَّ الإسلام على الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ولا يخفى أن المقصود بالاجتهاد هو إعمال العقل في التفكير والتدبر، والنظر والقياس، بحيث لا يمكن التوصل إلى استنباط الحكم إلا بإعمال العقل.
• جعل القرآن الكريم الشورى والتشاور أساسًا في الحكم والسياسة وأحكام الرعية والعلاقات الدولية. ولا يمكن التشاور إلا بإعمال العقل والتفكير.
كيف تفاعل العقل المسلم مع دعوة القرآن الكريم لإعمال العقل؟
كان الجيل الاول سامعًا مطيعًا ملبيًا لأوامر القرآن الكريم ومطبقًا أوامره على الوجه الذي ينبغي وبالطريقة المثلى التي تنبغي. ومن تلكم الأوامر إعمال العقل والجمع بين النقل والعقل والتوفيق بينهما في السياسة وحياتهم اليومية. وهذا ما أدى إلى فتح البلدان وبناء أرقى حضارة إنسانية جامعة بين الإيمان والمدنية والقيم الخلقية، ونتج عن ذلك دخول الناس في دين الله أفواجًا. لكن لما تخلى الناس عن اتباع القرآن الكريم وتطبيق أوامره في الواقع، واختزال الدين في المسجد وحصره في الأمور التعبدية وإبعاده عن الواقع، وحصر الدين في الشكليات وفصله عن السياسة، والاكتفاء بظواهر النصوص والتخلي عن مقاصدها؛ أدى ذلك إلى صراعات فكرية وحروب داخلية، وإلى التفرق والتقهقر الحضاري والتخلف عن ركب الحضارة..
– لا يجوز تحريم علم كامل بحجة سد الذرائع الموهومة
لماذا صارت كلمة “العقل” عند البعض محل ازدراء، رغم عناية القر آن الكريم بالتفكر والتدبر؟
من حيث التنظير، جميع الفرق الاسلامية تدعي الاهتمام بالعقل ووجوب إعماله؛ لكن من حيث الواقع العملي، تجد غالبية المسلمين أهملوا العقل بل عطلوه؛ من خلال اختزال الدين في العبادات فحسب، وفصل الدين عن الحياة، والتغافل عن الآيات التي تدعو إلى إعمال العقل واستعمار الأرض ماديًّا ومعنويًّا كما في قوله تعالى: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} (هود: 61).
– علم الكلام ينقسم إلى ممدوح ومذموم
ومن ناحية أخرى حرم عدد من الفقهاء وطائفة كبيرة من المسلمين المنطق والفلسفة وعلم الكلام؛ ادعاءً منهم بأنها من العلوم البدعية المحرمة. وهذا بحد ذاته جناية على الدين والعلم معًا، إذ لا يجوز تحريم علم كامل بحجة سد الذرائع الموهومة؛ فإن الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وإن احتوت على بعض السلبيات لكن فيها إيجابيات كثيرة، منها: محاججة الخصوم بالحجاج العقلي الملزم لهم، إذ لا يصح محاججة الملحدين بالأدلة النقلية الظاهرية بل لابد من الحجاج العقلي والمنطقي الموجب للإذعان والتسليم بحقائق الإيمان. إذن، من الضروري تعلم المحاججة العقلية والفلسفية والمنطقية لمواجهة الملحدين والماديين، وإلزامهم بمعاييرهم، واستدراجهم إلى الإذعان للحق والاعتراف بوجود الخالق وصحة الرسالات السماوية وهدايتهم الى الإيمان.
كيف انقلبت طريقة القرآن في البرهنة- والقائمة على لفت النظر للكون والنفس- إلى الجدل الصوري اليوناني، أي العقلي المجرد؟ وما تأثير ذلك على مسيرة حضارتنا؟
لا يخفى أن المنهج الحجاجي القرآني هو أسمى المناهج الحجاجية؛ لأنه يخاطب جميع مدارك الإنسان، وجميع طبقات البشرية، ويتوافق مع جميع العقول، ويتناسب مع جميع الأزمنة والأمكنة.
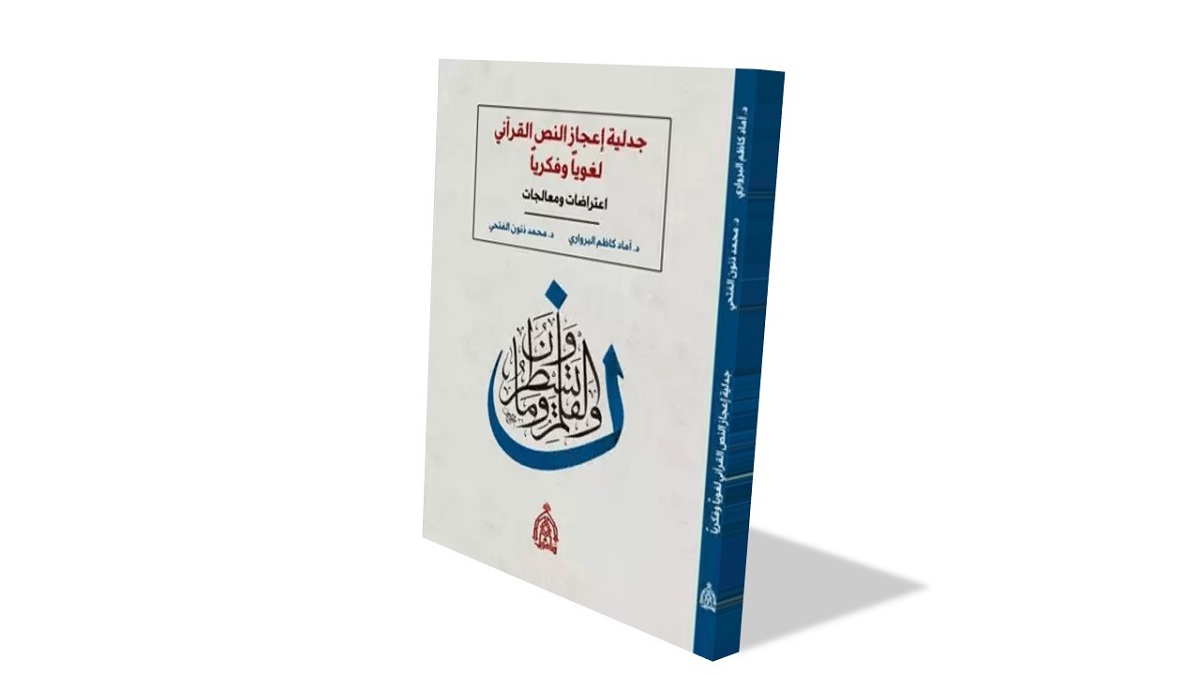
وقد صرح بوجود الحجاج في القرآن الكريم العلماء المتقدمون والمتأخرون، وصنَّف بعضهم مصنفات في ذلك. وقد أكد ابن قيم الجوزية احتواء القرآن الكريم على الحجاج العقلي؛ إذ قال: “إن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد، وإثبات الصانع والمعاد، وإرسال الرسل، وحدوث العالم، فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلًا صحيحًا على ذلك إلا وهو في القرآن بأفصح عبارة، وأوضح بيان، وأتم معنى وأبعده عن الإيرادات والأسئلة.
والممدوح هو الموضح لأصول الإيمان والمبرهن لها بالأدلة العقلية
ومن المعلوم أن قضية الجدل في الدين والخوض في قضايا أسماء الله وصفاته وعلمه وعدله وقضائه وقدره وقدم العالم وغيرها من المسائل الجدلية، لم تكن موجودة في عصر الصحابة والتابعين؛ إذ لم تكن مألوفة عندهم، وإنما تسللت إلى الإسلام في عصر الفتوحات، فعندما فتح المسلمون العراق والشام ومصر وبلاد فارس في القرن الثاني الهجري وجدوا في مدارسها العلوم اليونانية كالفلسفة والمنطق، وبفضل تشجيع الإسلام على العلم ونشر ثقافة التسامح إزاء الديانات الأخرى أدى ذلك إلى إثارة حب الاطلاع على تلك الثقافات التي التقوا بها. ولم يكن السبيل إلى معرفتها إلا بترجمتها، فشرع المسلمون بترجمة تلك العلوم من دون التميز بين غثها وسمينها، وهكذا تسللت الفلسفة اليونانية إلى الإسلام، وقد تأثر بها كثير من المسلمين.
ومن أشهر فلاسفة المسلمين الذي تأثروا بها الفيلسوف الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وجماعة إخوان الصفا، فطفقوا يقدمون العقل على النقل ويرجحونه عليه عند الاختلاف والتعارض. وقد تبنت هذه الفكرة المذهب المعتزلة إذ ذهبوا إلى أن الحسن والقبح عقليان وليسا شرعيين، وأن العقل مقدم على النقل عند التعارض. ولم تنل الفكرة قبولًا في أوساط طلبة العلم فضلًا عن العلماء، وقد عارضها علماء كثر وفنّدوها، غير أنها انتشرت في عصر العباسي بمنطق القوة والسلطة بعد أن دعّمها بعض الخلفاء العباسيين.
– هكذا بات من الضروري الدفاع عن عقائد أهل السنة والجماعة بمنطق العقل
وهكذا بات من الضروري الدفاع عن عقائد أهل السنة والجماعة بمنطق العقل، فنشأ علم الكلام السني لحاجات المجتمع الإسلامي، وللدفاع عن أصول الاعتقاد ضد شبه الفلاسفة والماديين، ومعتقدات الديانات القديمة التي كانت موجودة في بلاد الرافدين (مثل المانوية والزرادشتية والحركات الشعوبية)، وكذلك معتقدات الفرق البدعية مثل: المعتزلة والجهمية والخوارج والزنادقة والمجسمة..
وحري بالذكر أن علم الكلام ينقسم إلى ممدوح ومذموم؛ فالكلام الممدوح هو الموافق للكتاب والسنة الموضح لأصول الإيمان والمبرهن لها بالأدلة العقلية. أما الكلام المذموم فهو كلام أصحاب الأهوية، وما يزخرفه أرباب البدع للانحراف عن الدين، وعلى هذا يحمل كلام المعترضين له. فعقيدة السنة في الإسلام لا تتغير ولا تتبدل، بل الذي يتجدد هو طريق الدفاع عنها بالنظر لخصومها المتجددة..