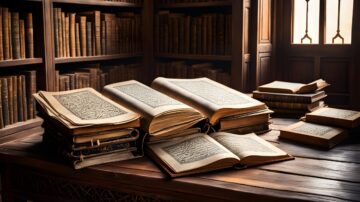هذا باب علمي مهم لا يستغنى عنه في الدرس الحديثي، ولا يصح إسقاط حديث لكونه ضعيفا سندا قبل النظر في جريان العمل به أو تركه، فإن من الحديث الضعيف ما أجمعت الأمّة على الأخذ به في الأحكام والفضائل والترغيب والترهيب..، ولم يراعوا في ذلك سبب ضعفه، لأنه يزول باتفاق العمل به، لكن ما مرادهم بهذا الإطلاق: “الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول؟”.
الجواب: يعنون به ذلك الضعيف غير المتروك الذي جرى به العمل من زمن الصحابة ومن بعدهم، وهذا قيد مهمّ في هذه المسألة، فما لم يعرفه الصحابة ولم يعملوا به لا يكون حديثا مقبولا، بل يخرج عن هذا الاصطلاح -وإن ظهر بعد عصر الصحابة وعمل به جماعة من العلماء-، فالضابط في الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول جريان العمل به عند الصحابة أوّلا ثم جريان عمل العلماء به بعدهم، كما عبر عنه الإمام الشافعي: “نقل عامة عن عامة”، ولا يدخل فيه عمل العالم أو فتوى إمام به.
مع التنبيه على أن تلقي الأمة للحديث الضعيف -غير المتروك- بالقبول لا يعني القطع بصحة نسبته للنبي ﷺ، وإنما يعني صحة العمل به لصحة معناه، ويدل على أن له أصلا في السنّة والدين، إذ لا يخرج عن كونه مستمدا من القرآن أو أحاديث أخرى أو من عمومات الشريعة ونحو ذلك، فالعبرة إذن بالعمل لا بالقطع بنسبته للنبي ﷺ، لكن بعض العلماء حكموا بصحة هذا القسم كما سيأتي في نقل الإمام ابن القيم، ومنهم من نـزّله منزلة المتواتر الذي ينسخ المقطوع، قال الزركشي: (الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع، ولهذا قال الشافعي في حديث “لا وصية لوارث” إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به، حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث)([1]).
تنبيه: ما نسبه الزركشي للشافعي من القول بنسخ هذا الحديث لآية الوصية فيه نظر، ذلك الإمام الشافعي لا يقول بنسخ السنة للقرآن، دل على هذا نصه في الرسالة، قال: (وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب يمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا)([2]).
والزركشي نقل هذا عنه في مواضع عدة في كتابه البحر المحيط، ومن ذلك قوله: (وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قاله ابن السمعاني: إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال، وإن كانت متواترة)([3]). ونقل أيضا عن الماوردي في الحاوي: قوله: (صرح الشافعي بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ووافقه أصحابه. واختلفوا هل منع منه العقل أو الشرع؟ على وجهين»([4]).
ونضيف أمرا آخر، وهو أن عمل العالم أو مذهب من المذاهب بالحديث الضعيف لا يعني الحكم بصحته في واقع الأمر، كما قال ابن الصلاح: (إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه)([5]).
وما نجده في جامع الترمذي من نقل اتفاق العلماء أو أكثرهم على العمل وفق حديث لا يعني تصحيح نسبته للنبي ﷺ، بدليل أنه قد يفعل ذلك مع حديث شديد الضعف، ومن ذلك ما رواه بسنده عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه» المغلوب على عقله. قال – الترمذي-: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث([6])، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته)([7]).
قلت: وليس فيما قال دليل على تصحيح هذا الحديث مرفوعا، ولو جرى في معناه العمل.
ثم إن هذه الأحاديث الضعيفة غير المتروكة المتلاقاة بالقبول معدودة ومعروفة عند العلماء – وإن اختلفوا في بعضها- ولكن لا يصح أن يقاس عليها غيرها كما يدعيه بعض الباحثين اليوم.
نصوص الأئمة في تقرير هذه المسالة
قال الإمام الشافعي: (ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح: “لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر”، ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين» .. ثم قال: (وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجال مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه)([8]).
وقال الحافظ ابن عبد البر: (وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء)([9]). وقال أيضًا – عن الكتاب الذي كتبه النبي ﷺ لعمرو بن حزم-: (وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل)([10]).
وقال الإمام السمعاني عن حديث معاذ لمَّا بعثه النبي ﷺ إلى اليمن قاضيا، قال له: “بم تحكم؟ قال: بكتاب الله…. الحديث: (وهذا نصٌّ ثابت، وهم يقولون: هذا خبر واحد لا يثبت به مثل هذا الأصل، وقد قالت الأصحاب هو خبر واحد، ولكن تلقته الأمة بالقبول، فصار دليلًا مقطوعًا به)([11]). وقال فيه الإمام ابن بطال: (وفى إجماع العلماء على القول به ما يغنى عن الإسناد فيه)([12]).
وقال الإمام ابن تيمية: (وفي السنن أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق كقوله ﷺ: “لا وصية لوارث”، فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول، والعمل بموجبه، وهو في السنن ليس في الصحيح)([13]).
وقال الإمام ابن القيم في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن: (فهذا حديث وإن كان عن غير مُسمَّيْنَ فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث… على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول اللَّه ﷺ: “لا وصية لوارث” وقوله في البحر: “هُوَ الطهور ماؤه الحل ميتته…”، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديثُ معاذ لما احتجوا به جميعًا غَنُوا عن طلب الإسناد له)([14]).
ونقل ابن القيم أيضا عن الإمام احمد القول بتلقين الميت في قبره، بل نقل عنه استحسانه، وإن كان في هذا نظر، وقبل رخص فيه دون الاستحسان، قال: (ويدل على هذا أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة، وكان عبثا، وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل، ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبرانى في معجمه من حديث أبى أمامة…)[15].
ومن مجموع هذه النصوص، نؤكد على هذا المسلك في التعامل مع نصوص الحديث النبوي، وهو مسلك ضروري يُحتكم إليه في فهم تلك النصوص، فالدرس الحديثي لا يقصي هذا النوع من الأحاديث لتلقي الأمة لها بالقبول وجريان العمل بها مما يدل على وجود أصل لها في الشريعة.