يعاني العقل المسلم المعاصر كثيرًا من المشكلات المعرفية والفكرية، وفي جوانب شتى.. ولا شك أن هذه المعاناة تستدعي اهتمامًا خاصًّا بالمفاهيم والمصطلحات والمضامين التي يتم تداولها؛ لأنها- عند عدم التدقيق والفحص- تُحدث لَبسًا وأزمة ذات أبعاد مركبة. وفي هذا الحوار مع الدكتور السيد عمر، أستاذ النظرية السياسية الإسلامية بجامعة حلوان، نتعرف على أهمية بناء المفاهيم، وخطورة هذه العملية، إضافة إلى التعرف على بعض الجهود البحثية التي قطعت شوطًا جيدًا في هذا الصدد.
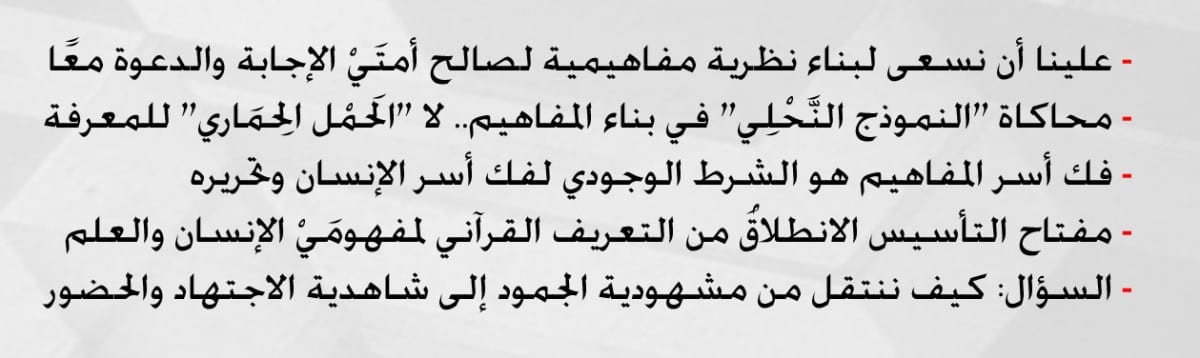
الدكتور السيد عمر مفكر مصري وأكاديمي، وصاحب اهتمامات فكرية عديدة، تتجاوز التخصص العلمي الدقيق له، وهو العلوم السياسية، إلى الشأن الفكري بأبعاد متعددة؛ انطلاقًا وتأسيسًا على الرؤية الإسلامية المعرفية.. من أهم مؤلفاته: (الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام)، (خارطة المفاهيم القرآنية)، (الأنا والآخر من منظور قرآني)، (دارفور بين إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة)، (وسائل فض المنازعات الدولية بين النظرية والتطبيق)، إضافة إلى الإشراف والإسهام في الكتاب الذي صدر مؤخرًا من جزءين بعنوان: (بناء المفاهيم الأصيلة لعلوم الأمة).. فإلى الحوار:
لكم اهتمام بـ”بناء المفاهيم”.. كيف بدأت هذه المسيرة؟
بدأت هذه المسيرة عام 1985 بفريق بحثي اصطلحنا على تسميته (فريق بناء المفاهيم). وقد عمل هذا الفريق في التدبر المعرفي والقدح الذهني، لوضع: تصور لبنية نظرية منهجية لبناء المفاهيم؛ لصالح أمتَيْ الإجابة والدعوة معًا- أي المسلمين وغيرهم- باستثناء المعاندين للحق المنكرين للشمس في يوم من أيام الصيف في ضحى يوم مشمس.
ويندرج هذا المسعى لتأسيس (علم بناء المفاهيم) بمستوييه النظري والتطبيقي ضمن مشروع الاحتساب للقيام بحمل هَمِ أمتنا على الثغر المعرفي. وعلى مدى قرابة أربعة عقود، أضاف ذلك الفريق بحوثًا تأسيسية جماعية وفردية، وسعى بكل وسعه إلى نقل ما أنعم الله به عليه إلى جيل جديد من شباب الباحثين.
وأثمر هذا المسعى خيوطًا باعثة على الرجاء، وخيوطًا باعثة على وجوب المراجعة والنصيحة والتناصح لله تعالى. وتلك مهمة جد ثقيلة؛ فلقد جرت مشيئة الله فينا أن نكون طلاب العلم في هذه الأمة في اللحظة الراهنة، المسؤولين عن المجاهدة بالقرآن في تخلية “الران المعرفي” الذي حجب عنها نور القرآن، وإزاحة ظلمات الجهالة بكل أشكالها عن عقلها ووجدانها، وإعادة بناء علومها من القرآن، والتفكر في سبل استثمار ثمرة تلك “التخلية” و”التحلية” في “التجلية” الناقلة لها من واقعها المعيش على مدى القرون الخمسة الأخيرة، إلى الوضعية الممكنة التي يتسنى لها بلوغها بالحوار مع القرآن ببصر وبصيرة، وريادتها على الطريق إلى استئناف الرسالة التي كلفها الله بها من بعثة النبي الخاتم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وتناسجت في هذا المسعى المعرفي “مدرسةُ حامد ربيع“- المفكر وأستاذ العلوم السياسية المعروف- و”مدرسةُ إسلامية المعرفة”- بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي- اللتان كان من المستحيل لأيهما الاستواء على سوقها دون الأخرى. وحالف التوفيق الإلهي هذا الفريق، في صياغة قواعد بناء المفاهيم، وشفع ذلك بنوعين من التطبيقات: بناء مفاهيم من الموسوعات والأدبيات المعرفية في مشارق الأرض ومغاربها بانفتاح بالغ، نافرًا من “الحَمْل الحِمَاري” للمعرفة، وساعيًا لمحاكاة “النموذج النَّحْلِي” في السير على طريق بيان علم بناء المفاهيم من مرجعية إسلامية.
ويبين “النموذج النحلي” أن نظام المخلوقات كله قائم على تراتبية ونظام في الوفاء بالأمر والنهي التكليفيين الإلهيين. فأَمْرُ النحل بأن تتخذ بيوتًا، يسبق أمرها بالأكل من كل الثمرات. وتسخير المخلوقات ليس للإنسان وحده. فالله يسخر الرياح والماء والهواء للنبات والحيوان والإنسان. وها هي النحل يسخر الله لها سبله ذللاً، ويأذن لها بالأكل من كل الثمرات. و”الشراب” الذي يخرج من بطونها يجيء مختلف الألوان، ويكون فيه شفاء للناس، وآيات لقوم يتفكرون. وفي هذا توجيه للإنسان بكل أنساقه عامة، ولطلاب العلم بوجه خاص، إلى محاكاة هذا النموذج قدر الاستطاعة الإنسانية، بأن تبني وتسعى في طلب الخير، وتخرج من سعيها في الأكل من كل الطيبات- بما تقوم به عليه من عمليات الفرز والتمثل والهضم وإعادة التركيب- ما به: شفاء للناس من الجهالة، ومن العوز، ومن التيه، ومن سوء المنقلب.
وما الثمرة التي نتجت عن هذا الجهد؟
هذه الجهود أثمرت حلقة أولى، صدرت تحت عنوان (بناء المفاهيم: دراسة معرفية ونماذج تطبيقية)، في أواخر تسعينيات القرن الماضي (1998م). وتضمنت هذه الحلقة تفكيك دراسة متطاولة على القرآن، باستخلاص مقياس قرآني لمعايرتها؛ حتى يكون الميزان ميزانًا والموزون موزونًا. وخُتمت تلك الحلقة التأسيسية بجمع خيوط التنظير والتطبيق فيما وصف بـ(خلاصة الخبرة البحثية) ونواتها هي أن بناء المفاهيم عملية تحكمها قاعدة: حدود لا قيود، وتتطلب التكافل المعرفي، وعمل فريق متعدد التخصصات، والبحث عن الجامع الإنساني المشترك، وليس الفارق.
وأستعيد في ثنايا هذا الجهد: الوعي بأن المفاهيم بمثابة لبنات للبناء المعرفي، لا يكفى التعريف بدلالاتها اللغوية والاصطلاحية، بل يلزم صناعتها بمعايير تكفل المناعة والمتانة والاستعصاء على النَّقب، والتناغم مع طبيعة البناء، جنبًا إلى جنب مع التفكر في المادة اللاصقة التي تسمح لها بأن تكون وحدات في بناء مرصوص، وبمثابة أعضاء في جسد واحد متراحم، لو اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وأن تكون بمثابة منظومة: لكل لبنة فيها مقام معلوم، وكل منها راع ومسؤول عن رعيته.
وبالتزود بالعبر التي أثمرتها تلك الحلقة التي دامت قرابة خمس سنوات، انصرف أعضاء الفريق إلى بناء ثلة من المفاهيم فرادى؛ وتبين في الجهد الجمعي والجهود الفردية معًا أن العبرة الأهم هي أن: ما بمنظومة المفاهيم- التي يتعاطى العقل الإنساني عامة والمسلم منه بوجه خاص- من أعطاب وتشوهات، يجعل من المستحيل الخروج من وضعية الوهن التي أصابت أمتنا، ومن حياة الضنك والصراع التي ابتليت بها البشرية في القرون الخمس الأخيرة وبوتيرة متصاعدة.. دون إعادة بناء المفاهيم من منظور قرآني جامع؛ أي بالعودة إلى تسمية كل شيء بالاسم الذي سماه الله ورسله به؛ وذلك بربط المفاهيم بالأسماء التي علمها الله تعالى لآدم من أول عهده بالوجود. فبتحريف الأسماء عن دلالاتها المحددة للوظيفة الوجودية التي خلقها الله لها، يقع اللبس والعماء، ويتنابذ الاسم مع المسمى!
إذن، كيف نستفيد من القرآن الكريم في عملية “بناء المفاهيم”؟
لقد كانت للقرآن الكريم حفاوة كبيرة بالتوجيه للحذر من التلاعب بالمفاهيم، ومن اختلاق أسماء ما أنزل الله بها من سلطان بالهوى، في أمثال قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (البقرة: 104)، وقوله: {مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً} (النساء: 46)، وقوله: {قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤكُم مَّا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ} (الأعراف: 71)، وقوله: {مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} (يوسف: 40).
وتكتسب عملية فك أسر مفاهيم علوم أمتَيْ الإجابة والدعوة- مما لحق بها، من غبش ومن عزل عن نور القرآن، ومن إبعاد لخرائطها ومتصلاتها الدلالية والعمرانية التي فطرها الله عليها أول مرة- أهميتها من كونها هي الشرط الوجودي لفك أسر مفهوم الإنسان وتحريره من الإصر والأغلال المعرفية المتراكمة، منذ السقوط في وزر استبدال المنطق الأرسطي بالقرآن، في لحظة تسمى: لحظة التألق الإسلامي في القرن الثالث الهجري؛ وهي- عند التدقيق- جذر كل ما أصاب الإنسانية من ويلات من حينها حتى يأذن الله برفعها بتوبة معرفية مقبولة، مفتاحها الوحيد هو: الفيئة الإنسانية للعودة إلى تسمية كل شيء بالاسم الذي ارتضاه الله له.
والإنسان بحكم الحرية التوحيدية صاحب قابلية للاستواء المفاهيمي، ببناء المفاهيم من رؤية كلية قرآنية ينبثق منها إطار مرجعي رأسي المسقط من الهدى الرباني المنزل، وتنتظم بهما ثلاثة عمليات:
أولاها: صناعة لبنات المعرفة بكل ما يرتبط بها من فحص لمادة التصنيع وشروطه وقياس الصلاحية وإزالة الخبث، والمراجعة، والتصديق عليها بالقرآن.
وثانيتها: رسم خريطة مقامات المفاهيم الكفيلة بوضع كل مفهوم في المقام المستحق له دون بغي ولا تطفيف.
وثالثتها: التعرف على المكان المناسب لكل مفهوم في البناء المعرفي العمراني بالنسبة لكافة الأنساق الإنسانية المجعولة والمحاكية والإنسانية الصنع، وتحديد نوعية المادة اللاصقة، وإنتاج (القِطر المعرفي) الكفيل بصبه على البناء المعرفي أن يجعله مستعصيًا على الاستهداف من أعلاه، وعلى النقب، باستلهام نصيب من سمات السُّور الذي بناه ذو القرنين لحجز عدوان المفسدين في الأرض على الزرع والنسل، كما ورد في القصة المعروفة بسورة الكهف.
ومن المهم- في التفكر في مسبار لبناء المفاهيم بمغزل توحيدي- القول بملء الفم: لا للقراءات الضالة بكل صورها، من: القراءة العشوائية، القراءة البرانية، القراءة الحصرية الأحادية النظرة، القراءة التشقيقية، القراءة الجانحة، القراءة العلمانية. ونعم بكياننا كله للاستظلال بظل: القراءة المنهاجية الجامعة بسم الله؛ بكل روافدها من: القراءة السياقية المقارنة، القراءة الترشيحية التشريحية، القراءة الناقدة، القراءة الكاشفة، القراءة الفارقة، القراءة الفرقانية، القراءة البانية الواعية.
ومفتاح التأسيس لاجتناب القراءات المريضة والممرضة، والتمرس بالقراءات المستبصرة هو: الانطلاق من التعريف القرآني لمفهومَيْ: الإنسان والعلم النافع.
ومن المفارقات أن (التعريف الإبليسي) لمفهوم (الإنسان) كان أكثر إنصافًا من تعريف (الإنسان الدهري) في العصر الحديث لنفسه. فإبليس عرَّف الإنسان بأنه كائن خلقه الله من طين وكرمه عن غير استحقاق، لكون النار- في نظره- أولى بالتكريم بالمقارنة بالطين. وأما الإنسان الدهري المعاصر فانطلق من فرية دارون المتعلقة بالنشوء والتطور، إلى القول بأن أصل الإنسان قرد، وتردد به بين ادعاءين مزيفين متناقضين؛ هو مع أولهما: مجرد حيوان مترقي، ومع الثاني: إله من دون الله. ويؤسس هذا لتعريف للإنسان لـ(العلم) على نحو يحصره في العلم الضار المضيع، الذي يثمر رباعية التعاسة: الخوف ولحزن والضلال والشقاوة.
وأما موضوع العلم- فيما يتعلق بعمليات “بناء المفاهيم” في منهاجية القراءة الجامعة بسم الله تعالى- فهو: العودة إلى تسمية كل شيء بالاسم الذي ارتضاه الله له يوم خلق السماوات والأرض؛ لكون ذلك هو الشرط اللازم لرعاية الإنسان أمانة حفظ نفسه محررة لله، وتأدية الأمانات إلى أهلها.
أصدرتم مؤخرًا ضمن عمل جماعي كتاب (بناء المفاهيم الأصيلة لعلوم الأمة).. كيف جاء صدور هذا العمل؟ وما رسالته الأساسية؟
هذا الكتاب هو فرع لمعطيات الحلقة الأولى التي أشرنا إليها، والمتمثلة في ثمرتين؛ أولاهما: خريطة تنظيرية لخطوات بناء المفاهيم، ولآليات الاستقامة في معايرة المفاهيم، ولأساليب العبث بالمفاهيم، وأهم آليات استعادة مفاهيم علوم الأمة لعافيتها. والثانية: عشرات البحوث الفردية لمدرسة حامد ربيع، نواتها جميعًا هي الخبرة النظرية والتطبيقية للحلقة الأولى، في بناء مفاهيم مفتاحية، وفي تطوير منهاجية بناء المفاهيم.
وبالمراكمة على تلكما الثمرتين، تحركت الجماعة العلمية بالمعهد العالمي صوب الحلقة الجماعية الثانية، وهي كتاب (بناء المفاهيم الأصيلة لعلوم الأمة)، الذي صدر بتعاون مشترك مع مركز “أركان للدراسات والأبحاث والنشر”. وكنت أحد المشرفين على هذا العمل مع الأساتذة د. عبد الرحمن النقيب، د. رفعت العوضي، د. محمد صالحين، د. نعمت عبد اللطيف مشهور، ومعنا فريق من شباب الباحثين الجادين.
وفي هذا الكتاب قمنا ببناء ستة عشر مفهومًا من مفاهيم علوم الأمة، تستهل بإطلالة على بنية مفهوم (الأمة) بوصفه هو المظلة التي تندرج تحتها كافة المفاهيم الأخرى: مفهوما الدين، والمعرفة، ثم مفهوم الإنسان والمفاهيم الدائرة في فلكه. العالِم والمتعلم والأخلاق والسلام وحقوق الإنسان في المنظورين الغربي والإسلامي، ومفهوم الدولة، والاقتصاد والاستخلاف والإعمار والتمويل والرشد الاقتصادي والأصولية والإعلام.
ما الخطوة التالية في مشروع “بناء المفاهيم” الممتد؟
شرعنا بفضل الله تعالى منذ شهور في إعداد (موسوعة مفاهيم إسلامية المعرفة)، التي ترمي إلى بناء منظومة من المفاهيم المفتاحية مستدعية لكل منها نواته والمفاهيم المحورية والمفاهيم الطرفية ذات الصلة به، كما تضمنتها أدبيات المعهد العالمي للفكر الإسلامي منذ نشأته حتى الآن.
وتشمل تلك الموسوعة بمشيئة الله بناء ثلاثين مفهومًا هي: التوحيد، الإنسان، إسلامية المعرفة، التكامل المعرفي، الدين، المنهجية القرآنية الجامعة، العبادة، الخلافة، الحضارة الإسلامية، علم العمران الحضاري الجامع، فقه علوم الأمة، إصلاح الفكر الإسلامي، تنشئة الإنسان الكوني، مفهوم جودة العملية التعليمية، مفهوم الأمة، منظومة القيم الإسلامية، السلام الإسلامي، النموذج المعرفي الإسلامي، فقه التربية، الاقتصاد الإسلامي، التجديد الإسلامي، علم التاريخ، الإعلام الإسلامي، السياسة الإسلامية، فقه المراجعات، التراث، الفساد، الفقه المقاصدي، الجهاد.
وتتطلع الجماعة العلمية بالمعهد بمشيئة الله إلى تتويج مشروع بناء المفاهيم بإنتاج (موسوعة المفاهيم القرآنية)؛ وفي الصدارة منها رسم معالم النموذج المعرفي القرآني لبناء المفاهيم، وتحديد أهم المفاتيح للقراءة الإنسانية المتبعة للقراءة الربانية للقرآن؛ والتي ستمثل نقلة نوعية أبعد بكثير من الدلالة المضمونية لمفهوم (القراءتين) التي انطلق منها المعهد، وهي: الجمع بين قراءة الكون المقروء والكون المنظور.
لاشك أن طريق “بناء المفاهيم” به مزالق ومنحنيات.. فبم توصون الباحثين لتجنب ذلك؟
إن كانت لي توصية أوصي بها إخواني الباحثين فهي: عليكم بالنهل من القرآن، واجتناب العجلة، والتحلي بالصبر، والحذر من فخاخ “المسخ المعرفي”؛ وفي مقدمتها ما يحيط بالمعرفة الدهرية المعاصرة من زخرف القول.
بجانب هذا، يتعين علينا الحذر من المقولتين المولدتين للضلال المعاصر في عالم المفاهيم؛ وهما مقولة: أن أصل ما لدى الغرب من علوم هو ما قدمه العقل المسلم له قبل عصر ما يسمى النهضة الأوربية. وثانيتهما مقولة: (الحكمة ضالة المؤمن)؛ والتي تتوهم إمكانية تلمس حكمة في معرفة رافضة للنور المنزل من عند الله.
فالعقل الدهري ينتج على مدى التاريخ الإنساني علومًا مغايرة لتلك التي ينتجها العقل التوحيدي، وما ننقله عن الغرب هو بالتالي معرفة مشبوهة، لا بد من التنبه إلى كامنها المفخخ، وإخضاعها لمرشحات معرفية، والتزود بكواسح ألغام، وبحصانة قرآنية، بالنسبة لكل من يسعى من علماء الأمة للتدبر فيها، والفحص الرشيد لمسمياتها ولفروعها ولمفاهيمها ولمآلات دخول جحر ضبها.
ويمكنني في هذا المقام أن أكتفي بذكر مفتاح ما يستحق أن يسمى (بضاعتنا) وما حقه أن يسمى (بضاعتهم)، وهو: بضاعتنا هي كل ما يمت بصلة لـ(قوة الحق). وأما كل ما يمت بصلة لـ(حق القوة) فهو- حتى لو كانت بذرته الأولى من عند أمتنا المكلفة بأن تكون خير أمة أخرجت للناس- لم يعد يمت لنا بصلة، بعد أن تم أسره وتفخيخه وتسميمه، وتوظيفه في استعمار ديار الإسلام وعقول المسلمين، وأصبح دليله هو: البقاء للأقوى، بمنأى تام عن: التزام كلمة التقوى والبحث عن الكلمة السواء والسعي إلى ما يجمع بين البشر واجتناب ما يؤدي إلى الفرقة والصراع بينهم.
ولعلي أذكّر علماء أمتي هنا ببعض مقولات، سيسألون بين يدي الله تعالى عن هجرها وعدم القيام بحقها. فمالك بن نبي يحذر أمته من ثلاثة:
الأورام المعرفية:والتي من بين شواهدها الاحتكام إلى عدد المؤلفات في كل علم، وليس إلى نوعيتها ووزنها في ميزان المقاصد القرآنية العليا ومقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة.
والقوارض المجازة: أي مَنْ يخرجون إلى الغرب من المبتعثين دون تحصين قرآني كاف، فيعودون من هناك بنفاياته وبمعرفة سطحية بعلومه، مع جهل بهويتهم الأصلية؛ فيصيرون بمثابة فئران يخرقون سفينة عقل الأمة.
والمرايا المعطلة: أي المعرفة المزجاة التي يلتبس فيها الحق بالباطل؛ فتصير- بالنسبة لمن يريد أن يرى ذاته بها، وأن يرى الخليقة بها- شبيهة بالمرآة المليئة بالشقوق، التي تجعله عاجزًا عن رؤية أي شيء على حقيقته؛ بما يفتح المجال واسعًا أمام الرؤية بأضغاث أحلام، وبخيال مريض وممرض.
ما أهم المفاهيم التي ترونها بحاجة ملحة للمراجعة؟
مازال هناك الكثير أمام العقل المسلم، مما أسماه المفكر الكبير إسماعيل راجي الفاروقي، رحمه الله: (منهاجية إزالة الاستعمار الغربي للمعرفة).
والدكتور الشاهد البوشيخي يقدم بدوره مفتاح التحصين للعقل المسلم ضد الاستعمار المعرفي، بتجليته حقيقة أن أهم مفهوم يتعين أن يركز عليه الباحثون وعلماء الأمة في كافة مجالات المعرفة هو مفهوم: ( الذات: من نحن ؟)؛ بما أنه هو وعاء كافة مكنات الأمة.
ومن هنا، فإن جوهر وهن الأمة الحالي هو أن المفهوم الذي هو في بؤرة اهتمام أبنائها هو مفهوم (غير الذات)؛ مع أن استيعاب ما لدى الغير واستقبال مصطلحاته ينبغي أن ينطلق من الرؤية الخاصة لمفهوم (مصطلحات الذات)، وينضبط بمفاهيمها.
ونواة مفهوم (الذات) هو: مفهوم (القرآن والسنة البيان). فبهذا المفهوم، وله، وعليه، قامت الأمة. والأمة لا تقوم ما لم تفهمه حق الفهم، ولا تعتبر قائمة به ولا عليه ما لم تقيمه كما أُمِرت صدقاً وعدلاً. ومقتضى إقامة الأمة لهذا المفهوم الأصل، هو: إقامة (المفهوم الفرع) النابع منه، والمتمثل في مفهوم (الأمة) ذاتها، وفى أصول تفاعلها مع التاريخ، وفى التاريخ. ويتطلب ذلك إعادة بناء مفهوم (مصطلح العلوم والفنون والصناعات) مع فهمه وتقويمه وتوظيفه صدقاً وعدلاً. ويرتبط بذلك أيضًا تجديد الفهم لعلوم الشرع، وعلوم الإنسان، وعلوم المادة، وتنقيتها مما دس فيها أو شوهها عبر الفعل الإنساني.
ويحتاج مفهوما (الإنسان) و(علوم الإنسان) بشدة إلى (جمارك قرآنية) لغلبة المضامين الدلالية الوافدة عليهما. فالبحث في هذين المفهومين قائم الآن برؤية الآخر ومنهاجه. والأمة المرشحة لإنصاف الإنسان وتحقيق عزته وكرامته، وإعادة الآدمية المسلوبة للعلوم الإنسانية كلها بالتحول من المفهوم المادي للإنسان إلى خصوصيته في الخلق والتكريم، هي الأمة الإسلامية، المكلفة بحفظ وظيفة العلوم، بما ينفع الناس ويمكث في الأرض.
ويرتبط قيام أمة الإجابة بهذه المهمة باستعادتها لوضعية (الشهود الحضاري). ولا شهادة إلا بأهلية. وشروط هذه الأهلية هي: استعادة الأمة الوسط الخيرة، حاملة الأمانة.
ومن هنا، يأتي في صدارة المعالجة المعرفية المستقيمة لموضوع: إعادة بناء علوم الأمة، قيام علماء الأمة بالسهر لحراسة ثغرها المعرفي؛ وذلك برسم معالم سؤال أمة الإجابة في لحظتها الحاضرة: ما هو بيان طريق تعافيها العمراني بعد أن أصبحت أشلاء، من: مشهودية واقع الجمود والجحود، إلى شاهدية الموقع بالاجتهاد والحضور والشهود الحضاري؟
ومفتاح الإجابة هو استحضار خلاصة هذه “السُّنة الإلهية” ببعديها التكويني والتكليفي: لا إصلاح حال قبل إصلاح العمل، ولا إصلاح عمل قبل تجديد الفهم، ولا تجديد للفهم قبل تجديد المنهج، ولا تجديد يعتد به للمنهج إلا ببنائه من القرآن، ولا قيمة لتجديد الوعي بالشرعة والمنهاجية القرآنية ما لم يتم تجاوز (المعرفة النظرية) بهما إلى آفاق (الاستعانة الفعلية) بهما في إعادة استكشاف كل من: الرؤية الكلية والإطار المرجعي المستمدَيْن من القرآن الكريم.

