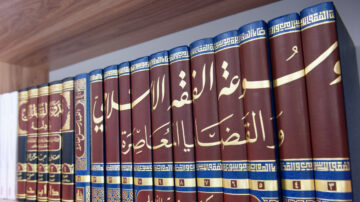الفرض الكفائي هو ما يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وقد قصد الشارع به تحقيق المصلحة دون نظر إلى الفاعل بالذات. يعني أن الشارع لا يطلب من كل مكلف بعينه أداء هذا الفرض، بل يكفي أن يقوم به بعضهم، فإذا تحقق الغرض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يتحقق، أثم الجميع. أمثلة: تغسيل الميت، الجهاد، التعليم، الطب، بناء المستشفيات.
علامات الفرض الكفائي
تعرف الفروض الكفائية بعلامات هي:
– أن يكون الخطاب الشرعي لا يقتضي أن يعم الفرض جميع المكلفين.
– أن يكون الخطاب بلفظ يقتضي العموم، لكن توجد قرينة تقتضي أن الفرض يسقط بفعل البعض، ومن القرائن الدالة على ذلك: الدليل المتصل، الدليل المنفصل، الإجماع، العقل، تحقق المصلحة بفعل البعض.
نوعا الفروض الكفائية
والفروض الكفائية على نوعين:
- الفرض الفردي: ما كان في حدود قدرة الفرد الواحد.
- الفرض الجماعي: ما كان أعلى من قدرة الفرد، ويجب أن تتعاون على أدائه الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى الدولة أيضا أن تخصص جهازا لإدارة هذه الفروض وتنظيمها والإشراف عليها.
ما حدود مسؤولية الفرد عن الفروض الكفائية؟
ولعل أهم سؤال تتعلق به فاعلية الفروض الكفائية في الحياة المعاصرة هو: ما حدود مسؤولية الفرد عن تلك الفروض؟
والإجابة عن هذا السؤال قاربها الأصوليون والفقهاء في مسألتين هما:
- متعلق الخطاب في الفرض الكفائي؛ والتحقيق فيها أن الفرض الكفائي يجب على جميع المكلفين بشرطي: العلم والقدرة. فهذه المسألة تبين المسؤولية عن الفروض الكفائية ابتداء؛ لكن المسألة الأهم في الإجابة عن ذلك السؤال هي:
- تعين الفرض الكفائي؛ فقد ذكر العلماء عدة حالات لتعين الفرض الكفائي، بعضها متفق عليها، وبعضها مختلف فيها.
الحالات المتفق عليها لتعيين الفرض الكفائي
- إذا ظن المكلف أن غيره لم يقم بالفرض الكفائي.
- إذا انحصر الوجوب في شخص واحد أو جماعة.
- إذا قصر المكلف بأدائه أو لم يحقق الكفاية تعين على الأقرب فالأقرب.
- يتعين طلب العلم الذي لا يتم الواجب إلا به.
الحالات المختلف فيها
أما الحالات المختلف فيها فهي:
- إذا طُلب من المكلف أداؤه.
- إذا شرع المكلف فيه.
والملاحظ في هذه الحالات –بشكل عام- أنها حالات ظرفية لا تسمح ببناء نظام عام لتقسيم المسؤولية عن الفرض الكفائي؛ وهنا تأتي أهمية قاعدة الشاطبي حيث إنها تعطي تصورا عاما لتعين الفرض الكفائي؛ يمكن من خلالها وضع نظام عام ودقيق لتوزيع المسؤولية عن الفروض الكفائية بين المكلفين؛ وبذلك تُفعّل الفروض الكفائية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة.
الإمام الشاطبي واختياره لهذه القاعدة
الإمام الشاطبي لم يتحدث عن الفرض الكفائي فقط، بل قدّم قاعدة متقدمة ومتفردة في تحديد من يتعين عليه الفرض الكفائي، وهي قاعدة تعين الفروض الكفائية حسب النعم والفروق الفردية.[1]
وبذلك، لا يرى الشاطبي أن الفرض الكفائي يتعين فقط بسبب نقص في من يؤديه، بل يرى أن وجود المؤهلات في شخص معين يُلزمه بأداء ذلك الفرض.
القاعدة وأثرها في نهضة الأمة
لو استوعبت هذه القاعدة جيدا لكان سببا في حل كثير من الأزمات الرئيسية التي تعاني منها الأمة الإسلامية، والتي تتركز على ضعف التقدير للموارد البشرية وقلة الاهتمام بالإنسان الذي هو محور الحضارة وأساسها؛ فلا نهضة للأمة ولا تجديد لحضارتها إلا بالإنسان وهذا لوه ارتباط بضعف المنظومات التربوية في الدول الإسلامية. .
ومن تجليات هذه الأزمة:
- ضعف التوجيه المهني؛ الذي تبدو آثاره صارخة في الواقع؛ تجد الطالب لا يعرف شيئا عن مستقبله المهني والجامعي خلال الأطوار الأولى للتعليم، وفجأة يجد نفسه على أبواب الجامعة يدرس تخصصا لا يحبه أو ليس له من القدرات ما يمكنه من مواصلة الدراسة فيه، فربما اختار تخصصا آخر ولاقى من المشاكل ما لاقى في تخصصه الأول؛ فيقرر أن يضع حدا لهذا المسار ويتوجه إلى الحياة العملية، وهكذا تفقد الأمة طاقاتها البشرية التي هي أعز ما تملكها.
وربما يوفق في دراسته الجامعية لكنه بعد التخرج يفاجأ بأن تخصصه غير مطلوب في سوق الشغل، فيضطر إلى التوظف في غير تخصصه فيضيع العلم والخبرة.
- وجود الرجل المناسب في غير المكان المناسب؛ حيث تجد المتخصص في الاقتصاد موظفا في الهندسة مثلا؛ وتجد المتخصص في الهندسة موظفا في الاقتصاد؛ وهكذا…
وهذا ما تنبه إليه الشاطبي والعلماء الأوائل حين وضعوا قاعدة تعين الفروض الكفائية، واعتبروا أن المهن والحرف كلها من فروض الكفاية، ولكن يراعى استحضار الضوابط الشرعية في اختيارها. والشاطبي عبر عن هذا بوضوح أن الفرض الكفائي يتعين على الناس بحسب قدراتهم وسماتهم وميولهم ومواهبهم.
تحليل القاعدة (شرح تفصيلي بمقتطفات)
الفروق الفردية
والفروق الفردية ظاهرة بشرية نبهت إليها النصوص الشرعية، وتكلم عنها العلماء؛ ففي القرآن الكريم إقرار واضح بوجود الفروق الفردية بين الناس وأن الله خلق الناس مختلفين ومتفاوتين في خصائصهم. قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود: 118]
الميول
الميول تُعبّر عن رغبة داخلية تجاه مجال معين، والميل المهني: الاتجاه الإيجابي نحو مهنة ما، بحيث يكون الشخص محبًا لتلك المهنة، مقبلًا عليها، مستمتعًا بقضاء وقته فيها”
وقد تنبه علماء المسلمين إلى أهمية مراعاة الميول في اختيار المهنة للصبي؛ يقول ابن سينا: “فإذا اختار –مدبر الصبي- له إحدى الصناعات تعرف قدر ميله إليها ورغبته فيها.
ويقول الشاطبي: فإذا دخل في ذلك البعض (من العلوم) فمال به طبعه إليه على الخصوص، وأحبه أكثر من غيره، ترك وما أحب.[2]“.
القدرات والاستعدادات
القدرة تُعرّف بأنها: إمكانية الفرد الحالية على مزاولة نشاط ذهني أو حسي أو حركي سواء اكتسب تلك القدرة بسبب التدريب والتعليم أو بدونهما.
وتختلف القدرة عن الاستعداد في أن القدرات تطلق على الإمكانيات الموجودة بالفعل، أما الاستعدادت فتطلق على القدرات التي يمكن لفرد أن يكتسبها بسرعة أكثر من غيره بسبب وجود قدرات حالية لديه . وتعتبر القدرة شرطا من شروط التكليف وعليها تنبني كثير من الأحكام الشرعية والرخص وغير ذلك؛ قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]
وقد عبر الشاطبي عن القدرات والاستعدادت فقال: “وفي أثناء العناية بذلك (أي التربية والتعليم) يقوى في كل واحد من الخلق ما فطر عليه وما ألهم له من تفاصيل الأحوال والأعمال، فيظهر فيه وعليه، ويبرز فيه على أقرانه ممن لم يهيأ تلك الهيئة، فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد نجم على ظاهره ما فطر عليه في أوليته فترى واحدا قد تهيأ للعلم، وآخر لطلب الرئاسة، وآخر للتصنع ببعض المهن المحتاج إليها، وآخر للصراع والنطاح إلى سائر الأمور”.
ويبدو من سياق كلامه أن النشء إذا وجد فيه استعداد لعلم أو مهنة وجب على المربين أن يشجعوه عليها ويوجهوه إليها حتى يتمكن فيها فيتعين عليه الفرض الكفائي المناسب لها.
السمات الشخصية
هي الصفات الأخلاقية والاجتماعية التي تميز الفرد، مثل القيادة والحلم والصلابة… ويقول النبي ﷺ:
“إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحِلم والأناة”.
فالصفات الاجتماعية كالتسامح أو التشدد؛ والانطواء أو الانبساط؛ والاستقلال أو الاتكال، والصفات الخُلُقية كالصدق أو الكذب؛ والأمانة أو الخيانة… وأما الصفات المزاجية فيُنظر فيها إلى درجة تأثر الفرد بالمواقف التي تثير الانفعال، وإلى الحالة الانفعالية الغالبة كالمرح أو الاكتئاب، وإلى ثبات الانفعالات أو تقلبها وتذبذبها، وأما الدوافع فهي ميول الفرد واهتماماته ومستوى طموحه وعواطفه واتجهاته النفسية المختلفة.
ويُستنتج مما سبق أن السمات الشخصية نوعان: سمات إيجابية وسمات سلبية، فأما السمات السلبية فلا يتعين بها الفرض الكفائي، وأما السمات الإيجابية إذا لوحظ وجودها في فرد ما فيجب على المربين أن يشجعوه عليها ويوجهوه إليها حتى يتمكن فيها فيتعين عليه الفرض الكفائي المناسب لها، وقد عبر الشاطبي عن هذا المعنى كذلك في سياق كلامه.
المواهب
الموهبة هي: مستوى عالٍ من الاستعدادات الخاصة في مجال معين، سواء أكان علميًا، أدبيًا، فنيًا…” وقد كان الرسول يهتم كثيرا باكتشاف مواهب الصغار ويولي للموهوبين أكبر اهتمام لتُصقل موهبتهم وتتطور؛ فقد لاحظ في ابن عباس –مثلا- استعدادات علمية بارزة فاهتم به ودعا الله أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل.
ومثال ذلك، عن النبي ﷺ مع زيد بن ثابت: فأمره ﷺ بتعلم لغة اليهود، فتعلمها في نصف شهر، وأصبح ترجمان النبي….
النعم
النعم لا تُقصد فقط بمعناها المادي، بل تشمل كل العطايا الإلهية، وقد عرفها الجرجاني كما نُقل في الدراسة:
النعمة: ما قُصد به الإحسان والنفع لا لغرض ولا لعوض.
ويقول ابن السبكي: لكل نعمة شكر يخصها، فمن عدل عنها إلى نوع آخر من الشكر فقد قصر وترك الأهم”.
وليس كل النعم يتعين بها الفرض الكفائي فالنعم العامة في الغالب لا يتعين بها الفرض الكفائي؛ كنعمة الماء والهواء ونعمة خلق السماوات والأرض.
أما النعم الخاصة فقد تكون سببا لتعين الفرض الكفائي، ويمكن التمثيل لها بما يلي:
– القدرات والاستعدادات والسمات الشخصية الإيجابية: ذلك أن هذه الأمور قد تكون فطرية وقد تكون مكتسبة، وقد تعزى للوراثة أو للبيئة أو إليهما معا، وفي كل تلك الأحوال نجد عطاء الله تعالى واضحا؛ فهي إذا نعم من الله تعالى.
– المال: المال نعمة من الله تعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن هل هذه النعمة سبب لتعين الفرض الكفائي؟ لم يشر الشاطبي إلى ذلك، لكن العلماء ذكروا حالات تتعين فيها بعض الفروض الكفائية المالية على الميسورين من المسلمين.
“إذا وُجد فرض كفائي لم تتحقق الكفاية فيه، ووجدت لدى شخص النعم والقدرات والسمات والميول الضرورية لذلك الفرض، فإنه يتعين عليه“.
الأدلة الشرعية للقاعدة
ذكر الشاطبي أن الفرض الكفائي قد يتعين بحسب الفروق الفردية، ولم يذكر الأدلة على ذلك، فما صحة تلك القاعدة؟
نرى أن قاعدة الشاطبي قاعدة صحيحة عظيمة؛ تدل عليها كليات الدين وفروع الشريعة، وسنسوق هنا دليلا كليا.
أما الدليل الكلي فهو مركب من مقدمتين ونتيجة:
- أما المقدمة الأولى فتنص على أن الله عادل، وهذا من قطعيات الدين التي لا يجوز أن يشك فيها المسلم طرفة عين أبدا.
- وأما المقدمة الثانية فهي أن الخلق متفاوتون في النعم والقدرات، وأدلة الشرع والواقع على هذه القاعدة كثيرة.
- والنتيجة: أن العدالة الإلهية تقتضي مراعاة النعم والقدرات في التكاليف والواجبات الشرعية.
تطبيقات القاعدة
ذكر الفقهاء مسائل كثيرة يمكن اعتبارها فروعا لقاعدة الشاطبي، ذلك أنهم حكموا بتعين بعض الفروض الكفائية على من كانت عنده نعمة أو فروق فردية يُحتاج إليها في أداء تلك الفروض،
تعين الفروض الكفائية المالية على أغنياء المسلمين
مثل: التكفل بضعاف المسلمين إذا لم يوجد بيت المال أو لم تف أموال الزكاة بحاجاتهم.
– الإنفاق على تجهيز الميت المسلم إذا لم تف بذلك تركته ولم يوجد من تلزمه نفقته متعين على الموسرين.
– فك أسرى المسلمين إذا لم تف أموالهم بذلك متعين على أغنياء المسلمين
– أجرة تعليم القرآن للناشئة تجب على المتعلِّم ثم من تلزمه نفقته ثم في أموال الموسرين
تعين طلب العلم الشرعي
يتعين طلب العلم الشرعي على من وجدت فيه القدرات اللازمة، يقول السمعاني: “إن الإنسان إذا تعين لطلب العلم؛ فإنه لم يكن في ناحيته من يصلح لطلب العلم سواه يجب عليه أن يطلبه، ولا يحل له أن يتركه، وهذا إذا وجد فيه شروط الطلب، وشروط الطلب في الإنسان صحة حواسه، ووفور عقله، وسلامة آليته، فإذا تكاملت فيه آلية الطلب وجب عليه الطلب.
تعين تعليم العلم الذي يحتاج إليه المسلمون
ويدل على ذلك الوعيد الشديد على كاتم العلم، فقد قال النبي ﷺ: “من كتم علما تلجم بلجام من نار يوم القيامة.
التفعيل المؤسسي للقاعدة
وإذا أريد تطبيق هذه القاعدة وتفعيلها في الواقع فإنه لا يمكن الاعتماد فقط على الاجتهادات الفردية، بل لا بد من نظام مؤسسي ينظم الفروض الكفائية:
التفعيل المؤسسي للقاعدة
وإذا أريد تطبيق هذه القاعدة وتفعيلها في الواقع فإنه لا يمكن الاعتماد فقط على الاجتهادات الفردية، بل لا بد من نظام مؤسسي ينظم الفروض الكفائية:
“الفروض الجماعية… يجب أن تتعاون على أدائها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى الدولة أيضًا أن تخصص جهازًا لإدارة هذه الفروض وتنظيمها والإشراف عليها”[3]
نركز على التوجيه المهني كأحد منطلقات الأزمة التي تعرقل سير الأمة ونهوضها، فإنه يمر بأربع مراحل هي:
- اختيار المهنة.
- الاستعداد لها.
- الالتحاق بها.
- النجاح فيها.
واقتصر البحث على المرحلة الأولى التي هي اختيار المهنة، لأنها أهم المراحل وأصعبها، ويكون اختيار المهنة مبنيا على أمرين هما:
– دراسة الفرد من حيث قدراته واستعدادته وسماته وميوله.
– دراسة المهنة من حيث شروطها ومقتضيات النجاح فيها؛ ثم المواءمة بين المهنة وبين خصائص الفرد.
ولكي يتم إرشاد الفرد إلى أحسن مهنة تناسبه؛ ينبغي دراسة الفرد من جوانب متعددة هي:
1. الذكاء العام: يعتبر الذكاء العام من أهم العوامل المؤثرة في اختيار المهنة؛ لأن كل مهنة تحتاج إلى مستوى معين
من الذكاء.
2. القدرات الخاصة والاستعدادت: تعتبر القدرات والاستعدادات من أهم العوامل المؤثرة في اختيار المهنة، وهي
أنواع كثيرة؛ أذكر بعضها: القدرة اللفظية، الميكانيكية، العددية، المكانية، الجسمية، الحسية، الاجتماعية..
3. السمات الشخصية: ويمكن قياس السمات الشخصية للتلميذ في المدرسة بعدة طرق منها: ملاحظة التلاميذ،
تقارير المعلمين، السجل التراكمي المدرسي، مجالس الآباء والمعلمين، أسلوب الاختبارات الإسقاطية..
4. القيم: تؤثر القيم تأثيرا كبيرا في اختيار المهنة، لذا يجب دراسة قيم الفرد قبل إرشاده.
5. الميول: تعتبر الميول من أهم عوامل اختيار المهنة؛ إذ إن الفرد يتجه في الغالب إلى ممارسة المهنة التي يميل إليها
ويحبها. لكن هل الميل الذي يكون لدى الطفل يبقى ثابتا أثناء نموه أو أنه ينمو ويتغير؟
6. التحصيل: يقصد به المعرفة المنظمة التي حصل عليها الطالب في المدرسة خاصة، وقد تعتمد المهنة المختارة على
التحصيل العام، أو على التحصيل في مادة معينة، لذا يجب قياسهما معا.
ومن هنا يجب أن تولي المنظومة التربوية أهمية كبرى للتوجيه المهني لأهميته في تفعيل الفروض الكفائية، ومن ثم في نهضة الأمة وتمكينها؛ إذ كلما زادت فعالية التوجيه المهني قلت نسبة الطاقات الضائعة من خلال الدخول في تخصص أو مهنة لا تناسب صاحبها.
الخلاصة
قاعدة الشاطبي ليست مجرد نظرية، بل هي إطار عملي شامل يمكن أن يُطبّق في المدارس، الجامعات، مؤسسات الدولة، والقطاع المهني… شرط أن تتوفر:
- أدوات علمية (مثل اختبارات القدرات، التوجيه المهني).
- هيئات متخصصة تشرف على الفروض الكفائية.
- خريطة واضحة لاحتياجات المجتمع.