المشهد الروائي العربي يستدعي كثيرًا من الأسئلة، حول طبيعته وقدرته على التعبير عن الهموم والتطلعات.. وقد دخل الشباب مؤخرًا بقوة مجال الكتابة وفي قلب هذا المشهد الروائي؛ مما يضاعف الأسئلة، ويستدعي مراجعة لهذا الإنتاج الذي يغمرنا ربما لدرجة الإغراق.
أسئلة كثيرة حملناها للناقد والأكاديمي المصري د. وجيه يعقوب السيد، أستاذ النقد الأدبي الحديث بقسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وصاحب العديد من الأعمال النقدية والإبداعية المهمة، إضافة إلى إسهامه المتميز في الكتابة للطفل.
من أبرز أعمال د. وجيه يعقوب في مجال الكتابة والنقد : مناهج النقد الروائي. الرواية والتراث العربي. الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية الحديثة. استلهام التراث في روايات جمال الغيطاني. عناصر الحداثة في الرواية العربية المعاصرة. توظيف الأسطورة في الرواية العربية المعاصرة. صورة الذات والآخر في السيرة الذاتية- عبد الرحمن بدوي نموذجًا. رواية أولاد حارتنا بين التفسير الديني والتحليل الفني. فادعوه بها- تأملات في أسماء الله الحسنى. عظماء منذ الطفولة. أشبال الإسلام (26 جزءًا). نساء مسلمات (30 جزءًا). (نوادر أشعب (50 جزءًا)..
- الرواية” منفتحة على سائر الفنون وتعبر عن الآمال والإحباطات
- الأدب الحقيقي يلبي حاجة الإنسان النفسية والفكرية والعاطفية
- كثير من روايات الشباب أقرب إلى الحواديت والرؤية التسجيلية
- “الرواية” تستقي موضوعاتها من الواقع لكن لا تضاهيه ولا تنقل عنه
- “النقد” مهم للقارئ والأديب.. وهو منهج وطريقة في التفكير والتحليل
إلى الحوار:
كيف ترون المشهد الروائي العربي بنظرة إجمالية؟
الرواية كما نعلم فن حديث النشأة نسبيًّا بالقياس إلى سائر الأجناس الأدبية الأخرى كالشعر والمسرح، ومع ذلك فقد خطت الرواية خطوات هائلة وانتزعت لنفسها مكانة كبيرة لا تقل إن لم تزد في بعض الأحيان عن مكانة تلك الأجناس.
وبالطبع لا ينبغي أن نضع تاريخ الرواية كله في سلة واحدة إذا أردنا أن نصف المشهد وصفًا دقيقًا؛ فقد مرت الرواية خلال هذا العمر القصير نسبيًّا بتطورات أو قل بقفزات كبيرة؛ بدأت الرواية مع جيل هيكل والسحار وطاهر لاشين، وكانت بطبيعة الحال وهي تخطو خطواتها الأولى يغلب عليها التقليد والمحاكاة وقد شابها كثير من العيوب؛ فعلى الرغم من الثقافة الواسعة التي كان يتمتع بها الرعيل الأول من كتاب الرواية وإدراكهم أهمية هذا الفن وضرورة توظيفه في التعبير عن قضايا الواقع المعيش، فقد بقيت أساليب الكتابة أشبه بالسرد التاريخي ولم تخل من عيوب الصنعة والتكلف والإكثار من التصوير والوصف بدون ضرورة، ويمكن ملاحظة ذلك في رواية زينب للدكتور محمد حسين هيكل وفي روايات محمد فريد وجدي وعلي أحمد باكثير.
وخطا نجيب محفوظ ويحيى حقي وتوفيق الحكيم بالرواية خطوة أوسع، فاشتبكت الرواية وتلاحمت بقضايا المجتمع وتطورت الأساليب وتنوعت المعالجات الفنية بصورة كبيرة. ولو سلطنا الضوء على تجربة نجيب محفوظ وحدها على سبيل المثال لوجدنا أنه تقريبًا لم يترك شكلاً أدبيًّا إلا واستفاد منه في كتابته الروائية، وهو ما منح للرواية مكانتها واستقلالها ورسوخها. وظلت الرواية في اطراد وتقدم من جيل إلى جيل حتى بات بعض النقاد يعتبر هذا العصر هو عصر الرواية بامتياز، ومهما يكن من مبالغة في هذا الرأي فإنه يعبر عن الأهمية المتزايدة والضرورية لفن الرواية.
وبمرور الوقت- وربما بسبب ما حققه فن الرواية من ذيوع ورسوخ- زاد عدد الكتاب بصورة كبيرة جدًّا، وتعددت طرق الكتابة وأساليب الكتاب وأصبحت الرواية تجسد أعقد المشكلات وأدقها وهو ما جعلها أكثر التحامًا بالواقع وبالناس؛ قضايا المرأة والحريات والاستقلال والسياسة وغير ذلك من القضايا المسكوت عنها، لكن يلاحظ أن كثيرًا من المقتحمين للكتابة الروائية لا يفرِّقون بين “المتن الحكائي” و”المبنى الحكائي”؛ فأصبحت الروايات عند بعض المتعجلين نقلاً حرفيًّا عن الواقع واستناخًا له.
الرواية تستقي موضوعاتها من الواقع، نعم؛ لكنها لا تضاهيه ولا تنقل عنه. وهذا ما يجب أن يعيه الشباب بشكل خاص. رواية “اللص والكلاب” لنجيب محفوظ مستلهمة من حدث واقعي بالفعل، لكنها وظفت الحدث لخدمة قضية أعمق وأعقد، فكُتب لها البقاء؛ أما الروايات التي يستنسخ أصحابها أحداث الواقع ويحاكونها، فهي صور باهتة كتلك الصور التي يلتقطها مصور بعدسته لمشهد من المشاهد.
إلى أي مدى يمكن القول إن الإنسان العربي يجد نفسه، همومه وأحلامه، في الرواية العربية؟
الأدب الأصيل والحقيقي بكل أشكاله يلبي حاجة الإنسان النفسية والفكرية والعاطفية؛ فالإبداع من أعظم نعم الله على الإنسان، ولولاه لعاش في اضطراب وتوتر وقلق كبير. وربما كانت الرواية من أكثر الأشكال الأدبية قدرة على الالتحام بمشكلات الإنسان العصرية بسبب مرونتها وقدرتها على مضاهاة الواقع ونقده وتجاوزه في الوقت نفسه، لذلك وظفها الكتاب وطوعوها للتعبير عن أعقد المشكلات الاجتماعية والسياسية والدينية. وقد ساعدت الدراما التلفزيونية الرواية على تبوؤ هذه المكانة من خلال تحويل النصوص الكلاسيكية الجادة إلى أعمال فنية يشاهدها ملايين البشر، كما أن الرواية منفتحة بطبيعتها على سائر الفنون؛ فبإمكان الروائي توظيف تقنيات الشعر والمسرح وعلم النفس ومختلف العلوم والمعارف في إبداعه القصصي، لذلك يمكن القول إن الرواية مع سائر الفنون بالطبع تستطيع أن تعبر بصدق عن آمال وأشواق وإحباطات وهموم وتطلعات المواطن العربي وغير العربي، مع الأخذ في الاعتبار أن الأدب يعيش وينمو ويتنفس ويؤدي رسالته في ظل الحرية والوعي والشعور بالمسؤولية.
نلاحظ في الفترة الأخيرة، وبصورة لافتة، انتشار الرواية بين الشباب.. كيف ترصدون ذلك؟ وما دلالته؟ وماذا عن “الرواية الشبابية”، أي التي ينتجها الشباب، من حيث الكمّ والجودة؟
أنا من المتعاطفين جدًّا مع الشباب ومن الداعمين والمشجعين لهم باستمرار، لكن دعني أحدثك حديثًا من القلب فيما يخص هذه الجزئية: فلست أنصح الشباب باستعجال النشر قبل إتقانهم لأدوات الكتابة والتعبير، وقبل أن تتأكد موهبتهم وتترسخ وأنهم يسيرون في الطريق الصحيح. بعضهم ينشر لمجرد الشهرة، أو لأن لديه عددًا كبيرًا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، أو لأنه يملك المال، أو لقلة وعيه، أو لغير ذلك من الأسباب. رأيت فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها السادسة عشرة في معرض إحدى الدول، قبل عامين، تحضر حفل توقيع رواية من تأليفها؛ ولما سألت الناشر عن مدى موهبتها، أخبرني أنها لا تمتلك موهبة حقيقية ولكن لها متابعين بالآلاف على وسائل التواصل وهو ما يضمن بيع الرواية، كما أن والدتها دفعت ثمن طبع الرواية بالكامل، فكيف أرفض النشر لها ولغيرها؟
وهذا الأمر رأيته وعاينته بنفسي في العديد من دور النشر.. ما يهم كثيرًا من الناشرين هو تحقيق الربح مهما كانت ضآلة العمل. وبالطبع لا أذكر هذا الكلام لأفتّ في عضد الشباب الموهوبين أو للتقليل من دورهم، ولكن على العكس من ذلك فقد أردت تقديم النصيحة الصادقة والمخلصة لهم، حتى إذا جاءتهم الفرصة تشبثوا بها ولم يفلتوها من أيديهم.
وأما عن كتابات الشباب أو الرواية الشبابية وهل هي جديرة بأن تبقى وأن تحفر لنفسها مكانة وحضورًا؟ فللأسف الشديد لا أرى ذلك، وبإمكانك أن تقرأ كثيرًا من تلك الروايات لترى أن أصحابها تعجلوا في نشرها، وأنها أقرب إلى الحواديت والرؤية التسجيلية، وأنها لا تتمتع بالحد الأدنى من استقامة الأسلوب وصحته فضلاً عن جماله وشعريته، كما أن التكرار والتقليد يغلب على أكثرها، لذلك يحتاج الأمر إلى روية وتمهل كما ذكرنا. وما أجمل ما قاله ابن الرومي في هذا المعنى:
نارُ الرَّويَّة نارٌ جِدُّ مُنْضِجَةٍ ** وللبديهَةِ نارٌ ذَاتُ تَلْويحِ
وَقَدْ يُفضِّلُهَا قَوْمٌ لِعَاجِلِها ** لكنَّهُ عاجِلٌ يَمْضي مع الريحِ
هل تتفقون مع رؤية البعض بأن ضغوط الحياة التي يواجهها الشباب العربي، تدفعهم للخيال أكثر، أو للانفصال عن الواقع، بحيث يجدون أنفسهم في الرواية كجنس أدبي؟
الكتابة في حد ذاتها والبوح بكل صوره أفضل من الكبت والصمت، ولجوء الشباب إلى الكتابة ظاهرة صحية يجب أن نشجعها ونستثمرها، لكن هناك فرقًا كبيرًا بين التعبير والبوح والتدريب وبين الكتابة الاحترافية والإنتاجية؛ أؤمن بتلك المقولة كثيرًا: أن تكون مستعدًا ولا تأتيك الفرصة خير لك من أن تأتيك الفرصة وأنت غير مستعد.
بعض الشباب جاءتهم فرصة النشر للأسباب التي ذكرناها وهم غير مستعدين، فرأينا تلك الفوضى وهذا الغثاء، وبعضهم يتدرب ويقرأ ويصقل موهبته بشتى الطرق وينتظر الفرصة المواتية التي يطل منها على القراء؛ هؤلاء رغم عدم شهرتهم تبقى أعمالهم ويكتب لها البقاء.
أما سؤالك عن ضغوط الحياة والخيال والأسباب التي تدفع الشباب إلى فن الرواية بالذات، فأرى أن أحد أهم الأسباب هو استسهال الكتابة الروائية من قبل كثير من الشباب؛ لأن الرواية في نظر كثير منهم هي مجرد حدوتة أو حكاية مسلية، فهو يسرد أحداثًا واقعية أو تاريخية فتأتي كتاباتهم مكتظة بالتفاصيل، ولا تخضع للتنظيم والاختيار وانتقاء المناسب من الأحداث، وترتيبه بطريقة فنية؛ لذلك لا يكون لرواياتهم إيقاع ولا حبكة ولا ضوابط.. فما أكثر الحكايات! وما أقل الروايات الفنية التي تُقَدم!

هل انغماس الشباب في عالم الرواية يؤثر سلبًا على تكوينهم العقلي والفكري؛ مما يقودنا إلى ضرورة القراءة المتنوعة في مجالات المعرفة المختلفة؟ أم إن الرواية الجيدة، من حيث المضمون والبناء الفني، تتطلب فكرًا ناضجًا ومعرفة متنوعة؟
هذا يتوقف على اختيار الروايات المناسبة والجيدة التي تسهم في تكوين الشباب فكريًّا ووجدانيًّا وعاطفيًّا؛ ففي معظم المناهج التعليمية في العالم بأسره تدرس القصة والرواية وتقرر على الطلاب، وتختار هذه الروايات بواسطة أدباء ومتخصصين وتربويين.
وكما تعلم ففي المناهج التعليمية في مصر والبلدان العربية يستعينون بالقصة في مراحل التعليم المختلفة، وبالطبع لن نستطيع السيطرة ولا المصادرة على حق أحد في القراءة واختيار ما يناسبه؛ لذلك يجب الاعتماد على مبدأ الحوار والمناقشة، وأن يشارك الآباء والمعلمون الطلاب اهتماماتهم بدلاً من إلقاء اللوم عليهم؛ فالرواية قالب محايد مثله مثل أي عمل فني آخر يمكن أن يكون معول هدم ويمكن أن يكون وسيلة بناء حقيقي.
لو ارتقينا بأذواق أبنائنا وتفكيرهم لأصبح الأمر سهلاً وما عانينا من هذه المشكلة؛ لأنهم ساعتها سيكونون قادرين على الاختيار والتمييز بين الغث والسمين.
الذائقة الأدبية للشباب.. كيف ترون مصادر تشكُّلِها؟
من خلال تدريسي لطلاب الجامعة واحتكاكي بهم أجد أن الشباب- رغم كل ما يقال- قابلون للنصح والتوجيه، خاصة حين يجدون القدوة، ومَن يبعث فيهم الأمل، ويتيح لهم التعبير عن آرائهم بحرية، ويصبر عليهم ولا يصادر على رأيهم.
علينا أن نعترف أن الأجيال الحالية ما وصلت إلى هذا الحال برغبتها واختيارها، وإنما بسبب تراجع التعليم، وغياب الحلم، وضبابية المشهد، وغياب القدوات الصالحة، وغير ذلك من الأسباب التي لا نجهلها. وهو ما يقتضي منا أخلاقيًّا وتعليميًّا وتربويًّا أن نسعى إلى ترميم هذه المشكلات المتراكمة، وأن نعذر الشباب ونصبر عليهم ونمد أيدينا لهم بحب وحدب، حتى نستطيع التأثير فيهم وتغيير قناعاتهم.
دَرَّست لأجيال مختلفة من الطلاب ولمست حرص كثير منهم على المعرفة والتعلم والاستزادة، فكانوا لا يكتفون بالمحاضرة بل يسعون إلى التواصل خارج المحاضرة لسؤالك عن كتاب أو معلومة معينة أو كاتب جيد يمكنهم قراءة أعماله وهكذا. إن تأثير الإعلام السلبي والعشوائي على عقول وأذواق أبنائنا لن يختفي في يوم وليلة، ولن يمحو أثره شخص أو مجموعة من الناس؛ وإنما يقوم بذلك المجتمع كله، خاصة الأسرة والمعلمين والدوائر الرسمية التي يقع الشباب في دائرة مسؤوليتها.
وما دور مناهج التعليم في ذلك؟
لا شك أن مناهج التعليم في كل مكان تتأثر سلبًا وإيجابًا بمستوى الطلاب وبأشياء أخرى تحتاج إلى شرح مطول؛ فعندما كان الطلاب بالأمس هم طه حسين والمازني وأحمد أمين وعبد الرحمن بدوي كانت المناهج كما تعلم من حيث المحتوى والمضمون؛ كان الطلاب في المرحلة الابتدائية يدرسون على سبيل المثال كتب الجاحظ وفولتير وروائع الأدب العالمي ونهج البلاغة وغير ذلك من عيون الكتب، أما اليوم فقد اختلفت الأوضاع كثيرًا ولا يتحمل واضعو المناهج ولا التربويون وحدهم مسؤولية هذا التدهور.
لذلك، يجب أن تنهض الدول والمؤسسات بدورها في هذا الاتجاه، كل الأمم التي نهضت بلا استثناء لم تنهض بغير التعليم؛ لذلك علينا ألا نضيع مزيدًا من الوقت في التحسر والبكاء على الماضي، بل علينا أن نشخص المشكلة بدقة وأن نضع الحلول لها سريعًا قبل أن تستفحل ويصعب علاجها.
كما أن المناهج نفسها بحاجة إلى تطوير حقيقي حتى تكون جاذبة للطلاب، وأن تتخلص من الحشو والتعقيد، وغير ذلك من العيوب التي لا تخفى على أحد.
وماذا عن دور الإعلام؟
الإعلام أقوى تأثيرًا من الآلة العسكرية؛ إذا أردت التأثير في أمة تأثيرًا مستدامًا وحقيقيًّا فإن ذلك لا يكون إلا عن طريق الثقافة والإعلام والفكر؛ ولذلك فإن الحملات العسكرية قديمًا كانت عادة تُسبَق أو تكون مصحوبة بحملات دعائية وتبشيرية.
ورغم التأثير السلبي لمنابر إعلامية كثيرة، وعدم رقابة الآباء لأبنائهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة، لا شك أنه يبقى دائمًا في هذا الغبش وهذا الظلام بصيص من النور والأمل؛ فمنابر الإعلام اليوم كثيرة ومتعددة، وبإمكان المرء أن يختار ما يناسبه، ومهما زَيَّف الإعلام الحقائق فإن الوقت كفيل بإفاقة الواهمين وردِّهم إلى الصواب.
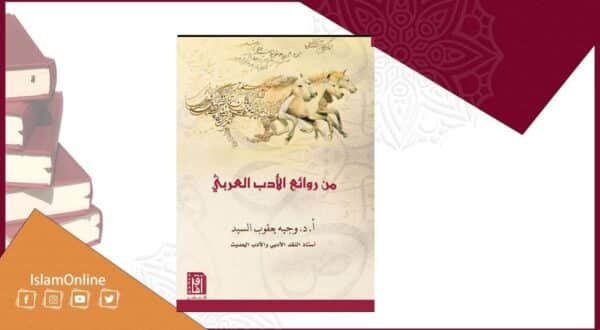
كيف تلاحظون تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الذائقة الأدبية، إيجابًا وسلبًا؟
شخصيًّا أستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة؛ فقد سهلت تلك الوسائل علي الحصول على المعلومة التي أريد الوصول إليها، والتواصل مع الزملاء والأصدقاء والمفكرين من مختلف الأجيال والمدارس ومناقشتهم، ومن خلالها نستطيع أن نقيّم كتاباتنا وأفكارنا بشكل صحيح، لأنها منبر حواري تتعدد فيه الآراء، لكن المهم هو كيفية استخدام تلك الوسائل وضبطها حتى لا تفلت الأمور وتتحول إلى عكس ما نريد.
علينا ألا ننخدع بكثرة المتابعين أو بمن يجاملوننا ولا يصدقوننا النصح، هناك صفحات جادة وممتازة يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في تنمية الحس والوجدان والوعي، وهناك في المقابل عشرات الصفحات التي لا فائدة منها بالطبع.
باعتبار تخصصكم الأساس، النقد، ما دور النقد في إثراء الأدب والمعرفة عمومًا؟
النقد مهم للغاية؛ فهو يساعد القارئ على فهم النصوص الأدبية وتفسيرها تفسيرًا دقيقًا، خاصة تلك النصوص التي قد يشوبها قدر من الغموض والتشويش، خذ مثلاً رواية “أولاد حارتنا” لنجيب محفوظ، تلك الرواية المثيرة للجدل، والتي كانت سببًا في نشوب معارك ما زالت أصداؤها إلى اليوم؛ فقد التبست الرموز على كثير من القراء ولم يدركوا المعنى الكامن وراء تلك الرموز، فحدث هذا الاضطراب وهذا الالتباس واشتعلت المعارك. ولا شك أن النقد الصحيح والموضوعي والمتخصص هو وحده القادر على أن يدلي بدلوه في مثل هذه المسائل.
النقد ليس مهمًّا للقارئ فحسب بل للأديب أيضًا، خاصة حين يمارس الناقد عمله بموضوعية واحترافية، ويحتكم إلى معايير واضحة ومنهج علمي سديد. إن النقد ليس ممارسة كهنوتية تحتكره فئة مخصوصة من الناس، وليس الناقد هو ذلك الأديب الفاشل الذي يسقط فشله وعُقَدَه على تجارب الأدباء الناجحين كما كان يشاع، ولكنه تخصص وعلم ومنهج وطريقة قويمة في التفكير والتحليل.
وبهذا المعنى نحن جميعًا مدعوون إلى التفكير النقدي الذي يمكّننا من الحكم على الأفكار والأشياء حكمًا صحيحًا، لا يقوم على الهوى والذاتية والانحياز. إن الناقد لا يقدم قراءة قطعية للنص ولكنها قراءة وتجربة قابلة هي الأخرى للنقد والتصويب؛ لذلك نجد “النقد” و”نقد النقد” الذي يتتبع فيه الباحث تطبيقات النقاد، ويراجع مصطلحاتهم وأدواتهم الإجرائية والتحليلية.

