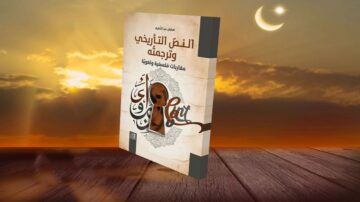هل تُترجم النصوص التأريخية بالأدوات نفسها التي نترجم بها الأدب، أم أن للتاريخ لغته ومنهجه؟ يكشف كتاب “النص التأريخي وترجمته: مقاربات فلسفية ولغوية” عن فجوة منهجية بين التاريخ والترجمة، وينتقد مفهوم الأمانة التقليدي لصالح مفهوم الكشف، ويقترح إطارا وظيفيًا جديدا يجمع الفلسفة واللسانيات.
ستتعرف على استراتيجيا الاستئراخ التي توازن بين المعطيات التاريخية، والأنساق الخطابية، والوظائف الاتصالية، وحالة المترجم؛ ما يمنح المترجم دور الشريك لا الناقل في تمثيل الماضي لقارئ الحاضر.
من خلال قراءة كتاب “النص التأريخي وترجمته” قد تلجأ إلى إعادة صياغة منهجك في ترجمة النص التأريخي: تبنى الكشف بدل الاكتفاء بـالأمانة، وتطبّق الاستئراخ لضمان دقة معرفية وأثر تواصلي أقوى.
التاريخ والترجمة.. ثنائية التأسيس المعرفي
يُعدّ كتاب “النص التأريخي وترجمته: مقاربات فلسفية ولغوية”، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، للباحث والأكاديمي الجزائري سفيان عبد اللّطيف، إضافة نوعية ومحورية للمكتبة العربية في حقل الدراسات البينية التي تتقاطع فيها الترجمة والتاريخ والفلسفة واللسانيات. ولا يكتفي كتاب “النص التأريخي وترجمته” بتقديم مقاربة تقليدية لترجمة النصوص التاريخية، بل يسعى إلى تأسيس نظرية جديدة تهدف إلى سد الفجوة المعرفية والمنهجية التي نشأت بين حقلين لطالما تعاملا مع اللغة والتاريخ بوصفهما كيانين منفصلين.
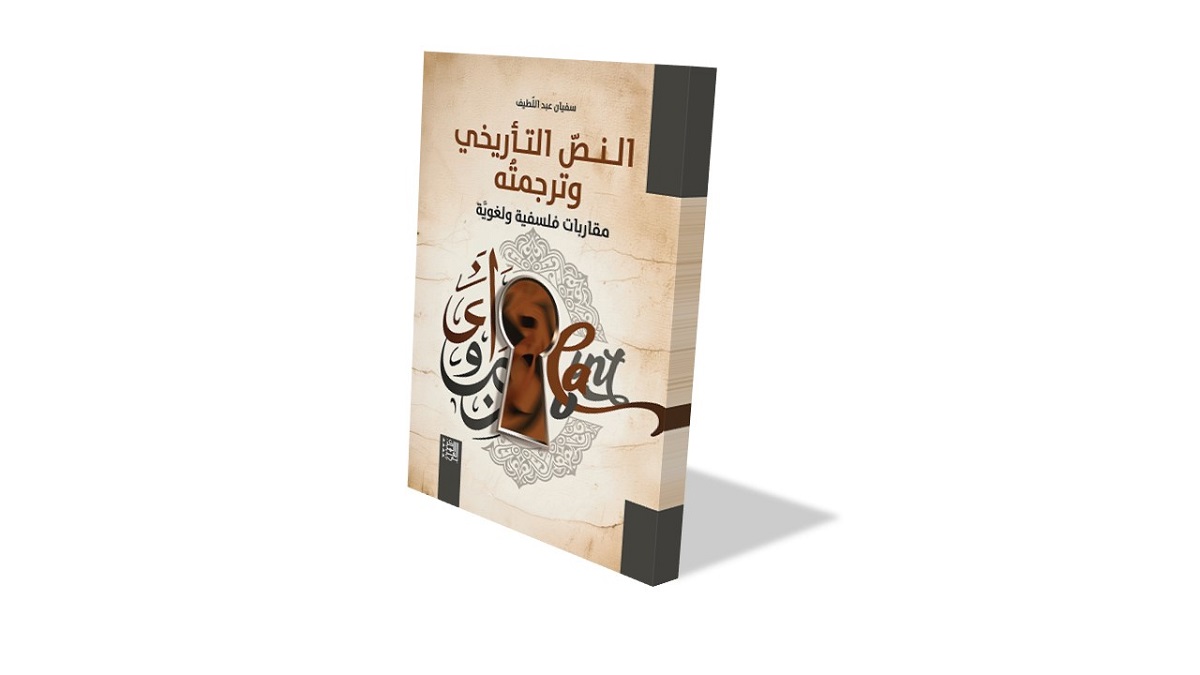
يأتي هذا العمل ليواجه حقيقة أن النص التأريخي، بخصوصيته وتعقيداته، ظل يُترجم وفق استراتيجيات الترجمة العامة التي لا تراعي طبيعته المزدوجة؛ فهو نص لغوي من جهة، ومحاولة لصوغ معطيات ماضٍ “غيبي” من جهة أخرى. ومن هنا، يطرح الكتاب إشكالاً عميقاً حول كيفية تعامل المترجم مع هذا النوع من النصوص، مقترحاً إطاراً نظرياً جديداً يهدف إلى ضبط ممارسات هذا الحقل المعرفي وتوجيهها.
مقاربة فلسفية ولغوية: تفكيك العلاقة بين التاريخ واللغة
يرتكز كتاب “النص التأريخي وترجمته” على تفكيك العلاقة التقليدية بين التاريخ واللغة، التي اعتبرت التاريخ مادة خام، واللغة مجرد أداة لتقييده، أو اعتبرت التاريخ عنصراً سردياً في بنية النصوص اللغوية. هذه المقاربات التخصصية أدت إلى غياب أنساق فلسفية واضحة تؤطر عملية ترجمة النص التأريخي، مما أفضى إلى فوضى تراكمية في الممارسة.
يسعى سفيان عبد اللطيف في كتابه “النص التأريخي وترجمته” إلى حصر المفاهيم التي تشكل الأطر التقعيدية لهذا التفاعل فلسفياً ولغوياً، مؤكداً على أن الترجمة والتاريخ ليسا مجرد عمليتين متجاورتين، بل هما طرفا معادلة تفاعلية متكافئة وظيفياً. فالمؤرخ يترجم معطيات الماضي من أشكالها المصدرية إلى نص لغوي، والمترجم يتعامل مع النص اللغوي للمؤرخ باعتماد رموز اتصالية جديدة لمتلقٍ آخر. هذا التكافؤ الوظيفي هو نقطة الانطلاق نحو إعادة ترتيب مفاهيم الموضوع ونقدها، بهدف مراجعة الاستراتيجيات السائدة واقتراح بدائل تتلاءم مع خصوصية النص التأريخي.
من “الأمانة” إلى “الكشف”: سكيزوفرينيا المترجم
يُعدّ هذا المحور من أهم وأكثر المحاور إثارة للجدل في كتاب “النص التأريخي وترجمته”، حيث ينتقد المؤلف بشدة التصور التقليدي لـ “الأمانة” في ترجمة النص التأريخي. يعود هذا التصور إلى أعمال سابقة مثل كتاب “ترجمة كلمة الرب” لجون بيكمان وجون كالاو (1974)، التي دافعت عن الأمانة التاريخية، مما رسخ فكرة أن المترجم يجب أن يكون أميناً للنص الأصلي للمؤرخ.
يرى عبد اللطيف أن هذه الأمانة هي “ملكية متوهمة”، لأن معطيات التاريخ هي واقعة خارج نطاق إبداع المؤرخ، والنص الأصلي هو مجرد محاولة لصوغ هذه المعطيات على نسق يختاره المؤرخ. وبما أن النص التأريخي يستمد مصادره من “ماضٍ غيبي”، فإن مهمة المترجم يجب أن تتحول من “الوفاء” لصوغ المؤرخ إلى “الكشف” عن المعطيات التاريخية الكامنة وراء النص.
هذا التحول يضع المترجم في حالة وصفها المؤلف بـ “سكيزوفرينيا المترجم”، وهي حالة انشطار معرفي ومنهجي بين ثلاثة أطراف متنازعة:
1- حقيقة المعطيات التاريخية: الواقع الماضي الذي لا يد للمترجم فيه، والذي يمثل المادة الخام للتأريخ.
2- صوغ صاحب النص الأصل: النسق اللغوي الذي اختاره المؤرخ، والذي قد يكون مشوباً بمرجعيته الأيديولوجية أو الثقافية.
3- الصوغ الذي يختاره المترجم: النسق اللغوي للنص الهدف، والذي يجب أن يوازن بين أداء المعطيات التاريخية ومتطلبات المتلقي الجديد.
يناقش كتاب “النص التأريخي وترجمته” هذه الحالة المعقدة بعمق، مستعرضاً التحديات الأخلاقية والمنهجية التي يواجهها المترجم عند محاولة التوفيق بين هذه الأطراف. ويقترح حلولاً مختلفة للتعامل معها، مؤكداً على أن الأمانة المطلقة للنص الأصلي قد تخون الحقيقة التاريخية، خاصة وأن النص التأريخي ليس نصاً إبداعياً خالصاً، بل هو محاولة لتمثيل واقع ماضٍ. لذا، يرى المؤلف أن الكشف عن المعطيات التاريخية هو الأولوية المعرفية، مما يتطلب من المترجم وعياً نقدياً متقدماً يتجاوز حدود الأمانة اللفظية إلى الأمانة المعرفية والتاريخية. هذا التوجه يفتح الباب أمام دور أكثر فاعلية للمترجم كشريك في عملية التأريخ، وليس مجرد ناقل سلبي.
الترجمة بوصفها تأريخاً أم التأريخ بوصفه ترجمة؟
يطرح كتاب “النص التأريخي وترجمته” سؤالاً جوهرياً حول العلاقة الوظيفية بين الفعلين: هل الترجمة هي شكل من أشكال التأريخ، أم أن التأريخ هو في جوهره عملية ترجمة؟ يؤكد المؤلف على تكافؤ الفعلين وظيفياً، حيث أن كلاهما يتعامل مع معطيات الماضي ويحولها إلى رموز اتصالية لغوية قابلة للاستثمار المعرفي.
هذا التكافؤ يفتح الباب أمام النظريات الحديثة (الثقافية، الاتصالية، الوظيفية، التفكيكية) التي تمنح المترجم معايير أخرى للتصرف في التقنيات والاستراتيجيات، بشرط أن يتيح هذا التصرف أداء المعطيات التاريخية في النص الهدف. بعد نقد معمق لهذه الاستراتيجيات، يقترح المؤلف استراتيجية جديدة أسماها “استراتيجيا الاستئراخ”. هذه الاستراتيجية، التي تتشكل قاعدتها من مجموع المراجعات النظرية والمنهجية التي قام بها في كتاب “النص التأريخي وترجمته”، تقدم منظوراً معيارياً أكثر واقعية لـممارسة ترجمة النصوص التأريخية. وتعتبر “الاستئراخ” بمثابة إطار عمل متكامل يهدف إلى ضبط الممارسة الترجمية لهذا النوع من النصوص، من خلال الموازنة بين متطلبات النص الأصل وحاجات المتلقي في النص الهدف.
وتراعي هذه الاستراتيجية أربعة عناصر أساسية يجب على المترجم أخذها بعين الاعتبار:
الأصل المعطياتي:
ضرورة فهم طبيعة المعطيات التاريخية التي يتضمنها النص، والتمييز بين الحقائق الثابتة والتفسيرات السردية.
الأنساق الخطابية:
تحليل البنية السردية واللغوية التي اختارها المؤرخ، وكيف يمكن إعادة إنتاجها أو تعديلها لخدمة الوظيفة التاريخية في النص الهدف.
الوظائف الاتصالية والمعرفية:
تحديد الهدف من الترجمة والتأثير المعرفي المتوقع على المتلقي، بما يضمن وصول المعلومة التاريخية بشكل فعال وموثوق.
أحوال المترجم عند أدائها:
إدراك الحالة الذهنية والمنهجية للمترجم أثناء عملية الصوغ، وضرورة تحليه بالوعي النقدي والمسؤولية التاريخية.
إن “استراتيجيا الاستئراخ” تمثل خلاصة فكرية ومنهجية للكتاب، وتدعو إلى تجاوز حالة الانشطار (السكيزوفرينيا) إلى حالة من التوازن المنهجي الذي يخدم الحقيقة التاريخية عبر بوابة الترجمة.
التأسيس لحقل معرفي جديد
يمثل كتاب “النص التأريخي وترجمته: مقاربات فلسفية ولغوية” محاولة جادة وناجحة للتأسيس النظري لحقل معرفي دقيق ومهم، هو ترجمة النصوص التأريخية. لقد تجاوز المؤلف حدود المقاربات التقليدية، مقدماً نقداً جريئاً لمفهوم “الأمانة” ومقترحاً بديلاً منهجياً هو “الكشف” و”الاستئراخ”.
إن هذا العمل ليس مجرد دراسة في الترجمة، بل هو دعوة لإعادة النظر في العلاقة بين التاريخ واللغة والفلسفة، وتأكيد على أن المترجم ليس مجرد ناقل، بل هو شريك في عملية التأريخ، يواجه تحديات فلسفية ولغوية عميقة في سعيه لإيصال حقيقة الماضي إلى متلقي الحاضر. ومن المؤمل أن تساهم استراتيجيا الاستئراخ التي اقترحها المؤلف في وضع قواعد راسخة لهذا الحقل المعرفي، وتفتح آفاقاً لبحوث أخرى تثري الموضوع.