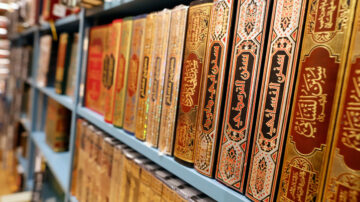عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله ﷺ قال: “أُمِرتُ أن أُقاتلَ الناسَ حتّى يشهدوا أن لا إلهَ إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويُقيموا الصلاةَ، ويُؤتوا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءَهم وأموالَهم إلا بحق الإسلام، وحسابُهُم على اللهِ”([1]).
وجاء في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله”([2]).
وفي رواية عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما قال لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ﷺ: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله”([3]). وليس فيه ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
وفي رواية عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله”، ثم قرأ: ﴿ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِّرࣱ لَّسۡتَ عَلَیۡهِم بِمُصَیۡطِرٍ﴾﴾([4]).
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي ﷺ فجاء رجل فساره، فقال: اقتلوه، ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكنما يقولها تعوذا، فقال رسول الله ﷺ: لا تقتلوه، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله”([5]).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: “أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها”([6]).
فهذا الحديث متواتر، رواه أكثر من خمسة عشر صحابيا،منهم: أبو هريرة وعمر وابن عمر وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، ومعاذ بن جبل، والنعمان بن بشير، وأوس بن أوس… الخ. وعن أبي هريرة وحده رواه عنه نحو ثلاثين من التابعين. ولم يعرف عن أحد من العلماء تضعيف هذا الحديث أو فهمه على ما يتداوله بعض الناس في هذا العصر.
مناسبات إيراد الحديث
وهذا الحديث في أوّله مناسبة إيراده، ففي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله ﷺ، واستُخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقّه، وحسابه على الله”؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن بين من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)([7]).
في قصة عمر ومحاورته لأبي بكر رضي الله عنهما ليس فيها إلا ذكر الشهادتين دون ذكر الصلاة والزكاة، فلعل ذلك مما فات عمر سماعه، ولأجل ذلك احتج على أبي بكر، ولو كان يعلم في الحديث ذكر الصلاة والزكاة ما فعل ذلك، وقد علمهما ابن عمر وغيره كما في الروايات السابقة.
قال الإمام ابن القيم: (وكذلك قد قيل في مانعي الزكاة أنهم على ضربين منهم من حكم بكفره، وهم من آمن بمسيلمة وطليحة العنسي، منهم من لم يحكم بكفره، وهم من لم يؤمنوا بهم، لكن منعوا الزكاة، وتأولوا أنها كانت واجبة عليهم، لأن النبي ﷺ كان يصلي عليهم، وكانت صلاته سكنا لهم، قالوا: وليس صلاة ابن أبي قحافة سكنا لنا، فلم يحكم بكفرهم لأنه لم يكن قد انتشرت أحكام الإسلام…([8]).
وقال الحافظ ابن عبد البر: (وسمَى بعض الصحابة مانعي الزكاة أهل ردّة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة، ومعلومٌ مشهورٌ عنهم أنّهم قالوا ما تركنا ديننا، ولكنّ شححنا على أموالنا)([9]).
ما يدل على عدم كفرهم
1 – ما روي من قولهم: “ما كفرنا بعد إيماننا، ولكن شححنا على أموالنا”([10]).
2- مناظرة عمر لأبي بكر، ولو كان كفرهم ظاهرا ما اعترض عمر ومن معه على أبي بكر.
3- استدلال أبي بكر على قتالهم إذ لم يقل: “لأنهم كفار”، ولكن لتفريقهم بين الصلاة والزكاة، ما يدل أنهم كانوا يصلون.
4- يظهر من بعض الروايات أنهم كانوا متأولين، لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. (قالوا: إنه كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره)([11]). (قالوا: إنّما كنّا نُؤدِّى إلى رسول الله ﷺ؛ لأنّ صلاته سكنٌ لنا، وليس صلاة أبى بكر سكنا لنا، فلا نؤدى إليه)([12]).
الردّ على الشبهات
شبهة “الإسلام سفك للدماء”
ذهب طوائف من الحاقدين إلى اتهام الإسلام بأنه حريص على سفك الدماء، وقد جاء لقتل كل الناس إذا لم يسلموا، مستشهدين بهذا الحديث.
والجواب بإيجاز: قوله ﷺ: “أمرت أنأقاتل الناس ..“، وأقاتل من المقاتلة، وهي مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، وليس كذلك القتل، ولا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل([13]). قال الإمام الشافعي: (ليس القتال من القتل بسبيل قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله)([14]).
توضيح عمومية “الناس” وخصوصيته
ثانيا: عبارة “الناس” في قوله ﷺ: “أمرت أن أقاتل الناس”، ظاهر اللفظ يفيد العموم، يدخل فيه كل الناس، لكن هل المقصود به العموم؟
الجواب: في البدء ينبغي التنبيه إلى خطر القراءة التجزيئية للنصوص، فإنه لا يمكن إدراك مقاصد الخطاب في الحديث النبوي إلا باستقراء رواياته وجمع ألفاظه، فلكَيْ يفهم الحديث فهما صحيحا مستوعبا لا بد من جمع النصوص الواردة في الباب أيضا لتتحقق الرؤية التكاملية لدلالات النص، أو ما يسمى بـ “الحديث الموضوعي“، أو “الجمع الموضوعي” للحديث. والأصل المنهجي في مثل هذه المسائل أن الحديث لا يفهم فهما صحيحا إلا بمجموع النصوص الواردة في الباب، باستحضار كل الأحاديث المروية في الموضوع، فإن الحديث يفسر بعضه بعضا، وكذا يلزم استحضار آيات الكتاب العزيز في ذلك. وهذا الحديث – الذي بين أيدنا – إذا قرئ مستقلا منفردا من غير استحضار النصوص الواردة في بابه لا يمكن أن يدرك مراد النبي ﷺ، بل سينحرف المعنى المراد منه، وهذا مزلق خطر.
معنى “الناس” في اللغة والشرع
ففي أول النظر في عبارة الحديث: “… أن أقاتل الناس”، يتبادر إلى الذهن أن “الناس” لفظ عام يدخل فيه كل الناس بمن فيهم أصناف هم معصومو الدم والمال بالنص، وهم أربعة: المسلم، والمعاهد([15])، والذمي([16])، والمستأمن([17]). فكل هؤلاء لا يحل قتلهم ولا أكل أموالهم؛ لأنهم معصومو الدم والمال بنصوص القرآن والسنّة، فالمسلم غير داخل في الخطاب قطعا، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله، والمنافق كذلك غير داخل لكونه يقولها ولو ظاهريا، ويبقى الكافر، فإما أن يكون محاربا، أو غير محارب – وهذا يدخل فيه الذمي والمعاهد والمستأمن- ، فإن لم يكن محاربا فما عليه من سبيل، وإن كان محاربا فهذا هو المراد في الحديث من لفظ الناس، وقد ثبت بيان ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين؛ كانوا مشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه…)([18]).
ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]. وفي الحديث: “من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنّة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا”([19]).
وفي رواية: قال: “من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما”([20]).
ويبقى صنف وهو الخامس: المشرك، وهو إما محارب أو مسالم، وقد مر معنا حديث أنس رضي الله عنه -وفيه: “… أمرت أن أقاتل المشركين”، وثبت عن عباس بيان أحوالهم- كما سبق- في قوله: “كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين؛ كانوا مشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه..)([21]).
ويؤيد معنى الحديث ما دلت عليه الآية في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. [التوبة:5]. فمنتهى قتال المشركين التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا هو الحد الذي تعصم فيه دماؤهم وأموالهم.
وبهذا يتبين أن لفظ الناس في الحديث من العام المخصوص، وأن المقصود بهم في الحديث مشركو العرب المعتدون، ولفظ حديث أنس المبين للفظ الناس: “أمرت أن أقاتل المشركين”، فيحمل ذاك العموم على هذا، وبذلك يتبين مراد النبي ﷺ، وأن ما ذهب إليه المرجفون مردود عليهم.
قال الإمام ابن تيمية: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله)([22]).
مزيد بيان
- أولا– لو كان الخطاب عاما في الحديث، كيف أباح الله الزواج بالكتابيات وأكل طعام أهل الكتاب كما في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ﴾ [المائدة:5].
- ثانيا– ولو كان الخطاب عاما فكيف قبِلت الشريعة من أهل الكتاب دفع الجزية، كما في قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾. [التوية: 29]. والمعنى أنهم إذا لم يسلموا ورضوا بدفع الجزية مع بقائهم على دينهم، عصموا دماءهم بذلك، ولم يكرهوا على الإسلام.
- ثالثا– ولو كان الخطاب عاما، كيف يكون للنبي ﷺ خادم يهودي يخدمه، وعاده في مرضه، ودعاه إلى الإسلام قبل موته فأسلم؟ كما في حديث أنس رضي الله عنه، قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ، فمرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: “أسلم”، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم ﷺ، فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: “الحمد لله الذي أنقذه من النار”([23]).
- رابعا – ولو كان الخطاب عاما لما نهى النبي ﷺ عن قتل الكافرات غير المقاتلات وصبيانهم، كما صح من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة، فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان([24]). وفي رواية: (فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان)([25]).
- خامسا – وفي رواية عن رباح بن ربيع، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا، فقال: “انظر علام اجتمع هؤلاء؟”. فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: “ما كانت هذه لتقاتل”. قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا. فقال: “قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا”([26]). وفي رواية بلفظ: “الـحَقْ خالدا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا”([27]).
- سادسا – ولو كان الخطاب عاما لما رهن النبي ﷺ درعه عند يهودي، ولما أبقاه على قيد الحياة، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير)([28]).
- سابعا– لو كان الخطاب عاما لما أفلت النبي ﷺ عبدَ الله بنَ أبي سلول مع علمه بنفاقه، وهو الذي قال: “لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل”، كما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه -وفيه-: قال عبد الله بن أبيّ: أو قد فعلوا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي ﷺ: “دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)([29]).
- ثامنا – ولو كان الخطاب عاما لكان يكفيه – صلى اله عليه وسلم- أن يدعو الله على من حاربه بالزوال، ولم يفعل، بل تعامل معهم بقلب رؤوف رحيم، ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله! هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: “لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، قال: فناداني ملك الجبال، وسلم علي، ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله ﷺ: “بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئا”([30]).
- تاسعا – ولو كان الخطاب عاما لما قبل النبي ﷺ من امراة إجارة مشرك وتأمينه، كما ثبت في حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: (ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فقال: “من هذه؟”. فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: “مرحبا بأم هانئ”. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات، ملتحفا في ثوب واحد، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، عليّ، أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة. فقال رسول الله ﷺ: “قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ…”([31]). وفي رواية: قالت: (قلت: ألم تر ما لقيت من ابن أبي؟، أجرت حموين لي من المشركين، فأراد أن يقتلهما. فقال: “ليس له ذلك، قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت… الحديث([32]).
استطراد
هناك ملمح آخر لسبب قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة، وهو أنهم امتنعوا عن دفع الزكاة بشبهة – كما سبق بيان ذلك- لكن لما اقترن منعهم هذا بتكتلهم وتجمعهم على ذلك، عد هذا في الظاهر شق لعصا المسلمين وتفريق لصفهم، والحق أن هذا بُعد نظر من الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، لم يلتفت له أحد ممن كان معه، وهذا كفيل بأن يؤهله لقيادة الأمة وخلافة النبي ﷺ، لأن مثل هذه المواقف الحاسمة قلّ من ينتبه لها إلا من أوتي سياسة وفهما قياديا بصيرا بمصالح الأمة وإدراكا للمخاطر التي تحدق بها في العاجل والآجل. والله أعلم.