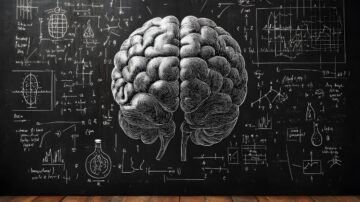لما نتأمل السيرة النبوية والدعوة التي جاء بها النبي ﷺ، نجد أنه جاء يؤسس مجتمعاً يقوم على العلم في كل شيء، حتى يتحول العلم إلى ثقافة تتشكل فيها المعارف والأذواق والمهارات والتطلعات الروحية والمادية ويقوم عليها السلوك.
ولهذا فإن النبي ﷺ قام بتحول كبير في ثقافة المجتمع الذي بعث فيه ، أدى به إلى تأسيس مجتمع جديد في نظرته للعالم، وفي بنائه المعرفي، وفي سلوكه، وفي قيمه، وفي ذوقه، وفي إطلاق قدرات الإنسان وشحذ فعاليته الروحية والعقلية والنفسية والمهارية، حتى صار المجتمع المسلم مركز إشعاع ديني وحضاري، جعل الناس يدخلون أفواجا في الدين، وينضوون تحت ظلال الحضارة الوليدة، ويساهمون فيها.
فلم يأت النبي ﷺ بالقرآن من عند الله لمجرد أن يعرف الناس وتزداد معارفهم، ويعرفون الله ورسوله والقرآن والأنبياء وعالم الشهادة وعالم الغيب، وغيرها من أمور الشرع وأمور الدنيا، من المعارف فحسب، بل لتتحول هذه المعارف التي جاء بها القرآن والسنة، إلى منبع للتصورات والمفاهيم والقيم، وأن توجه حياتنا، وتضبط سلوكنا، وتزكي أنفسنا. لأن تلك المعارف التي جاء بها الوحي، تمثل الحق، وجاءت من الحق. ولا معنى لأن نعرف الحق ثم لا نلتزم به، ولا نعمل به، ولا نصوغ حياتنا وفقه!
فالعلم الذي جاء به النبي ﷺ في القرآن والسنة، إنما جاء ليخرج الإنسان من رؤية وثنية للعالم، وقيم جاهلية، ومجتمع طبقي عنصري، ومحدودية للعلم والمهارات الحياتية، ليتحول إلى مجتمع جديد متحضر، وفق رؤية الإسلام. وهذا يتطلب أن المعارف التي جاء بها الوحي، ينبغي أن تصير المحيط أو الوسط الذي تتشكل فيه كل أفكارنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا وأذواقنا وأشواقنا الدنيوية والأخروية. أو بعبارة مالك بن نبي؛ يتحول العلم إلى مؤسس لثقافة الفرد والجماعة. وبهذا فإن الثقافة التي يشكلها الوحي هي ثقافة تبني على العلم كل “الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه”، وليست ثقافة الجاهلية الأولى، ولا ثقافة الأساطير التي نشأت عليها الحضارات القديمة أو الحديثة.
ولهذا، فإن المتأمل فيما أنجزته الدعوة النبوية، يرى أنها أوجدت وسطاً جديداً للقيم والمعايير، التي على أساسها يعيش الانسان ويتعامل ويسعى وينجز، حتى تحول ما جاء به القرآن والسنة إلى مؤسس لثقافة جديدة، شكلت “المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته” .
وفي هذا السياق، فإن الأستاذ مالك بن نبي عليه رحمة الله، وهو يتأمل ويدرس ويحلل وضع أمتنا وحضارتنا الإسلامية، وجد أن وضعنا المتميز بالتخلف الحضاري، لا يمكن أن يتغير ما لم نستعد ذلك المحيط الذي شكله الوحي والدعوة النبوية، لنعيد تشكيل شخصية الإنسان المسلم فرداً وجماعةً، ونعيد تشكيل وعينا وما يترتب عليه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [سورة الرعد: 11]؛ أي تغيير وعي الإنسان وفكره وسلوكه وذوقه ومهاراته. وهذا الذي يسميه مالك بن نبي الثقافة.
وهذا يتطلب منا بناء ثقافة علمية تكون هي الوسط (البلازما بلغة الطب) التي يتشكل فيها وعينا بذاتنا وبغيرنا، وتتشكل فيها رؤيتنا للعالم، وتبنى وفقها أذواقنا، ومعارفنا، وسلوكياتنا، وخبراتنا، ومهاراتنا، لنستطيع أن نبدأ دورتنا الحضارية باقتدار من جديد. وهذا منبعه القرآن، لأنه كتاب الله تعالى الذي يؤسس كل حياتنا على العلم، ولا يترك مساحة للفوضى، والخرافة، والأساطير، والعشوائية.
انظر إلى قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (الاسراء، 36)، وقوله تعالى: {… وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} (فاطر، 28)، وقوله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} (الزمر، 9)، وغيرها من الآيات التي تجعل كل شيء يقوم على العلم؛ في تصوراتنا وأقوالنا وأفعالنا وكل تصرفاتنا.
بل أن النظر في أقوال وأفعال النبيﷺ، يجد أنها كلها تدل على تبجيله للعلم، وتوجيهه أصحابه وأمته من بعده إلى أن يؤسسوا حياتهم على العلم. ولعل أول ما يتبادر إلى النظر هو فرضية طلب العلم: ﴿طلب العلم فريضةٌ على كل مسلمٍ﴾ ، وتقديم النبي ﷺ للأقرأ والأعلم في أمور القضاء والقيادة والتجارة والحكم والصلاة على غيره، وغيرها من التصرفات التي بينت أن المجتمع المسلم ينبغي أن يقوم على العلم، وأن يتحول العلم فيه إلى ثقافة تشكل المحيط الذي تنمو فيه شخصية الأفراد والمجتمع، وتتشكل فيه التصورات، ويسلك فيه المجتمع طريق الحضارة.
والتاريخ شاهد على الثورة العلمية التي حدثت في تاريخ أمتنا بمجيء الوحي، وأن العلم بكل أصنافه وفروعه وتخصصاته ومجالاته صار ركيزة المجتمع، والوسط الذي هيأ لأمتنا التفوق الحضاري طيلة قرون، وأن ثقافتنا لما تخلت عن العلم أساساً لها، واتخذت التقليد والأساطير والخرافات بكل أنواعها متكأً، تحولت أمتنا إلى أمة متخلفة، يعبث بها خصومها، وتفتن في مصيرها.